 رد: شرح العمدة لابن تيمية كتاب الصيام --- متجدد فى رمضان
رد: شرح العمدة لابن تيمية كتاب الصيام --- متجدد فى رمضان
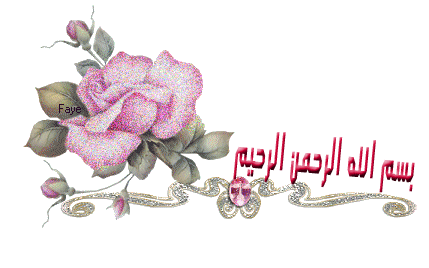
شرح العمدة لابن تيمية كتاب الصيام
تقي الدين أبو العباس أحمد بن تيمية
من صــ 786الى صــ 795
(55)
المجلد الثانى
كتاب الصيام
(25)

863 - ما روى علي بن الحسين: أن صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوره في اعتكافه في المسجد في العشر الأواخر من رمضان, فتحدثت عنده ساعة, ثم قامت تنقلب, فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها يقلبها, حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب أم سلمة؛ مرَّ رجلان من الأنصار, فسلما عللا رسول الله صلى الله عليه وسلم, فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: «على رسلكما؛ إنها صفية بنت حيي». فقالا: سبحان الله! وكَبُر عليهما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الشيطان يجري من الإِنسان مجرى الدم, وإني خشيت أن يلقي في أنفسكما شيئاً». رواه الجماعة إلا الترمذي.
وفي رواية متفق عليها: وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد.
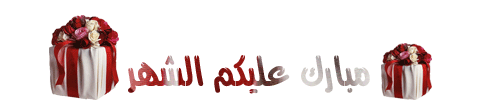
وفي لفظ للبخاري: كان النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد عنده أزواجه, فرحن, فقال لصفية بنت حيي: «لا تعجلي حتى أنصرف معك» , وكان بيتها في دار أسامة بن زيد, فخرج النبي صلى الله عليه وسلم معها, فلقيه رجلان. . . (وذكر الحديث).
وهذا صريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج معها من المسجد, وأن قولها: «حتى بلغت باب المسجد عند باب أم سلمة»؛ تعني: باباً غير الباب الذي خرج منه؛ فإن حجر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كانت شرقي المسجد وقبلته, وكان للمسجد عدة أبواب, أظنها ستة, فيمر على الباب بعد الباب, والرجلان رأيا النبي صلى الله عليه وسلم ومعه المرأة خارج المسجد؛ فإنه لو كان في المسجد؛ لم يحتج إلى هذا الكلام.
وقوله: «لا تعجلي حتى أنصرف معك» , وقيامه معها ليقلبها: دليل على أن مكانها كان بينه وبين المسجد مسافة يخاف فيها من سير المرأة وحدها ليلاً, وذلك والله أعلم قبل أن يتخذ حجرتها قريباً من المسجد, ولهذا قال: «كان مسكنها في دار أسامة».
وهذا كله مبين لخروجه من المسجد؛ فإن خروجه إلى مجرد باب المسجد لا فائدة فيه, ولا خصوص لصفية فيه لو كان منزلها قريباً دون سائر أزواجه, فهذا خروج للخوف على أهله, فيلحق به كل حاجة.
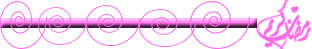
ولا يجوز أن يقال: اعتكافه كان تطوعاً, وللمتطوع أن يدع الاعتكاف؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحفظ اعتكافه مما ينقصه, ولهذا كان لا يدخله إلا لحاجة, ويصغي رأسه إلى عائشة لترجله, ولا يدخل.
ولأنه لو ترك الاعتكاف ساعة؛ لم يكن قد اعتكف العشر الأواخر, وهو صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر.
ثم إنه كان يقضي هذا الاعتكاف إذا فاته؛ فكيف يفسده أو يترك منه شيئاً؟!
على أن أحداً من الناس لم يقل: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد كان ترك اعتكافه بخروجه مع صفية؛ فإن العمدة في صفة الاعتكاف فرضه ونفله على اعتكافه صلى الله عليه وسلم, كيف وقد كان إذا عمل عملاً أثبته صلى الله عليه وسلم.
* فصل:
وأما عيادة المريض وشهود الجنازة؛ ففيه روايتان منصوصتان:
إحداهما: يجوز.
قال في رواية ابن الحكم: المعتكف يعود المريض ويشهد الجنازة.
864 - ويروى عن عاصم بن ضمرة, عن علي رضي الله عنه «المعتكف يعود المريض ويشهد الجنازة والجمعة». وعاصم بن ضمرة عندي حجة.
وقال حرب: سل أحمد عن المعتكف يشهد الجنازة ويعود المريض ويأتي الجمعة؟ قال: نعم. ويتطوع في مسجد الجامع؟ قال: نعم؛ أرجو أن لا يضره. قيل: فيشترط المعتكف الغداء أو العشاء في منزله؟ فكره ذلك. قيل: فيشترط الخياطة في المسجد؟ قال: لا أدري. قيل: فهل يكون اعتكاف إلا بصيام؟ قال: قد اختلفوا فيه.
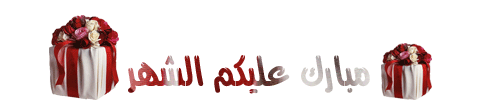
وكذلك نقل عن الأثرم: يخرج لصلاة الجنازة.
وقال في رواية حنبل: ويعود المريض, ولا يجلس, ويقضي الحاجة, ويعود إلى معتكفه, ولا يشتري, ولا يبيع؛ إلا أن يشتري ما لا بد له منه؛ طعام أو نحو ذلك, وأما التجارة والأخذ والعطاء؛ فلا يجوز شيء من ذلك.
والرواية الثانية: لا يجوز ذلك إلا بشرط.
قال في رواية المروذي في المعتكف: يشترط أن يعود المريض ويتبع الجنازة؟ قال: أرجو. كأنه لم ير به بأساً.
ويشبه أن تكون هي الآخرة؛ لأن ابن الحكم قديم.
وهذه اختيار عامة أصحابنا: الخرقي, وأبي بكر, وابن أبي موسى, والقاضي, وأصحابه, وغيرهم.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإِنسان.
فعلم أن هذه سنة الاعتكاف, وفعله يفسر الاعتكاف المذكور في القرآن.
وقد تقدم حديث عائشة رضي الله عنها على المعتكف: «أن لا يعود مريضاً, ولا يشهد جنازة, ولا يمس امرأة, ولا يباشرها, ولا يخرج إلا لما لا بد منه».
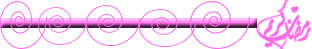
865 - وعن عائشة رضي الله عنها؛ قالت: «إن كنت لأدخل البيت للحاجة, والمريض فيه, فما أسأل عنه إلا وأنا مارة». متفق عليه.
866 - وعنها؛ قالت: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر بالمريض وهو معتكف, فيمر كما هو, ولا يعرج يسأل عنه». رواه أبو داوود, عن ليث بن أبي سليم, عن ابن القاسم, عن أبيه, عن عائشة.
وفي لفظ: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يعود المريض وهو معتكف».
ولأنه خروج لما له منه بد, فلم يجز؛ كما لو خرج لزيارة والديه أو صديقه أو طلب العلم ونحو ذلك من القرب.
فعلى هذا: إذا خرج لحاجة؛ فله أن يسأل عن المريض في طريقه, ولا يجلس عنده, ولا يقف أيضاً, بل يسأل عنه مارّاً؛ لأنه [مقيم] لغير حاجة.
وقد ذكر عائشة مثل ذلك.
وقول أحمد: «يعود المريض ولا يجلس»: دليل على جواز الوقوف؛ إلا أن يحمل على الرواية الأخرى.
ووجه الرواية الأولى: ما احتج به أحمد, وهو ما رواه عاصم بن ضمرة, عن علي رضي الله عنه؛ قال: «إذا اعتكف الرجل؛ فليشهد الجمعة, وليحضر الجنازة, وليعد المريض, وليأت أهله يأمرهم بحاجته وهو قائم».
867 - وعن عبد الله بن يسار: «أن عليّاً أعان ابن أخيه جعدة بن هبيرة بسبع مائة درهم من عطائه أن يشتري خادماً, فقال له: ما منعك أن تبتاع خادماً؟! فقال: إني كنت معتكفاً. قال: وما عليك لو خرجت إلى السوق فابتعت؟!».
868 - وعن إبراهيم؛ قال: «كانوا يحبون للمعتكف أن يشترط هذه الخصال, وهي له [و] إن لم يشترط: عيادة المريض, ولا يدخل سقفاً, ويأتي الجمعة, ويشهد الجنازة, ويخرج في الحاجة».
869 - قال: وكان إبراهيم يقول: «لا يدخل المعتكف سقيفة إلا لحاجة أو سقف المسجد». رواهن سعيد.
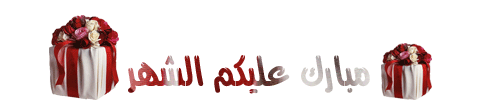
870 - وقد روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «المعتكف يتبع الجنازة ويعود المريض». رواه ابن ماجه, وراويه متروك الحديث.
وأيضاً؛ فإن هذا خروج لحاجة لا تتكرر في الغالب, فلم يخرج به عن كونه معتكفاً؛ كالواجبات.
وذلك أن عيادة المريض من الحقوق التي تجب للمسلم على المسلم, وكذلك عيادة المريض. . .؛ فعلى هذه الرواية هل يقعد عنده؟. . . .
وإن تعين عليه الصلاة على الجنازة, وأمكنه فعلها في المسجد؛ لم يجز الخروج إليها, وإن لم يمكنه؛ فله الخروج إليها.
وكذلك يخرج لتغسيل الميت وحمله ودفنه إذا تعيَّن عليه.
وأما إذا شرط ذلك؛ فيجوز في المنصوص المشهور كما تقدم.
وقال في رواية الأثرم: يشترط المعتكف أن يأكل في أهله, ويجوز الشرط في الاعتكاف.
وحكى الترمذي وابن المنذر عن أحمد. . . .
871 - لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لضباعة: «حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني؛ فإن لك على ربك ما اشترطت».
عام, فإذا كان الإِحرام الذي هو ألزم العبادات بالشروع يجوز مخالفة موجبه بالشرط؛ فالاعتكاف أولى.
872 - [وعن إبراهيم؛ قال: «كانوا يحبون للمعتكف أن يشترط هذه الخصال, وهي له إن لم يشترط: عيادة المريض, ولا يدخل سقفاً, ويأتي الجمعة, ويشهد الجنازة, ويخرج في الحاجة».]
وكان إبراهيم يقول: «لا يدخل المعتكف سقيفة إلا لحاجة أو سقف المسجد». رواه سعيد.
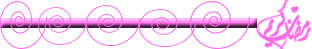
* فصل:
قال أبو بكر: لا يقرأ القرآن, ولا يكتب الحديث, ولا يجالس العلماء,
ولا يتطيب, ولا يشهد جنازة, ولا يعود مريضاً؛ إلا أن يشترط في اعتكافه.
ذكر ابن حامد والقاضي وغيرهما: أن له أن يشترط كل ما في فعله قربة؛ مثل: العيادة, وزيارة بعض أهله, وقصد بعض العلماء.
وقسموا الخروج ثلاثة أقسام:
أحدها: ما يجوز بالشرط ودونه ولا يبطل الاعتكاف.
وهو الخروج لما لا بد منه من قضاء الحاجة والخوف والمرض ونحو ذلك مما تقدم.
والثاني: ما لا يجوز الخروج إليه إلا بشرط.
وهو عيادة المريض, وزيارة الوالدة, واتباع الجنازة.
والثالث: ما لا يجوز الخروج إليه بشرط وبغير شرط, ومتى خرج إليه؛ بطل اعتكافه.
وهو اشتراط ما لا قربة فيه؛ كالفرجة والنزهة والبيع في الأسواق.
وكذا لو شرط أن يجامع متى شاء.
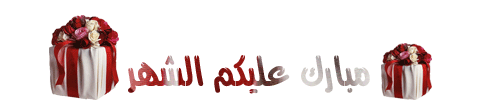
قال بعض أصحابنا: وكذا إن شرط التجارة في المسجد أو التكسب بالصنعة فيه أو خارجاً منه.
وأما المنصوص عن أحمد, والذي ذكره قدماء وأصحابه؛ فهو اشتراط عيادة المريض واتباع الجنازة.
قال ابن عقيل: وزاد ابن حامد فقال: ولا بأس أن يشترط زيارة أهله لأنه لما كان له أن يشترط قطعه والخروج منه؛ كان له أن يشترط تحلل القربة له.
قال: والجواب عما ذكره ابن حامد: أنه ليس إذا ملك أن يقطع الاعتكاف, يملك أن يشترط شيئاً يبطل مثله الاعتكاف مع عدم الشرط؛ كما أنه يجوز أن يشترط يوماً ويوماً لا, ولا يملك أن يطأ في اليوم الذي لم ينذر اعتكافه, ومع هذا لا يملك أن يطأ.
فأما اشتراط المباح؛ على ما ذكره القاضي: لا يجوز.
وقال بعض أصحابنا: يجوز شرط ما يحتاج إليه؛ كالأكل والمبيت في المنزل؛ لأن الاعتكاف يجب بعقده, فكان الشرط إليه فيه كالوقف.
ولأنه لا يختص بقدر, فإذا شرط الخروج؛ فكأنه نذر القدر الذي أقامه.
أما الأكل؛ ففيه عن أحمد روايتان؛ كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
وأما المبيت؛ فقال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يُسأل عن المعتكف يشترط أن يأكل في أهله؟ قال: إذا اشترط؛ فنعم. قيل له: وتجيز الشرط في الاعتكاف؟ قال: نعم. قلت له: فيبيت في أهله؟ قال: إذا كان تطوعاً؛ جاز.
فأخذ بعض أصحابنا من هذا جواز شرط المبيت لجواز شرط الأكل, [و] ليس بجيد؛ فإن أحمد أجاز الأكل بالشرط مطلقاً, وأجاز المبيت في الأهل إذا كان متطوعاً, ولم يعلقه بشرط, فعلم أنه لا يجوز في النذر.
وليس هذا لأجل الشرط, بل لأن التطوع له تركه متى شاء؛ فإذا بات في أهله؛ كأنه يعتكف النهار دون الليل.
ولو نذر أن يعتكف عشرة أيام يبيت بالليل عند أهله؛ يكون قد نذر اعتكاف الأيام دون الليالي, فيكون اعتكاف كل يوم اعتكافاً جديداً يحتاج إلى نية مستأنفة.
وإذا خرج بالليل؛ لم يكن معتكفاً, حتى لو جامع أهله فيه؛ كان له ذلك.
فأما جواز المبيت في أهله, مع كونه معتكفاً؛ فهذا إخراج للاعتكاف عن حقيقته. . . .

__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟ فبكى رحمه الله ثم قال : أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.
|

