 رد: معارك حربية مهمة فى التاريخ الاسلامى ...يوميا فى رمضان
رد: معارك حربية مهمة فى التاريخ الاسلامى ...يوميا فى رمضان

معركة بلاط الشهداء(2)
(114 هـ / 732م)
ويكيبيديا
(32)
اختلاف الآراء حول المعركة
انقسمت الآراء التاريخية حول المعركة إلى ثلاث وجهات نظر. ففي الوقت الذي رأى فيه المؤرخون الغربيون كجيبون وجيله من المؤرخين الذين اعتمدوا على تأريخ عام 754 وتأريخ فريدغر، بأن شارل مارتل أنقذ المسيحية، وأن المعركة بلا شك كانت حاسمة في تاريخ العالم. إلا أن المؤرخين المعاصرين قد انقسموا حول ذلك، إلى معسكرين. الأول يتفق مع جيبون، والآخر يقول بأن المعركة بُولغ فيها بشدة وتم تصويرها وكأنها نهاية عصر الفتح الإسلامي. بل وحتى المعسكر الأول الذي رأى أهمية المعركة التاريخية الكبيرة، اتخذ عدد منهم نهجًا أكثر اعتدالاً ودقة في وصف أهمية المعركة، بدلاً من الوصف الدراماتيكي الذي اتخذه جيبون. أبرز هؤلاء هو ويليام واتسون، الذي آمن بأهمية المعركة تاريخيًا، لكنه حللها عسكريًا وثقافيًا وسياسيًا، بدلاً من أن ينظر إليها من منظور الصراع الكلاسيكي بين المسلمين والمسيحيين. أما الآن، فقد انقسم المؤرخون الغربيون المعاصرون بشكل واضح على أهمية المعركة، وأين ينبغي أن تُصنّف في التاريخ العسكري.
آراء تضخم من أهمية المعركة
يقول المؤرخ إدوارد جيبون في كتابه "اضمحلال الإمبراطورية الرومانية": «خط انتصار [المسلمين] طوله ألف ميل من جبل طارق حتى نهر اللوار كان غير مستبعد أن يكرر في مناطق أخرى في قلب القارة الأوروبية حتى يصل بالساراسنز [يقصد المسلمين] إلى حدود بولندا ومرتفعات أسكتلندا، فالراين ليس بأصعب مرورا من النيل والفرات، وإن حصل ما قد ذكرت كنا اليوم سنرى الأساطيل الإسلامية تبحر في مصب التايمز بدون معارك بحرية ولكان القرآن يدرس اليوم في أوكسفورد ولكان علماء الجامعة اليوم يشرحون للطلاب باستفاضة عن الوحي النازل على محمد.[54]»

مقاطعة فريزلند
لم يكن جيبون وحده الذي أثنى على شارل مارتل كمنقذ للمسيحية والحضارة الغربية، فقد قال هربرت جورج ويلز في كتابه "موجز تاريخ العالم": «عندما عبر المسلمون البرانس عام 720، وجدوا مملكة الفرنجة تحت الحكم الفعلي لشارل مارتل رئيس بلاط قصر سلالة كلوفيس، الذي تحققت الهزيمة الساحقة في بواتييه عام 732 على يديه. كان شارل مارتل هذا عمليًا سيد أوروبا في شمال جبال الألب من البرانس إلى هنغاريا، مترأسًا عدد كبير من الحكام الناطقين بالفرنسية اللاتينية، واللغات الألمانية العليا والمنخفضة.» ومن أنصار هذا المعسكر أيضًا المؤرخ البلجيكي غودفروا كورث، الذي كتب عن المعركة قائلاً: «يجب أن تظل هذه المعركة واحدة من أهم الأحداث الكبرى في تاريخ العالم، لأنها حددت ما إذا كانت الحضارة المسيحية ستستمر أم سيسود الإسلام جميع أنحاء أوروبا.[55]» تحمس أيضًا على وجه الخصوص المؤرخون الألمان في مدح شارل مارتل؛ ومدح هذا النصر العظيم على حد وصف كارل فريدريش فيلهلم شليغل،[56] الذي قال: «لقد حفظت سواعد شارل مارتل الأمم المسيحية الغربية من قبضة الإسلام المدمرة.» وقد نقل إدوارد كريزي رأي رانكه عن تلك الفترة قائلاً: «كانت أحد أهم الحقب في تاريخ العالم، فمع بداية القرن الثامن، عندما هددت المحمدية إيطاليا وبلاد الغال، وعدد من المناطق الوثنية القديمة كساكسونيا وفرايزلاند مرة أخرى عبر نهر الراين. وفي ظل هذا الخطر الذي هدد المجتمعات المسيحية، ظهر الأمير الشاب من أصل جرماني شارل مارتل، كبطلهم الذي حافظ عليهم بكل الطاقة الضرورية اللازمة للدفاع عن النفس، وفي النهاية، استطاع نشرهم في مناطق جديدة.[56]»

ساكسونيا
كما قال المؤرخ العسكري الألماني هانس ديلبروك عن هذه المعركة: «لم يكن هناك معركة أكثر أهمية منها في تاريخ العالم.[57]» كما أكد المؤرخ هنري هالام أنه لو لم يحتوِ شارل مارتل هجوم المسلمين، لما كان هناك شارلمان ولا الإمبراطورية الرومانية المقدسة أو حتى الدولة البابوية. وقد صنّف المؤرخ توماس أرنولد انتصار شارل مارتل بأنه أهم من انتصار أرمينيوس في تأثيره على كل التاريخ الحديث: «كان انتصار شارل مارتل في تور كان من بين أطواق النجاة التي أثرت لقرون في سعادة البشرية.[58]» وقال لويس غوستاف وتشارلز شتراوس في كتابهما "المسلمون والفرنجة؛ أو شارل مارتل وإنقاذ أوروبا": «النصر الذي تم حاسم ونهائي، فتراجع سيل الغزو العربي إلى الوراء، وأنقذت أوروبا خطر نير المسلمون.[59]» كما قال تشارلز أومان، في كتابه "تاريخ فن الحرب في العصور الوسطى"، بأن: «في بواتييه، قاتل الفرنجة كما فعلوا قبل مئتي سنة في كاسيلينيوم، ككتلة واحدة صلبة، دون أن تنكسر صفوفهم أو يحاولوا المناورة. تحقق انتصارهم من خلال تكتيكات دفاعية بحتة باستخدام المشاة؛ محطمين العرب المتعصبين مرة بعد مرة إلى قطع، إلى أن هربوا في النهاية في ستار الليل. ولكن دون سعي من جهة كارل للسماح لرجاله بمطاردة العدو المكسور.[60]» وكتب جون باغنيل بيري في مطلع القرن العشرين: «معركة تور... كثيرًا ما تصور كحدث من الدرجة الأولى لتاريخ العالم، لأنه بعدها، وصل تغلغل الإسلام في أوروبا في النهاية إلى طريق مسدود.[61]»
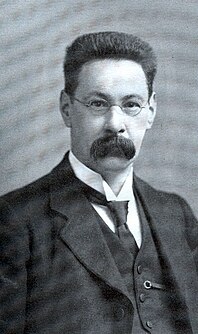
توماس أرنولد
وقال المؤرخ الأمريكي ويليام واتسون عن أهمية المعركة أنها أوقفت جيوش المسلمين، وأبقت الحضارة الغربية بجذور المسيحية والتي ستكون سببًا في ازدهار الحضارة الغربية وتطورها.[62] كما وصف الكاتب جون هنري هارين في كتابه "مشاهير رجال العصور الوسطى" المعركة قائلاً: «تعد معركة تور أو بواتييه كما ينبغي أن يطلق عليها، أحد المعارك الحاسمة في العالم. فهي التي جعلت المسيحيين، لا المسلمين، السلطة الحاكمة في أوروبا".[63]»
آراء تقلل من أهمية المعركة

أستراسيا، موطن الفرنجة (الأخضر الداكن) والفتوحات التالية (ظلال اللون الأخضر الأخرى).
وعلى الجانب الآخر، رأى عدد من المؤرخين الغربيين، برأي المؤرخين المسلمين في أن المعركة لم تكن بتلك الأهمية. فقد قال برنارد لويس: «إن المؤرخين العرب، إذا ما ذكروا هذا الاشتباك [يعني المعركة] بصفة عامة، يذكرون أنها كانت مناوشات طفيفة.[64]» وكتب غوستاف جرونبوم: «هذه الانتكاسة قد تكون مهمة من وجهة النظر الأوروبية، ولكن بالنسبة للمسلمين في ذلك الوقت، لم يروا فيها أي خطة كبير، وبالتالي لم تكن لها أهمية أكبر من ذلك.[65]» ذكر ابن عذاري المعركة في كتابه البيان المغرب، قائلاً: «ولي الأندلس عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي، فغزا الروم، واستشهد مع جماعة من عسكره سنة 115 هـ، بموضع يعرف ببلاط الشهداء.[50]» وقد أشار هنري كوبيه إلى أن نفس الاسم البلاط أطلق على معركة تولوز،(3) والعديد من المعارك الأخرى التي هُزم فيها المسلمين.[66] ويقول الإيطالي أليساندرو باربيرو: «يميل المؤرخون اليوم إلى التقليل من أهمية معركة بواتييه، حيث أن هدف القوات العربية التي هزمها شارل مارتل لم يكن فتح مملكة الفرنجة، ولكنه ببساطة لجمع الغنائم من دير سانت مارتن الغني في تور.[67]» كذلك كتب توماز ماستناك: «لقد نسج المؤرخون المعاصرون أسطورة حول هذا الانتصار، بأنه الذي أنقذ أوروبا المسيحية من المسلمين. فإدوارد جيبون، على سبيل المثال، دعا شارل مارتل بمنقذ المسيحية وأن المعركة التي دارت قرب بواتييه غيرت تاريخ العالم ... وقد ظلت تلك الأسطورة حية بشكل جيد في عصرنا ... رغم أن المعاصرين للمعركة، لم يبالغوا في أهميتها. فتأريخ فريدغر، الذي كتب على الأرجح في منتصف القرن الثامن، صوّر المعركة كواحدة من العديد من المعارك بين المسيحيين والعرب المسلمين - بل باعتبارها واحدة من سلسلة حروب التي خاضها أمراء الفرنجة من أجل الغنائم والأراضي ... وصف تاريخ فريدغر معركة بواتييه كما هي بالفعل: حلقة في الصراع بين الأمراء المسيحيين مثل الكارولينجيون الذين سعوا لضم أقطانيا تحت حكمهم.[68]» كذلك يرى المؤرخ الإيطالي فرانكو كارديني في كتابه "أوروبا والإسلام"، قائلاً: «إنه من الحصافة أن تقلل من أهمية أو نفي الصفة الأسطورية لهذا الحدث، الذي لا يعتقد أي شخص الآن أنه كان حاسمًا. إن أسطورة النصر العسكري المميز تدخل اليوم في نطاق الكليشيهات الإعلامية، التي لا يصعب القضاء عليها. فمن المعروف جيدًا كيف نسج الترويج للفرنجة وتمجيد البابوية للنصر الذي تم في الطريق بين تور وبواتييه...[69]»
وفي مقدمة كتابهما "رفيق القارئ إلى التاريخ العسكري" لخّص روبرت كاولي وجيفري باركر وجهة النظر الحديثة هذه عن المعركة، قائلين: «إن دراسة التاريخ العسكري شهدت تغيرات جذرية في السنوات الأخيرة. فلم يعد نهج الطبول والأبواق القديم فعّالا، حيث حظيت عوامل كالاقتصاد والخدمات اللوجستية والاستخبارات والتكنولوجيا بالاهتمام لتقييم المعارك والحملات والخسائر. واكتسبت كلمات مثل "استراتيجية" و"عمليات" معانٍ ربما لم تكن معروفة منذ جيل مضى. وقد غيرت الأبحاث الجديدة وجهات نظرنا ... على سبيل المثال، العديد من المعارك التي أدرجها إدوارد شيبرد كريزي عام 1851 في كتابه المشهور "أكثر خمسة عشر معركة حسمًا في العالم" نذكر منها هنا، المواجهة بين المسلمين والمسيحيين في بواتييه-تور عام 732، التي كان ينظر إليها أنها حدثًا فاصلاً، خُفّضت إلى مجرد غارة.[70]»
الجدل حول أعداد الجيشين
افترض معظم المؤرخين أن الجيشين التقيا عند ملتقى نهري كلين وفيين بين تور وبواتييه، ولا يعرف عدد الجنود في كلا الجيشين. وقد وصف تأريخ عام 754 وهي وثيقة لاتينية معاصرة للمعركة، المعركة بتفصيل أكبر من أي مصدر لاتيني أو عربي آخر، حيث نصت على أن "شعب أوستراسيا [قوات الفرنجة]، الأكثر جندًا وتسليحًا بشكل هائل، قتل الملك عبد الرحمن"،[71] وهو ما يتوافق مع ما ذكره العديد من المؤرخين العرب والمسلمين. ومع ذلك، تختلف كل المصادر الغربية تقريبًا مع ذلك، فتقدّر قوات الفرنجة بحوالي 30,000 مقاتل، أي أقل من نصف عدد قوات المسلمين.[72]

منذ القرن التاسع الميلادي, يعتقد بأن جيروم هو مؤلف كتاب الباباوات.
حاول المؤرخون المعاصرون تقدير أعداد الجيشين، اعتمادًا على تقدير ما العدد الذي تستوعبه أرض المعركة، وما العدد الذي يمكن لشارل مارتل أن يجمعه من مملكته ويضيف إليه خلال حملته، ومع تقدير أعداد قوات المسلمين، وما لحق بها من أعداد قبل تور، لتفوق بكثير أعداد الفرنجة، وبالاستناد إلى مصادر إسلامية غير معاصرة للمعركة. قدّر كريسي قوات المسلمين بحوالي 80,000 مقاتل أو أكثر. وفي عام 1999، قدّر المؤرخ بول ديفيس قوات المسلمين بحوالي 80,000 والفرنجة في حوالي 30,000،[72] وأشار بأن المؤرخين الحديثين قدروا قوات الجيش الأموي في تور ما بين 20,000-80,000 مقاتل.[73] وقد رفض المؤرخ إدوارد شونفيلد التقديرات القديمة بأن أعداد الأمويين بين 60,000-400,000 والفرنجة 75,000، قائلاً: «إن تقدير عدد الأمويين بأكثر من خمسين ألف جندي (وبأن الفرنجة كانوا أكثر) مستحيل لوجستيًا.[10]» وأيد ذلك، المؤرخ فيكتور ديفيس هانسون الذي اعتقد بأن الجيشين كانا تقريبًا بنفس الحجم حوالي 30,000 رجل.[74]
قد يكون المؤرخون الحديثون أكثر دقة من مصادر القرون الوسطى، حيث استندوا على تقديرات القدرات اللوجستية في المناطق الريفية المجاورة التي تكفي هذه الأعداد من الرجال والحيوانات. واتفق ديفيس وهانسون على كون وجوب اعتماد الجيشين على الريف المجاور، حيث لم يكن لديهما أنظمة كافية لتوفير الإمدادات اللازمة للحملتين. وقد قدّرت مصادر أخرى كغور الذي قدّر الجيش الفرنجي بين 15,000-20,000، بينما قدّره آخرون ما بين 30,000-80,000. وعلى الرغم من اختلاف تقدير قوات المسلمين بتفاوت كبير، إلا أن غور قدره ما بين 20,000-25,000، فيما زادته تقديرات أخرى إلى نحو 80,000 رجل.[75]

معركة تولوشة
معركة تولوز
خسائر المعركة غير معروفة، غير أن بعض المؤرخين بعد ذلك زعموا بأن قوات شارل مارتل خسرت حوالي 1,500، بينما منيت قوات المسلمين بخسائر ضخمة تصل إلى 375,000 رجل. وقد ذكرت تلك الأرقام في كتاب الباباوات الذي يروي انتصار أودو دوق أقطانيا في معركة تولوز. وقد صحّح بولس الشماس في كتابه تاريخ اللومبارد (الذي كتبه حوالي عام 785) أن هذا التأريخ دون تلك الأعداد كونها أعداد خسائر معركة تولوز (وزعم أيضًا أن شارل مارتل قاتل في تلك المعركة جنبًا إلى جنب مع أودو)، ولكن الكتاب اللاحقين، الذين ربما تأثروا بتأريخ فريدغر، نسبوا خسائر المسلمين فقط لشارل مارتل، وأصبحت المعركة التي وقعت فيها تلك الخسائر معركة بواتييه بلا شك.[76] كما ذكر تأريخ حياة باردولف المكتوب في منتصف القرن الثامن، أن قوات عبد الرحمن حرقت ونهبت ما في طريقها إلى ليموزين في طريق عودتهم إلى الأندلس، مما يعني أن الجيش لم يدمر إلى الحد الذي صوره تأريخ فريدغر.[77][78]
الهوامش
1 وصف الأسقف إيزيدور الباجي مدون تأريخ عام 754 خسائر المعركة بعبارة (باللاتينية: solus Deus numerum morientium vel pereuntium recognoscat) التي تعني "الله وحده يعلم عدد القتلى".[71][79][80]
2 نقل عنان في كتابه "دولة الإسلام في الأندلس" رواية منسوبة إلى شخص يدعى القديس دينيس "Saint Denis" يقول فيها: "وعندئد خرج العرب وملكهم عبد الرحمن من إسبانيا، مع جميع نسائهم وأولادهم وعددهم وأقواتهم".[81] مما يبرر هرع المسلمين لإنقاذ معسكرهم دفاعًا عن ذراريهم.
3 نقل المقري في كتابه "نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب" عن ابن حيان القرطبي، أن السمح بن مالك الخولاني قُتل في الوقعة المشهورة عند أهل الأندلس بوقعة البلاط.[82] والمعروف أن السمح قتل في معركة تولوز.
4 كانت قوات شارل مارتل خليطًا من قوات مسيحية ووثنية أشارت إليها وثيقة تأريخ المستعربين لعام 754، باسم "قوات الشمال"، كان أكثرها من أوستراسيا ونيوستريا،[83] وبورغنديا، وشوابيا،[84] بالإضافة إلى قوات من مرتزقة وثنيين لقبائل جرمانية عدة من حدود الراين[28][85] أشهرها السكسون[84]، إضافة إلى بقايا جيش أقطانيا بقيادة الدوق أودو.
المراجع
↑ تعدى إلى الأعلى ل: أب Tom oberhofer، "battle of poitiers 729 battle of Moussais, battle of Tours, Charles Martel Eudes of Aquitaine, Abd. er-Rahman, medieval warfare"، Home.eckerd.edu، مؤرشف من الأصل في 2 فبراير 2017، اطلع عليه بتاريخ 04 أكتوبر 2012.
^ Hanson, 2001, p. 141.
↑ تعدى إلى الأعلى ل: أبالحجي 1981، صفحة 193
^ Oman, 1960, p. 167, gives the traditional date of October 10, 732. Lynn White, Jr., Medieval Technology and Social Change, 1962, citing M. Baudot, 1955, goes with October 17, 733. Roger Collins, The Arab Conquest of Spain, 1989, concludes "late (October?) 733" based on the "likely" appointment date of the successor of Abdul Rahman, who was killed in the battle. See White, p. 3, note 3, and Collins, pp. 90-91.
↑ تعدى إلى الأعلى ل: أبأبو خليل 1998، صفحة 25
^ Bachrach, 2001, p. 276.
^ Fouracre, 2002, p. 87 citing the Vita Eucherii, ed. W. Levison, Monumenta Germaniæ Historica, Scriptores Rerum Merovingicarum VII, pp. 46–53, ch. 8, pp. 49–50; Gesta Episcoporum Autissiodorensium, extracts ed. G. Waitz, Monumenta Germaniae Historica, Scriptores XIII, pp. 394–400, ch. 27, p. 394.
^ Riche, 1993, p. 44.
^ Hanson, 2001, p. 143.
↑ تعدى إلى الأعلى ل: أب Schoenfeld, 2001, p. 366.
^ "Battle of Tours (European history) - Britannica Online Encyclopedia"، .britannica.com، مؤرشف من الأصل في 27 أغسطس 2008، اطلع عليه بتاريخ 04 أكتوبر 2012.
^ Hanson, 2001, p. 166.
^ Ranke, Leopold von. "History of the Reformation", vol. 1, 5
^ Davis, 1999, p. 106.
↑ تعدى إلى الأعلى ل: أبعنان 1997، صفحة 106
^المقري 1968، صفحة 15
^عنان 1997، صفحة 106-108
↑ تعدى إلى الأعلى ل: أبتالحجي 1981، صفحة 194
^الغنيمي 1996، صفحة 76
^مؤنس 2002، صفحة 303
^الغنيمي 1996، صفحة 65
^الحجي 1981، صفحة 205
^الغنيمي 1996، صفحة 64
↑ تعدى إلى الأعلى ل: أبمؤنس 2002، صفحة 216
^الغنيمي 1996، صفحة 63
^أبو خليل 1998، صفحة 18
^أبو خليل 1998، صفحة 30
↑ تعدى إلى الأعلى ل: أبالحجي 1981، صفحة 202
^الغنيمي 1996، صفحة 67
↑ تعدى إلى الأعلى ل: أبتعنان 1997، صفحة 99-100
^الغنيمي 1996، صفحة 66
^الغنيمي 1996، صفحة 66-67
^ Davis, Paul K. (1999) page 105
^الغنيمي 1996، صفحة 74
^الغنيمي 1996، صفحة 72-74
^عنان 1997، صفحة 105
^أرسلان -، صفحة 91
^السامرائي وذنون ومطلوب 2000، صفحة 58
^الغنيمي 1996، صفحة 77
^ Wolf, p. 145 (trans) Chronicle of 754
^ Fouracre, 2000, p. 96.
^الحجي 1981، صفحة 202-204
^مؤنس 2002، صفحة 333
↑ تعدى إلى الأعلى ل: أبSantosuosso 2004، صفحة 126
^مؤنس 2002، صفحة 336
^أرسلان -، صفحة 105
^عنان 1997، صفحة 131-134
^مؤنس 2002، صفحة 343
^ابن عذاري 1980، صفحة 28
↑ تعدى إلى الأعلى ل: أبابن عذاري 1980، صفحة 51
^المقري 1968، صفحة 236
^ابن عبد الحكم 1999، صفحة 292
^ الكامل في التاريخ-ذكر قتل عبد الرحمن أمير الأندلس وولاية عبد الملك بن قطن نسخة محفوظة 17 ديسمبر 2019 على موقع واي باك مشين.
^ The Decline And Fall Of The Roman Empire by Edward Gibbon, Chapter LII. نسخة محفوظة 22 فبراير 2017 على موقع واي باك مشين.
^ quoted in Frank D. Gilliard, The Senators of Sixth-Century Gaul, Speculum, Vol. 54, No. 4 (Oct., 1979), pp. 685-697
↑ تعدى إلى الأعلى ل: أب quoted in Creasy, 1851/2001, p. 158.
^ The Barbarian Invasions, page 441., Hans Delbrück
^ History of the later Roman Commonwealth, vol ii. p. 317, quoted in Creasy, 1851/2001, p. 158.
^ Moslem and Frank; or, Charles Martel and the rescue of Europe, Louis Gustave and Charles Strauss, page 122
^ Charles Oman, History of the Art of War in the Middle Ages, Vol. I, 58
^ Cambridge Medieval History p.374.
^ Watson, William, E. (1993). The Battle of Tours-Poitiers Revisited. Providence: Studies in Western Civilization v.2 n.1.[وصلة مكسورة] نسخة محفوظة 4 فبراير 2012 على موقع واي باك مشين.
^ Famous Men of The Middle Ages by John H. Haaren, LL.D. and A. B. Poland, Ph.D. Project Gutenberg Etext. نسخة محفوظة 26 سبتمبر 2009 على موقع واي باك مشين.[وصلة مكسورة]
^ Lewis, 1994, p. 11.
^ von Grunebaum, 2005, p. 66.
^(Coppée 2002, p. 13)
^ Barbero, 2004, p. 10.
^ Mastnak, 2002, pp. 99-100.
^ Cardini, 2001, p. 9.
^ 'Editors' Note', Cowley and Parker, 2001, p. xiii.
↑ تعدى إلى الأعلى ل: أب Wolf, 2000, p. 145
↑ تعدى إلى الأعلى ل: أب Davis, Paul K. "100 Decisive Battles: From Ancient Times to the Present"
^ Davis, p. 105.
^ Hanson, Victor Davis. "Culture and Carnage: Landmark Battles in the Rise of Western Power"
^ tom oberhofer، "battle of poitiers 732 battle of Moussais, battle of Tours, Charles Martel Eudes of Aquitaine, Abd. er-Rahman, medieval warfare"، Home.eckerd.edu، مؤرشف من الأصل في 2 فبراير 2017، اطلع عليه بتاريخ 04 أكتوبر 2012.
^ Fouracre, 2000, p. 85 citing U. Nonn, 'Das Bild Karl Martells in Mittelalterliche Quellen', in Jarnut, Nonn and Richeter (eds), Karl Martel in Seiner Zeit, pp. 9–21, at pp. 11–12.
^ Fouracre, 2000, p. 88.
^مؤنس 2002، صفحة 331
^عنان 1997، صفحة 90
^ O'Callaghan, 1983, p. 189.
^عنان 1997، صفحة 102
^المقري 1968، صفحة 14
^عنان 1997، صفحة 96
↑ تعدى إلى الأعلى ل: أبأبو خليل 1998، صفحة 34
^عنان 1997، صفحة 99
المصادر
الحجي, عبد الرحمن علي (1981)، التاريخ الأندلسي من الفتح الإسلامي حتى سقوط غرناطة 92-897 هـ (711-1492 م)، دار القلم، دمشق - بيروت.
أبو خليل, شوقي (1998)، بلاط الشهداء بقيادة عبد الرحمن الغافقي، دار الفكر المعاصر، بيروت - دار الفكر، دمشق، ISBN 1-57547-503-0.
عنان, محمد عبد الله (1997)، دولة الإسلام في الأندلس، الجزء الأول، مكتبة الخانجي، القاهرة، ISBN 977-505-082-4. ،
المقري, أبو العباس أحمد بن محمد بن أحمد (1988)، نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب - المجلد الثالث، دار صادر، بيروت.
الغنيمي, عبد الفتاح مقلد (1996)، معركة بلاط الشهداء في التاريخ الإسلامي والأوروبي (رمضان 114 هـ - أكتوبر 732 م)، عالم الكتب، القاهرة، ISBN 977-232-081-9.
ابن عبد الحكم, أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله (1999)، فتوح مصر والمغرب، الهيئة العامة لقصور الثقافة، مصر.
مؤنس, حسين (2002)، فجر الأندلس، العصر الحديث للنشر والتوزيع ودار المنهل للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت.
ابن عذاري, أبو العباس أحمد بن محمد (1980)، البيان المغرب في اختصار أخبار ملوك الأندلس والمغرب - الجزء الأول والثاني، دار الثقافة، بيروت.
السامرائي, خليل إبراهيم وآخرون (2000)، تاريخ العرب وحضارتهم في الأندلس، دار الكتاب الجديد المتحدة، ISBN 9959-29-015-8.
أرسلان, شكيب (-)، تاريخ غزوات العرب في فرنسا وسويسرا وإيطاليا وجزائر البحر المتوسط، دار الكتاب العلمية، بيروت.
Oman, Charles W. (1960). Art of War in the Middle Ages A. D. 378-1515. Cornell University Press. ISBN 0-8014-9062-6
Bachrach, Bernard S. (2001). Early Carolingian Warfare: Prelude to Empire. University of Pennsylvania Press. ISBN 0-8122-3533-9
Fouracre, Paul (2000). The Age of Charles Martel. Pearson Education. ISBN 0-582-06476-7
Riche, Paul (1993). The Carolingians: A Family Who Forged Europe. University of Pennsylvania Press. ISBN 0-8122-1342-4
Hanson, Victor Davis. Carnage and Culture: Landmark Battles in the Rise of Western Power. Anchor Books, 2001. Published in the UK as Why the West has Won. Faber and Faber, 2001. ISBN 0-571-21640-4
Schoenfeld, Edward J. (2001). Battle of Poitiers. In Robert Cowley and Geoffrey Parker (Eds.). (2001). The Reader's Companion to Military History (p. 366). Houghton Mifflin Books. ISBN 0-618-12742-9
Davis, Paul K. (1999) "100 Decisive Battles From Ancient Times to the Present" ISBN 0-19-514366-3
Wolf, Kenneth Baxter (2000). Conquerors and Chroniclers of Early Medieval Spain. Liverpool University Press. ISBN 0-85323-554-6
Santosuosso, Antonio (2004)، Barbarians, Marauders, and Infidels، Westview Press، ISBN 0-8133-9153-9.
Creasy, Edward Shepherd (1851/2001). Decisive Battles of the World. Simon Publications. ISBN 1-931541-81-7
Grunebaum, Gustave von (2005). Classical Islam: A History, 600 A.D. to 1258 A.D. Aldine Transaction. ISBN 0-202-30767-0
Lewis, Bernard (1994). Islam and the West. Oxford University Press. ISBN 0-19-509061-6
Barbero, Alessandro (2004). Charlemagne: Father of a Continent. University of California Press. ISBN 0-520-23943-1
Mastnak, Tomaž (2002). Crusading Peace: Christendom, the Muslim World, and Western Political Order. University of California Press. ISBN 0-520-22635-6

__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟ فبكى رحمه الله ثم قال : أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.
|

