|
|||||||
| الملتقى العلمي والثقافي قسم يختص بكل النظريات والدراسات الاعجازية والثقافية والعلمية |
 |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
|
|
#1
|
|||
|
|||
|
الوجه الآخر لرشاد أبو شاور بقلم: عوني صادق بدأت معرفتي به قبل أن تصدر له أول مجموعة قصصية في العام 1970 بعنوان (ذكري الأيام الماضية)، وتوطدت علاقتنا مع مرور الأيام، وتابعت كل ما صدر له من روايات ومجموعات قصصية بحكم الصداقة والزمالة، وطبيعة المهنة وميلي الخاص إلي قراءة الأدب. مع ذلك لم أجد نفسي راغبا في الكتابة عن أي من أعمال رشاد أبو شاور إلا مرة واحدة، ولكني أيضا لم أفعل. كان ذلك عندما صدرت له رواية (العشاق) في العام 1977 عن دائرة الإعلام والثقافة الفلسطينية، والتي أعتبرها أحد أهم الأعمال في الأدب الفلسطيني لفترة ما بعد النكبة، وذلك لأنني لست ناقدا أدبيا من ناحية، ولأنني، من ناحية ثانية، أحب أن أظل بعيدا عن اتهام طالما سمعته يوجه للبعض، ويتصل بقاعدة منتشرة في أوساطنا الثقافية، أعني بها قاعدة شيلني لشيلك ! وظل ذلك ساريا حتي قبل أسابيع قليلة، حين وقعت تحت يدي وبالصدفة المجموعة القصصية المعنونة (الموت غناء) الصادرة في العام 2003 عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، والتي لم أكن قد رأيتها أو سمعت عنها، كما أن رشاد لم يقدمها لي، كما يفعل في كثير من الحالات. بعد أن قرأتها أحسست برغبة قوية في الكتابة عنها، خلافا للقاعدة العامة التي أتمسك بها. أما لماذا، فلسبب بسيط جدا، هو أنها كشفت لي ما أسميه الوجه الآخر الذي لم أعرفه لرشاد أبو شاور بالرغم من صداقة اقترب عمرها من أربعة عقود! تضم مجموعة (الموت غناء) أربعا وعشرين قصة قصيرة، تتحدث كلها عن الإنسان البسيط الفقير المقهور وما يعانيه ويواجهه في عالم تسود فيه القوة بمعناها الواسع، ويستشري فيه الخوف والتسلط والفساد. لكن نصف هذه القصص علي الأقل تدور أحداثها بشكل أو بآخر حول (الموت)، ليس فقط كمصير محتوم للإنسان يأتي في نهاية العمر، بل كـ واقعة تراجيدية تعايشه العمر كله، قبل أن يصل إلي النهاية المحتومة. الموت مأزق وجودي بالنسبة للإنسان منذ وجد الإنسان، وطالما توقف أمامه الأدباء والفنانون والفلاسفة إلي جانب الأديان، ودائما وجد الإنسان نفسه عاجزا في مواجهته. ولعل كل ما يفعله الإنسان في حياته، وتحت أي عنوان كان، لا يزيد عن كونه محاولة فاشلة للابتعاد عن التفكير في هذا المأزق، وتلهيا عن واقعة الموت التي لا مفر منها. وفي هذه القصص جميعا، يعايش شخوصها الموت بطريقة أو أخري في خط مواز لكل ما يفعلون. تراه يعشش في حيواتهم ويلونها ألوانا شتي، يدفعهم للدفاع مرة وللهجوم أخري دون جدوي، يتربص بهم في كل حركة من حركاتهم وكل سكنة من سكناتهم، حتي عندما ينامون! هذا ما يقوله بطريقته رشاد أبو شاور. ذلك هو الوجه الآخر لرشاد أبو شاور. من يعرف رشاد من الخارج، يجده إنسانا ضحوكا دائم الابتسام، مرحا يحب النكتة فتسير علي لسانه دون عناء، صاحب بديهة حاضرة تلعب علي الأفكار والألفاظ تستخرج منها النكتة بمناسبة وبدونها بحيث يبدو له أنه لا يعير اهتماما إلا للحياة وبوصفها مساحة للنزال. لكنه من الداخل وفي العمق، وكما تبدي لي في قصص هذه المجموعة، إنسان حزين غارق في حزنه حتي الثمالة، وهو ما يفسر لي لماذا تأتي النكته علي لسانه، في حالات كثيرة، أقرب إلي السخرية شديدة المرارة، ونوعا من الكوميديا السوداء، حتي في أكثر حالاته فرحا. فرشاد يقلقه جدا، بل يخيفه ويحيره الموت الذي لا يجد له تفسيرا، رغم ما هو عليه من إيمان. ولهذا أري أنه كان منطقيا وطبيعيا جدا، بل أكاد أقول حتميا، أن تحمل هذه المجموعة القصصية عنوان الموت غناء ، وكأنه يريد أن يقول إن الموت موجود في أصل الفرح الذي هو لحظة عابرة في حياة الإنسان، وربما أراد القول: حتي الغناء هو شكل من أشكال الموت! أولا : في التكنيك علي غلاف المجموعة، كتب المؤلف: دائما كنت علي قناعة بأن القصة القصيرة فن ممتع يلتقط التفاصيل ويتعامل مع الزمن والنفس الإنسانية، في لحظة حاسمة، وأنها فن الحكاية المركزة والمقطرة... . هذه القناعة لدي رشاد أبو شاور عن القصة القصيرة تسود تماما بحرفيتها في قصص الموت غناء ، حيث نجد الحكاية دائما، وحيث يتحكم السرد بشكل القصة، فدائما هناك الراوي الذي يروي الحكاية. أما التفاصيل ، بل وتفاصيل التفاصيل، فهي ما تتركز عليه عينا المؤلف لينسج منها ما يسميه اللحظة الحاسمة التي تكشف عن نفسها بعفوية أحيانا، وبطريقة مرسومة أحيانا أخري، لترسم تداعيات تلك اللحظة علي النفس الإنسانية التي هي دائما، مرة أخري، موضوع قصص رشاد أبو شاور، حتي عندما يبدو أن تلك القصص لها هدف آخر غير تلك النفس. يفتتح رشاد أبو شاور مجموعته بقصة يا دنيا ... ولم يكن ذلك اعتباطا، بل علي الأرجح أنها كانت افتتاحية مقصودة تكشف عن مكنونات نفسه، وما يعتمل فيها من خوف وحيرة، وربما عبثية! القصة رمزية بامتياز، حيث لم تستطع كل المعطيات و التفاصيل الواقعية أن تغطي علي رمزيتها الواضحة. تعرض القصة لحظة البداية لدخول رجل غريب إلي مدينة حيث تقع عيناه فيها علي امرأة فاتنة، يتبعها ليجد نفسه في نهاية المطاف وحيدا في صحراء قاحلة متعبا ومرهقا ويائسا. فالمدينة ترمز إلي حياة الإنسان في هذا العالم، لها بابان (الولادة والموت)، يدخل من أحدهما ويخرج من الآخر. وتتم المقايسة بين الدنيا والمرأة الفاتنة اللعوب، وما تمثله وما تنطوي عليه من خداع للإنسان. وفيها نجد رأي أبو شاور بالدنيا، رأياً هو أقرب إلي الصورة المتكونة عنه، وهو أنه لا يجب علي الإنسان أن يأخذها علي محمل الجد، حيث جاء علي لسان أحد شخصيات القصة وهو يصف الغريب الذي صدق أن المرأة عشقته، قوله: يبدو أنه غشيم، لقد أخذها المسكين جدا ! ثانيا: انشغالات أخري إذا كان الموت هو بطل مجموعة الموت غناء ، فإنها تحمل أيضا بعض ما يشغل رشاد أبو شاور في هذه الدنيا، فهناك قضايا لم يسلب الموت أهميتها طالما فرضت الحياة علي الإنسان، أعطاها المؤلف حيزا كبيرا من المساحة المخصصة، وإن لم تغب صورة الموت عنها، بل يمكن القول إن هذه القضايا عكست صورا أخري للموت. أول هذه القضايا قضية الحرية المسلوبة في بلداننا العربية، كما عرضتها قصص: شارع الحرية ، فنجان قهوة فقط ، مكان نظيف حسن الإضاءة ، حكاية الضابط والمعلم و الموت غناء . في كل هذه القصص رصد تفصيلي مثابر لمشكلة تبدو في أساس كل مشاكل حياتنا العربية، وقد لجأ أبو شاور إلي تنويعة من المفارقات والحيل جعلت السخرية المرة، التي سبق وأشرت إليها، هي الجو السائد في هذه القصص. فقصة شارع الحرية تتحدث عن غريب يبحث عن عنوان شركة قيل في الإعلان عنها إنها تقع في شارع الحرية . وعندما يسأل عن الشارع لا يجد أحدا يعرفه، فيضطر لأن يسأل شرطيا عنه، فينتهي به الأمر إلي السجن! أما فنجان قهوة فقط ، فتحكي عن سياسي قديم دعته المخابرات للتحقيق معه لتتركه بعد ساعات، يعود إلي بيته ويجلس علي كرسي ليرتاح، لتكتشف زوجته بعد لحظات أنه مات! وتعرض مكان نظيف حسن الإضاءة لصحفي ينتهي إلي السجن لأنه طالب بحق المواطن في بيت نظيف حسن الإضاءة! لكن الموت غناء صورة ساطعة للقوة والتسلط والفساد، حيث تتحكم الأقانيم الثلاثة بمصائر الكثرة من البشر، وقد استطاع الكاتب أن يجعل منها مأساة فيها من الضحك ما يدفع علي البكاء، حيث يفرض علي المغني أن يغني حتي الموت! ثالثا: إنسانيات الجزء الثالث من قصص المجموعة كانت عبارة عن لقطات إنسانية تكشف عن جانب مهم من إنسانية الكاتب، كما في قصة نصف رغيف ناشف ، التي تتحدث عن طالب فقير يحاول مداراة فقره عن العيون. وكذلك قصة حياة موحشة ، التي تظهر ما يمكن للحب أن يشيعه من حيوية في حياة الإنسان، وما يمكن أن يخلقه من أمل في نفس الإنسان وسط ظروفه الشقية. بالطبع لم يكن ممكنا، ولم يكن الغرض عرض، أو التوقف عند، قصص المجموعة بالتفصيل الذي تستحق، بل هي مجرد إشارات إلي بعضها لتوضيح رأي صادر عن قارئ، إذ ليس من طريقة للاستمتاع بقصص هذه المجموعة غير قراءتها، وهو ما أرجو أن أكون في هذه العجالة قد أثرت اهتمام القراء وفضولهم، ممن لم يقرأوها، لقراءتها. *كاتب من فلسطين النسخة الأصلية كتبت في تاريخ 23 أيار، 2008
__________________
 قمة آلحزن ! عندمآ تجبرُ نفسّك على ڪره شخص .. كآنَ يعني لك آلعالم بِآگملہ ؤآلأصعب منـہ ! عِندمآـآ تتصنّع آلڪره .. و بِدآخلڪ حنيين وحب [ گبير لہ
|
|
#2
|
|||
|
|||
|
الأديب رشاد أبو شاور  روائي، قاص وكاتب صحفي فلسطيني روائي، قاص وكاتب صحفي فلسطيني  ولد في قرية ( ذكرين) قضاء الخليل بتاريخ 15/6/1942.هاجر مع أسرته عام 48 ولد في قرية ( ذكرين) قضاء الخليل بتاريخ 15/6/1942.هاجر مع أسرته عام 48  عاش مع والده _ كانت والدته قد توفيت ودفنت في القرية قبل سنةً من النكبة _ فترة قصيرة في ( الخليل) ، ثمّ كانت الإقامة في مخيم ( الدهيشة ) قرب بيت لحم حتى العام 52 . عاش مع والده _ كانت والدته قد توفيت ودفنت في القرية قبل سنةً من النكبة _ فترة قصيرة في ( الخليل) ، ثمّ كانت الإقامة في مخيم ( الدهيشة ) قرب بيت لحم حتى العام 52 . انتقل مع والده إلى مخيم ( النويعمة) قرب أريحا ، وهناك عاشا حتى العام 57. انتقل مع والده إلى مخيم ( النويعمة) قرب أريحا ، وهناك عاشا حتى العام 57.  عام 57 لجأ والده إلى سوريّة وحصل على اللجوء السياسي ، ولقد لحق بوالده وعاش في دمشق حتى العام 65 ، ومن بعد عادا إلى ( النويعمة) قرب أريحا حيث عاشا حتى حزيران 67 . عام 57 لجأ والده إلى سوريّة وحصل على اللجوء السياسي ، ولقد لحق بوالده وعاش في دمشق حتى العام 65 ، ومن بعد عادا إلى ( النويعمة) قرب أريحا حيث عاشا حتى حزيران 67 .- استقال من عمله البنكي بعد حزيران 67 ليتفرّغ للعمل الوطني . - عمل في الإعلام الفلسطيني الموّحد ، وترّأس صحيفة يومية في بيروت . - أقام في بيروت حتى العام 82 ، وفي دمشق حتى العام 88 . - أقام مع أسرته في تونس حتى العام 94 ... - يعيش منذ ذلك التاريخ في العاصمة الأردنية عمّان . - منح عضوية اتحاد الكتّاب الفلسطينيين ، القاهرة ، عام 69 . - أسهم في تأسيس الاتحاد العام للكتّاب والصحفيين الفلسطينيين ، وانتخب عضواً في الأمانة العّامة لعدّة دورات . - رئيس اللجنة التحضيريّة لتجمّع الأدباء والكتّاب الفلسطينيين . - عضو مجلس وطني فلسطيني منذ العام 83 . - منذ نهاية الستينات وهو يكتب في كبريات المجلاّت والصحف العربية . - يكتب في ( القدس العربي ) منذ العام 90 . صدرت له الأعمال الأدبية التالية : الروايات : _ أيام الحب والموت/ دار العودة بيروت 1973 _ البكاء على صدر الحبيب / دار العودة بيروت 1974 _ العشّاق / دائرة الإعلام والثقافة م.ت ف 1977 _ الرب لم يسترح في اليوم السابع/ دار الحوار سورية 1986 _ شبابيك زينب/ دار الآداب بيروت 1994 المجموعات القصصية : _ ذكرى الأيام الماضية/ دار الطليعة بيروت 1971 _ بيت أخضر ذو سقف قرميدي/ وزارة الإعلام بغداد 1974 _الأشجار لا تنمو على الدفاتر/ الإعلام الفلسطيني بيروت 1975 _ مهر البراري/ الاتحاد العام للكتّاب والصحفيين الفلسطينيين- بيروت 1977 _ بيتزا من أجل ذكرى مريم / الاتحاد العام للكتّاب والصحفيين الفلسطينيين بيروت 1981 _ حكاية الناس والحجار/ دار العودة بيروت 1989 _ الضحك في آخر الليل/ دار كنعان _ تونس 1999 _ الموت غناءً/ المؤسسة العربية بيروت 2003 _ مجلد الأعمال القصصية/ بيروت 1982ويضم المجموعات الخمس الأولى. كتابات نثرية : _ ثورة في عصر القرود ( مقالات مختارة) بيروت 1981 _ آه يا بيروت/ دار صلامبو تونس ( عن معركة بيروت عام 82) 1983 _ رائحة التمر حنّة/ المؤسسة العربية بيروت 1999 مسرح : _الغريب والسلطان/ دار الحقائق دمشق1984 للفتيان : _ عطر الياسمين/ قصص دار المسيرة بيروت 1979 _ أحلام والحصان الأبيض/ قصص دار الآداب بيروت 1980 _ أرض العسل/ رواية دار الحقائق بيروت 1981 - ترجمت رواية ( البكاء على صدر الحبيب ) إلى الروسية ،ونشرت في مجلة (الآداب الأجنبيّة )المختصة بنقل الروايات العالمية إلى الروسيّة ، كما نشرت في مجلد مختارات من الأدب الفلسطيني . - ترجمت مجموعة القصص ( حكاية الناس والحجارة ) إلى الفارسية ، وصدرت عن دار ( صحف) في طهران . - ترجمت كثير من قصصه القصيرة ... - قدّمت عن رواياته وقصصه أطروحات جامعية ... - عام1983منح وسام المنظمة العالمية للصحفيين( I.O.J) تقديراً لدوره في معركة بيروت عام ،82 والتي كتب عنها (آه يا بيروت) . - عام 1996 منح جائزة القصّة القصيرة ( محمود سيف الدين الإيراني) من رابطة الكتّاب الأردنيين. - يصدر له قريباً عن (دار الشروق_ عمّان ) كتاب: قراءات في الأدب الفلسطيني
__________________
 قمة آلحزن ! عندمآ تجبرُ نفسّك على ڪره شخص .. كآنَ يعني لك آلعالم بِآگملہ ؤآلأصعب منـہ ! عِندمآـآ تتصنّع آلڪره .. و بِدآخلڪ حنيين وحب [ گبير لہ
|
|
#3
|
|||
|
|||
|
اهم الاحداث التي اثرت في طفولة رشاد ابو شاور لا شك ان هناك الكثير من الالم الذي تعددت اسبابه لكن اهم مصادر الالم هو يتمه وهو في سن الـخامسة. يتيم الام في سن 5 سنوات
__________________
 قمة آلحزن ! عندمآ تجبرُ نفسّك على ڪره شخص .. كآنَ يعني لك آلعالم بِآگملہ ؤآلأصعب منـہ ! عِندمآـآ تتصنّع آلڪره .. و بِدآخلڪ حنيين وحب [ گبير لہ
|
|
#4
|
|||
|
|||
|
33- الاعتراف على ابو الريش الامارات 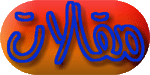 الرواية الإماراتية وقائع ملتقى الشارقة الأول للرواية *عزت عمر عن سلسلة كتاب الرافد صدر كتاب "الرواية الإماراتية" أعده الناقد والقاص عبد الفتاح صبري، وهو عبارة عن مجموعة من الأبحاث والشهادات التي كانت ألقيت ونوقشت في ملتقى الشارقة الأول للرواية خلال 18 – 19 ديسمبر 2002 الذي نظّمته دائرة الثقافة والإعلام، وذلك من اجل تسليط الأضواء على الرواية الإماراتية ومنجزها بعدما تخطّت مرحلة التأسيس وبدأت تراكم ذاتها كمّاً ونوعاً في المشهد الثقافي المحلي والعربي، من خلال توجّه الكتاب لإثراء ساحة الإبداع الوطنية بإبداعاتهم الروائية، بما يؤكّد وعيهم بأهمية هذا الجنس الدبي ودوره المتأمل والعاكس في إعادة إنتاج مشاهد التحول الذي شهده المجتمع الإماراتي إبان تأسيس الدولة والتي طالت بنيته الاقتصادية والسياسية. تنضّدت في الكتاب ثلاثة فصول ومقدمة وملحق ضمّ التوصيات التي خرجت بها الندوة، وقد تركّزت غالبية الأبحاث حول موضوعي: "الرواية والتاريخ" و "تقنيات السرد" والقضايا النظرية والتطبيقية المتفرعة عنهما، هذا بالإضافة إلى بعض الأبحاث التي بحثت في نشأة الرواية وتاريخ تكوّنها منذ صدور أول رواية إماراتية سعت لانطلاق هذا الجنس الأدبي، كورقة عبد الفتاح صبري الذي ربط بين التحوّلات الاجتماعية وبداية السرد الروائي، ورصد عملية الوعي بأهمية هذا السرد من خلال تعبيره عن اللحظة الانتقالية بين ثقافة المشافهة والكتابة، وعن تأثر هذا السرد بالأحداث السياسية العربية، وإلى جانب ذلك أهميته من حيث الوقوف على المفاهيم الفنية والأدبية التي ميزت المرحلة الأولى للاشتغال على هذا النوع من الأدب في سياق المنجز مع باقي الأجناس الأخرى. وإلى ذلك فقد تضمنت الورقة محاور مهمّة من مثل: الرواية التأسيسية وسؤال الهوية، حيث درس رواية "شاهندة" لراشد عبد الله كمحاولة لتقديم تصور خاص للتاريخ انبنت على لحظة قدرية ومجموعة من المصادفات تداخلت بين أدب الرحلة والحكاية الشعبية. ومحور الرواية والتاريخ ناقش من خلاله النصوص الروائية التاريخية ك"ساحل الأبطال" لعلي محمد راشد، وروايتي: "الأمير الثائر" و "الشيخ الأبيض" للشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، وروايتي: "ابن مولاي السلطان" و "الرجل الذي اشترى اسمه" لمنصور عبد الرحمن. مؤكّداً أن العلاقة بين الحقيقي والمتخيل في الرواية ليست جديدة، حيث يحاول الروائيون دوماً البحث في ما صمت عنه التاريخ والمؤرخون. وفي ورقة مماثلة ناقش د.محسن موسوي قضية نشأة الرواية المتأخرة نسبياً في الوطن العربي، ولكنها إلى ذلك انشغلت بعاملي الهوية، وأكّدت أهمية الوعي المتزايد للمتعلّمين الذين تأثروا بالمنجز السردي الغربي وسعوا لممارسة دورهم التنويري من خلاله. وفي ما يخص الرواية الإماراتية نوّه الباحث إلى أن هذه الرواية تشترك مع القصة القصيرة بجملة من الاهتمامات الاجتماعية والسياسية والمكانية، وكلتاهما تحفلان بحياة البحر والصحراء ومكابدة الناس وقسوة حياة مرحلة ما قبل النفط، ولكنه إلى ذلك لم يقدّم دراسة تؤكّد ما ذهب إليه بمقدار ما طرح من آراء يمكن وصفها بالعامة. شأنها في ذلك شان ورقة الباحثة فاطمة السويدي التي تناولت أبرز النماذج الروائية على مدى العقود الثلاثة، مشيرة إلى تطور تقنيات السرد لدى الروائيين الإماراتيين من أمثال: علي أبو الريش، ثاني السويدي، منصور عبد الرحمن، محمد غباش وغيرهم، مؤكدة في الوقت نفسه تأثر هؤلاء الكتاب بالأشكال الفنية الحديثة للسرد الروائي. في الفصل الثاني سوف تتنضد مجموعة كبيرة من الأبحاث حول "تقنيات السرد" كدراسة أحمد حسين حميدان عن: المكان والزمان كتقنية سردية في الرواية الإماراتية، ورواية "أحداث مدينة على الشاطئ" لمحمد حسن الحربي نموذجاً. ودراسة د. رشيد بو شعير في السرد بين السيرة والتخييل الروائي عبر تناوله رواية "حلم كزرقة البحر" لأمنيات سالم نموذجاً. بينما سيدرس د. أحمد الزعبي تقنيات السرد في رواية "نافذة الجنون" لعلي أبو الريش من خلال محاورات الذات وشعرية اللغة وإيقاعات الأزمنة والأمكنة، وبدوره سيتناول د. إبراهيم السعافين الفضاء الروائي في رواية "الاعتراف" لعلي أبو الريش معتبراً أنها من أبرز الروايات الإماراتية دلالة على الفضاء الروائي، وذلك في تعبيرها عن المكان باعتباره فضاء جغرافياً، وعلى الفضاء الاجتماعي والثقافي والشعبي واللغوي والسيميائي والدلالي، الفضاء الذي يبتدئ بالمكان المحصور على شاطئ "المعيريض" في رأس الخيمة، كتعبير عن وعي الإنسان بما يحيط به من ظواهر، وما يتفاعل معه من عادات وتقاليد وطقوس، وما يتصل بها من رموز أسطورية، وما ينعكس على ذاته من مظاهر اجتماعية يتداخل فيها السلب والإيجاب كما في الكفاح ضد الجهل والمرض والفقر والوقوع في دوائرها من جديد. و "رواية الاعتراف" بتعبيره تعبّر عن تشابك اجتماعي تتفجّر فيه العواطف المتناقضة في إطار العادات والتقاليد والقيم المتعارضة، وتبرز تناقض الأجيال و صراعاتها وتحوُّلاتها الممتدة، مثلما تبرز حركة التطور باتجاه التقدّم الآخذ بأسباب المعرفة والعلم والوعي. بينما في بحثه المعنون "الحكاية والسارد" يتجه د.سحر روحي الفيصل إلى اعتبار الرواية الإماراتية حديثة وغير ناضجة لخلل لازم بنيتها الفنية من حيث الانسجام بين الحكاية والسارد ولم يستثن من هذا الكم سوى ثلاث روايات لعلي أبو الريش هي: "نافذة الجنون، تل الصنم، وثنائية مجبل بن شهوان. أما الروايات الأخرى فقد اعتبرها روايات ذات بنية تقليدية تنهض استناداً إلى حكاية ذات حوادث معبّرة، وحبكة حريصة على المنطق في أثناء ترتيب الحوادث، وشخصيات واضحة محددة تعرف هدفها وتسعى إليه من بداية الرواية إلى نهايتها، وإلى جانب ذلك سارد عالم بكل شيء، يحاول توجيه الشخصيات وتحديد حركتها الخارجية والداخلية، ولكن الرواية إلى ذلك لم تتألق بحيث توهم المتلقي بأن الحكاية فيها مستقلة عن السارد، وقد أشار في ختام ورقته إلى أن تقنيات السرد في الرواية الإماراتية ستتطوّر في اتجاه التخلّص من السارد المهمين، وفي اتجاه الإكثار من السارد الممثّل (السارد من داخل الحكاية). ولعلها تتجه إلى تعدد الرواة بعد ذلك. أما الحكاية الروائية فالظن أنها ستترسخ في الرواية الإماراتية، وسيعبّر سرد الحوادث فيها عن مشكلات الواقع بوساطة ساردين أكثر قدرة على إيهام المتلقي بحقيقة المسرود. وفي ورقتها "تقنيات السرد في الرواية الإماراتية"، رواية "السيف والزهرة" نموذجاً قدّمت ريم العيساوي لبحثها بمقدمة عن عناية النقاد والدارسين العرب بمجال "السرديات" منذ سبعينيات القرن المنصرم. وقد ساهم هذا الاهتمام في تعميق الوعي النقدي والمعرفة التنظيرية والتطبيقية والتحليلية للنظريات والمناهج في أصولها الغربية. وهذا الانفتاح صاحبته محاولات جادة لتأصيل السرديات العربية من خلال الأشكال السردية المعروفة في تراثنا : " كليلة ودمنة، ألف ليلة وليلة، المقامات والسير الشعبية....." وذلك للإفادة منها في تطوير المناهج الجديدة، وفي محاولة تأسيس رؤية نقدية عربية تربط بين القديم والحديث. وفي ضوء ذلك درست شخصيات الرواية والفضاء الروائي كحيّز، وأشكال الزمن: التاريخي، والقصصي، والذاتي، لتتوقف بعدها عند مستويات اللغة ما بين سرد ووصف وحوار. وفي الختام قدّم الناقد عزت عمر دراسة بعنوان "تنوّع مستويات السرد في الرواية الإماراتية" نوّه من خلالها إلى أن الرواية في الإمارات بدأت تشهد صعوداً وازدهاراً فاق التوقعات من حيث الكم والطروحات الفكرية التي تداولتها سواء على المستوى الاجتماعي أو التاريخي، المر الذي يعكس وعياً كبيراً بأهمية هذا الجنس الأدبي، وبدوره الواضح في إعادة إنتاج الانعطافة النوعية لعملية التحول الاجتماعي التي شهدها المجتمع الإماراتي بعد ظهور النفط وتأسيس الاتحاد، وبداية التعليم النظامي وانتشار وسائل الإعلام المختلفة وخصوصاً الصحافة، كما أشاد بدور الكاتبة الإماراتية في مجال القصّة القصيرة وتطلعها للتعبير عن ذاتها روائياً مع صدور رواية أمنيات سالم الأولى "حلم كزرقة البحر" مؤكّداً ان هذا التوجّه من قبل الكتاب جميعاً إنما يعكس أهمية حضور الكتابة الروائية في المشهد الإبداعي كرأسمال رمزي ينضاف إلى جملة الإبداعات الأخرى، وكتعبير صادق عن الحياة من خلال التطرّق إلى موضوعات تعبّر عن علاقة الإنسان بالمكان والزمان والمجتمع والموروث الثقافي والجمالي، وكحقل معرّفي يعبّر عن تنوّع لغوي واجتماعي جديدين، يمكّن الروائي من صياغة "أنا" المرحلة الاجتماعية والتاريخية عبر شخصياته وأبطاله. أما من جانب تقنيات الكتابة الروائية، فإنه رأى ان الظهور المتأخر نسبياً للرواية الإماراتية عن زميلتها العربية قد أفادها كثيراً من حيث إنها لم تعان من جملة المشكلات التي عانت منها هذه الرواية في طور نشوئها مطلع القرن العشرين من حيث سذاجة الطرح، وإنما جملة معاناتها تتلخّص في نقص التجربة والتراكم، فباستثناء الروائي علي أبو الريش لم يراكم أحد من الروائيين تجربته الروائية بمزيد من الأعمال مكتفياً برواية واحدة أو روايتين. وإلى ذلك قسم الباحث دراسته إلى محورين رئيسين: أولهما السرد التاريخي القائم نظام التسلسل الزمني: درس من خلاله رواية "الشيخ الأبيض" للدكتور سلطان بن محمد القاسمي، ورواية "ساحل الأبطال" لعلي محمد راشد. وثانيهما السرد التجريبي القائم على نظام تشابك الأزمنة وتعدد الرواة، درس من خلاله العديد من الروايات: كرواية "الديزل" لثاني السويدي، ورواية "أحداث مدينة على الشاطئ" لمحمد حسن الحربي. هذا وقد جاء الفصل الثالث كمجموعة من الشهادات لكلّ من: علي أبو الريش، ومحمد عبيد غباش، ومنصور عبد الرحمن، و أمنيات سالم ود. يوسف عيدابي. بينما تضمن الملحق توصيات الملتقى التي أكّدت على أهمية هذا الملتقى وضرورة انعقاده كلّ عامين، وطباعة أعماله وتسجيلها على أشرطة فيديو، وتشكيل لجنة إعداد دائمة للملتقى، وتنظيم ورش إبداع كنشاط شهري، وإصدار كتاب نقدي سنوياً. * مرجع مهم للباحثين وطلبة الآداب المعنيين بالكتابة الروائية الإماراتية وتقنياتها. هامش: الكتاب: الرواية الإماراتية / وقائع الملتقى الأول للرواية. تحرير وإعداد: عبد الفتاح صبري. الناشر: دائرة الثقافة والإعلام، الشارقة، 2003. عدد الصفحات: 240 من القطع المتوسط
__________________
 قمة آلحزن ! عندمآ تجبرُ نفسّك على ڪره شخص .. كآنَ يعني لك آلعالم بِآگملہ ؤآلأصعب منـہ ! عِندمآـآ تتصنّع آلڪره .. و بِدآخلڪ حنيين وحب [ گبير لہ
|
|
#5
|
|||
|
|||
|
الروائي الاماراتي علي أبو الريش: أخشى أن تعيدنا الثورات إلى الوراء
الاتحاد الاربعاء, 01 فبراير 2012  أبو ظبي - الشيماء خالد علي أبو الريش كاتب مغرم بالصحراء والمرأة، يسمّى «شيخ» الروائيين في الإمارات، ويعتبر من أهم أدباء الخليج. روايته «الاعتراف» اختارها اتحاد الكتاب العرب كإحدى أهم الروايات العربية في القرن العشرين، وله أربع عشرة رواية، منها: «زينة الملكة»، «الغرفة رقم 357»، «تل الصنم» ، «نافذة الجنون»، «سلايم»، «رماد الدم»، «السيف والزهرة»، وصدرت له مجموعات قصصية، منها: «ذات المخالب» و مسرحية «الرسالة وجزر السلام»... عشية صدور روايتيه الجديدتين وهما «امرأة استثنائية» و «أم الدويس» يتحدث أبو الريش، عن رؤيته للأدب، ويكشف عوالمه السردية متحدثاً عن جماليات الوحدة وأثرها في الكاتب، غائصاً في عشقه للمرأة والمكان، وعارضاً أفكاراً لطالما كانت خارج المعترك الأدبي في الامارات والعالم العربي. > بداية، كيف ترى معالم الرواية الإماراتية، وإلى أين تتجه في علاقتها بالقضايا سواء المجتمعية أو الثقافية وحتى بالتراث والبعد الإنساني؟ - إنها تعتمد على انتماءات الكتّاب بطبيعة الحال. هناك من كتاب الإمارات من يمثل التراث لهم هاجساً، وهم يخوضونه ويقلبون عليه، وهناك كتاب آخرون هواهم القضايا الإنسانية في شكل عام ويرونها أهم من الخوض في حيز التراث الضيق. وأتصور أن أي رواية كانت حتى وإن غاصت في عمق الفلسفة مثلاً، لا بد أن يكون المجتمع حاضراً فيها، ما دامت تتحدث عن الإنسان، وقد يكون ذلك مطلبنا أحياناً، كما للواقع الذي يعيشه الكاتب دور. وصحيح أن ذلك يأتي اليوم مع الانفتاح السياسي والاقتصادي ولكن لابد من وجود شيء من الرقابة الذاتية التي تطبع الرواية الإماراتية. > هل تؤيد هذه الرقابة؟ - المفروض أن لا يكون لها من داع، فعلى الكاتب التحرر من هذه الأمور، إذا كان كاتباً حقيقياً، ويجب عليه التخلص من الإرث القديم ومخاوفه، فلا أحد منا في النهاية ضد الآخر في العمل الإبداعي، وكلنا شركاء في هذا المكان، ومن حقنا الكتابة والتعبير عن المشاعر والهموم، ولكن بطريقة تليق بالإبداع نفسه، وألا تكون المسألة كتابة تقريرية مسطحة. وفي الحالة تلك لن يختلف المبدع عن رجل الشارع، إذا ما تناول المسألة بأساليب سوقية أو مبتذلة. > لكنك من دعاة الجرأة، مع أن خلطاً يحصل بين الابتذال والجرأة في الطرح أو الكتابة؟ - إذا لم يمتلك المبدع حيزاً من الجرأة لن يكون كاتباً في المقام الأول، فيجب أن يمتلك وجهة نظره المجتمعية أو الفلسفية في الحياة، وإلا ما قيمة ما يكتب أساساً؟ ... إذا أصبح مع العادي والتقليدي فلا قيمة ساعتها لأي عمل إبداعي. > بالعودة إلى الرواية الإماراتية، ما الذي تشكله كمعنى أو قضية لكتابها؟ - مع قلة الكتّاب وقلة الإنتاج الروائي في الإمارات، فإنّ ما قرأته لكتّابنا يصب في تيار الرواية العربية والعالمية. لا يمكن لمجتمع أن يغلق نفسه على نفسه ولا لكتّاب أن يجلسوا وحدهم في جزيرة معزولة، فهم جزء من العالم، وما ينتجونه يبرز في السياق نفسه. المشكلة هنا في الإنتاج نفسه والهم ذاته، فأنا أتصور أن الكتابة نوعان، فهي إما أن تشكل هاجساً وتصبح جزءاً لا يتجزأ من صاحبها، ولا تتوقف إلا بموته كالدورة الدموية، أو مجرد ترف، فيكتب بعضهم عملاً واحداً ثم يتوقف، فالكتابة إما أن تكون مشروعاً لا يكتمل وتبقى متواصلة، أو لا نسميها إبداعاً. مرحلة من التراجع > يرى بعضهم أن الرواية العربية تمر في مرحلة انحطاط، رغم ازدهار حركة نشرها ويقال إنها فقدت ثراءها، ولم يعد هناك أعمدة، ما رأيك؟ - في هذا الكلام جانب من الصحة، فمن الأكيد أننا نعيش في مرحلة من التسطيح والتراجع في كل شيء، فإذا تراجعت السياسة يتراجع كل شيء آخر، ونحن في ذيل الأمم في المجال السياسي والاقتصادي والإنتاجي بالذات. وأمة لا تنتج قوت يومها لا تستطيع أن تبدع، إلا في حالات استثنائية. في العالم العربي نحن شعوب مهزومة ومهضومة ومكلومة، وكل هذه التراكمات وضعت الأدب في حيز الترقب، إن لم يكن في حيز التقهقر، وما نجح إلا الأدباء الذين داهنوا وساوموا وبالذات في دول عربية كبيرة، ظهر فيها أدباء أخذوا شهرة قد تصل إلى العالمية أحياناً، لأنهم فقط مشوا مع التيار. هذا رغم أن في تلك الدول نفسها كتاباً وشعراء أهم من غيرهم بكثير لكنهم تواروا بعيداً عن الأضواء لأنهم غير متماشين مع الواقع الســـياسي والاجتماعي في بلدانهم. لذلك نحن في حاجة - قبل الثورات السياسية - إلى ما ليس فقط ثورة، بل إلى «زلزلة ثقافية»، وحتى الثورات التي تحدث في عالمنا العربي اليوم أنا غير مقتنع بها وستعيدنا للوراء أكثر مما فعلت الحكومات السابقة. والسبب هو أن تلك الأنظمة اســتطاعت أن تخلق في داخل كل شخص ديكتاتوراً صغيراً، كل على مستــواه، وديكتـــاتوراً جــباناً، والآن مع زوال هذه الأنـــظمة كم ديكتــاتور سنجد لدينا ؟... ملايين. وفي نظري إذا كانت هناك نخبة ثقافية فيجب ألا يكون تركيزها على إلقاء الخطب العصماء في شتم هذا الرئيس أم ذاك، هذه الأنظمة أم تلك، نحن في حاجة الآن إلى «غسيل» ثقافي، إلى تطهير، فالذات أصبحت ملوثة ومهزومة. الإنسان الآن في ليبيا يصرخ بحرية مثلاً، لكن الوضع أسوأ، فكل واحد منهم يريد أن يكون إمبراطور المكان الذي حل فيه، لأن الديكتاتورية لم تمت، راح شخص وجاء آخر. > في روايتك «الغرفة رقم 357» ثمة تفاصيل وخواطر كثيرة دارت في رأس البطل ومنها نقاشه مع الذات، وأدخلت القارئ في جو محموم، وبعضهم قال إنها أشعرتهم بالدوار رغم إعجابهم بها. من أين تأتي هذه اللعبة في روايتك؟ - أولاً أنني اعتمدت في هذه الرواية أسلوباً غير أسلوب الرواية التقليدي (المقدمة والثيمة والخاتمة)، والشيء الأهم أن الإنسان حين يعتمل في داخله شيء يريد أن يقوله أو لا يقوله، لا بد من أن يحدث عنده شيء من المقاومة والصراع: هل يقبل أم لا؟ لذا تكلمت عن خصوصيات ذلك الإنسان بهذا الشكل المحموم كما هو يعتلج في ذاته، ولربما هذا هو السبب. واقع اللاشعور > كشفت لنا تلك الرواية صورة أبعد بكثير عن الصورة النمطية للرجل الخليجي، هل قصدت ذلك؟ - كان الهدف منها أن تلامس اللاشعور الجمعي عند أهل الخليج، وأنا لست أنا حين أكون جالساً بمفردي أكتب، والأمر ذاته لدينا جميعاً. هذا ما بحثت فيه، ذلك المخزون اللاشعوري الأهم برأيي في الإنسان، لأنه يحرك سلوكه، وكل المحسنات البديعية لسلوكاتنا كبشر مجرد مجاملة أو نفاق، ليست حقيقية البتة. والواقع الحقيقي والصحيح بلا جدال هو اللاشعور، وهذا العمق هو ما جعل القارئ يرى الصورة الحقيقية للرجل الخليجي مثلاً، كإنسان. > كيف يمكن للأدب أن يحرك المجتمعات المعاصرة، هل يملك الأدب هذه القدرة؟ - الأدب لا يحرك المجتمعات، لكنه يعطي رؤية فلسفية إلى الكون، ومن يريد أن يفهم فليفعل. الآن مثلاً يقولون إن في مصر صدرت أربع أو خمس روايات عن الثورة، وردّي هو: ما هذا النتاج البهيج؟ ... إنه مثل المفرقعات، الأدب لا علاقة له بالتماهي المتعمد مع الأمور الراهنة، بل يعطي رؤية تلقائية، وقد يتنبأ الأديب أو المبدع بشيء سيحدث لكنه لا يعيش حالة الكتابة عنه بجمع قصاصات من الأحداث، فهذا يتنافى والعملية الإبداعية. > إذاً كيف تتوقع أن يكون مستوى أدب الثورة كما يسمى، والذي بدأ يظهر اليوم؟ - ضعيفاً طبعاً، لأنه يعبر عن مكبوتات، مجرد تنفـــيس، ليس ناتجاً من رؤية إبداعية فلسفية لمجتمع ما، بل هو سيل يدفق من سد تحطم، وسيكون رديفاً للكبت النفسي، وبلا قيمة إبداعية، لكنه قد يلقى رضى المكبوتين. > ولكن يقال إن بعض الأدب تنبأ بقيام ما يسمى الربيع العربي، وهناك روائيون صرحوا بهذا، ما ردك؟ -لم تكن تنبؤات، كانت تلك تمنيات، ولكن اليوم بطبيعة الحال الكل سيقول إنه تنبأ، فالنصر يملكه الجميع والهزيمة يملكها واحد. الأدب لا يصنع ثورات آنية، لكنه يصنع ثقافة ثورات. الأدب الحقيقي أقصد، ونحن لم يكن لدينا في ما سبق ثقافة ثورات بل ثقافة هزيمة، لهذا لم تقعني ثورات اليوم، هذه خزعبلات، نحن لم نُجد القراءة ما بين السطور في عالمنا العربي وكأن كل إجاباتنا يجب أن تكون جاهزة. الرواية والمأساة > أعظم الروايات نبعت من العذابات كما يقال، هل على الكاتب حقاً أن يكون معذباً حتى يبدع؟ - يجب على الكاتب الحقيقي أن يعيش مأساة وجودية، مأساة داخلية، فحينذاك يلامس الكاتب الإنسان الآخر، مع ملايين الأسئلة. هذه المأساة هي التي تجعل الروايات خالدة أو لها لمسة خاصة بلا شك، وإن لم تكن تلك المأساة حاضرة لدى الروائي المبدع فهو يكون طافياً حاله حال أي قشة. > أنت دائماً مناصر للمرأة والمكان في رواياتك، من أين ينبع ذلك؟ - أولاً إني تربيت على يد امرأة، احترمتها وقدرتها كثيراً، والدتي التي رأيت خلالها الجوهر المذهل للمرأة. وصحيح أن الرجل يجد أحياناً في نفسه من الغرور ما يجعل لسان حاله يقول: لماذا أهتم بالمرأة؟ فلأستفد كرجل مادام المجتمع يعطيني حقوقاً مكتسبة، فلماذا أضيعها؟ لقد أدركت أنا أن هذا لسان حال الأغبياء والحمقى والقساة، رأيت أنهم ابتعدوا عن إنسانيتهم، فكنت دائماً أرد على الواحد من هؤلاء: أن اجلس مع نفسك في لحظة محاكاة مع الذات، ستشعر حينها بالاشمئزاز من نفسك عندما تأخذ ما لا يحق لك، والأمر عن المرأة في هذا الإطار. كانت المفاصحة مع الذات سبباً كبيراً في نصرتي للمرأة، والمكان كيان بذاته، وإدراكي لهذا الأمر يهمني دائماً. > رغم أنك من أهم روائيي الخليج والإمارات بالذات، فإن أعمالك لم تترجم، هل لأنك لا تهتم بالتسويق لنفسك، أم هي ناجمة عن إشكالية ما، هذا رغم علاقتك القوية مع الوسط الإعلامي؟ - لم يهمني هذا الأمر يوماً. ترجم «اتحاد الكتاب العرب» روايتي «الاعتراف»، لكني لم أنشغل بهذه النقطة ولم أبحث فيها، كانت غايتي أن أشبع هذه الذات العطشى. كتبت حتى اليوم أربع عشرة رواية، لكني أشعر أن مازال لدي الكثير، الكثير مما لم أبح به ولم أقله، وإذا كان في العمر بقية، فسأنهي ذلك البوح ثم أموت. > لماذا لم يكن هناك متابعة نقدية مهمة لأعمالك، وحين صدرت «ثلاثية الحب والماء والتراب»، ظن الكثير أنها ستثير جدلاً عربياً كبيراً، فلماذا لم يحدث ذلك؟ -لا يوجد ناقد في العالم العربي، ما يقدم ويكتب مجرد انطباعات، النقد الحقيقي غير موجود، والنقد العلمي اختفى. وفي الإمارات بالذات للأسف الشـــديد تؤدي وسائل الإعلام دورها على اســتحياء بالنسبة للأدب ككل وليس فقط معي أنا، على خلاف ما هو موجود في السعودية حقيقة. ومن ناحية أخرى لقد توقف النقد عند مدارس نقدية معينة، بينما الأدب خطا خطوات شاسعة. > ما رأيك في الرواية الخليجية؟ - لا تختلف عن غيرها، هي جزء من هذا التيار، ولكن في الفارق الأساسي أن غالبية الكتاب في دول الخليج لا يتوجهون إلى الرواية، إنها ليست هاجساً، إلا لدى قلة، مثل ليلى العثمان، أو أسماء إسماعيل، أما الغالبية فلا. > من أهم الكتاب المثيرين لاهتمامك؟ - بصراحة كنت وما زلت معجباً جداً بإبراهيم الكوني، وأشعر أنني أشبهه، أنه يعبّر عني وكأنه يكتب ما أريد قوله ولا يسعفني قلمي في كتابته. أحياناً هناك توارد للمشاعر الإنسانية لدى كاتبين، هكذا أشعر وأنا أقرأ روايات إبراهيم الكوني. أحب كذلك الطاهر وطار الكاتب المميز صاحب العطاء الغزير، والطيب صالح وحيدر حيدر، وهذا الأخير بالذات مهضوم حقه وهو من أهم الكتاب ويستحق أن يكون الأشهر. > هل لك طقوس معينة في الكتابة، وبماذا تشعر حين تنهي الرواية؟ - لا شيء معين، العزلة فقط، وأفضل الليل وهدوءه، أشعر بالظفر كأني أنجبت، عندما أنهي الرواية. وأثناء الكتابة في ما أسميه عملية الخلق يكون الوضع عسيراً علي، أكون مشحوناً ومتوتراً، ومزاجياً جداً، هناك نوع من الكتاب ينقح ويضيف ويحذف من روايته بعد انتهائه منها وقبل أن تخرج في الصورة النهائية، وهذا ما أكرهه، ولا أقتنع به. فلتخرج كما هي، ولو تدخلت مرة ثانية في الرواية تشوهها، فتلك الومضة تأتي مرة واحدة وإذا لم تحترم ذلك فأنت تخدع القارئ وتخدع نفسك. > ما الفرق عندك بين متعة إنجاز رواية وقراءة أخرى؟ - الاثنتان غرامي، فحين أقرأ رواية ممتازة أشعر بالظفر والتحفز لأكتب فتدفعني دفعاً إلى الإبداع، وتفتح لي آفاقاً واسعة
__________________
 قمة آلحزن ! عندمآ تجبرُ نفسّك على ڪره شخص .. كآنَ يعني لك آلعالم بِآگملہ ؤآلأصعب منـہ ! عِندمآـآ تتصنّع آلڪره .. و بِدآخلڪ حنيين وحب [ گبير لہ
|
|
#6
|
|||
|
|||
|
علي أبو الريش من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة علي أبو الريش هو روائي وشاعر وإعلامي إماراتي كبير وإن كانت شهرته الروائية أكبر من شهرته الشِعرية. مولده ونسبة ولد علي عبد الله محمد أبو الريش في 9/6/1956م في منطقة معيرض في إمارة رأس الخيمة. ترجمتة تخرج من جامعة عين شمس قسم علم النفس، وبعد تخرجة سنة 1979م انضم إلى عالم الصحافة وإلى جريدة الإتحاد حيث عمل في القسم الثقافي فيها، وأخذ يترقى في المناصب حتى وصل في 2007 إلى منصب مدير التحرير. له عمود يومي بالجريدة. يعمل حالياً مدير لمشروع (قلم) بهيئة أبوظبي للثقافة والتراث. مؤلفاته الاعتراف 1982. (اختارها أتحاد الكتاب العرب كأحدى أهم الرويات العربية في القرن العشرين) السيف والزهرة. رماد الدم. نافذة الجنون. تل الصنم. ثنائية مجبل بن شهوان. سلائم. ثنائية الروح والحجر. التمثال 2001. تقدير الدولة له حصل على جائزة الإمارات التقديرية للعلوم والفنون والآداب سنة 2008 تسلمها من يد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة. وصلات خارجية == علي أبو الريش ٢٥ تشرين الثاني (نوفمبر) ٢٠٠٦ نبذة عن حياته: ولد علي أبو الريش عام 1957 و نشأ في المعيريض في مدينة رأس الخيمة ، أنه المتصف الوحيد أن " تخرج من كلية الآداب من عين شمس (تخصص علم نفس ) ، عقب تخرجه التحق بالصحافة و ترأس القسم الثقافي بجريدة الاتحاد ، فتولي حاليا منصب رئيس التحرير التنفيذي بالجريدة نفسها أسلوبه في كتابة القصة: إن علي أبو الريش على الرغم من التباين الواضح في مواقفه الروائية إلا أنه ظهر غير منفك عن تصوير الحياة المتناقضة للإنسان في مجتمعة و الغربة التي كان يعاني منها المواطن في وطنه في مرحلة تاريخية معينة في مجتمعة . فتجربة علي أبو الريش الروائية جديرة بالحفاوة والإضاءة و الحوار وذلك لما يتميز به من سمات تجعله منفردا من بين جميع الروائيين بشكل خاص : 1. فهو الوحيد المتصف بالاستمرار و العكوف على فن الرواية على امتداد ثمانية أعمال أولها في 1982 ( الاعتراف ، السيف و الزهرة ، رماد الدم ، نافذة الجنون ، تل الصنم، ثنائية مجبل بن شهوان، سلايم، ثنائية الروح و الحجر ، التمثال 2001) منتقيا فيها شكل الرواية الإحداثية المتجاوزة لمركزية البطولة و تسلسل الأحداث . 2. تمتعه بلغة شاعرية و مخزون لغوي ينم عن إلمام قاموسي متنوع . 3. يستدعي مخزون الطفولة لديه محاولا استخدامه لمصادمة واقع معطوف علي النضج الاجتماعي و العمق الفكري أحيانا . 4. الشخوص في رواياته يطغى عليها غشاء رقيق يجعل لمسها مهمة صعبة . 5. نظرته الموضوعية إلى الناس و الأعمال و التواضع و الرقة في القول و السلوك الذي يربطه في روايته. 6. شدة الوعي بالمجتمع و الارتباط به و القدرة علي التأمل و التحليل المنطقي. 7. جمع بين تقنيات القص التقليدي و القص الحديث فوجدنا الحوار بكل أشكاله. 8. الرقابة على الترتيب المنطقي لزمن الأحداث . 9. مواضيعه مقتبسة من صميم الحياة وهي مستمدة من الواقع ، وغالبا ما يجسد مدينته رأس الخيمة فهي في نظره ليست مدينة شاطئ بحري وحسب إنما هي محطة العظماء و المشاهير أمثال أحمد بن ماجد و ابن بطوطة . 10. يكتب من منطقة الدوافع الانفعالية للإنسان . الشكل الفني لروايته: ففي المرحلة الأولي من تجربته كان موضوع الرواية دائما يتعلق بالمجتمع وما يميز مواضيعه إنها متنوعة من صميم الحياة وهي مستمدة من واقع الكاتب غالبا مجسدا برأس الخيمة كما في رواية الاعتراف – السيف و الزهرة – رماد الدم. في الشكل الفني الحديث لروايته وجد الكاتب علي أبو الريش حريته في التعبير عن ذلك المخزون الساكن في ذاكرته و الذي لم يستطيع التعبير عنه في ظل القيود حبكة الإحداث المتتابعة علي نسق محدد. فنراه في رواية تل الصنم ينحو منحني تجريبي يحاول فيه تجديد أسلو به فيحاول التخلص من القيود المألوفة ، معتبرا للسرد قدرة علي نحو آخر و يوفي بالغرض وجعل أسلوبه مطعما يجمع بين البناء التقليدي و البناء الحديث ، لقد ازدادت مساحة التداعي للأفكار و تحرر من سطوة ضرورة ترتيب الإحداث علي نحو منطقي و إن كان ذلك قد جاء علي نحو محدود مقارنة بروايتيه اللاحقتين ثنائية مجبل بن شهوان و سلايم ، أيضا نجده في أحد روايته يهاجم الظواهر السيئة الجديدة التي يفرزها الواقع كظاهرة التواكل مثلا تلك القضية التي ضربت مجتمع الإمارات فاهتزت له كل بني المجتمع و المرتكزات القيمة و النفسية للأسرة وبناء عليها أدت إلى تفاقم ظاهرة الأيدي العاملة الآسيوية بخاصة و الوافدة بعامة كما في "السيف و الزهرة " حيث شكلت هذه القضية محورا أساسيا في الرواية . ولقد وفر الشكل الحديث تلك القدرة للكاتب علي البوح عن مكنون ذاته علي لسان شخصياته علي نحو أوسع وإن هذا المكتب الذي وجد علي أبو الريش أنه بمثابة انتصاراته وقد تحقق في هذه الرواية دفع به ألي تعزيزه و تطويره أكثر في رواياته اللاحقتين الثنائية مجبل بن شهوان – سلايم . مقتربا بذلك أكثر من الرواية الحديثة بمعاييرها التي ينبئ عنها بأسلوبه ، بأنه ملم إلماما متينا بمعطياتها. مؤلفاته: صدرت له ثماني روايات هي بالترتيب: 1. الاعتراف 1982. 2. السيف و الزهرة 3. رماد الدم . 4. نافذة الجنون . 5. تل الصنم . 6. ثنائية مجبل بن شهوان . 7. سلائم . 8. ثنائية الروح و الحجر. 9. التمثال 2001. أصدر أيضا مجموعة قصصية و أخرى نثرية و مسرحيتين ، بجانب مجموعة من المقالات الصحافية الأدبية. اختيرت مؤخرا روايته " الاعتراف" إحدى أهم رواية عربية في القرن العشرين من جانب اتحاد الكتاب العرب. المادة مأخوذة بتصرف من: 1. يوسف أبو لوز . شجرة الكلام وجوه ثقافية و أدبية من الإمارات .ـ الإمارات :دار الخليج للصحافة و الطباعة و النشر ، 2000. المصدر ديوان العرب.
__________________
 قمة آلحزن ! عندمآ تجبرُ نفسّك على ڪره شخص .. كآنَ يعني لك آلعالم بِآگملہ ؤآلأصعب منـہ ! عِندمآـآ تتصنّع آلڪره .. و بِدآخلڪ حنيين وحب [ گبير لہ
|
|
#7
|
|||
|
|||
|
علي أبو الريش يختبر الحرية في " الشارقة - محمد ولد محمد سالم:سلايم" آخر تحديث:السبت ,10/09/2011 يعتبر علي أبو الريش أكثر الروائيين الإماراتيين مثابرة على الكتابة وأغزرهم إنتاجاً، فعلى مدى يزيد على ثلاثين عاماً أصدر أربع عشرة رواية، بدأها برواية “الاعتراف” سنة 1980 ثم “السيف والزهرة”، و”رماد الدم” و”نافذة الجنون”، و”تل الصنم”، و”ثنائية مجبل بن شهوان”، و”سلايم”، و”ثنائية الروح والحجر التمثال”، و”زينة الملكة” إلى آخر القائمة، وقد توجت مسيرته الروائية بجائزة الدولة التقديرية سنة 2008 . تميزت تجربة أبو الريش الروائية بمرحلتين، فقد تشكلت بدايات تجربته الروائية وهو طالب في مصر في السبعينات وكان منطقياً أن يتأثر بالاتجاه الواقعي الذي كان يسود عالم الرواية في تلك الفترة، فبدأ في رواية “الاعتراف” بداية يصور فيها حياة القرية والعلاقات الاجتماعية التقليدية وصور الصراع التي كانت تحدث بين أفراد المجتمع، وما يحدث من غدر وثأر واستغلال وحرمان وفقر وغير ذلك، وبدايات تشكل وعي الأفراد من خلال المدارس الحديثة واكتساب طلابها وعياً يتجاوز وعي آبائهم ويجعلهم قادرين على الاعتراف بالآخر ابن الغريم ومسالمته بل مودته وحبه وواصل هذا في روايتي “السيف والزهرة”، و”رماد الدم”، لكنه لم يلبث أن انفتح على نمط جديد من الكتابة برز في الوطن العربي في السبعينات وانتشر وتأصل في الثمانينات وهو “تيار الوعي” فطفق أبو الريش يكتب منشداً هذه الصيغة التي وقع عليها، والتي بدا أنها تستجيب لخبراته العلمية كدارس لعلم النفس وحاصل على شهادة البكالوريوس في جامعة القاهرة عام ،1979 وهو من التيارات الأدبية التي نشأت في الرواية الغربية ثم انتقلت بفعل التأثر والترجمة إلى الرواية العربية . عرف الناقد الإنجليزي روبرت همفرى رواية تيار الوعي بأنها “نوع من السرد الروائي يركز فيه الكاتب على ارتياد مستويات ما قبل الكلام من الوعي بهدف الكشف عن الكيان النفسي للشخصية الروائية من خلال مجموعة من التداعيات المركبة للخواطر عند هذه الشخصية”، ففي هذا النوع من الرواية لا توجد حكاية تتلاحق أحداثها نحو ذروة ثم نهاية بل هي صوت لشخصية تنثر مكنونات نفسها، وما يجيش في خاطرها ويعتمل في شعورها من أفكار وخواطر وأحاسيس، ويتبع الكاتب ذلك النثر بشكل متدفق، لا يعتمد أي رباط منطقي، لا من حيث الحدث ولا الزمان ولا المكان، وتعتبر رواية “سلايم” إحدى أهم الأمثلة على تجربة أبو الريش في هذا الاتجاه، فهي تتكئ على تيار وعي الشخصية الرئيسة “عبد الله الشديد” الذي يحاول أن يتذكر حياته الأولى، ومن هو؟ وأين كان؟ وعن طريق تشغيل تدفق الأفكار يقدم عبدالله الشديد صورة مشوشة عن حياته من خلال استرجاعه صوراً لأشخاص كان لهم دور فيها، وأولهم هي “سلايم” تلك المرأة التي يتملكه الإعجاب بها، ولا نكاد نعرف عنها سوى أنها عاشت ثمانين عاماً في خيمة في حي “لخديجة” ولم تقبل أن يدنس سمعتها أحد، وصدت جميع الرجال الطامعين فيها طلباً لنقاء أبدي فعاشت شامخة كشجرة الغاف المجاورة لخيمتها، فهي رمز الطهر والنقاء والاستقلال وحب الأرض، والشخصية الثانية الحاضرة في وعي عبدالله الشديد هي “النوخذة” الذي عمل معه على سفينته، فكرهه النوخذة لأنه كان قوياً جداً وصامتاً دائماً لا يضحك ولا يشارك في إضحاك النوخذة كما يفعل غيره من البحارة، فما كان من النوخذة إلا أن رمى به في البحر لتأكله الحيتان، لكنه استطاع أن يخرج من البحر، فهذا النوخذة رمز للطغيان والاستبداد والقهر واستعباد الآخرين، وتكميم الأفواه، فلا أحد يجرؤ على نقاشه أو معارضته أو الحديث بما لا يرضيه . وهناك شخصية شمسة التي أحبها عبدالله الشديد في بداية شبابه، وبادلته الحب لكن مفهومها للحب كان مفهوماً مادياً، ولم تستطع أن ترقى معه إلى الحب الروحي الذي يطلبه ويجد فيه ذاته، لذلك تركها واعتبرها غير جديرة بالحب، وأما غزالة تلك المرأة المفعمة بالحب والقوة والإرادة التي تريده قوياً قاطعاً قادراً على التحرر من ذله ووضاعته وعلى مواجهة الزيف والطغيان . وهناك شخصيات أخرى تستدعيها ذاكرة عبدالله الشديد كسالم المغربي وعبدو اليمني وراشد الصومالي وهي شخصيات وحيدة غامضة غريبة على القرية لكل منها مسكنه المنعزل ورؤيته للحياة، ويتخذها عبدالشديد للمقارنة رموزاً لواقعه الذي صار إليه بعد خروجه من البحر، واقع التشرد والوحدة والانعزال، والذي سيسلمه إلى الجنون حيث سنكتشف في النهاية أنه يعيش منفرداً في زنزانة مصحة نفسية . يدفع بناء تلك الشخصيات برمزياتها التي تحدثنا عنها آنفاً إلى رؤية تأويلية تقوم على المقابلة بين مختلف أنماط تلك الشخصيات . فشخصية “سلايم” يمكن اعتبارها رمز الإنسان الأول في طهره وإخلاصه ونقاء سريرته، إنسان يعيش الحياة بكل جوارحه ويتشبث بها لكنه يأبى أبداً أن تدنسه تلك الحياة أو أن تجرفه سيول جرائم وموبقات الآخرين، رغم استبداد شرورهم واستفحالها، ولذلك اختارها الكاتب عنواناً لروايته “سلايم” وربطها بالقرية والطبيعة ممثلة في شجرة الغاف، في مقابل المدينة الأسمنتية التي يورد تلميحات كثيرة بإدانتها لما جلبته معها من شرور، في مقابل سلايم هناك النوخذة رمز الظلم والكذب وتشويه الحقيقة، وهناك عبدو وراشد وسالم الذين رضوا بالانعزال والفقر على الذل في مقابل رجال النوخذة رمز الذل والمهانة، وهناك غزالة الطاهرة التي هي الصيغة الجديدة من سلايم في مقابل شمسة التي دنستها الحياة وسحقت براءتها، وفي الوسط من كل أولئك يقف عبدالله الشديد وحيداً كالمشردين مؤمناً بسلايم وأفكارها وأصالة موقفها من الحياة، محباً إلى حد العشق لغزالة لكنه عاجز عن الوفاء بشرط حبها وهو مواجهة نفسه والتخلص من خوفه وعقده التي رسخها فيه المجتمع، رغم أنه لم ينافق ولم يذل كما ذل الآخرون، وبكلمة واحدة فهو غير قادر على صناعة ثورته وامتلاك حرية الفعل وصناعة المستقبل، لينتهي في النهاية إلى المصحة مستسلماً عاجزاً حتى عن الهروب من بين يدي الأطباء، ونخلص في النهاية إلى أن الكاتب يريد أن يقدم رؤية وجودية تقول إن شرط تحقق ذات الإنسان هو قدرته على الفعل والاختيار، قدرته على صناعة حريته، وما لم يستطع فعل ذلك فستظل حياته عبثية لا طائل من ورائها، وسيظل العفن مسيطراً على العالم . هذا التماسك الظاهري في بناء وجهة النظر في الرواية، ليس على إطلاقه ففي داخل الرواية ترد وقائع وأوصاف تشتت ذهن القارئ العادي وتحد من قدرته على التأويل، فصورة سلايم لم تسلم من الاضطراب والغموض حيث ورد في إحدى الصفحات أن كارثة كبيرة حلت بها، وأن جيشاً عظيماً فاتحاً يقوده عنترة بنياشينه قد حل بالمكان وأنها استسلمت، ويتعمد الكاتب ترميز الموقف والإيهام ما يجعل احتمال سقوط صفات الشموخ والنقاء عن سلايم وارداً، وهناك شمسة التي تأرجحت صورتها بين الحب الشديد لعبدالله الشديد وبين خيانته، مما يضعف رمزيتها في النص، كذلك فإن الشخصيات الثلاثة المنعزلة (المغربي واليمني والصومالي) التي أوردها الكاتب هي نمط لشخصية واحدة، ويعسر أن تجد بينها فروقاً ذات رمزية مهمة فوجودها كلها محير في الوقت الذي يمكن أن يستغنى بشخصية واحدة عنها جميعاً، ومما يحد أيضاً من وضوح الرؤية أن عبدالله الشديد في اللاوعي يمتلك نظرة متقدمة إلى العالم تناقض وضعه كبحار جاهل منبوذ، فحين كان صغيراً كان يصغي إلى حكايات أمه عن “حلوم” تلك المرأة الخارقة التي تدعي أمه أنها تطير وتأتي بأفعال لا يمكن أن يأتي بها البشر، ويعلق عبدالله الشديد على ذلك بقوله: “كنت أقاطعها كثيراً وأمطرها بمزيد من الأسئلة بيد أنها كانت تنهرني قائلة: “لا تقاطع الأكبر منك، الكلام الذي أقوله لك لا يقبل الجدل، فأخفض بصري وألتزم الصمت، حلوم بالنسبة إلى أمي كائن يجب ألا تدور حوله الشكوك ، كان لا بد لي أن أنكفئ لكي أسمع المزيد، فمثل هذه القصص على الرغم من سذاجتها إلا أنها ستهديني نهر الحلم في داخلي”، ويصف أمه بأنها كانت تحبه لكنه حب قمعي “وباسم هذا الحب يفتك بالأحلام، وتغتال الآمال”، لكن عذر الكاتب في أن رواية تيار الوعي لا تهتم بالبناء المنطقي للشخصية ولا إقناعيتها، فالشخصية عند أصحاب هذا التيار هلامية مرنة قابلة للتشكل في كل الاتجاهات، وهو أحد أسباب الغموض في هذا النمط من الكتابة . لم تتوقف مسيرة علي أبو الريش مع الرواية تيار الوعي عند هذا الحد بل ظل يعتمد عليه اعتماداً كلياً أو شبه كلي في رواياته اللاحقة وحتى روايته “ك ص، ثلاثية الحب والماء والتراب” الصادرة سنة 2009 نجده لا يزال يواصل حفره، وكأنه لم يستنفد كل التقنيات الفنية لهذا التيار، ما يدفع إلى التساؤل عما إذا كان أبو الريش قد اطمأن إلى تلك الطريقة أسلوباً خاصاً به أم أنه لا يزال في سياق البحث عن صيغته الخاصة .
__________________
 قمة آلحزن ! عندمآ تجبرُ نفسّك على ڪره شخص .. كآنَ يعني لك آلعالم بِآگملہ ؤآلأصعب منـہ ! عِندمآـآ تتصنّع آلڪره .. و بِدآخلڪ حنيين وحب [ گبير لہ
|
|
#8
|
|||
|
|||
|
علي أبو الريش: بتنا نعيش غرباء عن أنفسنا وذاكرتي هي التي تكتبني تاريخ النشر: الخميس 26 أغسطس 2010 جهاد هديب ويقول “آنذاك، لم يكن بوسع الطفل أن يلعب وحيداً، فلابدّ من فريق متكامل وألعاب معروفة بالنسبة له مسبقاً، أي أن هناك وجداناً مشتركاً بالأساس يشكّل جامعاً لهذه الطفولة، لذلك نشعر بالحنين إليها لأننا أصبحنا اليوم غرباء عن أنفسنا أيضاً، وعنما أزور أماكن طفولتي هناك أشعر بأنني عدت أتنفس، حقيقة”. “لا أقل أولاً أنّ الطفولة وجدان، وليست ذاكرة فحسب، وهي اكتشاف، فكل ما يراه الطفل فإنه يراه لأول مرّة، من هنا كان رمضان يأتي بالجديد والمختلف وما لم نعهد من قبل أو نرى، لذلك كنّا نحتفي به ذلك الاحتفاء كله. وذلك على العكس مما هي عليه الطفولة الآن. نحن، عندما كنّا أطفالاً تلمسنا الرطوبة تأتي مع رائحة البحر والرمل. بهذا المعنى خلق منا رمضان جيلاً ينتمي لزمانه ذاك وتقلباته وكل مايجدّ عليه فيه ويختزنه في لاوعيه، ببساطة”. بهذا “الوجدان” اليَقِظ، بدأ الروائي المعروف وكاتب العمود الصحفي علي أبو الريش حديثه لـ”الاتحاد” ضمن حلقاتها التي يتحدث فيها مبدعو الإمارات عن ذاكرتهم مع هذا الشهر الفضيل. ويضيف “كان رمضان يأتي إلينا بأشياء جديدة دائماً؛ ملابس وألعاب وأكلات وحلويات ولقاءات تحدث لأول مرة، لذلك ما زال حضوره قوياً. كانت العلاقات بين الناس في منطقة المعيريض برأس الخيمة، حيث نشأت، كما في سائر الإمارات آنذاك، إنسانية وروحية وسهلة ودافئة، أما أيامنا هذه فسلبت منّا العلاقات الإنسانية التي تربط الإنسان بالإنسان، بدءاً من علاقة الطفل بالطفل وليس انتهاء بعلاقة الجار بجاره. إن الأغلب الأعم من بين الناس إما أن ينام حتى موعد الإفطار أو يقلِّب الريموت أمام التلفزيون، فيما يلهو الطفل وحيداً مع جهازه الجامد”. ويؤكد “لكنني مازلت أختزن تلك الطفولة في ذاكرة معينة. صحيح أن الطفرة النفطية قد منحتنا الكثير، لكنها سلبت منا الكثير وجعلتنا نعيش صراعا مع الجيل اللاحق. لقد عشنا المرحلتين، والفرق بينهما شاسع؛ الأولى، أي السابقة على الطفرة، رغم بساطتها وفقرها المادي لكنها منحتنا مخزوناً هائلاً من الذكريات والعاطفة الإنسانية الثرية جداً والحارّة، أما المرحلة التالية فبتنا فيها غرباء حتى عن أنفسنا “. ويزيد في سياق التأكيد ذاته “لو لم نكن، وجدانياً، أبناء تلك المرحلة لما استطعنا العيش الآن، ومقارعة كل هذه التغيرات وملاحظة الآثار التي تتركها فينا كأفراد وفي مجتمعاتنا والكتابة عنها، لقد خلقت منا أيامنا الأولى جيلاً قوياً وإنساناً قوياً” ويضيف “كنا نتلمّس المكان وثقافثه وتاريخه الاجتماعي والسياسي بدءاً من الوسط الاجتماعي المحيط ذاته؛ من الأب والأم والجيران والعائلة الممتدة و”الفريج” ثم المعيريض بأكملها. كانوا يمنحوننا بذلك الإحساس باختلاف رمضان عبرهم وعبر رؤيتهم لأنفسهم فكانوا يؤثرون في رؤيتنا إلى العالم بدءاً من المكان وبالتالي يوثّقون من ارتباطنا به وبحضارته وثقافته. وذلك على العكس مما يحدث الآن، فهذا الجيل يعرف كل شيء عن العالم ولا يعرف شيئاً عن مكانه”. أما عن الألعاب التي كانوا يمارسونها أطفالاً، فأشار الروائي علي أبو الريش إلى أنها كانت ألعاباً شعبية مثل “المقصي” والأرجوحة” وسواهما من ألعاب “لكننا لم نكن نتأخر في اللعب بحكم أن “الفرجان” في المعيريض كانت متباعدة آنذاك ولم تكن هناك أبراج، فكنا نلعب حتى منتصف الليل أو الواحدة صباحا ثم ننام حتى يأتي “أحمد قنوة” “المسحر” الذي يدعو بقرقعته الناس إلى القيام لتناول السحور، وأتذكّر أنه كان شخصية مختلفة، فهو يكره اسمه ذاك لكننا، نحن الأطفال، لما نراه، نهاراً، نركض خلفه ونناديه باسمه، فكان يجري خلفنا فيما نتراكض ضاحكين وهاربين في أزقة “الفريج”. وعندما يقترب العيد كان يطوف بالبيوت فيأخذ أجرته طحيناً أو تمراً. لقد فرض نفسه عليّ وكان واحداً من شخصيات إحدى رواياتي”. ولما قلت إن الصنيع الروائي، إجمالاً، لديه، قائم على فعل تذكّر للمكان والشخصيات أكد أبو الريش “إن ذاكرتي هي التي تكتبني، أو هي المكتبة التي أستل من بين رفوفها كتبي”. وفي سياق صنيعه الروائي وعلاقته بدراسته علم النفس العام، أكّد علي أبو الريش “يجب على الروائي، من وجهة نظري، أن يكون ملّماً بشيء من علم النفس، إذ إنه يتعامل مع شخصيات وأمكنة وأزمنة متعددة وفقاً لحالات نفسية متعددة وهذا ما منَحني طول النفَس في الكتابة الروائية لأنني أقوم بدراسة “الحالة”، أي الشخصية وهو مصطلح علمي متداول في علم النفس، بدءاً من الطفولة وحتى اللحظة الراهنة، أي أن الشخصية التي أكتبها لها تاريخها الخاص المنفصل عن الشخصيات الأخرى، وهو تاريخ لا يظهر في العمل نفسه بل يشكّل جانباً من الخلفية التي أنتجت العمل ككل”. وأضاف “إن تلمّس الشخصيات في العمل الروائي هو واحدة من أكثر مراحل البناء الروائي عسراً، لكن بمرور الوقت اعتدنا على تجاوز هذا العسر بالجلوس إلى الطاولة لأربع أو خمس ساعات، فيما يدرس المرء الشخصية من خلال زمنها والمرحلة التي عاشت فيها وطبيعة تلك المرحلة بتداخل كبير مع تلك الشخصيات التي ما زالت فاعلة في ذاكرته الشخصية، فهذا الذهاب إلى الماضي عبر الذاكرة أمر لا محيد عنها”. وختم الروائي علي أبو الريش حديثه لـ”الاتحاد” في صدد الرد على سؤال تعلق بحنينه إلى تلك الأيام الرمضانية بالقول “بالتأكيد أحنّ إلى تلك الطفولة وليس إلى المكان الذي حدثت فيه تلك الطفولة يوماً ما وصار جزءاً منها. أتدري؟ الآن سأحجز بطاقة سفر ومقعداً في طائرة ورقية وأعود إلى الطفل الذي كنت هناك”. اقرأ المزيد : المقال كامل - علي أبو الريش: بتنا نعيش غرباء عن أنفسنا وذاكرتي هي التي تكتبني - جريدة الاتحاد http://www.alittihad.ae/details.php?id=53843&y=2010&article=full#ixzz1mRpROqoE المصدر : الاتحاد. == إشكالية الموت في " رواية زينة الملكة " للروائي الإماراتي علي أبو الريش - ريم العيساوي تأثرت الرواية العربية عموما بالرواية الغربية ، غير أنها بعد الحرب العالمية الثانية بدأت تحقق ذاتها نحو النضج الفني والتأصيل وتتعمق شكلا ومضمونا ، على يدي كبار الروائيين العرب المعاصرين. ومن الملاحظ أن تأثر الرواية العربية المعاصرة بالرواية الغربية كان واضحا في الأساليب الفنية أكثر من المضامين وذلك لاختلاف واقع المجتمع العربي عن المجتمع الغربي . وتندرج رواية " زينة الملكة " لعلي أبو الريش ، ضمن هذا التأثير، وقد استفاد من تقنيات الرواية الجديدة التي تفنن أصحابها في تنويع أنماط الحديث الباطني وانفتح على التراث العربي الإسلامي ، معتمدا على المحلية كمنبع ثري لتجديدها و تكثيف دلالتها وتعميق أبعادها . يطرح علي أبو الريش في رواية " زينة الملكة " غربة الإنسان المعاصر ، مصورا همومه وتطلعاته ، أحلامه وصراعاته ، ومعاناته إزاء إشكالية الموت ، وذلك من خلال الشخصية المحورية "زينة الملكة " وبتوظيفه توظيفا متقنا لأسلوب تيار الوعي والرمز، متناولا قضية الموت بأبعادها الاجتماعية والفلسفية محافظا على أصالتها بتوجهه نحو الكتابة التي تعتمد على الجانب التاريخي والأسطوري ، موظفا التراث الصوفي الإسلامي مستلهما من الذهنية الشعبية الخرافية ، مؤكدا أن المحلية هي السبيل المؤدي إلى تأصيل الرواية العربية وتخليصها من قيود التبعية ، محققا المعادلة بين توظيف التراث والاستفادة من الثقافة العالمية ، ومبرهنا على أن الرواية لها أن تولد من أرحام القرية . وإن ربط أحداث الرواية بقرية " المعيريض " بالإمارات العربية المتحدة فإن الرواية تنفتح على الآفاق الإنسانية الرحبة ترمز إلى واقع الإنسان وما يعانيه من غربة الذات وغربة الوجود . لقد كانت وما زالت إشكالية الموت بمفهومها الحقيقي و بمفهومها الفلسفي إشكالية محورية في الرواية العربية المعاصرة وهي سمة بارزة في الإبداع العربي عامة ، وقد تفاقمت بسبب ما لحق الواقع العربي من أزمات متكررة ، فكان الإحساس بعبثية الواقع وعدميته . وليس غريبا أن يعتبر الموت قضية إشكالية وفد بحث فيه المفكرون في جميع الفلسفات والحضارات ، وخاض العقل قاصرا غمار هذه المسألة، فكانت الضرورة لتلبية صوت الإيمان . إن رواية " زينة الملكة " من الروايات العربية المعاصرة المندرجة تحت تيار الرواية الوجودية يطرح فيها كاتبها قضية الموت بوجوهها المتعددة وقد كان الموت جرسا مرعبا يدق عبر نسيج الرواية ويعكس الواقع الدرامي المهدد للإنسان والحيوان على السواء ويسلب الكائنات شعورها بالأمان . كيف كانت رحلة زينة مع الموت ؟ وكيف تشكلت صورته في الرواية ؟ وكيف كان أثره على الإنسان؟ ما هي دلالاته ؟ وإلى أي حد تتجلى رؤية الكاتب وفلسفته في الوجود؟ وما هي المرجعيات التي تستند عليها هذه الرؤية ؟ الموت الواقعي في الرواية والتجربة الحسية الوجودية : تنفتح الرواية بعبارة مشحونة بدلالات الموت :" ( زينة ) البهية الزهية ، في زرقة الموت ، انتعلت خسارتها ، ووضعت جسدها المنهك عند ناحية الفجيعة وانتظرت زيارة الصباح....هذا الصباح لا يأتي محملا برائحة الأطفال الذين ذهبوا بعيدا ، عند ناصية المقبرة القديمة ...صباح سكران بالكافور وبكاء الجارات اللاتي ، ودعن فلذات الأكباد ، وكلما فقدت معيريض عزيزا ، جئن بالسواد، مكللات بالدموع والعبوس "( 7) . إن هذا الانفتاح ، يبني علاقة غير مألوفة بين الموت الذي عرف ببشاعته وصفة البهاء وما تحمله من معان تشير للمعنى الرمزي للموت، وهذا يتقابل مع معناه الحقيقي و منذ المنطلق تبرز ثنائية صريحة بين قبح الموت وجماله . كما أن دلالة المكان ( المقبرة القديمة ) ، وعلاقتها بالزمن النفسي (صباح سكران بالكافور وبكاء الجارات ) يعمق الوجه الدرامي للموت ويكثف سوداويته . ولعل هذا المدخل بجميع عناصره الدلالية بمثابة الميثاق الروائي بين الكاتب والقارئ . ضرب من التهيب في خوض هذه الإشكالية الوجودية الأبدية ، صراع الإنسان مع الموت . هكذا تنفتح الرواية بإطارها الزمكاني معلنة عن وجهين متقابلين للموت ، الموت الواقعي الوجودي والموت الفلسفي الرمزي . يدق جرس الموت ضربات موجعة منذ الصفحات الأولى ( ص 8) يعلن عن موت " يوسف الراوي " زوج زينة وهو الحدث الفاجعة المعذب لنفس "زينة الملكة " ومنطلق استرجاعها لذكرياتها وتفاصيل حياتها ، ومكانة زوجها في وجدانها ، وقد عمق علي أبو الريش تلك العلاقة الرائعة بين الزوجين ، فقد تحابا إلى حد الذوبان وتكللت حياتهما بالسعادة رغم فقرها واتكائها على هبات الجيران ، وعاشا معا التجربة الحسية بكل عشق وامتلاء إلى حد التوحد والالتحام . " فقد سلب منها النوخذا متآمرا مع البحر الدماء التي كانت تلون بها وجهها عند الصباح " ( ص42 ) .ولم تنس زينة كلماته الحانية :" أنت الروح التي ينبض بها قلبي ، والدماء التي تسري في جسدي " ( ً 96 ) . ويمثل فقدان زينة لزوجها "يوسف الراوي" بداية وعيها بمفهوم الموت ومنطلق بحثها عن الحقيقة الكبرى: " ظلت زينة مسلوبة باتجاه حقيقة مطلقة واحدة ألا وهي الموت ...والكائنات على أرض البسيطة تولد ومن ثم تموت وتنتهي إلى لاشيء دون أن تتوقف لحظة للتأمل في أصل الغياب الأبدي ، بينما هي الوحيدة التي انشغلت منذ غياب يوسف الراوي بأمر الموت ، بل هي ليست مقتنعة أبدا بأسرار الموت التي يجترها الآخرون ( ص123 ) . إن موت زوجها سبب لها الشعور بالتيه والضياع وموته هو موتها ، و صارت تتجرع مرارة الخواء واليأس . وتظل زينة بعد موت زوجها تشعر بوجوده ، وتراه في أحلامها و في يقظتها ، رافضة فكرة الموت ، حالمة بانبعاث روحه ، لذلك فهي تصورته في صورة الرجل العملاق الخرافي الذي شاهدته في المقبرة . كما تصورته في صورة القمر ، ثم في صورة الجبل العملاق ، الذي حققت به الصعود والانعتاق بعد أن جربت صعودها الأول مع القمر . " قالت في لحظة استجلاء الحقيقة ، لم يخرج الرجل الخرافي ، من أجل إخافة امرأة وحيدة ضعيفة ، إنما هو ظهر هكذا كصورة مثلى للموت الجميل الذي يعانق الأرواح ويمنحها زهو الخلود، وهو نفسه يوسف الراوي " ( ص 112 ) إن زوجها لم يمت وخاصة ، كان قبل وفاته يحدثها :" لا تخشي شيئا يا زينة ، لن أموت ...لأنني أحببت امرأة رائعة مثلك أنت يا زينة ساكنة قلبي و أنا على يقين من أنني أستعمر فؤادك ... لذلك الذين يحبون لا يموتون " ( ص 94 ) . " و أن الناس النبلاء لا يموتون " " إن أمثال يوسف الراوي لا يموتون فهم قابضون على الحياة ، متمسكون بقيمها الرفيعة ، لا تفارقهم الأنفاس أينما كانوا ، سواء كانوا تحت التراب أو فوقه ( ص 121 ) . إنها فكرة الخلود وانبعاث روح يوسف الراوي ، فكرة تواترت عبر الرواية وزينة " مقتنعة بأن زوجها جاءها في ذاك المساء ليؤكد قناعتها أنه لم يمت ، وأن ما نقل عن وفاته ليس إلا مجرد حيلة رسمها أحمد بن السلطان النوخذا.."( ص 100 ) . ومن هنا تكشف الرواية عن صورة عميقة للموت ، تجلت بعد انتقام النوخذا من زوج زينة وهو الحدث الذي ينسج خيوط الرواية وتتمحور حوله باقي الأحداث وهو العمود والأساس الذي بني عليه هيكل الرواية ، موت زوج زينة " يوسف الراوي " ، بالرغم من قدرته المهنية وكونه الذراع الأيمن للنوخذا والخبير في مهنة البحر ، إلا أنه لتمرده على ظلم النوخذا الذي يمارس جبروته على الفقراء ، لقي حتفه ودبر له مؤامرة لغرقه، إنها صورة للموت العقاب لكل من تسول له نفسه المطالبة بحقه . و هنا يوثق علي أبو الريش لمرحلة ما قبل اكتشاف النفط ، حين كان القوي يأكل الضعيف والمالك يملك مصائر الفقراء ، وتعكس الرواية طموح الفرد لتحقيق التوازن الاجتماعي والانسجام بين شرائحه وفئاته . إن صورة الموت الانتقام فيها إدانة الكاتب للظلم . ولعل يوسف الراوي الذي دفع حياته ثمنا لتمرده هو صورة الفرد الواعي بقضيته وبمنزلته والرافض للممارسات الجائرة وقد رسم علي أبو الريش على لسان زينة ملامحه رسما فنيا فبدت شخصيته غير عادية ، فيها من الدهشة والإبهار، فهو رجل لغير هذا الزمان ، لما في روحه من جلال الأخلاق ورفعتها * ( صورة يوسف الراوي في دراسة سابقة بالخليج) ومن خلال رسمه ليوسف الراوي فهو يستنهض همة الضعفاء المتخاذلين للثورة على الاستبداد ويطمح أن تمثل هذه الشريحة المسحوقة جبهة الرفض والتحدي ومقاومة الواقع المتردي والمساهمة في تصحيح الواقع بصورة إيجابية وفاعلة والوصول إلى التوازن الاجتماعي وتحويل العلاقات القائمة بين الفئات الاجتماعية من الشكل الصدامي والعدائي إلى علاقة أساسها الانسجام والوئام . ويدق جرس الموت مرة ثانية :" قي صباح وغد عبوس ، صحت المرأة المفجوعة على الهول فتحت عينيها على الكارثة ...لا تملك إلا الصرخة تقاوم بها أنياب الفجيعة المباغتة تلوب في فناء البيت كالمجنونة وتطوف بالزوايا في تيه المفاجآت المذهلة وتهرول في الاتجاهات بلا هدى لا تعرف سبيل الأسباب التي أدت إلى موت قطتها الصغيرة سلوى" ( ص22 ) . لقد عمق علي أبو الريش أثر موت القطة على زينة ، فهو شبيه بحزن الأم على وليدها وهي القطة المدللة التي دأبت على الاحتماء بصدر زينة " بكت زينة بمرارة الحرمان والعدوان الهمجي ... ارتجفت رفعت بصرها إلى السماء ظلت شاهقة واجمة تنوء بوزر حزن أثقل صدرها المتعب " كان موت القطة سلوى نكبة عظيمة في حياة زينة ، ألح علي أبو الريش على دراميته و صرح به قائلا :" رحيل سلوى فتح فوهة نار حامية ، طالت ألسنتها اللاهبة شغاف من ألفها ،، في هذا النهار انشقت الأرض وابتلعت دماء الجسد الناحل ،واستدارت السماء لتكنس الرائحة الطيبة التي خلفتها سلوى " ( ص28 ) . كما هيج موت القطة ذكرى موت زوجها يوسف واسترجعت حنوه الفائق عليها . وعكس حزن زينة على قطتها تمردا على الموت ، وهي المرحلة الوجودية التي تعكس الخوف من هذا السر وكان عزاؤها الأمل في عودة الروح إليها . ويمثل هذا الحدث بداية التفكير في مسألة الانبعاث . " زينة لا تريد أن ترى القطة جثة هامدة ... هذه قيامة الله في أرضه هذه الساعة الأخيرة لهيام الأرواح " . و قرب الخيمة تدفن زينة قطتها سلوى بعناية ورفق وتعي زينة بحزنها الشديد هذا فتحدث نفسها : " مات يوسف الراوي وانتزعه الموت من كبدي ، وبقيت وحدي تصفعني الزوايا بوحشية الوحدة القاتمة ، إلا أنني لم أشهد حزنا كهذا الذي أنا فيه رحيل سلوى فتح أمام عيني نفقا أسود لا أستطيع مقاومته " ( ص24 ) . ولعل هذا الجزع الكبير على موت القطة سلوى تبرره دلالتها ، ألا تكن القطة رمزا للأمل وشعاع النور و الفرحة بالحياة الطليقة الخالصة من أوجاع الواقع ؟ :" رائحة سلوى تملأ زوايا البيت " و" سلوى قطة رائعة عظيمة بعظمة الموت النبيل " . وصور علي أبو الريش موقف الإنسان المؤمن من تصرف زينة المتبرم من الموت وذلك من خلال شخصية مهرة قارئة القرآن :" همهمت مهرة بضحكة مبهمة ساخرة ساخطة ثم أردفت :" لكن ما تفعلينه شرك ، فهناك نساء ورجال فقدوا فلذات أكبادهم فلم يفعلوا ما تفعلينه ، بل استخاروا الصبر مؤمنين أن الموت حق ، دعك من هذا الإسفاف إنه شرك عظيم " . وبقدر ما تنظر مهرة للحيوانات نظرة اشمئزاز وتراها رمزا للنجاسة ، فإن زينة تنظر لحيواناتها نظرة مخالفة ، نظرة إنسانية وكثيرا ما فضلت حيواناتها على الناس المنافقين المستبدين ،الفاقدين للقيم . وترى زينة في قططها وفي كلبها فهد معنى لوجودها ، وقد رددت مرارا إن :" الحياة بدون هذه الكائنات بلهاء جافة " ( ص 26) . ومثل موت القطة مرحلة جديدة في وعي زينة بمشكلة الموت فصار مفهومه عندها :" رحلة الغياب الطويلة " ووصف علي أبو الريش نظرتها له بقوله " لا يمكن لزينة أن تفكر في الموت سوى أنه كائن حي ، يسير على قدمين يتحدث معها ، ويؤنبها أحيانا .. و أحيانا يغبطها" ( ص30 ) ، واقتنعت زينة أنه لا ضرورة للحزن على سلوى ما دام الأمر مجرد انتقال من عالم إلى عالم آخر " ( ص 30 ) .و هذه خطوة جديدة في وعي زينة بقضية الموت ، والاقتراب إلى منبع الإيمان، وما يدل على هذا التحول ،اعتبارها للموت مجرد تحول من مكان محدود إلى مكان مطلق وقولها :" ربما لا تكون سلوى أحبت عالم الخيمة المزدحم ففكرت في الرحيل ...و هكذا تفعل الكائنات عندما تضيق الأرض وتعيش فإنها تلوذ بالعالم الأوسع ، هكذا يصبح مفهوم الموت تخلصا من المقيد وارتقاء نحو المطلق . وتتبع علي أبو الريش تدرج هذا الوعي بقوله :" نمت الفكرة في رأس زينة ، صارت كبيرة بحجم الغياب ومقدار حبها لسلوى واقتنعت تماما أن الموت ليس فناء أبديا بل هو الاقتراب من مثل أعلى ، سلوى كانت ليست كسائر القطط، كانت تنحو باتجاه النساء ولم تلبث يوما أ ن سقطت في رذيلة التهافت كان ملاذها صدر زينة تستلهم منه خلجات النفس العليا ... الموت ليس معناه إزهاق الروح بل هو الإطلاق والتحرر" ( ص 31 ) . وتستخلص زينة أن الموت يختار الأرواح النقية ، وعبر الكاتب عن هذه الفكرة بقوله :" إن الله سعيد بمجاورة سلوى لبنيانه الرفيع، وهي قطة فاضلة لا تسقط عيناها إلا على المثل العليا " ( ص 32 ) . " لا أعتقد الموت كائنا بغيضا ...إنه عندما يأخذ الأرواح يميز بين اللئيم والحليم ...لقد انتزع روح النوخذا ليذهب إلى جحيم مؤكد ، بينما رافق روح الراوي وكذلك القطط إلى حيث أعيش هنا...لا يمكن أن يذهب يوسف الراوي بعيدا وكذلك القطط.... لا شيء أذكر عن الموت ، إنه الفطنة الوحيدة على هذه الأرض .." ( ص 184 ) . إن هذا التحول غير حزن زينة إلى سعادة باعتبار الموت هو خلود في الفضاء الأعلى :" انفرجت أساريرها ...فكرت مليا وبصرت القبر جليا وانداحت أمام عينيها فكرة جديدة ربما تكون غريبة لكنها الأقرب إلى قناعتها ، الغياب مسألة رائعة أن يغيب الإنسان ، يذهب بهدوء كما جاء ، بهدوء تفتقت السماء عن وميض كان أشبه بالبهاء الذي ينزل على العينين ثم يسرق الحقيقة ليضعها على كتف المشتاق للمثل " ويصرح علي أبو الريش بالمفهوم الجديد للموت في تصور زينة :" الموت ليس معناه إزهاق الروح بل هو الانطلاق والتحرر والدخول في بهاء أوسع " ( ص 31 ) . وإذا كان النوخذا قتل يوسف الراوي دفاعا عن مكاسبه المادية وتمسكا بمستواه المادي وقد تضمنت الرواية العديد من الإشارات الكاشفة ل تقديس النوخذا للمال ، فإن موت الفتاة سلمى على يدي والدها ، دفاعا عن شرفه تعكس صورة أخرى للموت الانتقام وهو تجسيد للظلم الاجتماعي في أبشع صوره و أضراها ، ظلم يمارس داخل الأسرة ، الشريحة الخلية للمجتمع ظلم يمارسه الوالد على المولود ومن هنا يبرز لنا الكاتب مواطن الخلل في المجتمع والقطيعة بين الآباء والأبناء والصراع الدموي بينهما. وإذا صور علي أبو الريش انبعاث الفتاة المقتولة على يدي والدها وإعلانها عن براءتها وإفصاحها بجريمة والدها فهذا احتجاج منه على هذا السلوك اللاإنساني وإن هذا الانتقام ليس هو الحل وإنما الحل يكمن في التخلص من الأسباب والظروف التي تصنع الصراع وتمضي به إلى النهاية المأساوية . وعلى الجيل القديم أن يتفهم طبيعة الواقع الجديد ويتخلص من رواسب العادات المتحجرة ويسلك طريق التعقل والخيار الإنساني الأفضل .وما شعور الأب بالندم بعد قتله لابنته غير صراعه مع واقع العادات المتحجرة . ما انبعاث الفتاة في المقبرة أمام عيني زينة إلا ـأكيدا على فكرة خلود الروح ، وأن الموت ليس نهاية الحياة . وتصبغ أحداث الموت المتكرر المكان بمسحة الحزن حتى في المناسبات السعيدة التي يفترض أن يفرح فيها الناس ، أيام العيد وكذلك في المكان الذي تعود الناس أن يكون مصدر سعادتهم وألفتهم وهو سدرة بيت أبو حميد :" في الصباح الباكر كانت سدرة بيت أبو حميد تشهد حدثا دراميا أسيفا ومحزنا ... كانت بنات معيريض يتجمعن من كل حدب وصوب وبملابس العيد المنقوشة والمزركشة والمنقطة بدوائر الزري ... جل البنات بخضاب العيد ورائحة الحناء وزعفران الفرح ... قفزت الذاكرة نحو نواح مزر ألهب فؤاد المرأة ، تذكرت تلك الفتاة التي انزلقت من حبل الأرجوحة لتقع على التراب الحجري مغشيا عليها فاستحال فرح العيد إلى نكبة " ( ص103 ) . الموت الفلسفي الرمزي في الرواية والتجربة الروحية : بعد رحلة طويلة من التأملات، وبعد تكرر أحداث الموت المحدقة بحياة زينة ، وبعد صراعات حادة مع الذات ومع الناس وتناقضاتهم ، تحول مفهوم الموت في تفكير زينة إلى معنى جميل ، فهو لا يتعارض مع الحياة بل هو القيمة الإيجابية لها ، وبعد أن سيطرت فكرة الموت على تفكيرها وتسربلت حياتها بالخوف وعدم القدرة على التكيف مع المجتمع ،وقوي إحساسها بالغربة والتهميش ، في خيمة مظلمة ، متعفنة، ينيرها مصباح خافت ، والمعاناة من العزلة وانعدام تواصلها مع الناس ، أصبح وضعها مأزوما وقوي إحساسها بالإحباط و تكثفت نظرتها السوداوية للوجود ، وبلغت ذروة اللاتوازن مع العالم ، فظهرت أمامها علاقة الحب والموت :" هذا الجبل الشامخ الذي يقطن بجواري ، ليس إلا جبل الحب ..آه ..الحب هو الموت بعينه ...الذي يحب لا يموت .." ( ص 184 ) . ولا يخفى على أحد علاقة الحب بالموت في التصوف الإسلامي، سواء على مستوى الحب الحسي أو على مستوى الحب الروحي ، فمن علامات تلك العلاقة أنها علاقة تدل على المشاعر النبيلة الصادقة أثر من آثار هذا العالم الفاني تنقل صاحبها إلى العالم الباقي ، فالمحبة هي الوصل بين الأرواح ، ورمز البقاء الأصدق في هذا الوجود . وحب زينة رمز لصفاء روحها ،وخلو نفسها من عفن البدن ، وحبها الصادق للمثل ولزوجها ولحيواناتها مكنها من الوصول إلى حب الله ،وهيّأها لتفهم أسرار الكون هذا الحب أمد زينة بوجود أعلى و أشرف من الوجود المحسوس . ومن دلالة هذا الحب إرادة الحياة التي لا يمكن أن تنتهي بالموت بل تتواصل بوجود لا ينغصه الفناء ، وفي إرادة الموت تذوب الفردية ، ويبقى المطلق ، أعلى صور الإرادة و أكملها وهذا أبدع ما في التصوف الإسلامي . وهذا الحب جعل زينة تختار الموت الجميل الذي ترى فيه خلاصها من واقعها المتردي . وكان فقدانها لزوجها ثم لحيواناتها تلك الروابط الوحيدة التي تعطي معنى لوجودها سببا في اختيارها الموت، الذي نفذت لجوهره وتخطت معناه السطحي بوعيها لزيف الحياة :" الحياة تشبه الناس الغادرين المنافقين الماكرين ، تصنع الأشياء جميلة ، رائعة ، براقة ، ثم تتخلى عنها لتسلمها لقبضة الموت ...الموت هو الكائن الوحيد الشفاف ، الجريء الصادق ، المحنك الذي لا يعرف الخديعة ولا يرتكب الرذيلة ...إنه يأخذ الأشياء إلى العميق ، المعتم ، يحفظها ويهيل عليها التراب كي يستر فقرها وعجزها ، ثم يلتفت إلى أشياء أخرى ،الناس يخشون الموت وكأنه الغاصب المحتل ، بيد أنهم لا يعون أن ما تقدمه الحياة هو ضوء كاذب .." ( ص 120 ) . " إن الموت حياة أخرى أجمل ، وأروع ، وأكثر صدقا " ( ص 121 ) وهو الخلاص لها من عذاباتها والمطهر لآلامها ولحالة الانتظار القاسية التي تعيش عليها . وصار الموت في هذه المرحلة محققا لكرامتها بعد أن كان مدمرا لها . وألح الكاتب على هذا التحول الجذري في صورة الموت بقوله :"الموت الذي كانت تعتقده كائنا مخيفا يقتحم الأجساد فجأة ويذهب بأرواحها إلى المجهول ويدع الأجساد هامدة ، تغيب بعد وقت كثير من زوال الروح تحت ركام الرمل بلا رجعة ، أصبحت الآن تقرأ ملامحه بروح شقية ، حية، تحدثه ، تبتسم في وجهه ، تستقبله بمزاج رائع لا تشوبه دمعات الأنين " ( ص 60 ) . وجسد علي أبو الريش شوقها إلى الموت بقوله :" هي الآن لا تفكر في هذا العمر لا تفكر في الموت كونه نهاية بقدر ما تفكر به ككائن حي ، تريد أن يقبل عليها في ليلة ليحدثها عن سيرة الذين رافقوه :" ( ص 188 ) . لقد جسد علي أبو الريش في روايته هذه صراع الإنسان مع الموت وهو خيار أمامه لحياة غير مجدية ، حياة أبشع من الموت وقد عاشت زينة ضربين من الموت موتا داخليا نفسيا ينخر فكرها وموتا خارجيا يصبغ وجودها بالقتامة ، موت مركب في صورة ظاهرة وأخرى لامرئية . إن الحيرة الوجودية التي مرت بها زينة جعلتها تتساءل هل تواصل الموت في الحياة راضية بالعذاب ؟ أم تغتال هذه الحياة المريرة وترحب بالموت الجميل وتستعجله بشوق لتلحق بزوجها يوسف الراوي . إن هذا المعنى الفلسفي للموت الذي صوره علي أبو الريش في رواية "زينة الملكة "عكس فيه وعي الإنسان المتمرد غير المقتنع بجدوى وجوده ، موقف الرفض والاحتجاج على كل الممارسات اللاإنسانية وذلك بالهروب والاعتزال وقد عمق الحس العبثي التشاؤمي مما جعل الشخصية بهروبها من واقعها شخصية انهزامية وسلبية ، تهرب من الواقع إلى عالم الحلم والخيال وتحقق ما حرمت منه بعد فقدان زوجها ، كأن تتزوج من القمر وتنجب منه ولكن هروبها هذا ملاذ أخير للتطهر من أدران الحياة وسرابها الخلب :" لا يخطر ببال أحد لو قالت زينة لجار أو جاره إنها تزوجت في ذات يوم القمر، وأنجبت مكنه البنات والبنين ، وكانت تضاهي الشمس في حميتها وسعيرها ..كان القمر يقول فيها شعرا حزينا ...هذه الحكاية سرية ولم تسردها لأحد خشية أن توصف بالجنون ...أرسل القمر إشارته الأولى ، كانت رسالة عبارة عن قطرة ماء عذبة تلقفتها زينة بشفتين ناشفتين ...بعد ذلك أصبحت زينة مسكونة بهذا الحب معلقة بين السماء والأرض " ( ص 133 ) . أو تتخيل بعلها يوسف في صورة الجبل الذي حط أمام خيمتها وتلتحم به غائبة معه في عالمه بعيدة عن الأرض :"نظرت إلى العراء ، لكن الجبل يدوي هو أشبه برجل الشريشة ؟ يذكرني هذا بيوسف الراوي ، كان رقيقا شفافا ...لكنه في صلابة الجبال وشموخ الدوح الأشم ...صمتت لكن الجبل يدوي يهدر، ويهز صخوره كأنه الزلزال ... تشوقت شعرت أن الخيمة الوضيعة ، لا تسع مشاعرها المتوقدة ... بهتت زينة قالت هذا هو يوسف الراوي هذا الشفق المنشق عن ومضة الحلم ... أنا لا أحلم بل أنا يقظة ... صارت يداها جناحين ، وصار جناحاها شراعا يسبح في الفضاء .. يا إلهي ! ما أسعد الإنسان عندما يغادر الأرض الملعونة ... حلقت زينة كان " باب سلامة "ينشق عن موجات وأعماق ، زرقاء تغوص في ألوان حقيقتها أسرار وألغاز .. كان الناس يحكون عن باب سلامة القصص المرعبة وعن الموت الذي يتربص بالأشرعة والرؤوس ، هنا في هذا المدخل الضيق المحتشد بزرقة الضجيج وعتمة الخوف .. بدا الجبل باسما .. بعد مضي زمن ، فتحت زينة عينيها ، نظرت إلى أسفل قدميها ، لمحت بئرا عميقة تبتلع فرحتها .. حدثت الكلب قالت : ما أريد أن ألمسه هو هذا الموت الجميل ، لولاه لما حلم الناس بالحياة ولما فكروا في مقايضته بالحلم ، ما بين الموت والحياة حلم كل الأشياء التي تبدو رائعة هي من صنيع الموت .." ( ص 200 ) وفي هذه المرحلة تحققت زينة "أن الوصول إلى ذروة الموت هو أقصى حالات النشوة " ( ص 204 ) ويصور علي أبو الريش معانقتها للموت في لغة شاعرية شفافة صافية في صفاء الفضاء الذي حلقت فيه وبتفاصيل دقيقة :" لا أحد هنا في الملكوت سواها ويوسف الراوي يبتسم للموت ... تحمل فرحتها على صفحة قلب أخضر ... صمتت زينة ، غابت أجهضت الوعي نافرة صوب الرحاب الواسعة ... صمتت وكل شيء سكن متكئة على الغياب في صحبة الموت ..وهي في السفر الأخير في سطوة الغياب الجميل ، في زرقة النهاية.. لا ضير أن أفتح عيني لأرى يوسف الراوي وقد نام في مهد قيلولته الحالمة يضع يدي على وجهه ثم يقبل وجهي ويقول : لا تجزعي يا زينة، يا ملكة ، لا يفزعك الغياب فخلودك هذا يكفيني ... كانت الغفوة العميقة تسيطر على زينة وكانت سطوتها الرائعة تمنحها نشوة الخلق الجديد ... " ( ص211 ) . لقد حققت زينة ولادة جديدة وانبعاثا ، فيه لذة الذوق ، وأمّنت راحتها بالرجوع إلى الوطن الأصل ، حضن الجبل ، رمز الطبيعة البكر، بعيدا عن زيف الدنيا وسعار التهافت والغرور والشهوات والفناء الجميل في ذات المحبوب . و نلاحظ بوضوح ، المرجعية الصوفية الإسلامية ، في أحسن توظيف ، تتجلى في بروز خصائص الأحوال الصوفية كالشعور بالخلود وتلاشي الخوف من الموت والإحساس بالسعادة ، والشعور بالفناء التام في الحقيقة المطلقة وخرق حواجز الزمان والمكان وصورة المحبة الشاملة تلميحا إلى وحدة الوجود ، وهو مفهوم متفق عليه عند المتصوفة ، والإشارة إلى أن الموت لا يصيب إلا صورنا المحسوسة الفانية كما عبر عن هذا ابن عربي :" و إن فسدت الصورة في الحس فإن الحد يضبطها والخيال لا يزيلها " . إنّ علي أبو الريش من منطلق المرجعية الصوفية تصدى للوجود الروحي لحل معضلة الموت، الذي فيه خلاص الإنسان من أزمته الوجودية . وقد استطاعت زينة بلوغ هذه المرتبة لأن قلبها خرق أستار الحجب وكثافة الحواجز نحو إدراك السر، ولأن روحها تعطرت بشذى التبتل العميق و لم تدرك هذا المقام بمدد من العقل فقط ، بل وإنما أدركته بمرتقى لا يدرك بالأبصار ، وإنما عن طريق الحدس وهو المرقى الذي يعرج فيه الإنسان بروحه صعدا في طراز رفيع من النفحات العلوية ، طراز الروح الصافية . لقد خلص علي أبو الريش إلى أن الموت ليس مشكلة ، لأنه شيء يرد إلى الشعور بالذات ، كما أنه شيء متناقض في ذاته عصي على الفهم لا يفهم إلا بالمكابدة وترويض النفس ، ولكن في الحقيقة مشكلة الإيمان الذي يقبله وجدان ويرفضه وجدان المنكر ، هو الحل لهذه القضية . لقد بين الكاتب أنه عندما تختفي صفة الذاتية يصير الموت وصلا مع الكون و مع الله واتصالا جوهريا تكمن فيه الصفة الأساسية التي ينشدها صاحب الحقيقة ، علاقة مباشرة مع المطلق وهذا تأكيد على القيمة الروحية ، فالوجود الحقيقي هو الوجود الروحي وهو العالم الأفضل و الأبقى .إنه حل لمشكلة الموت حلا صوفيا عن طريق الإيمان ومن هنا تعلن الرواية عن فلسفة وجودية إسلامية
__________________
 قمة آلحزن ! عندمآ تجبرُ نفسّك على ڪره شخص .. كآنَ يعني لك آلعالم بِآگملہ ؤآلأصعب منـہ ! عِندمآـآ تتصنّع آلڪره .. و بِدآخلڪ حنيين وحب [ گبير لہ
|
|
#9
|
|||
|
|||
|
34- النخلة والجبران غائب طعمة فرمانالعراق النخلة والجيران ياسر عيسى الياسري سينما الصورة الذهنية في الرواية العراقية واستمرار الرؤيا علم واثر.. سلسلة دأبت دار الشؤون الثقافية على اصدارها حيث اهتمت بنشر أهم الأعمال الأدبية التي لم تعد طبعاتها متاحة أمام القراء ولعل أهم الروايات التي أعيد طبعها في تلك السلسلة رواية النخلة والجيران للروائي العراقي الكبير غائب طعمه فرمان كنت قد قرأت الرواية منذ زمن بعيد نسبيا و لا اذكر تماما أنني أكملت مشاهدة المسرحية لأنها عرضت أيام الوفاق والتصالح السياسي الذي انفكت عراه عندما دخل التلفزيون الى بيوتنا المتواضعة وهكذا وجدت نفسي محلقا بشكل لا إرادي في عوالم سليمة الخبازة وأحلام العصافير لحسين ومصير صاحب ابو البايسكلات وبطولات ابن الحولة وتحايلات مصطفى أفندي للحصول على ثقة الانكليز وهكذا كان لابد لي من ان أعايش تلك الشخصيات على طول الخط القرائي للرواية وعلى الرغم من استحضاري كل المهارات في التلقي وعدم الانجرار الى ما يرده الكاتب من ان يجعلني اضحك او أتابع دون انقطاع او انفعال وجدتني عاجزا أمام قدرة هائلة ومذهلة في تكوين الصورة السينمائية الذهنية التي لا يمكن الفكاك عنها بسهولة، لذا كنت اشعر أنني أمام رواية اقرأها للمرة الأولى وأتفاعل معها للمرة الأولى وللمرة الأولى أجد الغبن يطال عملاق آخر من عمالقة الفن الروائي العراقي الذين تجاوزوا كل المقاييس العالمية، ولكن لأن غائب طعمه فرمان عراقي ومات غريبا ووحيدا بعيدا عن شمس العراق قريبا من ثلوج سيبريا لم يحظ بالاهتمام الكامل الذي يليق به، ولكنه عراقي كما أسلفت القول لا يحتفى به الا بعد موته ولكنه لم يحتفى به لا حيا ولاميتا الا في قلوب محبيه ومثقفو العراق وبعيدا عن تلك الآهات التي لا تجدي. أقف أمام رواية تميزت بدقة السرد الوصفي الذي يخرج من إطار الكلمة المحددة بمجموعة من الحروف الا صورة ذهنية سينمائية داخل التكوين العام لهيكل الرواية. . . تخرج الكلمة من إطارها المقروء المحدد بحروف سوداء تعكس تلك الصور الدقيقة التي عمل على إخراجها المؤلف لا برؤية الكاتب وإنما برؤى متعددة منها ما عكس المرحلة الزمنية التي كان يمر بها العراق فالرواية تقع بين زمنين من القلق والتحول يمر بها العراق ككل وبغداد بشكل خاص فالحرب العالمية الثانية على وشك النهاية او لنقل انتهت وجيوش الانكليز تستعد لمغادرة بغداد ومعها لا بد ان تتغير الخارطة الاجتماعية والمكانية في بغداد حيث هناك مئات من العاطلين عن العمل بسبب رحيل الانكليز وهناك المئات من الأسر التي فقدت مصدر رزقها وان كان ملوث بالطين العالق بجزم الغزاة الثقيلة الطين الذي يسميه المؤلف السريافه التي لا يدخلها احد الا ويتلوث مهما حرص على البقاء نظيفا، هذا بالنسبة للزمن القلق التي تدور فيها الأحداث أما المكان فكان من أبدع الصور المرئية على شكل لوحات بحروف وكلمات استفاض المؤلف في قراءة تفاصيل المكان الرئيس للحدث بيت سليمة الخبازة والنخلة التي تقبع وسط الدار الكئيب وهسيس الحطب المحترق في قعر التنور الأسود والجيران من الخان والطولة فكان المؤلف غائبا عن المكان لأنه ترك المكان يتحدث عن نفسه دون ان يعمل على التدخل بشكل واضح بحيث لا يتدخل في التزويق الداخلي او وضع رموز بشكل قسري وسط المكان المعد كمسرح للإحداث. . . باحة داخلية غير مضاءة بشكل كامل تنور محطم الأطراف ياون مهمل لا يستعمل لغرضه الأساس في تحضير الرز الخام وطحن الحبوب وإنما دائما منكفئ على وجهه الذي لم يعد يتذكره احد والنخلة التي تشكل الجزء الأول من اسم الرواية والرمز الذي ينبغي على القارئ تأويله او على الأقل تفسيره ولو بشكل أولي فالنخلة مرتبطة بالحكمة ومرتبطة بأرض العراق ومرتبطة بشكل لا يقبل الفكاك مع شخصية إنسان هذا البلد. النخلة الشجرة الصابرة بغض النظر ان كان الجار طيب أم شرير نخلة دائما يدخل إليها المؤلف بلقطات فريبة بل وبعدسات زوم دقيقة تعكس التغضنات الدقيقة للسعف الجاف الذي ينتظر ربما موسما ما من مواسم الخضرة لا الجفاف ولكنها بقيت جافه وبالقرب من جذعها كانت هناك بقايا مياه قذرة لبقايا التنور وفتات الخبز المخلوط بذرات الغبار الأسود مضاف الى هذا الجو الكابوسي هناك شتائم تكال الى النخلة ربما غير مسموعة في معظم الأحيان لان النخلة يجب ان تكون لها فائدة ولكن نخلة سليمة لا فائدة منها فهي لا تمنح الظل او تمنح الرطب او تصلح لأعشاش العصافير او القبرات نخلة يصفها المؤلف قميئة قصيرة متيبسة لم تحمل طلعا، او بشارة لعذوق التمر فلماذا هذا التركيز المستمر من قبل المؤلف على تلك النخلة. من جانب نستطيع ان نربط ما بين سليمة الخبازة العاقر ونخلتها ولكن من بين أيدي سليمة يخرج الخبز الساخن على الرغم من كونه اسود بسبب طحين الحصة التموينية الا انه كان يمد هذا السكون بحياة لا مثيل لها داخل هذا البيت وعلى الرغم من ان تلك النخلة وبشكلها المادي المرئي في الرواية نخله بحكم الميتة الا ان الروائي يصر على ان يذكرنا بها بين الفينة والفينة مثيرا ذلك صورة ذهنية قد تكون لا مرئية للشخصيات الرواية ولكنها تشكل صورة مرئية في ذهن القارئ الذي يتلقى تلك الصورة التي تخفي في داخلها رمزا من الرموز التي يسهل تلقيها لعامة القراء، ولكن لماذا هذا العقم وتكمن الإجابة خارج البيت انه عقم تلك الفترة على جميع الصعد الاجتماعية والسياسية حيث هناك تكمن بداية عمليات بيع الأرض للرأسماليات الجديدة التي وعلى الرغم من خروج القوات الأجنبية الا أنها زرعت نظاما اجتماعيا جديدا تمثل في نهاية عصر وبداية عصر آخر الطولة التي بيعت وبيت سليمة ونخلتها الذي بيع كذلك صاحب ابو البايسكلات الذي قتل وتحول حسين من إنسان مسالم الى قاتل بعد ضياع تماضر ولكن هل استطاع المؤلف ان يقنعنا ان المجتمع العراقي متكون من هذه الشرائح فقط ولماذا غابت صورة المثقف المغير للاتجاهات وهنا تكمن روعة تلك الرواية وسرها الذي جعلها تعيش كل تلك العقود من السنوات، وهي ان المؤلف كان هو الذي يوجه القارئ نحو الصور السينمائية التي تنتجها عينه الشبيه بكاميرا، فلولا تلك العين الكاميرا لم تكن لتصل الينا تلك الشخصيات التي ابدع المؤلف في دقة الوصف الذي قد تعجز عن ايصاله الكاميرا السينمائية. لذا كانت عينه بمثابة الراصد لهذا التغير الاجتماعي والسياسي وكان هو ذاته صوت التغير صوت الثورة على هذا الواقع المرير الذي كان يقبع تحت ثقله العراقيين جميعا. ولكن يبدو أننا كعراقيين وعلى الرغم من شدة وضوح ودقة الصورة السينمائية الذهنية التي قدمها غائب طعمه فرمان إلا أننا لم نكن لا نحن ولا الجيل الذي سبقنا و لا الجيل الذي سيأتي أحسنا قراءة تلك الرواية التي ان قرأها هذا الجيل لشعر ان غائب كان حاضرا معنا في هذه الظروف التي مرت بالعراق من حروب وحصارات أكلنا فيها الخبز الأسود من يد أكثر سليمة الخبازة وماتت الملايين من النخلات وتهجر آلاف من الجيران وأحيطت بغداد بالجدران وانتشر الجنود الأجانب في الطرقات، لذا لم تكن تلك الرواية رواية فترة زمنية محددة وإنما رواية مستمرة تشبه المسلسلات الطويلة ولكنها طويلة أكثر مما ينبغي طويلة وهي تسجل عذابات العراق وأهله وموت نخيله وتهجير الجيران، منذ ان كانت الصورة شمسية الى عصر الصورة الرقمية وبذلك لا أجدني قد انتهيت من قراءة رواية النخلة والجيران لان صورها ما تزال مستمرة مؤسسة بذلك اتجاها خاصا في الرواية العراقية يحول الصورة الذهنية الى صورة سينمائية مما يمنح فرادة لأسلوب قل نظيره في الرواية العربية. ولكن كل مشكلة الكبير غائب طعمه فرمان انه عراقي حقيقي ولاشيء آخر
__________________
 قمة آلحزن ! عندمآ تجبرُ نفسّك على ڪره شخص .. كآنَ يعني لك آلعالم بِآگملہ ؤآلأصعب منـہ ! عِندمآـآ تتصنّع آلڪره .. و بِدآخلڪ حنيين وحب [ گبير لہ
|
|
#10
|
|||
|
|||
|
عن النخلة والجيران د.عبدالله إبراهيم 15/08/2010 بُنيتْ أحداث رواية "النخلة والجيران" لـلروائي العراقي "غائب طعمة فرمان" على خلفية آثار الحرب العالمية الثانية في العراق، إذ صيغ نظام الحياة اليومية لشخصياتها في ضوء تداعيات تلك الحرب في بغداد، فظهرت منزوعة الإرادة، ومجرّدة عن أي فعل إيجابي، وما لبثت أن مضت في حال يكتنفها اليأس إلى نهايات مقفلة أدّت بها إما إلى الموت أو القتل أو الغياب، وبذلك تكون الرواية قد طرحت قضية التاريخ الراكد للأمة حيث يتلاشى الأمل بالتغيير، فكل شيء في تراجع مطّرد، إذ تستسلم معظم الشخصيات ليأس عام يخيّم عليها من كل جانب، وتذوي النخلة الوحيدة، وتباع الدار، ويهدم الإسطبل، وتكاد الحواري الطينية الضيقة تخلو من الحركة، وتبدو المشاركة الاجتماعية مشلولة، بل معطّلة، فقد انسدت الآفاق أمام شخصيات مهمّشة جرى تقييد إرادتها من طرف غامض، وأصبحت طيّ النسيان. فشرعت في الاقتصاص من بعضها بالطمع والقتل والخداع. وحينما أطبق اليأس على مجتمع "النخلة والجيران" انفلت العنف ليمارس دوره بدواعي تحقيق عدالة غائبة، أو رغبة في الامتثال إلى عرف اجتماعي أو قبلي، فالقتل نزوة عارضة مدعومة بفرضية أخلاقية مبهمة، يمكن أن يقابل بتقدير اجتماعي يرفع من شأن القاتل في ظل انهيار سلطة الدولة، فلا يحتاج إلى سبب كبير لحدوثه إنما تدفع به مشاجرة تافهة، وخصومة عابرة، لأن الأرواح البشرية فقدت قيمتها في المجتمع المتخيّل للرواية، وهو مجتمع يحيل بالتمثيل السردي على عالم بغداد في أربعينيات القرن العشرين في ظل الاحتلال الإنجليزي، وحينما يبلغ الإحباط العام مداه الأقصى تلوح فكرة العنف، ثم تتبلور، وتصبح ممارسة فعلية، فلم ينتبه "حسين" إلى جرائم "ابن الحولة" وإهاناته، إلا حينما فقد "تماضر" وباع الدار التي ورثها عن أبيه، فجاء اغتياله للمجرم تخلّصا من فشل ذاتي أكثر مما هو انتصاف لصديقه القتيل "صاحب"، فالعنف ذو مسار لولبي يتدفّق في وسط أخلاقيات رخوة، ثم يصبح سلوكا اجتماعيا محمودا، دون أن يقع التفكير بتداعياته. انحسرت الروح المدنية لبغداد حينما انخرطت شريحة من العراقيين في مضاربات ممنوعة مع جيش الاحتلال، فذهب بها الظن إلى أن الإنجليز باقون في البلاد إلى الأبد، وكفّت فئة أخرى يدها عن أية مسؤولية فراحت تتبرم يائسة، وانحسرت الأفعال الإيجابية من فضاء السرد، فمضى الرجال يدورون في حلقات مفرغة من الإحباط والبطالة، وجرى العبث بالنساء اللواتي خدعن، ووقع استغلالهن عاطفيا وماليا، وامتد ذلك إلى النخلة والبيت، وهما شاهدان على التراجع الثابت في نظام القيم، فكأن زمن الرواية يمضي إلى الوراء بعد أن تفكّكت الأواصر الاجتماعية، وبها استبدل سلوك اجتماعي خديج لا هوية له، فترك الشخصيات تنزلق إلى آثام سلوكية قاعدتها الخداع والطمع، فلا تكاد تظهر شخصية سوية، حتى "سليمة الخبازة" لم يوفّر لها السرد حصانة الاستقامة، فابتكر لها سذاجة دفعتها إلى الوقوع في أحابيل "مصطفى" المخادع الذي كان يتاجر بالممنوعات مع الجيش الانجليزي. وخضعت رواية "النخلة والجيران" إلى زمن شبه راكد في نظام أحداثها، فالبشر والأشياء والأمكنة تتردّى ببطء، وظل وعي الشخصيات بذاتها وعلاقاتها ساكنا لم يتعرّض للتغيير، فاكتسى كل فعل بعدمية، وانتهى بإخفاق، وفيما كان يخيّل للمتلقّي بأن خبز "سليمة" علامة إنتاج مفيدة في مجتمع استهلاكي، مثل حب "تماضر" في بيئة خلت من الحميمية، فإنهما - الخبز والحب- أصبحا ذريعة للخداع والاستغلال، فحلم الإنسان المجرّد عن الوعي يقوده إلى الوراء في حركة لا نهاية لها، فيتعثّر بما هو أسوأ مما كان عليه، وكأن الحياة متاهة كبيرة نزعت عنها العلامات الدالّة على النهاية. تضافرت البيوت الخربة، والأزقة الموحلة، والشخصيات الضالة، والحركة الرتيبة، والسرد التفسيري، فيما بينها، فأصبحت أدلّة على أفول عالم، وتعذّر انبثاق آخر بديل، فمشهد القتل العنيف الذي ختمت به الرواية رسم في أفق السرد حلا مبهما لنهاية عالم؛ حيث يريد "حسين" أن يتخطّى إخفاقاته على مستوى الحب، والمال، والبنوّة، بالقتل، فابتاع مدية حادة، وراح يلاحق "ابن الحولة" مترددا وخائفا دون أن يجد سببا مقنعا للقتل، فبحث عن أية ذريعة كي يتراجع عن رغبته القاتلة إلى أن عرض له "ابن الحولة" في حالة سكر شديد، فكأنه يدعوه لقتله، فيترنح المجرم الأصلي قتيلا دونما سبب مباشر سوى أن البطل الجديد رغب في إرسال السكين إلى جسده المخمور ليمارس دوره، فكأنه ضحية بريئة، فقد قُتل المجرم القديم لأن المجرم الجديد راوده حلم بدوره اجتماعي يرهب به الآخرين بوصفه قاتلا أكثر مما كان يريد الاقتصاص من المجرم بسبب جريمة قتل صديقه "صاحب". أصبحت الجريمة الثانية مكافئا لدور بطولي مقترح، وليس عقابا عن جريمة سابقة، ومهما كان فلا يمكن التورط في جريمة بسبب جريمة أخرى، فتلك متاهة من العنف لا تفضي إلا إلى مزيد من أعمال القتل. لكن القتل في مجتمع راكد بدواعي الشرف أو الثأر أو البحث عن دور جديد له معنى عرفي يتعارض مع الدلالة المدنية لمفهوم العقاب، فغالبا ما يتولّد عنه نوع من الترقية الاعتبارية العامة، فيحتفى بالقاتل لأنه عرض معنى مضافا لبطولة فردية تصون العلاقات التقليدية، فالتكافل السلبي بين الجماعات والأفراد ينتج معاني متحيّزة للقتل بدواعي الشرف والهيبة والثأر، فيصبح ممارسة محمودة يراد بها الحفاظ على الروابط التقليدية، وصون القيم الجماعية، وهو أمر يلاقي دعما قويا في مجتمع الرواية الذي يعاني من العوز، ويفتقر للإرادة، ويساوي بين القتلة والضحايا، والمخادعين والمخدوعين، فينعدم التمييز بين الشرّ والخير، وبين الخطأ والصواب، فكلما جرى محو الحدود الفاصلة بين الآمال والإخفاقات انكشفت هوة خطيرة أمام الجميع، فيصبح انزلاقهم إليها محتملا. وهو أمر جنته شخصيات الرواية كلها، فلم تتفاعل فيما بينها، ولم تعد النظر بعلاقاتها، ونزع عنها الوعي بعالمها، فظهرت عائمة على سطح السرد. د. عبد الله ابراهيم ناقد واستاذ جامعي عراقي مقيم في الامارات [email protected]
__________________
 قمة آلحزن ! عندمآ تجبرُ نفسّك على ڪره شخص .. كآنَ يعني لك آلعالم بِآگملہ ؤآلأصعب منـہ ! عِندمآـآ تتصنّع آلڪره .. و بِدآخلڪ حنيين وحب [ گبير لہ
|
 |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |