|
|||||||
| هيا بنا نحفظ القرآن ونرضى الرحمن قسم يختص بحفظ واستظهار كتاب الله عز وجل بالإضافة الى المسابقات القرآنية المنوعة |
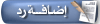 |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#211
|
||||
|
||||
 تَّفْسِيرِ (الْجَامِعِ لِأَحْكَامِ الْقُرْآنِ ، وَالْمُبَيِّنِ لِمَا تَضَمَّنَهُ مِنَ السُّنَّةِ وَآيِ الْفُرْقَانِ ) الشَّيْخُ الْفَقِيهُ الْإِمَامُ الْعَالِمُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْقُرْطُبِيُّ المجلد (4) سورة آل عمران من صــ 276 الى صــ 283 الحلقة (211) لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد قوله تعالى : لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء ذكر تعالى قبيح قول الكفار ولا سيما اليهود . وقال أهل التفسير : لما أنزل الله من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا قال قوم من اليهود - منهم حيي بن أخطب ; في قول الحسن . وقال عكرمة وغيره : هو فنحاص بن عازوراء - إن الله فقير ونحن أغنياء يقترض منا . وإنما قالوا هذا تمويها على ضعفائهم ، لا أنهم يعتقدون هذا ; لأنهم أهل كتاب . ولكنهم كفروا بهذا القول ; لأنهم أرادوا تشكيك الضعفاء منهم ومن المؤمنين ، وتكذيب النبي - صلى الله عليه وسلم - . أي إنه فقير على قول محمد - صلى الله عليه وسلم - ; لأنه اقترض منا . سنكتب ما قالوا سنجازيهم عليه . وقيل : سنكتبه في صحائف أعمالهم ، أي نأمر الحفظة بإثبات قولهم حتى يقرءوه يوم القيامة في كتبهم التي يؤتونها ; حتى يكون أوكد [ ص: 276 ] للحجة عليهم . وهذا كقوله : وإنا له كاتبون . وقيل : مقصود الكتابة الحفظ ، أي سنحفظ ما قالوا لنجازيهم . " وما " في قوله ما قالوا في موضع نصب " بسنكتب " . وقرأ الأعمش وحمزة " سيكتب " بالياء ; فيكون " ما " اسم ما لم يسم فاعله . واعتبر حمزة ذلك بقراءة ابن مسعود : " ويقال ذوقوا عذاب الحريق " . قوله تعالى : وقتلهم الأنبياء بغير حق أي ونكتب قتلهم الأنبياء ، أي رضاءهم بالقتل . والمراد قتل أسلافهم الأنبياء ; لكن لما رضوا بذلك صحت الإضافة إليهم . وحسن رجل عند الشعبي ، قتل عثمان - رضي الله عنه - فقال له الشعبي : شركت في دمه . فجعل الرضا بالقتل قتلا ; - رضي الله عنه - . قلت : وهذه مسألة عظمى ، حيث يكون الرضا بالمعصية معصية . وقد روى أبو داود عن العرس بن عميرة الكندي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من شهدها فكرهها - وقال مرة فأنكرها - كمن غاب عنها ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها . وهذا نص . قوله تعالى : بغير حق تقدم معناه في البقرة . ونقول ذوقوا عذاب الحريق أي يقال لهم في جهنم ، أو عند الموت ، أو عند الحساب هذا . ثم هذا القول من الله تعالى ، أو من الملائكة ; قولان . وقراءة ابن مسعود " ويقال " . والحريق اسم للملتهبة من النار ، والنار تشمل الملتهبة وغير الملتهبة . قوله تعالى : ذلك بما قدمت أيديكم أي ذلك العذاب بما سلف من الذنوب . وخص الأيدي بالذكر ليدل على تولي الفعل ومباشرته ; إذ قد يضاف الفعل إلى الإنسان بمعنى أنه أمر به ; كقوله : يذبح أبناءهم وأصل " أيديكم " أيديكم فحذفت الضمة لثقلها ، والله أعلم . قوله تعالى : الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير [ ص: 277 ] قوله تعالى : الذين في موضع خفض بدلا من " الذين " في قوله عز وجل لقد سمع الله قول الذين قالوا أو نعت " للعبيد " أو خبر ابتداء ، أي هم الذين قالوا . وقال الكلبي وغيره . نزلت في كعب بن الأشرف ، ومالك بن الصيف ، ووهب بن يهوذا وفنحاص بن عازوراء وجماعة أتوا النبي - صلى الله عليه وسلم - ; فقالوا له : أتزعم أن الله أرسلك إلينا ، وإنه أنزل علينا كتابا عهد إلينا فيه ألا نؤمن لرسول يزعم أنه من عند الله حتى يأتينا بقربان تأكله النار ، فإن جئنا به صدقناك . فأنزل الله هذه الآية . فقيل : كان هذا في التوراة ، ولكن كان تمام الكلام : حتى يأتيكم المسيح ومحمد فإذا أتياكم فآمنوا بهما من غير قربان . وقيل : كان أمر القرابين ثابتا إلى أن نسخت على لسان عيسى ابن مريم . وكان النبي منهم يذبح ويدعو فتنزل نار بيضاء لها دوي وحفيف لا دخان لها ، فتأكل القربان . فكان هذا القول دعوى من اليهود ; إذ كان ثم استثناء فأخفوه ، أو نسخ ، فكانوا في تمسكهم بذلك متعنتين ، ومعجزات النبي - صلى الله عليه وسلم - دليل قاطع في إبطال دعواهم ، وكذلك معجزات عيسى ; ومن وجب صدقه وجب تصديقه . ثم قال تعالى : إقامة للحجة عليهم : قل يا محمد قد جاءكم يا معشر اليهود رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم من القربان فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين يعني زكريا ويحيى وشعيا ، وسائر من قتلوا من الأنبياء عليهم السلام ولم تؤمنوا بهم . أراد بذلك أسلافهم . وهذه الآية هي التي تلاها عامر الشعبي - رضي الله عنه - ، فاحتج بها على الذي حسن قتل عثمان - رضي الله عنه - كما بيناه . وإن الله تعالى سمى اليهود قتلة لرضاهم بفعل أسلافهم ، وإن كان بينهم نحو من سبعمائة سنة . والقربان ما يتقرب به إلى الله تعالى من نسك وصدقة وعمل صالح ; وهو فعلان من القربة . ويكون اسما ومصدرا ; فمثال الاسم السلطان والبرهان . والمصدر العدوان والخسران . وكان عيسى بن عمر يقرأ " بقربان " بضم الراء إتباعا لضمة القاف ; كما قيل في جمع ظلمة : ظلمات ، وفي حجرة حجرات . ثم قال تعالى معزيا لنبيه ومؤنسا له : فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات أي بالدلالات . والزبر أي الكتب المزبورة ، يعني المكتوبة . والزبر جمع زبور وهو الكتاب . وأصله من زبرت أي كتبت . وكل زبور فهو كتاب ; قال امرؤ القيس : لمن طلل أبصرته فشجاني كخط زبور في عسيب يماني وأنا أعرف تزبرتي أي كتابتي . وقيل : الزبور من الزبر بمعنى الزجر . وزبرت الرجل انتهرته . وزبرت البئر : طويتها بالحجارة . وقرأ ابن عامر " بالزبر وبالكتاب المنير " بزيادة باء في الكلمتين . وكذلك هو في مصاحف أهل الشام . والكتاب المنير أي الواضح [ ص: 278 ] المضيء ; من قولك : أنرت الشيء أنيره ، أي أوضحته : يقال : نار الشيء وأناره ونوره واستناره بمعنى ، وكل واحد منهما لازم ومتعد . وجمع بين الزبر والكتاب - وهما بمعنى - لاختلاف لفظهما ، وأصلها كما ذكرنا .قوله تعالى : كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور فيه سبع مسائل : الأولى : لما أخبر جل وتعالى عن الباخلين وكفرهم في قولهم : إن الله فقير ونحن أغنياء وأمر المؤمنين بالصبر على أذاهم في قوله : لتبلون الآية - بين أن ذلك مما ينقضي ولا يدوم ; فإن أمد الدنيا قريب ، ويوم القيامة يوم الجزاء . ذائقة الموت من الذوق ، وهذا مما لا محيص عنه للإنسان ، ولا محيد عنه لحيوان . وقد قال أمية بن أبي الصلت : من لم يمت عبطة يمت هرما للموت كأس وإن المرء ذائقها وقال آخر : الموت باب وكل الناس داخله فليت شعري بعد الباب ما الدار الثانية : قراءة العامة ذائقة الموت بالإضافة . وقرأ الأعمش ويحيى وابن أبي إسحاق " ذائقة الموت " بالتنوين ونصب الموت . قالوا : لأنها لم تذق بعد . وذلك أن اسم الفاعل على ضربين : أحدهما أن يكون بمعنى المضي . والثاني بمعنى الاستقبال ; فإن أردت الأول لم يكن فيه إلا الإضافة إلى ما بعده ; كقولك : هذا ضارب زيد أمس ، وقاتل بكر أمس ; لأنه يجري مجرى الاسم الجامد وهو العلم ، نحو غلام زيد ، وصاحب بكر . قال الشاعر : الحافظو عورة العشيرة لا يأ تيهم من ورائهم وكف وإن أردت الثاني جاز الجر . والنصب والتنوين فيما هذا سبيله هو الأصل ; لأنه يجري [ ص: 279 ] مجرى الفعل المضارع فإن كان الفعل غير متعد ، لم يتعد نحو قائم زيد . وإن كان متعديا عديته ونصبت به ، فتقول : زيد ضارب عمرا بمعنى يضرب عمرا . ويجوز حذف التنوين والإضافة تخفيفا ، كما قال المرار " : سل الهموم بكل معطي رأسه ناج مخالط صهبة متعيس فحذف التنوين تخفيفا ، والأصل : معط رأسه بالتنوين والنصب ، ومثل هذا أيضا في التنزيل قوله تعالى هل هن كاشفات ضره وما كان مثله . مغتال أحبله مبين عنقه في منكب زبن المطي عرندس الثالثة : ثم اعلم أن للموت أسبابا وأمارات ، فمن علامات موت المؤمن عرق الجبين . أخرجه النسائي من حديث بريدة قال : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : المؤمن يموت بعرق الجبين . وقد بيناه في " التذكرة " فإذا احتضر لقن الشهادة ; لقوله عليه السلام : لقنوا موتاكم لا إله إلا الله لتكون آخر كلامه فيختم له بالشهادة ; ولا يعاد عليه منها لئلا يضجر . ويستحب قراءة " يس " ذلك الوقت ; لقوله عليه السلام : اقرءوا يس على موتاكم أخرجه أبو داود . وذكر الآجري في كتاب النصيحة من حديث أم الدرداء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : ما من ميت يقرأ عنده سورة يس إلا هون عليه الموت . فإذا قضي وتبع البصر الروح كما [ ص: 280 ] أخبر - صلى الله عليه وسلم - في صحيح مسلم وارتفعت العبادات وزال التكليف ، توجهت على الأحياء أحكام ; منها : تغميضه ، وإعلام إخوانه الصلحاء بموته . وكرهه قوم وقالوا : هو من النعي . والأول أصح ، وقد بيناه في غير هذا الموضع . ومنها الأخذ في تجهيزه بالغسل والدفن لئلا يسرع إليه التغير ; قال - صلى الله عليه وسلم - لقوم أخروا دفن ميتهم : عجلوا بدفن جيفتكم وقال : أسرعوا بالجنازة الحديث ، وسيأتي . الرابعة : فأما غسله فهو سنة لجميع المسلمين حاشا الشهيد على ما تقدم . قيل : غسله واجب قاله القاضي عبد الوهاب . والأول : مذهب الكتاب ، وعلى هذين القولين العلماء . وسبب الخلاف قوله عليه السلام لأم عطية في غسلها ابنته زينب ، على ما في كتاب مسلم . وقيل : هي أم كلثوم ، على ما في كتاب أبي داود : اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك الحديث . وهو الأصل عند العلماء في غسل الموتى . فقيل : المراد بهذا الأمر بيان حكم الغسل فيكون واجبا . وقيل : المقصود منه تعليم كيفية الغسل فلا يكون فيه ما يدل على الوجوب . قالوا ويدل عليه قوله : ( إن رأيتن ذلك ) وهذا يقتضي إخراج ظاهر الأمر عن الوجوب ; لأنه فوضه إلى نظرهن . قيل لهم : هذا فيه بعد ; لأن ردك ( إن رأيتن ) إلى الأمر ، ليس السابق إلى الفهم بل السابق رجوع هذا الشرط إلى أقرب مذكور ، وهو ( أكثر من ذلك ) أو إلى التخيير في الأعداد . وعلى الجملة فلا خلاف في أن غسل الميت مشروع معمول به في الشريعة لا يترك . وصفته كصفة غسل الجنابة على ما هو معروف . ولا يجاوز السبع غسلات في غسل الميت بإجماع ; على ما حكاه أبو عمر . فإن خرج منه شيء بعد السبع غسل الموضع [ ص: 281 ] وحده ، وحكمه حكم الجنب إذا أحدث بعد غسله . فإذا فرغ من غسله كفنه في ثيابه وهي : الخامسة : والتكفين واجب عند عامة العلماء ، فإن كان له مال فمن رأس ماله عند عامة العلماء إلا ما حكي عن طاوس أنه قال : من الثلث كان المال قليلا أو كثيرا . فإن كان الميت ممن تلزم غيره نفقته في حياته من سيد إن كان عبدا أو أب أو زوج أو ابن ; فعلى السيد باتفاق ، وعلى الزوج والأب والابن باختلاف . ثم على بيت المال أو على جماعة المسلمين على الكفاية . والذي يتعين منه بتعيين الفرض ستر العورة ; فإن كان فيه فضل غير أنه لا يعم جميع الجسد غطي رأسه ووجهه إكراما لوجهه وسترا لما يظهر من تغير محاسنه . والأصل في هذا قصة مصعب بن عمير ، فإنه ترك يوم أحد نمرة كان إذا غطي رأسه خرجت رجلاه ، وإذا غطي رجلاه خرج رأسه ; فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ضعوها مما يلي رأسه واجعلوا على رجليه من الإذخر أخرج الحديث مسلم . والوتر مستحب عند كافة العلماء في الكفن ، وكلهم مجمعون على أنه ليس فيه حد والمستحب منه البياض قال - صلى الله عليه وسلم - : البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم أخرجه أبو داود . وكفن - صلى الله عليه وسلم - في ثلاثة أثواب بيض سحولية من كرسف . والكفن في غير البياض جائز إلا أن يكون حريرا أو خزا . فإن تشاح الورثة في الكفن قضي عليهم في مثل لباسه في جمعته وأعياده قال - صلى الله عليه وسلم - : إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه أخرجه مسلم . إلا أن يوصي بأقل من ذلك . فإن أوصى بسرف قيل : يبطل الزائد . وقيل : يكون في الثلث . والأول أصح ; لقوله تعالى : ولا تسرفوا . وقال أبو بكر : إنه للمهلة . فإذا فرغ من غسله وتكفينه ووضع على سريره واحتمله الرجال على أعناقهم وهي : السادسة : فالحكم الإسراع في المشي ; لقوله عليه السلام : أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه وإن تكن غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم . لا كما يفعله اليوم [ ص: 282 ] الجهال في المشي رويدا والوقوف بها المرة بعد المرة ، وقراءة القرآن بالألحان إلى ما لا يحل ولا يجوز حسب ما يفعله أهل الديار المصرية بموتاهم . روى النسائي : أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال أنبأنا عيينة بن عبد الرحمن قال حدثني أبي قال : شهدت جنازة عبد الرحمن بن سمرة وخرج زياد يمشي بين يدي السرير ، فجعل رجال من أهل عبد الرحمن ومواليهم يستقبلون السرير ويمشون على أعقابهم ويقولون : رويدا رويدا ، بارك الله فيكم ! فكانوا يدبون دبيبا ، حتى إذا كنا ببعض طريق المربد لحقنا أبو بكرة - رضي الله عنه - على بغلة فلما رأى الذين يصنعون حمل عليهم ببغلته وأهوى إليهم بالسوط فقال : خلوا ! فوالذي أكرم وجه أبي القاسم - صلى الله عليه وسلم - لقد رأيتنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وإنها لنكاد نرمل بها رملا ، فانبسط القوم . وروى أبو ماجدة عن ابن مسعود قال سألنا نبينا صلى الله عليه سلم عن المشي مع الجنازة فقال : دون الخبب إن يكن خيرا يعجل إليه وإن يكن غير ذلك فبعدا لأهل النار الحديث . قال أبو عمر : والذي عليه جماعة العلماء في ذلك الإسراع فوق السجية قليلا ، والعجلة أحب إليهم من الإبطاء . ويكره الإسراع الذي يشق على ضعفة الناس ممن يتبعها . وقال إبراهيم النخعي : بطئوا بها قليلا ولا تدبوا دبيب اليهود والنصارى . وقد تأول قوم الإسراع في حديث أبي هريرة تعجيل الدفن لا المشي ، وليس بشيء لما ذكرنا . وبالله التوفيق . السابعة : وأما الصلاة عليه فهي واجبة على الكفاية كالجهاد . هذا هو المشهور من مذاهب العلماء : مالك وغيره ; لقوله في النجاشي : قوموا فصلوا عليه . وقال أصبغ : إنها سنة . وروى عن مالك . وسيأتي لهذا المعنى زيادة بيان في " براءة " . الثامنة : وأما دفنه في التراب ودسه وستره فذلك واجب ; لقوله تعالى : فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوأة أخيه . وهناك يذكر حكم بنيان القبر وما [ ص: 283 ] يستحب منه ، وكيفية جعل الميت فيه . ويأتي في " الكهف " حكم بناء المسجد عليه ، إن شاء الله تعالى . فهذه جملة من أحكام الموتى وما يجب لهم على الأحياء . وعن عائشة قالت : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا أخرجه مسلم . وفي سنن النسائي عنها أيضا قالت : ذكر عند النبي - صلى الله عليه وسلم - هالك بسوء فقال : لا تذكروا هلكاكم إلا بخير . قوله تعالى : وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فأجر المؤمن ثواب ، وأجر الكافر عقاب ، ولم يعتد بالنعمة والبلية في الدنيا أجرا وجزاء ; لأنها عرصة الفناء . فمن زحزح عن النار أي أبعد . وأدخل الجنة فقد فاز ظفر بما يرجو ، ونجا مما يخاف . وروى الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة عن عبد الله بن عمرو عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : من سره أن يزحزح عن النار وأن يدخل الجنة فلتأته منيته وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه . عن أبي هريرة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : موضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما فيها اقرءوا إن شئتم فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز . 
__________________
|
|
#212
|
||||
|
||||
 تَّفْسِيرِ (الْجَامِعِ لِأَحْكَامِ الْقُرْآنِ ، وَالْمُبَيِّنِ لِمَا تَضَمَّنَهُ مِنَ السُّنَّةِ وَآيِ الْفُرْقَانِ ) الشَّيْخُ الْفَقِيهُ الْإِمَامُ الْعَالِمُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْقُرْطُبِيُّ المجلد (4) سورة آل عمران من صــ 284 الى صــ 291 الحلقة (212) وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور أي تغر المؤمن وتخدعه فيظن طول البقاء وهي فانية . والمتاع ما يتمتع به وينتفع ; كالفأس والقدر والقصعة ثم يزول ولا يبقى ملكه ; قاله أكثر المفسرين . قال الحسن : كخضرة النبات ، ولعب البنات لا حاصل له . وقال قتادة : هي متاع [ ص: 284 ] متروك توشك أن تضمحل بأهلها ; فينبغي للإنسان أن يأخذ من هذا المتاع بطاعة الله سبحانه ما استطاع . ولقد أحسن من قال : هي الدار دار الأذى والقذى ودار الفناء ودار الغير والغرور ( بفتح الغين ) الشيطان ; يغر الناس بالتمنية والمواعيد الكاذبة . قال ابن عرفة : الغرور ما رأيت له ظاهرا تحبه ، وفيه باطن مكروه أو مجهول . والشيطان غرور ; لأنه يحمل على محاب النفس ، ووراء ذلك ما يسوء . قال : ومن هذا بيع الغرر ، وهو ما كان له ظاهر بيع يغر وباطن مجهول . فلو نلتها بحذافيرها لمت ولم تقض منها الوطر أيا من يؤمل طول الخلود وطول الخلود عليه ضرر إذا أنت شبت وبان الشباب فلا خير في العيش بعد الكبر قوله تعالى : لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور هذا الخطاب للنبي - صلى الله عليه وسلم - وأمته والمعنى : لتختبرن ولتمتحنن في أموالكم بالمصائب والأرزاء بالإنفاق في سبيل الله وسائر تكاليف الشرع . والابتلاء في الأنفس بالموت والأمراض وفقد الأحباب . وبدأ بذكر الأموال لكثرة المصائب بها . ولتسمعن إن قيل : لم ثبتت الواو في لتبلون وحذفت من ولتسمعن ; فالجواب أن الواو في " لتبلون " قبلها فتحة فحركت لالتقاء الساكنين ، وخصت بالضمة لأنها واو الجمع ، ولم يجز حذفها لأنها ليس قبلها ما يدل عليها ، وحذفت من " ولتسمعن " لأن قبلها ما يدل عليها . ولا يجوز همز الواو في " لتبلون " لأن حركتها عارضة ; قاله النحاس وغيره . ويقال للواحد من المذكر : لتبلين يا رجل . وللاثنين : لتبليان يا رجلان . ولجماعة الرجال : لتبلون . ونزلت بسبب أن أبا بكر - رضي الله عنه - سمع يهوديا يقول : إن الله فقير ونحن أغنياء . ردا على القرآن واستخفافا به حين أنزل الله من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فلطمه ; فشكاه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فنزلت . قيل : إن قائلها فنحاص اليهودي ; عن عكرمة . الزهري : هو كعب بن الأشرف نزلت بسببه ; وكان شاعرا ، وكان يهجو النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه ، ويؤلب عليه كفار قريش ، ويشبب بنساء المسلمين حتى بعث إليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - محمد بن مسلمة وأصحابه فقتله القتلة المشهورة في السير [ ص: 285 ] وصحيح الخبر . وقيل غير هذا . وكان - صلى الله عليه وسلم - لما قدم المدينة كان بها اليهود والمشركون ، فكان هو وأصحابه يسمعون أذى كثيرا . ، وفي الصحيحين أنه عليه السلام مر بابن أبي وهو عليه السلام على حمار فدعاه إلى الله تعالى فقال ابن أبي : إن كان ما تقول حقا فلا تؤذنا به في مجالسنا ! ارجع إلى رحلك ، فمن جاءك فاقصص عليه . وقبض على أنفه لئلا يصيبه غبار الحمار ، فقال ابن رواحة : نعم يا رسول الله ، فاغشنا في مجالسنا فإنا نحب ذلك . واستب المشركون الذين كانوا حول ابن أبي والمسلمون ، وما زال النبي - صلى الله عليه وسلم - يسكنهم حتى سكنوا . ثم دخل على سعد بن عبادة يعوده وهو مريض ، فقال : ( ألم تسمع ما قال فلان ) فقال سعد : اعف عنه واصفح ، فوالذي أنزل عليك الكتاب لقد جاءك الله بالحق الذي نزل ، وقد اصطلح أهل هذه البحيرة على أن يتوجوه ويعصبوه بالعصابة ; فلما رد الله ذلك بالحق الذي أعطاكه شرق به ، فذلك فعل به ما رأيت . فعفا عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ونزلت هذه الآية . قيل : هذا كان قبل نزول القتال ، وندب الله عباده إلى الصبر والتقوى وأخبر أنه من عزم الأمور . وكذا في البخاري في سياق الحديث ، إن ذلك كان قبل نزول القتال . والأظهر أنه ليس بمنسوخ ; فإن الجدال بالأحسن والمداراة أبدا مندوب إليها ، وكان عليه السلام مع الأمر بالقتال يوادع اليهود ويداريهم ، ويصفح عن المنافقين ، وهذا بين . ومعنى عزم الأمور شدها وصلابتها . وقد تقدم . قوله تعالى : وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون فيه مسألتان : الأولى : قوله تعالى : وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب هذا متصل بذكر اليهود ; فإنهم أمروا بالإيمان بمحمد عليه السلام وبيان أمره ، فكتموا نعته . فالآية توبيخ لهم ، ثم مع ذلك هو خبر عام لهم ولغيرهم . قال الحسن وقتادة : هي في كل من أوتي علم شيء من الكتاب . فمن علم شيئا فليعلمه ، وإياكم وكتمان العلم فإنه هلكة . وقال محمد بن كعب : لا يحل لعالم أن يسكت على علمه ، ولا للجاهل أن يسكت على جهله ; قال الله تعالى : وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب الآية . وقال : فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون . [ ص: 286 ] وقال أبو هريرة : لولا ما أخذ الله على أهل الكتاب ما حدثتكم بشيء ; ثم تلا هذه الآية وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب . وقال الحسن بن عمارة : أتيت الزهري بعدما ترك الحديث ، فألفيته على بابه فقلت : إن رأيت أن تحدثني . فقال : أما علمت أني تركت الحديث ؟ فقلت : إما أن تحدثني وإما أن أحدثك . قال حدثني . قلت : حدثني الحكم بن عتيبة عن يحيى بن الجزار قال سمعت علي بن أبي طالب يقول : ما أخذ الله على الجاهلين أن يتعلموا حتى أخذ على العلماء أن يعلموا . قال : فحدثني أربعين حديثا . الثانية : الهاء في قوله : لتبيننه للناس ترجع إلى محمد - صلى الله عليه وسلم - وإن لم يجر له ذكر . وقيل : ترجع إلى الكتاب ; ويدخل فيه بيان أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - ; لأنه في الكتاب . ولا تكتمونه ولم يقل تكتمنه لأنه في معنى الحال ، أي لتبيننه غير كاتمين . وقرأ أبو عمرو وعاصم في رواية أبي بكر وأهل مكة لتبيننه بالتاء على حكاية الخطاب . والباقون بالياء لأنهم غيب . وقرأ ابن عباس " وإذ أخذ الله ميثاق النبيين ليبيننه " . فيجيء قوله فنبذوه عائدا على الناس الذين بين لهم الأنبياء . وفي قراءة ابن مسعود " ليبينونه " دون النون الثقيلة . والنبذ الطرح . وقد تقدم بيانه في " البقرة " . وراء ظهورهم مبالغة في الاطراح ، ومنه واتخذتموه وراءكم ظهريا وقد تقدم في " البقرة " بيانه أيضا . وتقدم معنى قوله : واشتروا به ثمنا قليلا في " البقرة " فلا معنى لإعادته . فبئس ما يشترون تقدم أيضا . والحمد لله قوله تعالى : لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم أي بما فعلوا من القعود في التخلف عن الغزو وجاءوا به من العذر . ثبت في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري أن رجالا من المنافقين في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا خرج النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى الغزو تخلفوا عنه وفرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فإذا قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - اعتذروا إليه وحلفوا ، وأحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلوا ; فنزلت لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا الآية . وفي الصحيحين أيضا أن مروان قال لبوابه : اذهب يا رافع إلى ابن عباس فقل له : لئن كان كل امرئ منا فرح بما أوتي وأحب أن يحمد بما لم [ ص: 287 ] يفعل معذبا لنعذبن أجمعون . فقال ابن عباس : ما لكم ولهذه الآية ! إنما أنزلت هذه الآية في أهل الكتاب . ثم تلا ابن عباس وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه و لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا . وقال ابن عباس : سألهم النبي - صلى الله عليه وسلم - عن شيء فكتموه إياه ، وأخبروه بغيره ; فخرجوا وقد أروه أن قد أخبروه بما سألهم عنه واستحمدوا بذلك إليه ، وفرحوا بما أتوا من كتمانهم إياه ، وما سألهم عنه . وقال محمد بن كعب القرظي : نزلت في علماء بني إسرائيل الذين كتموا الحق ، وأتوا ملوكهم من العلم ما يوافقهم في باطلهم ، واشتروا به ثمنا قليلا أي بما أعطاهم الملوك من الدنيا ; فقال الله لنبيه - صلى الله عليه وسلم - : لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم . فأخبر أن لهم عذابا أليما بما أفسدوا من الدين على عباد الله . وقال الضحاك : إن اليهود كانوا يقولون للملوك إنا نجد في كتابنا أن الله يبعث نبينا في آخر الزمان يختم به النبوة ; فلما بعثه الله سألهم الملوك أهو هذا الذي تجدونه في كتابكم ؟ فقال اليهود طمعا في أموال الملوك : هو غير ذلك ، فأعطاهم الملوك الخزائن ; فقال الله تعالى : لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا الملوك من الكذب حتى يأخذوا عرض الدنيا . والحديث الأول خلاف مقتضى الحديث الثاني . ويحتمل أن يكون نزولها على السببين لاجتماعهما في زمن واحد ، فكانت جوابا للفريقين ، والله أعلم . وقوله : واستحمدوا بذلك إليه ، أي طلبوا أن يحمدوا . وقول مروان : لئن كان كل امرئ منا إلخ دليل على أن للعموم صيغا مخصوصة ، وأن " الذين " منها . وهذا مقطوع به من تفهم ذلك من القرآن والسنة . وقوله تعالى : ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا إذا كانت الآية في أهل الكتاب لا في المنافقين المتخلفين ; لأنهم كانوا يقولون : نحن على دين إبراهيم ولم يكونوا على دينه ، وكانوا يقولون : نحن أهل الصلاة والصوم والكتاب ; يريدون أن يحمدوا بذلك . و ( الذين ) فاعل بيحسبن بالياء . وهي قراءة نافع وابن عامر وابن كثير وأبي عمرو ; أي لا يحسبن الفارحون فرحهم منجيا لهم من العذاب . وقيل : المفعول الأول محذوف ، وهو أنفسهم . والثاني بمفازة . وقرأ الكوفيون تحسبن بالتاء على الخطاب للنبي - صلى الله عليه وسلم - ; أي لا تحسبن يا محمد الفارحين بمفازة من العذاب . وقوله فلا تحسبنهم بالتاء وفتح الباء ، [ ص: 288 ] إعادة تأكيد ، ومفعوله الأول الهاء والميم ، والمفعول الثاني محذوف ; أي كذلك ، والفاء عاطفة أو زائدة على بدل الفعل الثاني من الأول . وقرأ الضحاك وعيسى بن عمر بالتاء وضم الباء " فلا تحسبنهم " أراد محمدا - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه . وقرأ مجاهد وابن كثير وأبو عمرو ويحيى بن يعمر بالياء وضم الباء خبرا عن الفارحين ; أي فلا يحسبن أنفسهم ; " بمفازة " المفعول الثاني . ويكون " فلا يحسبنهم " تأكيدا . وقيل : " الذين " فاعل " بيحسبن " ومفعولاها محذوفان لدلالة " يحسبنهم " عليه ; كما قال الشاعر : بأي كتاب أم بأية آية ترى حبهم عارا علي وتحسب استغنى بذكر مفعول الواحد عن ذكر مفعول ، الثاني ، و " بمفازة " الثاني ، وهو بدل من الفعل الأول فأغنى لإبداله منه عن ذكر مفعوليه ، والفاء زائدة . وقيل : قد تجيء هذه الأفعال ملغاة لا في حكم الجمل المفيدة نحو قول الشاعر : وما خلت أبقى بيننا من مودة عراض المذاكي المسنفات القلائص المذاكي : الخيل التي قد أتى عليها بعد قروحها سنة أو سنتان ; الواحد مذك ، مثل المخلف من الإبل ; وفي المثل جري المذكيات غلاب ، والمسنفات اسم مفعول ; يقال : سنفت البعير أسنفه سنفا إذا كففته بزمامه وأنت راكبه ، وأسنف البعير لغة في سنفه ، وأسنف البعير بنفسه إذا رفع رأسه ; يتعدى ولا يتعدى . وكانت العرب تركب الإبل وتجنب الخيل ; تقول : الحرب لا تبقي مودة . وقال كعب بن أبي سلمى : أرجو وآمل أن تدنو مودتها وما إخال لدينا منك تنويل وقرأ جمهور القراء السبعة وغيرهم أتوا بقصر الألف ، أي بما جاءوا به من الكذب والكتمان . وقرأ مروان بن الحكم والأعمش وإبراهيم النخعي " آتوا " بالمد ، بمعنى أعطوا : وقرأ سعيد بن جبير " أوتوا " على ما لم يسم فاعله ; أي أعطوا . والمفازة المنجاة ، مفعلة من فاز يفوز إذا نجا ; أي ليسوا بفائزين . وسمي موضع المخاوف مفازة على جهة التفاؤل ; قاله الأصمعي . وقيل : لأنها موضع تفويز ومظنة هلاك ; تقول العرب : فوز الرجل إذا مات . قال ثعلب : حكيت لابن الأعرابي قول الأصمعي فقال أخطأ ، قال لي أبو المكارم : إنما سميت مفازة ; لأن من قطعها فاز . وقال الأصمعي : سمي اللديغ سليما تفاؤلا . قال ابن الأعرابي : [ ص: 289 ] لأنه مستسلم لما أصابه . وقيل : لا تحسبنهم بمكان بعيد من العذاب ; لأن الفوز التباعد عن المكروه ، والله أعلم .قوله تعالى : ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير هذا احتجاج على الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء ، وتكذيب لهم . وقيل : المعنى لا تظنن الفرحين ينجون من العذاب ; فإن لله كل شيء ، وهم في قبضة القدير ; فيكون معطوفا على الكلام الأول ، أي إنهم لا ينجون من عذابه ، يأخذهم متى شاء . والله على كل شيء أي ممكن قدير وقد مضى في " البقرة " . إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب ياأيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون [ ص: 290 ] فيه خمس وعشرون مسألة : الأولى : قوله تعالى : إن في خلق السماوات والأرض تقدم معنى هذه الآية في " البقرة " في غير موضع . فختم تعالى هذه السورة بالأمر بالنظر والاستدلال في آياته ; إذ لا تصدر إلا عن حي قيوم قدير وقدوس سلام غني عن العالمين ، حتى يكون إيمانهم مستندا إلى اليقين لا إلى التقليد . لآيات لأولي الألباب الذين يستعملون عقولهم في تأمل الدلائل . وروي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما نزلت هذه الآية على النبي قام يصلي ، فأتاه بلال يؤذنه بالصلاة ، فرآه يبكي فقال : يا رسول الله ، أتبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ! فقال : يا بلال : أفلا أكون عبدا شكورا ، ولقد أنزل الله علي الليلة آية إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب - ثم قال : ( ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها ) . الثانية : قال العلماء : يستحب لمن انتبه من نومه أن يمسح على وجهه ، ويستفتح قيامه بقراءة هذه العشر الآيات اقتداء بالنبي - صلى الله عليه وسلم - ثبت ذلك في الصحيحين وغيرهما وسيأتي ، ثم [ ص: 291 ] يصلي ما كتب له ، فيجمع بين التفكر والعمل ، وهو أفضل العمل على ما يأتي بيانه في هذه الآية بعد هذا . وروي عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ عشر آيات من آخر سورة " آل عمران " كل ليلة ، خرجه أبو نصر الوائلي السجستاني الحافظ في كتاب " الإبانة " من حديث سليمان بن موسى عن مظاهر بن أسلم المخزومي عن المقبري عن أبي هريرة . وقد تقدم أول السورة عن عثمان قال : من قرأ آخر آل عمران في ليلة كتب له قيام ليلة . الثالثة : قوله تعالى : الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ذكر تعالى ثلاث هيئات لا يخلو ابن آدم منها في غالب أمره ، فكأنها تحصر زمانه . ومن هذا المعنى قول عائشة رضي الله عنها : كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يذكر الله على كل أحيانه ، أخرجه مسلم . فدخل في ذلك كونه على الخلاء وغير ذلك . وقد اختلف العلماء في هذا ، فأجاز ذلك عبد الله بن عمرو وابن سيرين والنخعي ، وكره ذلك ابن عباس وعطاء والشعبي ، والأول أصح لعموم الآية والحديث . قال النخعي : لا بأس بذكر الله في الخلاء فإنه يصعد ، المعنى : تصعد به الملائكة مكتوبا في صحفهم ، فحذف المضاف ، دليله قوله تعالى : ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد . 
__________________
|
|
#213
|
||||
|
||||
 تَّفْسِيرِ (الْجَامِعِ لِأَحْكَامِ الْقُرْآنِ ، وَالْمُبَيِّنِ لِمَا تَضَمَّنَهُ مِنَ السُّنَّةِ وَآيِ الْفُرْقَانِ ) الشَّيْخُ الْفَقِيهُ الْإِمَامُ الْعَالِمُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْقُرْطُبِيُّ المجلد (4) سورة آل عمران من صــ 292 الى صــ 299 الحلقة (213) الرابعة : واختلف العلماء في كيفية صلاة المريض والقاعد وهيئتها ، فذكر ابن عبد الحكم عن مالك أنه يتربع في قيامه ، وقاله البويطي عن الشافعي فإذا أراد السجود تهيأ [ ص: 293 ] للسجود على قدر ما يطيق ، قال : وكذلك المتنفل . ونحوه قول الثوري ، وكذلك قال الليث وأحمد وإسحاق وأبو يوسف ومحمد . وقال الشافعي في رواية المزني : يجلس في صلاته كلها كجلوس التشهد . وروي هذا عن مالك وأصحابه . والأول المشهور وهو ظاهر المدونة . وقال أبو حنيفة وزفر : يجلس كجلوس التشهد ، وكذلك يركع ويسجد . الخامسة : قال : فإن لم يستطع القعود صلى على جنبه أو ظهره على التخيير ، هذا مذهب المدونة ، وحكى ابن حبيب عن ابن القاسم يصلي على ظهره ، فإن لم يستطع فعلى جنبه الأيمن ثم على جنبه الأيسر . وفي كتاب ابن المواز عكسه ، يصلي على جنبه الأيمن ، وإلا فعلى الأيسر ، وإلا فعلى الظهر . وقال سحنون : يصلي على الأيمن كما يجعل في لحده ، وإلا فعلى ظهره وإلا فعلى الأيسر . وقال مالك وأبو حنيفة : إذا صلى مضطجعا تكون رجلاه مما يلي القبلة . والشافعي والثوري : يصلي على جنبه ووجهه إلى القبلة . السادسة : فإن قوي لخفة المرض وهو في الصلاة قال ابن القاسم : إنه يقوم فيما بقي من صلاته ويبني على ما مضى ، وهو قول الشافعي وزفر والطبري . وقال أبو حنيفة وصاحباه يعقوب ومحمد فيمن صلى مضطجعا ركعة ثم صح أنه يستقبل الصلاة من أولها ، ولو كان قاعدا يركع ويسجد ثم صح بنى في قول أبي حنيفة ولم يبن في قول محمد . وقال أبو حنيفة وأصحابه : إذا افتتح الصلاة قائما ثم صار إلى حد الإيماء فليبن ، وروي عن أبي يوسف . وقال مالك في المريض الذي لا يستطيع الركوع ولا السجود وهو يستطيع القيام والجلوس : إنه يصلي قائما ويومئ إلى الركوع ، فإذا أراد السجود جلس وأومأ إلى السجود ، وهو قول أبي يوسف وقياس قول الشافعي وقال ، أبو حنيفة وأصحابه : يصلي قاعدا . السابعة : وأما صلاة الراقد الصحيح فروي عن حديث عمران بن حصين زيادة ليست موجودة في غيره ، وهي " صلاة الراقد مثل نصف صلاة القاعد " . قال أبو عمر : وجمهور أهل العلم لا يجيزون النافل مضطجعا ، وهو حديث لم يروه إلا حسين المعلم وهو حسين بن ذكوان عن عبد الله بن بريدة عن عمران بن حصين ، وقد اختلف على حسين في إسناده ومتنه اختلافا يوجب التوقف عنه ، وإن صح فلا أدري ما وجهه ، فإن كان أحد من أهل العلم قد أجاز [ ص: 294 ] النافلة مضطجعا لمن قدر على القعود أو على القيام فوجهه هذه الزيادة في هذا الخبر ، وهي حجة لمن ذهب إلى ذلك - وإن أجمعوا على كراهة النافلة راقدا لمن قدر على القعود أو القيام - فحديث حسين هذا إما غلط وإما منسوخ . وقيل : المراد بالآية الذين يستدلون بخلق السماوات والأرض على أن المتغير لا بد له من مغير ، وذلك المغير يجب أن يكون قادرا على الكمال ، وله أن يبعث الرسل ، فإن بعث رسولا ودل على صدقه بمعجزة واحدة لم يبق لأحد عذر ، فهؤلاء هم الذين يذكرون الله على كل حال ، والله أعلم . الثامنة : قوله تعالى : ويتفكرون في خلق السماوات والأرض قد بينا معنى : " ويذكرون " وهو إما ذكر باللسان وإما الصلاة فرضها ونفلها ، فعطف تعالى عبادة أخرى - على إحداهما - بعبادة أخرى ، وهي التفكر في قدرة الله تعالى ومخلوقاته والعبر الذي بث ; ليكون ذلك أزيد في بصائرهم : وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد وقيل : " يتفكرون " عطف على الحال . وقيل : يكون منقطعا ، والأول أشبه . والفكرة : تردد القلب في الشيء ، يقال : تفكر ، ورجل فكير كثير الفكر ، ومر النبي - صلى الله عليه وسلم - على قوم يتفكرون في الله فقال : ( تفكروا في الخلق ، ولا تتفكروا في الخالق فإنكم لا تقدرون قدره ) وإنما التفكر والاعتبار وانبساط الذهن في المخلوقات كما قال : ويتفكرون في خلق السماوات والأرض . وحكي أن سفيان الثوري - رضي الله عنه - صلى خلف المقام ركعتين ، ثم رفع رأسه إلى السماء فلما رأى الكواكب غشي عليه ، وكان يبول الدم من طول حزنه وفكرته . وروي عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : بينما رجل مستلق على فراشه إذ رفع رأسه فنظر إلى النجوم وإلى السماء فقال : أشهد أن لك ربا وخالقا ، اللهم اغفر لي ، فنظر الله إليه فغفر له وقال - صلى الله عليه وسلم - : لا عبادة كتفكر . وروي عنه عليه السلام قال : تفكر ساعة خير من عبادة سنة . وروى ابن القاسم عن مالك قال : قيل لأم الدرداء : ما كان أكثر شأن أبي الدرداء ؟ قالت : كان أكثر شأنه التفكر . قيل له : أفترى التفكر عملا من الأعمال ؟ قال : نعم ، هو اليقين . وقيل لابن المسيب في الصلاة بين الظهر والعصر ، قال : ليست هذه عبادة ، إنما العبادة الورع عما حرم الله والتفكر في أمر الله . وقال الحسن : تفكر ساعة خير من قيام ليلة ; [ ص: 295 ] وقاله ابن العباس وأبو الدرداء . وقال الحسن : الفكرة مرآة المؤمن ينظر فيها إلى حسناته وسيئاته . ومما يتفكر فيه مخاوف الآخرة من الحشر والنشر والجنة ونعيمها والنار وعذابها . ويروى أن أبا سليمان الداراني - رضي الله عنه - أخذ قدح الماء ليتوضأ لصلاة الليل وعنده ضيف ، فرآه لما أدخل أصبعه في أذن القدح أقام لذلك متفكرا حتى طلع الفجر ، فقال له : ما هذا يا أبا سليمان ؟ قال : إني لما طرحت أصبعي في أذن القدح تفكرت في قول الله تعالى إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون تفكرت في حالي وكيف أتلقى الغل إن طرح في عنقي يوم القيامة ، فما زلت في ذلك حتى أصبحت . قال ابن عطية : " وهذا نهاية الخوف ، وخير الأمور أوساطها ، وليس علماء الأمة الذين هم الحجة على هذا المنهاج ، وقراءة علم كتاب الله تعالى ومعاني سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لمن يفهم ويرجى نفعه أفضل من هذا " . قال ابن العربي : اختلف الناس أي العملين أفضل : التفكر أم الصلاة ، فذهب الصوفية إلى أن التفكر أفضل ; فإنه يثمر المعرفة وهو أفضل المقامات الشرعية . وذهب الفقهاء إلى أن الصلاة أفضل ; لما ورد في الحديث من الحث عليها والدعاء إليها والترغيب فيها . وفي الصحيحين عن ابن عباس أنه بات عند خالته ميمونة وفيه : فقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فمسح النوم عن وجهه ثم قرأ الآيات العشر الخواتم من سورة آل عمران ، وقام إلى شن معلق فتوضأ وضوءا خفيفا ثم صلى ثلاث عشرة ركعة الحديث . فانظروا - رحمكم الله - إلى جمعه بين التفكر في المخلوقات ثم إقباله على صلاته بعده ، وهذه السنة هي التي يعتمد عليها . فأما طريقة الصوفية أن يكون الشيخ منهم يوما وليلة وشهرا مفكرا لا يفتر فطريقة بعيدة عن الصواب غير لائقة بالبشر ، ولا مستمرة على السنن . قال ابن عطية : وحدثني أبي عن بعض علماء المشرق قال : كنت بائتا في مسجد الأقدام بمصر فصليت العتمة فرأيت رجلا قد اضطجع في كساء له مسجى بكسائه حتى أصبح ، وصلينا نحن تلك الليلة ، فلما أقيمت صلاة الصبح قام ذلك الرجل فاستقبل القبلة وصلى مع الناس ، فاستعظمت جراءته في الصلاة بغير وضوء ، فلما فرغت الصلاة خرج فتبعته لأعظه ، فلما دنوت منه سمعته ينشد شعرا : مسجى الجسم غائب حاضر منتبه القلب صامت ذاكر [ ص: 296 ] قال : فعلمت أنه ممن يعبد بالفكرة ، فانصرفت عنه . منقبض في الغيوب منبسط كذاك من كان عارفا ذاكر يبيت في ليله أخا فكر فهو مدى الليل نائم ساهر التاسعة : قوله تعالى : ربنا ما خلقت هذا باطلا أي يقولون : ما خلقته عبثا وهزلا ، بل خلقته دليلا على قدرتك وحكمتك . والباطل : الزائل الذاهب . ومنه قول لبيد : ألا كل شيء ما خلا الله باطل أي زائل . و ( باطلا ) نصب لأنه نعت مصدر محذوف ، أي خلقا باطلا ، وقيل : انتصب على نزع الخافض ، أي ما خلقتها للباطل . وقيل : على المفعول الثاني ، ويكون خلق بمعنى جعل . سبحانك أسند النحاس عن موسى بن طلحة قال : سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن معنى " سبحان الله " فقال : ( تنزيه الله عن السوء ) وقد تقدم في " البقرة " معناه مستوفى . وقنا عذاب النار أجرنا من عذابها ، وقد تقدم . العاشرة : قوله تعالى : ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته أي أذللته وأهنته . وقال المفضل أي أهلكته ، وأنشد : أخزى الإله من الصليب عبيده واللابسين قلانس الرهبان وقيل : فضحته وأبعدته ; يقال : أخزاه الله : أبعده ومقته . والاسم الخزي . قال ابن السكيت : خزي يخزى خزيا إذا وقع في بلية . وقد تمسك بهذه الآية أصحاب الوعيد وقالوا : من أدخل النار ينبغي ألا يكون مؤمنا ; لقوله تعالى : فقد أخزيته فإن الله يقول : يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه . وما قالوه مردود ; لقيام الأدلة على أن من ارتكب كبيرة لا يزول عنه اسم الإيمان ، كما تقدم ويأتي . والمراد من قوله : من تدخل النار من تخلد في النار ، قاله أنس بن مالك . وقال قتادة : تدخل مقلوب تخلد ، ولا نقول كما قال أهل حروراء . وقال سعيد بن المسيب : الآية خاصة في قوم لا يخرجون من النار ; ولهذا قال : وما للظالمين من أنصار : أي الكفار . وقال أهل المعاني : الخزي يحتمل أن يكون بمعنى الحياء ، يقال : خزي يخزى خزاية إذا استحيا ، فهو خزيان . قال ذو الرمة : خزاية أدركته عند جولته من جانب الحبل مخلوطا بها الغضب فخزي المؤمنين يومئذ استحياؤهم في دخول النار من سائر أهل الأديان إلى أن يخرجوا منها . والخزي للكافرين هو إهلاكهم فيها من غير موت ، والمؤمنون يموتون ، فافترقوا ، كذا ثبت في صحيح السنة من حديث أبي سعيد الخدري ، أخرجه مسلم ، وقد تقدم ويأتي . [ ص: 297 ] الحادية عشرة : قوله تعالى : ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أي محمدا - صلى الله عليه وسلم - قاله ابن مسعود وابن عباس وأكثر المفسرين . وقال قتادة ومحمد بن كعب القرظي : هو القرآن ، وليس كلهم سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دليل هذا القول ما أخبر الله تعالى عن مؤمني الجن إذ قالوا : إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد . وأجاب الأولون فقالوا : من سمع القرآن فكأنما لقي النبي - صلى الله عليه وسلم - وهذا صحيح معنى . و " أن " من " أن آمنوا " في موضع نصب على حذف حرف الخفض ، أي بأن آمنوا . وفي الكلام تقديم وتأخير ، أي : سمعنا مناديا للإيمان ينادي عن أبي عبيدة . وقيل : اللام بمعنى إلى ، أي إلى الإيمان ، كقوله : ثم يعودون لما نهوا عنه ، وقوله : بأن ربك أوحى لها وقوله : الحمد لله الذي هدانا لهذا أي إلى هذا ، ومثله كثير . وقيل : هي لام أجل ، أي لأجل الإيمان . الثانية عشرة : قوله تعالى : ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا تأكيد ومبالغة في الدعاء . ومعنى اللفظين واحد ، فإن الغفر والكفر : الستر . وتوفنا مع الأبرار أي أبرارا مع الأنبياء ، أي في جملتهم . واحدهم بر وبار وأصله من الاتساع ، فكأن البر متسع في طاعة الله ومتسعة له رحمة الله . الثالثة عشرة : ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك أي على ألسنة رسلك ، مثل واسأل القرية . وقرأ الأعمش والزهري " رسلك " بالتخفيف ، وهو ما ذكر من استغفار الأنبياء والملائكة للمؤمنين ، والملائكة يستغفرون لمن في الأرض . وما ذكر من دعاء نوح للمؤمنين ودعاء إبراهيم واستغفار النبي - صلى الله عليه وسلم - لأمته . ولا تخزنا أي لا تعذبنا ولا تهلكنا ولا تفضحنا ، ولا تهنا ولا تبعدنا ولا تمقتنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد إن قيل : ما وجه قولهم ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك وقد علموا أنه لا يخلف الميعاد ، فالجواب من ثلاثة أوجه : الأول : أن الله سبحانه وعد من آمن بالجنة ، فسألوا أن يكونوا ممن وعد بذلك دون الخزي والعقاب . [ ص: 298 ] الثاني : أنهم دعوا بهذا الدعاء على جهة العبادة والخضوع ، والدعاء مخ العبادة . وهذا كقوله قال رب احكم بالحق وإن كان هو لا يقضي إلا بالحق . الثالث : سألوا أن يعطوا ما وعدوا به من النصر على عدوهم معجلا ; لأنها حكاية عن أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - فسألوه ذلك إعزازا للدين ، والله أعلم . وروى أنس بن مالك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : من وعده الله عز وجل على عمل ثوابا فهو منجز له رحمة ، ومن وعده على عمل عقابا فهو فيه بالخيار . والعرب تذم بالمخالفة في الوعد وتمدح بذلك في الوعيد ، حتى قال قائلهم : ولا يرهب ابن العم ما عشت صولتي ولا أختفي من خشية المتهدد وإني متى أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي الرابعة عشرة : قوله تعالى : فاستجاب لهم ربهم أي أجابهم . قال الحسن : ما زالوا يقولون : ربنا ربنا ، حتى استجاب لهم . وقال جعفر الصادق : من حزبه أمر فقال خمس مرات : " ربنا " أنجاه الله مما يخاف وأعطاه ما أراد . قيل : وكيف ذلك ؟ قال : اقرءوا إن شئتم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم إلى قوله : إنك لا تخلف الميعاد . الخامسة عشرة : : قوله تعالى : أني ، أي بأني . وقرأ عيسى بن عمر " إني " بكسر الهمزة ، أي فقال : إني . وروى الحاكم أبو عبد الله في صحيحه عن أم سلمة أنها قالت : يا رسول الله ، ألا أسمع الله ذكر النساء في الهجرة بشيء ؟ فأنزل الله تعالى : فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى الآية . وأخرجه الترمذي . ودخلت " من " للتأكيد ; لأن قبلها حرف نفي . وقال الكوفيون : هي للتفسير ولا يجوز حذفها ; لأنها دخلت لمعنى لا يصلح الكلام إلا به ، وإنما تحذف إذا كان تأكيدا للجحد . بعضكم من بعض ابتداء وخبر ، أي دينكم واحد . وقيل : بعضكم من بعض في الثواب والأحكام والنصرة وشبه ذلك . وقال الضحاك : رجالكم شكل نسائكم في الطاعة ، ونساؤكم شكل [ ص: 299 ] رجالكم في الطاعة ، نظيرها قوله عز وجل : والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض . ويقال : فلان مني ، أي على مذهبي وخلقي . السادسة عشرة : قوله تعالى : فالذين هاجروا ابتداء وخبر ، أي هجروا أوطانهم وساروا إلى المدينة . وأخرجوا من ديارهم في طاعة الله عز وجل . وقاتلوا ، أي وقاتلوا أعدائي . وقتلوا ، أي في سبيلي . وقرأ ابن كثير وابن عامر : " وقاتلوا وقتلوا " على التكثير . وقرأ الأعمش " وقتلوا وقاتلوا " لأن الواو لا تدل على أن الثاني بعد الأول . وقيل : في الكلام إضمار قد ، أي قتلوا وقد قاتلوا ; ومنه قول الشاعر : تصابى وأمسى علاه الكبر أي وقد علاه الكبر . وقيل : أي وقد قاتل من بقي منهم ; تقول العرب : قتلنا بني تميم ، وإنما قتل بعضهم . وقال امرؤ القيس : فإن تقاتلونا نقتلكم وقرأ عمر بن عبد العزيز : " وقتلوا وقتلوا " خفيفة بغير ألف . لأكفرن عنهم سيئاتهم أي لأسترنها عليهم في الآخرة ، فلا أوبخهم بها ولا أعاقبهم عليها . ثوابا من عند الله مصدر مؤكد عند البصريين ; لأن معنى لأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار لأثيبنهم ثوابا . الكسائي : انتصب على القطع . الفراء : على التفسير . والله عنده حسن الثواب أي حسن الجزاء ; وهو ما يرجع على العامل من جراء عمله ، من ثاب يثوب . السابعة عشرة : قوله تعالى : لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد قيل : الخطاب للنبي - صلى الله عليه وسلم - والمراد الأمة . وقيل : للجميع . وذلك أن المسلمين قالوا : هؤلاء الكفار لهم تجائر وأموال واضطراب في البلاد ، وقد هلكنا نحن من الجوع ، فنزلت هذه الآية . أي لا يغرنكم سلامتهم بتقلبهم في أسفارهم . متاع قليل أي تقلبهم متاع قليل . وقرأ يعقوب " يغرنك " ساكنة النون ; وأنشد : لا يغرنك عشاء ساكن قد يوافي بالمنيات السحر 
__________________
|
|
#214
|
||||
|
||||
 تَّفْسِيرِ (الْجَامِعِ لِأَحْكَامِ الْقُرْآنِ ، وَالْمُبَيِّنِ لِمَا تَضَمَّنَهُ مِنَ السُّنَّةِ وَآيِ الْفُرْقَانِ ) الشَّيْخُ الْفَقِيهُ الْإِمَامُ الْعَالِمُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْقُرْطُبِيُّ المجلد (4) سورة آل عمران من صــ 300 الى صــ 307 الحلقة (214) ونظير هذه الآية قوله تعالى : فلا يغررك تقلبهم في البلاد . والمتاع : ما يعجل الانتفاع به ، وسماه قليلا لأنه فان ، وكل فان - وإن كان كثيرا - فهو قليل . وفي صحيح الترمذي عن [ ص: 300 ] المستورد الفهري قال : سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول : ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليم ، فلينظر بماذا يرجع . قيل : ( يرجع ) بالياء والتاء . وبئس المهاد أي بئس ما مهدوا لأنفسهم بكفرهم ، وما مهد الله لهم من النار . الثامنة عشرة : في هذه الآية وأمثالها كقوله : أنما نملي لهم خير الآية . وأملي لهم إن كيدي متين أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين . سنستدرجهم من حيث لا يعلمون دليل على أن الكفار غير منعم عليهم في الدنيا ; لأن حقيقة النعمة الخلوص من شوائب الضرر العاجلة والآجلة ، ونعم الكفار مشوبة بالآلام والعقوبات ، فصار كمن قدم بين يدي غيره حلاوة من عسل فيها السم ، فهو - وإن استلذ آكله - لا يقال : أنعم عليه ; لأن فيه هلاك روحه . ذهب إلى هذا جماعة من العلماء ، وهو قول الشيخ أبي الحسن الأشعري . وذهب جماعة منهم سيف السنة ولسان الأمة القاضي أبو بكر : إلى أن الله أنعم عليهم في الدنيا . قالوا : وأصل النعمة من النعمة بفتح النون ، وهي لين العيش ; ومنه قوله تعالى : ونعمة كانوا فيها فاكهين . يقال : دقيق ناعم ، إذا بولغ في طحنه وأجيد سحقه . وهذا هو الصحيح ، والدليل عليه أن الله تعالى أوجب على الكفار أن يشكروه وعلى جميع المكلفين فقال : فاذكروا آلاء الله . واشكروا لله والشكر لا يكون إلا على نعمة . وقال : وأحسن كما أحسن الله إليك وهذا خطاب لقارون . وقال : وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة الآية . فنبه سبحانه أنه قد أنعم عليهم نعمة دنياوية فجحدوها . وقال : يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وقال : يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم . وهذا عام في الكفار وغيرهم . فأما إذا قدم لغيره طعاما فيه سم فقد رفق به في [ ص: 301 ] الحال ; إذ لم يجرعه السم بحتا ; بل دسه في الحلاوة ، فلا يستبعد أن يقال : قد أنعم عليه ، وإذا ثبت هذا فالنعم ضربان : نعم نفع ونعم دفع ; فنعم النفع ما وصل إليهم من فنون اللذات ، ونعم الدفع ما صرف عنهم من أنواع الآفات . فعلى هذا قد أنعم على الكفار نعم الدفع قولا واحدا ، وهو ما زوي عنهم من الآلام والأسقام ، ولا خلاف بينهم في أنه لم ينعم عليهم نعمة دينه ، والحمد لله . التاسعة عشرة : قوله تعالى : لكن الذين اتقوا ربهم استدراك بعد كلام تقدم فيه معنى النفي ; لأن معنى ما تقدم ليس لهم في تقلبهم في البلاد كبير الانتفاع ، لكن المتقون لهم الانتفاع الكبير والخلد الدائم . فموضع لكن رفع بالابتداء . وقرأ يزيد بن القعقاع " لكن " بتشديد النون . الموفية عشرين : قوله تعالى : نزلا من عند الله نزلا مثل ثوابا عند البصريين ، وعند الكسائي يكون مصدرا . الفراء : هو مفسر . وقرأ الحسن والنخعي " نزلا " بتخفيف الزاي استثقالا لضمتين ، وثقله الباقون . والنزل ما يهيأ للنزيل ، والنزيل الضيف ، قال الشاعر : نزيل القوم أعظمهم حقوقا وحق الله في حق النزيل والجمع الأنزال . وحظ نزيل : مجتمع . والنزل : أيضا الريع ; يقال ; طعام كثير النزل والنزل . الحادية والعشرون : قلت : ولعل النزل - والله أعلم - ما جاء في صحيح مسلم من حديث ثوبان مولى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في قصة الحبر الذي سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - : أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات ؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ( هم في الظلمة دون الجسر ) قال : فمن أول الناس إجازة ؟ قال : ( فقراء المهاجرين ) قال اليهودي : فما تحفتهم حين يدخلون الجنة ؟ قال ( زيادة كبد النون ) قال : فما غذاؤهم على إثرها ؟ فقال : ( ينحر لهم ثور الجنة الذي كان يأكل من أطرافها ) قال : فما شرابهم عليه ؟ قال : ( من عين فيها تسمى سلسبيلا ) وذكر الحديث . قال أهل اللغة : والتحفة ما يتحف به الإنسان من الفواكه . والطرف محاسنه وملاطفه ، وهذا مطابق لما ذكرناه في النزل ، والله أعلم . وزيادة الكبد : قطعة منه كالأصبع . قال الهروي : نزلا من عند الله أي ثوابا . وقيل رزقا . وما عند الله خير للأبرار أي مما يتقلب [ ص: 302 ] به الكفار في الدنيا ، والله أعلم . الثانية والعشرون : قوله تعالى : وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله قال جابر بن عبد الله وأنس وابن عباس وقتادة والحسن : نزلت في النجاشي ، وذلك أنه لما مات نعاه جبريل عليه السلام لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - لأصحابه : ( قوموا فصلوا على أخيكم النجاشي ) ; فقال بعضهم لبعض : يأمرنا أن نصلي على علج من علوج الحبشة ، فأنزل الله تعالى وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم . قال الضحاك : وما أنزل إليكم القرآن . وما أنزل إليهم التوراة والإنجيل . وفي التنزيل : أولئك يؤتون أجرهم مرتين . وفي صحيح مسلم : ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين - فذكر - رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه ثم أدرك النبي - صلى الله عليه وسلم - فآمن به واتبعه وصدقه فله أجران وذكر الحديث . وقد تقدم في " البقرة " الصلاة عليه وما للعلماء في الصلاة على الميت الغائب ، فلا معنى للإعادة . وقال مجاهد وابن جريج وابن زيد : نزلت في مؤمني أهل الكتاب ، وهذا عام والنجاشي واحد منهم . واسمه أصحمة ، وهو بالعربية عطية . وخاشعين أذلة ، ونصب على الحال من المضمر الذي في يؤمن . وقيل : من الضمير في إليهم " أو في إليكم . وما في الآية بين ، وقد تقدم . الثالثة والعشرون : قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا اصبروا ختم تعالى السورة بما تضمنته هذه الآية العاشرة من الوصاة التي جمعت الظهور في الدنيا على الأعداء والفوز بنعيم الآخرة ، فحض على الصبر على الطاعات وعن الشهوات ، والصبر الحبس ، وقد تقدم في " البقرة " بيانه . وأمر بالمصابرة فقيل : معناه مصابرة الأعداء ، قاله زيد بن أسلم . وقال الحسن : على الصلوات الخمس . وقيل : إدامة مخالفة النفس عن شهواتها فهي تدعو وهو ينزع . وقال عطاء والقرظي : صابروا الوعد الذي وعدتم . أي لا تيأسوا وانتظروا الفرج ، قال - صلى الله عليه وسلم - : انتظار الفرج بالصبر عبادة . واختار هذا القول أبو عمر رحمه الله . والأول قول الجمهور ، ومنه قول عنترة : [ ص: 303 ] فلم أر حيا صابروا مثل صبرنا ولا كافحوا مثل الذين نكافح فقوله " صابروا مثل صبرنا " أي صابروا العدو في الحرب ولم يبد منهم جبن ولا خور . والمكافحة : المواجهة والمقابلة في الحرب ; ولذلك اختلفوا في معنى قوله ورابطوا ، فقال جمهور الأمة : رابطوا أعداءكم بالخيل ، أي ارتبطوها كما يرتبطها أعداؤكم ، ومنه قوله تعالى : ومن رباط الخيل وفي الموطأ عن مالك عن زيد بن أسلم قال : كتب أبو عبيدة بن الجراح إلى عمر بن الخطاب يذكر له جموعا من الروم وما يتخوف منهم ، فكتب إليه عمر : أما بعد ، فإنه مهما ينزل بعبد مؤمن من منزل شدة يجعل الله له بعدها فرجا ، وإنه لن يغلب عسر يسرين ، وإن الله تعالى يقول في كتابه يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون . وقال أبو سلمة بن عبد الرحمن : هذه الآية في انتظار الصلاة بعد الصلاة ، ولم يكن في زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غزو يرابط فيه . رواه الحاكم أبو عبد الله في صحيحه . واحتج أبو سلمة بقوله - عليه السلام - : ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطا إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط " . ثلاثا ، رواه مالك . قال ابن عطية : والقول الصحيح هو أن الرباط هو الملازمة في سبيل الله . أصلها من ربط الخيل ، ثم سمي كل ملازم لثغر من ثغور الإسلام مرابطا ، فارسا كان أو راجلا . واللفظ مأخوذ من الربط . وقول النبي - صلى الله عليه وسلم - ( فذلكم [ ص: 304 ] الرباط ) إنما هو تشبيه بالرباط في سبيل الله ، والرباط اللغوي هو الأول ، وهذا كقوله : ليس الشديد بالصرعة ، وقوله ليس المسكين بهذا الطواف إلى غير ذلك . قلت : قوله " والرباط اللغوي هو الأول " ليس بمسلم ، فإن الخليل بن أحمد أحد أئمة اللغة وثقاتها قد قال : الرباط ملازمة الثغور ، ومواظبة الصلاة أيضا ، فقد حصل أن انتظار الصلاة رباط لغوي حقيقة ، كما قال - صلى الله عليه وسلم - . وأكثر من هذا ما قاله الشيباني أنه يقال : ماء مترابط أي دائم لا ينزح ، حكاه ابن فارس وهو يقتضي تعدية الرباط لغة إلى غير ما ذكرناه . فإن المرابطة عند العرب : العقد على الشيء حتى لا ينحل ، فيعود إلى ما كان صبر عنه ، فيحبس القلب على النية الحسنة والجسم على فعل الطاعة . ومن أعظمها وأهمها ارتباط الخيل في سبيل الله كما نص عليه في التنزيل في قوله : ومن رباط الخيل على ما يأتي . وارتباط النفس على الصلوات كما قاله النبي - صلى الله عليه وسلم - رواه أبو هريرة وجابر وعلي ولا عطر بعد عروس . الرابعة والعشرون : المرابط في سبيل الله عند الفقهاء هو الذي يشخص إلى ثغر من الثغور ليرابط فيه مدة ما ، قاله محمد بن المواز ورواه . وأما سكان الثغور دائما بأهليهم الذين يعمرون ويكتسبون هنالك ، فهم - وإن كانوا حماة - فليسوا بمرابطين ، قاله ابن عطية . وقال ابن خويزمنداد : وللرباط حالتان : حالة يكون الثغر مأمونا منيعا يجوز سكناه بالأهل والولد . وإن كان غير مأمون جاز أن يرابط فيه بنفسه إذا كان من أهل القتال ، ولا ينقل إليه الأهل والولد لئلا يظهر العدو فيسبي ويسترق ، والله أعلم . الخامسة والعشرون : جاء في فضل الرباط أحاديث كثيرة ، منها ما رواه البخاري عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : رباط يوم في سبيل الله خير عند الله من الدنيا وما فيها . وفي صحيح مسلم عن سلمان قال : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : رباط يوم [ ص: 305 ] وليلة خير من صيام شهر وقيامه وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله وأجري عليه رزقه وأمن الفتان . وروى أبو داود في سننه عن فضالة بن عبيد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : كل ميت يختم على عمله إلا المرابط فإنه ينمو له عمله إلى يوم القيامة ويؤمن من فتان القبر . وفي هذين الحديثين دليل على أن الرباط أفضل الأعمال التي يبقى ثوابها بعد الموت ، كما جاء في حديث العلاء بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة ، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له وهو حديث صحيح انفرد بإخراجه مسلم ، فإن الصدقة الجارية والعلم المنتفع به والولد الصالح يدعو لأبويه ينقطع ذلك بنفاد الصدقات وذهاب العلم وموت الولد . والرباط يضاعف أجره إلى يوم القيامة ; لأنه لا معنى للنماء إلا المضاعفة ، وهي غير موقوفة على سبب فتنقطع بانقطاعه ، بل هي فضل دائم من الله تعالى إلى يوم القيامة . وهذا لأن أعمال البر كلها لا يتمكن منها إلا بالسلامة من العدو والتحرز منه بحراسة بيضة الدين وإقامة شعائر الإسلام . وهذا العمل الذي يجري عليه ثوابه هو ما كان يعمله من الأعمال الصالحة ، خرجه ابن ماجه بإسناد صحيح عن أبي هريرة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : من مات مرابطا في سبيل الله أجري عليه أجر عمله الصالح الذي كان يعمل وأجري عليه رزقه وأمن من الفتان وبعثه الله يوم القيامة آمنا من الفزع . وفي هذا الحديث قيد ثان وهو الموت حالة الرباط ، والله أعلم . وروي عن عثمان بن عفان قال : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : من رابط ليلة في سبيل [ ص: 306 ] الله كانت له كألف ليلة صيامها وقيامها . وروي عن أبي بن كعب قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : لرباط يوم في سبيل الله من وراء عورة المسلمين محتسبا من غير شهر رمضان أعظم أجرا من عبادة مائة سنة صيامها وقيامها ، ورباط يوم في سبيل الله من وراء عورة المسلمين محتسبا من شهر رمضان أفضل عند الله وأعظم أجرا - أراه قال - من عبادة ألف سنة صيامها وقيامها ، فإن رده الله إلى أهله سالما لم تكتب عليه سيئة ألف سنة وتكتب له الحسنات ويجرى له أجر الرباط إلى يوم القيامة . ودل هذا الحديث على أن رباط يوم في شهر رمضان يحصل له من الثواب الدائم وإن لم يمت مرابطا ، والله أعلم . وعن أنس بن مالك قال : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : حرس ليلة في سبيل الله أفضل من صيام رجل وقيامه في أهله ألف سنة السنة ثلاثمائة يوم وستون يوما واليوم كألف سنة . قلت : وجاء في انتظار الصلاة بعد الصلاة أنه رباط ، فقد يحصل لمنتظر الصلوات ذلك الفضل إن شاء الله تعالى . وقد روى أبو نعيم الحافظ قال : حدثنا سليمان بن أحمد قال : حدثنا علي بن عبد العزيز قال : حدثنا حجاج بن المنهال ح وحدثنا أبو بكر بن مالك قال : حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال : حدثني أبي قال : حدثني الحسن بن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أبي أيوب الأزدي عن نوف البكالي عن عبد الله بن عمرو أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى ذات ليلة المغرب فصلينا معه فعقب من عقب ورجع من رجع ، فجاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبل أن يثوب الناس لصلاة العشاء ، فجاء وقد حضره الناس رافعا أصبعه وقد [ ص: 307 ] عقد تسعا وعشرين يشير بالسبابة إلى السماء فحسر ثوبه عن ركبتيه وهو يقول : أبشروا معشر المسلمين هذا ربكم قد فتح بابا من أبواب السماء يباهي بكم الملائكة يقول يا ملائكتي انظروا إلى عبادي هؤلاء قضوا فريضة وهم ينتظرون أخرى . ورواه حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن مطرف بن عبد الله : أن نوفا وعبد الله بن عمرو اجتمعا فحدث نوف عن التوراة وحدث عبد الله بن عمرو بهذا الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - . واتقوا الله أي لم تؤمر بالجهاد من غير تقوى . لعلكم تفلحون لتكونوا على رجاء من الفلاح ، وقيل : لعل بمعنى لكي . والفلاح : البقاء ، وقد مضى هذا كله في " البقرة " مستوفى ، والحمد لله . نجز تفسير سورة آل عمران من ( جامع أحكام القرآن والمبين لما تضمن من السنة وآي الفرقان ) بحمد الله وعونه . تم الجزء الرابع من تفسير القرطبي يتلوه إن شاء الله تعالى الجزء الخامس وأوله : " سورة النساء 
__________________
|
|
#215
|
||||
|
||||
 تَّفْسِيرِ (الْجَامِعِ لِأَحْكَامِ الْقُرْآنِ ، وَالْمُبَيِّنِ لِمَا تَضَمَّنَهُ مِنَ السُّنَّةِ وَآيِ الْفُرْقَانِ ) الشَّيْخُ الْفَقِيهُ الْإِمَامُ الْعَالِمُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْقُرْطُبِيُّ المجلد (5) سُورَةُ النِّسَاءِ من صــ 3 الى صــ 10 الحلقة (215) [ ص: 3 ] بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ سُورَةُ النِّسَاءِ وَهِيَ مَدَنِيَّةٌ إِلَّا آيَةً وَاحِدَةً نَزَلَتْ بِمَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ فِي عُثْمَانَ بْنِ طَلْحَةَ الْحَجَبِيِّ وَهِيَ قَوْلُهُ : إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا عَلَى مَا يَأْتِي بَيَانُهُ . قَالَ النَّقَّاشُ : وَقِيلَ : نَزَلَتْ عِنْدَ هِجْرَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ . وَقَدْ قَالَ بَعْضُ النَّاسِ : إِنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى : يَا أَيُّهَا النَّاسُ حَيْثُ وَقَعَ إِنَّمَا هُوَ مَكِّيٌّ ، وَقَالَهُ عَلْقَمَةُ وَغَيْرُهُ ، فَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ صَدْرُ السُّورَةِ مَكِّيًّا ، وَمَا نَزَلَ بَعْدَ الْهِجْرَةِ فَإِنَّمَا هُوَ مَدَنِيٌّ . وَقَالَ النَّحَّاسُ : هَذِهِ السُّورَةُ مَكِّيَّةٌ . قُلْتُ : وَالصَّحِيحُ الْأَوَّلُ ، فَإِنَّ فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ : مَا نَزَلَتْ سُورَةُ النِّسَاءِ إِلَّا وَأَنَا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ تَعْنِي قَدْ بَنَى بِهَا . وَلَا خِلَافَ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا بَنَى بِعَائِشَةَ بِالْمَدِينَةِ . وَمَنْ تَبَيَّنَ أَحْكَامَهَا عَلِمَ أَنَّهَا مَدَنِيَّةٌ لَا شَكَّ فِيهَا . وَأَمَّا مَنْ قَالَ : إِنَّ قَوْلَهُ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ مَكِّيٌّ حَيْثُ وَقَعَ فَلَيْسَ بِصَحِيحٍ ؛ فَإِنَّ الْبَقَرَةَ مَدَنِيَّةٌ وَفِيهَا قَوْلُهُ ، يَا أَيُّهَا النَّاسُ فِي مَوْضِعَيْنِ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ قَوْلُهُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا فِيهِ سِتُّ مَسَائِلَ : الْأُولَى : قَوْلُهُ تَعَالَى : يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ قَدْ مَضَى فِي [ ص: 4 ] " الْبَقَرَةِ " اشْتِقَاقُ النَّاسِ وَمَعْنَى التَّقْوَى وَالرَّبِّ وَالْخَلْقِ وَالزَّوْجِ وَالْبَثِّ ، فَلَا مَعْنَى لِلْإِعَادَةِ . وَفِي الْآيَةِ تَنْبِيهٌ عَلَى الصَّانِعِ . وَقَالَ : " وَاحِدَةٍ " عَلَى تَأْنِيثِ لَفْظِ النَّفْسِ . وَلَفْظُ النَّفْسِ يُؤَنَّثُ وَإِنْ عُنِيَ بِهِ مُذَكَّرٌ . وَيَجُوزُ فِي الْكَلَامِ " مِنْ نَفْسٍ وَاحِدٍ " وَهَذَا عَلَى مُرَاعَاةِ الْمَعْنَى ؛ إِذِ الْمُرَادُ بِالنَّفْسِ آدَمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَهُ مُجَاهِدٌ وَقَتَادَةُ . وَهِيَ قِرَاءَةُ ابْنِ أَبِي عَبْلَةَ " وَاحِدٍ " بِغَيْرِ هَاءٍ . وَبَثَّ : فَرَّقَ وَنَشَرَ فِي الْأَرْضِ ؛ وَمِنْهُ وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي " الْبَقَرَةِ " . وَمِنْهُمَا يَعْنِي آدَمَ وَحَوَّاءَ . قَالَ مُجَاهِدٌ : خُلِقَتْ حَوَّاءُ مِنْ قُصَيْرَى آدَمَ . وَفِي الْحَدِيثِ : خُلِقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ ضِلْعٍ عَوْجَاءَ ، وَقَدْ مَضَى فِي الْبَقَرَةِ . رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً حَصَرَ ذُرِّيَّتَهُمَا فِي نَوْعَيْنِ ؛ فَاقْتَضَى أَنَّ الْخُنْثَى لَيْسَ بِنَوْعٍ ، لَكِنْ لَهُ حَقِيقَةٌ تَرُدُّهُ إِلَى هَذَيْنَ النَّوْعَيْنِ وَهِيَ الْآدَمِيَّةُ فَيَلْحَقُ بِأَحَدِهِمَا ، عَلَى مَا تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ فِي " الْبَقَرَةِ " مِنَ اعْتِبَارِ نَقْصِ الْأَعْضَاءِ وَزِيَادَتِهَا . الثَّانِيةُ : قَوْلُهُ تَعَالَى وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ كَرَّرَ الِاتِّقَاءَ تَأْكِيدًا وَتَنْبِيهًا لِنُفُوسِ الْمَأْمُورِينَ . وَالَّذِي فِي مَوْضِعِ نَصْبٍ عَلَى النَّعْتِ . وَالْأَرْحَامُ مَعْطُوفٌ . أَيِ اتَّقُوا اللَّهَ أَنْ تَعْصُوهُ ، وَاتَّقُوا الْأَرْحَامَ أَنْ تَقْطَعُوهَا . وَقَرَأَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ " تَسَّاءَلُونَ " بِإِدْغَامِ التَّاءِ فِي السِّينِ . وَأَهْلُ الْكُوفَةِ بِحَذْفِ التَّاءِ ، لِاجْتِمَاعِ تَاءَيْنِ ، وَتَخْفِيفِ السِّينِ ؛ لِأَنَّ الْمَعْنَى يُعْرَفُ ؛ وَهُوَ كَقَوْلِهِ : وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَتَنَزَّلُ وَشَبَهِهِ . وَقَرَأَ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ وَقَتَادَةُ وَالْأَعْمَشُ وَحَمْزَةُ " الْأَرْحَامِ " بِالْخَفْضِ . وَقَدْ تَكَلَّمَ النَّحْوِيُّونَ فِي ذَلِكَ . فَأَمَّا الْبَصْرِيُّونَ فَقَالَ رُؤَسَاؤُهُمْ : هُوَ لَحْنٌ لَا تَحِلُّ الْقِرَاءَةُ بِهِ . وَأَمَّا الْكُوفِيُّونَ فَقَالُوا : هُوَ قَبِيحٌ ؛ وَلَمْ يَزِيدُوا عَلَى هَذَا وَلَمْ يَذْكُرُوا عِلَّةَ قُبْحِهِ ؛ قَالَ النَّحَّاسُ : فِيمَا عَلِمْتُ . وَقَالَ سِيبَوَيْهِ : لَمْ يُعْطَفْ عَلَى الْمُضْمَرِ الْمَخْفُوضِ ؛ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ التَّنْوِينِ ، وَالتَّنْوِينُ لَا يُعْطَفُ عَلَيْهِ . وَقَالَ جَمَاعَةٌ : هُوَ مَعْطُوفٌ عَلَى الْمَكْنِيِّ ؛ فَإِنَّهُمْ كَانُوا يَتَسَاءَلُونَ بِهَا ، يَقُولُ الرَّجُلُ : سَأَلْتُكَ بِاللَّهِ وَالرَّحِمِ ؛ هَكَذَا فَسَّرَهُ الْحَسَنُ وَالنَّخَعِيُّ وَمُجَاهِدٌ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ فِي الْمَسْأَلَةِ ، عَلَى مَا يَأْتِي . وَضَعَّفَهُ أَقْوَامٌ مِنْهُمُ الزَّجَّاجُ ، وَقَالُوا : يَقْبُحُ عَطْفُ الِاسْمِ الظَّاهِرِ عَلَى الْمُضْمَرِ فِي الْخَفْضِ إِلَّا بِإِظْهَارِ الْخَافِضِ ؛ كَقَوْلِهِ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ وَيَقْبُحُ " مَرَرْتُ بِهِ وَزَيْدٍ " . قَالَ الزَّجَّاجُ : عَنِ الْمَازِنِيِّ : لِأَنَّ الْمَعْطُوفَ وَالْمَعْطُوفَ عَلَيْهِ شَرِيكَانِ [ ص: 5 ] ، يَحُلُّ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَحَلَّ صَاحِبِهِ ؛ فَكَمَا لَا يَجُوزُ " مَرَرْتُ بِزَيْدٍ وَكَ " كَذَلِكَ لَا يَجُوزُ " مَرَرْتُ بِكَ وَزَيْدٍ " . وَأَمَّا سِيبَوَيْهِ فَهِيَ عِنْدَهُ قَبِيحَةٌ وَلَا تَجُوزُ إِلَّا فِي الشِّعْرِ ؛ كَمَا قَالَ : فَالْيَوْمَ قَرَّبْتَ تَهْجُونَا وَتَشْتِمُنَا فَاذْهَبْ فَمَا بِكَ وَالْأَيَّامِ مِنْ عَجَبِ عَطَفَ " الْأَيَّامَ " عَلَى الْكَافِ فِي " بِكَ " بِغَيْرِ الْبَاءِ لِلضَّرُورَةِ . وَكَذَلِكَ قَوْلُ الْآخَرِ : نُعَلِّقُ فِي مِثْلِ السَّوَارِي سُيُوفَنَا وَمَا بَيْنَهَا وَالْكَعْبِ مَهْوَى نَفَانِفُ عَطَفَ " الْكَعْبَ " عَلَى الضَّمِيرِ فِي " بَيْنَهَا " ضَرُورَةً . وَقَالَ أَبُو عَلِيٍّ : ذَلِكَ ضَعِيفٌ فِي الْقِيَاسِ . وَفِي كِتَابِ التَّذْكِرَةِ الْمَهْدِيَّةِ عَنِ الْفَارِسِيِّ أَنَّ أَبَا الْعَبَّاسِ الْمُبَرِّدَ قَالَ : لَوْ صَلَّيْتُ خَلْفَ إِمَامٍ يَقْرَأُ مَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ وَ اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ لَأَخَذْتُ نَعْلِي وَمَضَيْتُ . قَالَ الزَّجَّاجُ : قِرَاءَةُ حَمْزَةَ مَعَ ضَعْفِهَا وَقُبْحِهَا فِي الْعَرَبِيَّةِ خَطَأٌ عَظِيمٌ فِي أُصُولِ أَمْرِ الدِّينِ ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ فَإِذَا لَمْ يَجُزِ الْحَلِفُ بِغَيْرِ اللَّهِ فَكَيْفَ يَجُوزُ بِالرَّحِمِ . وَرَأَيْتُ إِسْمَاعِيلَ بْنَ إِسْحَاقَ يَذْهَبُ إِلَى أَنَّ الْحَلِفَ بِغَيْرِ اللَّهِ أَمْرٌ عَظِيمٌ ، وَأَنَّهُ خَاصٌّ لِلَّهِ تَعَالَى . قَالَ النَّحَّاسُ : وَقَوْلُ بَعْضِهِمْ " وَالْأَرْحَامِ " قَسَمٌ خَطَأٌ مِنَ الْمَعْنَى وَالْإِعْرَابِ ؛ لِأَنَّ الْحَدِيثَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُلُّ عَلَى النَّصْبِ . وَرَوَى شُعْبَةُ عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ ، عَنِ الْمُنْذِرِ بْنِ جَرِيرٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى جَاءَ قَوْمٌ مِنْ مُضَرَ حُفَاةً عُرَاةً ، فَرَأَيْتُ وَجْهَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَغَيَّرُ لِمَا رَأَى مِنْ فَاقَتِهِمْ ؛ ثُمَّ صَلَّى الظُّهْرَ وَخَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ ، إِلَى : وَالْأَرْحَامَ ؛ ثُمَّ قَالَ : تَصَدَّقَ رَجُلٌ بِدِينَارِهِ تَصَدَّقَ رَجُلٌ بِدِرْهَمِهِ تَصَدَّقَ رَجُلٌ بِصَاعِ تَمْرِهِ . . . وَذَكَرَ الْحَدِيثَ . فَمَعْنَى هَذَا عَلَى النَّصْبِ ؛ لِأَنَّهُ حَضَّهُمْ عَلَى صِلَةِ أَرْحَامِهِمْ . وَأَيْضًا فَقَدْ صَحَّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ أَوْ لِيَصْمُتْ . فَهَذَا يَرُدُّ قَوْلَ مَنْ قَالَ : الْمَعْنَى أَسْأَلُكَ بِاللَّهِ وَبِالرَّحِمِ . وَقَدْ قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ : مَعْنَى تَسَاءَلُونَ بِهِ يَعْنِي تَطْلُبُونَ حُقُوقَكُمْ بِهِ . وَلَا مَعْنَى لِلْخَفْضِ أَيْضًا مَعَ هَذَا . قُلْتُ : هَذَا مَا وَقَفْتُ عَلَيْهِ مِنَ الْقَوْلِ لِعُلَمَاءِ اللِّسَانِ فِي مَنْعِ قِرَاءَةِ " وَالْأَرْحَامِ " [ ص: 6 ] بِالْخَفْضِ ، وَاخْتَارَهُ ابْنُ عَطِيَّةَ . وَرَدَّهُ الْإِمَامُ أَبُو نَصْرٍ عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْقُشَيْرِيُّ ، وَاخْتَارَ الْعَطْفَ فَقَالَ : وَمِثْلُ هَذَا الْكَلَامِ مَرْدُودٌ عِنْدَ أَئِمَّةِ الدِّينِ ؛ لِأَنَّ الْقِرَاءَاتِ الَّتِي قَرَأَ بِهَا أَئِمَّةُ الْقُرَّاءِ ثَبَتَتْ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَاتُرًا يَعْرِفُهُ أَهْلُ الصَّنْعَةِ ، وَإِذَا ثَبَتَ شَيْءٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَنْ رَدَّ ذَلِكَ فَقَدْ رَدَّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَاسْتَقْبَحَ مَا قَرَأَ بِهِ ، وَهَذَا مَقَامٌ مَحْذُورٌ ، وَلَا يُقَلَّدُ فِيهِ أَئِمَّةُ اللُّغَةِ وَالنَّحْوِ ؛ فَإِنَّ الْعَرَبِيَّةَ تُتَلَقَّى مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَا يَشُكُّ أَحَدٌ فِي فَصَاحَتِهِ . وَأَمَّا مَا ذُكِرَ مِنَ الْحَدِيثِ فَفِيهِ نَظَرٌ ؛ لِأَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ لِأَبِي الْعُشَرَاءِ : وَأَبِيكَ لَوْ طَعَنْتَ فِي خَاصِرَتِهِ . ثُمَّ النَّهْيُ إِنَّمَا جَاءَ فِي الْحَلِفِ بِغَيْرِ اللَّهِ ، وَهَذَا تَوَسُّلٌ إِلَى الْغَيْرِ بِحَقِّ الرَّحِمِ فَلَا نَهْيَ فِيهِ . قَالَ الْقُشَيْرِيُّ : وَقَدْ قِيلَ هَذَا إِقْسَامٌ بِالرَّحِمِ ، أَيِ اتَّقُوا اللَّهَ وَحَقِّ الرَّحِمِ ؛ كَمَا تَقُولُ : افْعَلْ كَذَا وَحَقِّ أَبِيكَ . وَقَدْ جَاءَ فِي التَّنْزِيلِ : وَالنَّجْمِ ، وَالطُّورِ ، وَالتِّينِ ، لَعَمْرُكَ وَهَذَا تَكَلُّفٌ قُلْتُ : لَا تَكَلُّفَ فِيهِ فَإِنَّهُ لَا يَبْعُدُ أَنْ يَكُونَ " وَالْأَرْحَامِ " مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ ، فَيَكُونُ أَقْسَمَ بِهَا كَمَا أَقْسَمَ بِمَخْلُوقَاتِهِ الدَّالَّةِ عَلَى وَحْدَانِيَّتِهِ وَقُدْرَتِهِ تَأْكِيدًا لَهَا حَتَّى قَرَنَهَا بِنَفْسِهِ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ . وَلِلَّهِ أَنْ يُقْسِمَ بِمَا شَاءَ وَيَمْنَعَ مَا شَاءَ وَيُبِيحَ مَا شَاءَ ، فَلَا يَبْعُدُ أَنْ يَكُونَ قَسَمًا . وَالْعَرَبُ تُقْسِمُ بِالرَّحِمِ . وَيَصِحُّ أَنْ تَكُونَ الْبَاءُ مُرَادَةً فَحَذَفَهَا كَمَا حَذَفَهَا فِي قَوْلِهِ : مَشَائِيمُ لَيْسُوا مُصْلِحِينَ عَشِيرَةً وَلَا نَاعِبٍ إِلَّا بِبَيْنٍ غُرَابُهَا فَجَرَّ وَإِنْ لَمْ يَتَقَدَّمْ بَاءٌ . قَالَ ابْنُ الدَّهَّانِ أَبُو مُحَمَّدٍ سَعِيدُ بْنُ مُبَارَكٍ : وَالْكُوفِيُّ يُجِيزُ عَطْفَ الظَّاهِرِ عَلَى الْمَجْرُورِ وَلَا يَمْنَعُ مِنْهُ . وَمِنْهُ قَوْلُهُ : آبَكَ أَيِّهْ بِيَ أَوْ مُصَدَّرِ مِنْ حُمُرِ الْجِلَّةِ جَأْبٍ حَشْوَرِ وَمِنْهُ : فَاذْهَبْ فَمَا بِكَ وَالْأَيَّامِ مِنْ عَجَبِ وَقَوْلُ الْآخَرِ : وَمَا بَيْنَهَا وَالْكَعْبِ غَوْطٌ نَفَانِفُ وَمِنْهُ : فَحَسْبُكَ وَالضَّحَّاكِ سَيْفٌ مُهَنَّدُ وَقَوْلُ الْآخَرِ : وَقَدْ رَامَ آفَاقَ السَّمَاءِ فَلَمْ يَجِدْ لَهُ مَصْعَدًا فِيهَا وَلَا الْأَرْضِ مَقْعَدَا [ ص: 7 ] وَقَوْلُ الْآخَرِ : مَا إِنْ بِهَا وَالْأُمُورِ مِنْ تَلَفٍ مَا حُمَّ مِنْ أَمْرِ غَيْبِهِ وَقَعَا وَقَوْلُ الْآخَرِ : أَمُرُّ عَلَى الْكَتِيبَةِ لَسْتُ أَدْرِي أَحَتْفِي كَانَ فِيهَا أَمْ سِوَاهَا فِ " سِوَاهَا " مَجْرُورُ الْمَوْضِعِ بِفِي . وَعَلَى هَذَا حَمَلَ بَعْضُهُمْ قَوْلَهُ تَعَالَى : وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ فَعَطَفَ عَلَى الْكَافِ وَالْمِيمِ . وَقَرَأَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ " وَالْأَرْحَامُ " بِالرَّفْعِ عَلَى الِابْتِدَاءِ ، وَالْخَبَرُ مُقَدَّرٌ ، تَقْدِيرُهُ : وَالْأَرْحَامُ أَهْلٌ أَنْ تُوصَلَ . وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ إِغْرَاءً ؛ لِأَنَّ مِنَ الْعَرَبِ مَنْ يَرْفَعُ الْمُغْرَى . وَأَنْشَدَ الْفَرَّاءُ : إِنَّ قَوْمًا مِنْهُمُ عُمَيْرٌ وَأَشْبَا هُ عُمَيْرٍ وَمِنْهُمُ السَّفَّاحُ وَقَدْ قِيلَ : إِنَّ " وَالْأَرْحَامَ " بِالنَّصْبِ عَطْفٌ عَلَى مَوْضِعِ بِهِ ؛ لِأَنَّ مَوْضِعَهُ نَصْبٌ ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ : لَجَدِيرُونَ بِاللِّقَاءِ إِذَا قَا لَ أَخُو النَّجْدَةِ السِّلَاحُ السِّلَاحُ فَلَسْنَا بِالْجِبَالِ وَلَا الْحَدِيدَا وَكَانُوا يَقُولُونَ : أَنْشُدُكَ بِاللَّهِ وَالرَّحِمَ . وَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ نَصْبٌ بِإِضْمَارِ فِعْلٍ كَمَا ذَكَرْنَا . الثَّالِثَةُ : اتَّفَقَتِ الْمِلَّةُ عَلَى أَنَّ صِلَةَ الرَّحِمِ وَاجِبَةٌ وَأَنَّ قَطِيعَتَهَا مُحَرَّمَةٌ . وَقَدْ صَحَّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِأَسْمَاءَ وَقَدْ سَأَلَتْهُ أَأَصِلُ أُمِّي ؟ نَعَمْ صِلِي أُمَّكِ فَأَمَرَهَا بِصِلَتِهَا وَهِيَ كَافِرَةٌ . فَلِتَأْكِيدِهَا دَخَلَ الْفَضْلُ فِي صِلَةِ الْكَافِرِ ، حَتَّى انْتَهَى الْحَالُ بِأَبِي حَنِيفَةَ وَأَصْحَابِهِ فَقَالُوا بِتَوَارُثِ ذَوِي الْأَرْحَامِ إِنْ لَمْ يَكُنْ عَصَبَةٌ وَلَا فَرْضٌ مُسَمًّى ، وَيَعْتِقُونَ عَلَى مَنِ اشْتَرَاهُمْ مِنْ ذَوِي رَحِمِهِمْ لِحُرْمَةِ الرَّحِمِ ؛ وَعَضَّدُوا ذَلِكَ بِمَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مُحَرَّمٍ فَهُوَ حُرٌّ . وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ . رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، وَلَا يُعْرَفُ لَهُمَا مُخَالِفٌ مِنَ الصَّحَابَةِ . وَهُوَ قَوْلُ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ وَجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ وَعَطَاءٍ وَالشَّعْبِيِّ وَالزُّهْرِيِّ ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الثَّوْرِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ . وَلِعُلَمَائِنَا فِي [ ص: 8 ] ذَلِكَ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ : الْأَوَّلُ - أَنَّهُ مَخْصُوصٌ بِالْآبَاءِ وَالْأَجْدَادِ . الثَّانِي - الْجَنَاحَانِ يَعْنِي الْإِخْوَةَ . الثَّالِثُ - كَقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ . وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : لَا يَعْتِقُ عَلَيْهِ إِلَّا أَوْلَادُهُ وَآبَاؤُهُ وَأُمَّهَاتُهُ ، وَلَا يَعْتِقُ عَلَيْهِ إِخْوَتُهُ وَلَا أَحَدٌ مِنْ ذَوِي قَرَابَتِهِ وَلُحْمَتِهِ . وَالصَّحِيحُ الْأَوَّلُ لِلْحَدِيثِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ . وَأَحْسَنُ طُرُقِهِ رِوَايَةُ النَّسَائِيِّ لَهُ ؛ رَوَاهُ مِنْ حَدِيثِ ضَمْرَةَ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ فَقَدْ عَتَقَ عَلَيْهِ . وَهُوَ حَدِيثٌ ثَابِتٌ بِنَقْلِ الْعَدْلِ عَنِ الْعَدْلِ وَلَمْ يَقْدَحْ فِيهِ أَحَدٌ مِنَ الْأَئِمَّةِ بِعِلَّةٍ تُوجِبُ تَرْكَهُ ؛ غَيْرَ أَنَّ النَّسَائِيَّ قَالَ فِي آخِرِهِ : هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ . وَقَالَ غَيْرُهُ : تَفَرَّدَ بِهِ ضَمْرَةُ . وَهَذَا هُوَ مَعْنَى الْمُنْكَرِ وَالشَّاذِّ فِي اصْطِلَاحِ الْمُحَدِّثِينَ . وَضَمْرَةُ عَدْلٌ ثِقَةٌ ، وَانْفِرَادُ الثِّقَةِ بِالْحَدِيثِ لَا يَضُرُّهُ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ . الرَّابِعَةُ : وَاخْتَلَفُوا مِنْ هَذَا الْبَابِ فِي ذَوِي الْمَحَارِمِ مِنَ الرَّضَاعَةِ . فَقَالَ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ لَا يَدْخُلُونَ فِي مُقْتَضَى الْحَدِيثِ . وَقَالَ شَرِيكٌ الْقَاضِي بِعِتْقِهِمْ . وَذَهَبَ أَهْلُ الظَّاهِرِ وَبَعْضُ الْمُتَكَلِّمِينَ إِلَى أَنَّ الْأَبَ لَا يَعْتِقُ عَلَى الِابْنِ إِذَا مَلَكَهُ ؛ وَاحْتَجُّوا بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : لَا يَجْزِي وَلَدٌ وَالِدًا إِلَّا أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكًا فَيَشْتَرِيَهُ فَيُعْتِقَهُ . قَالُوا : فَإِذَا صَحَّ الشِّرَاءُ فَقَدْ ثَبَتَ الْمِلْكُ ، وَلِصَاحِبِ الْمِلْكِ التَّصَرُّفُ . وَهَذَا جَهْلٌ مِنْهُمْ بِمَقَاصِدِ الشَّرْعِ ؛ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ : وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا فَقَدْ قَرَنَ بَيْنَ عِبَادَتِهِ وَبَيْنَ الْإِحْسَانِ لِلْوَالِدَيْنِ فِي الْوُجُوبِ ، وَلَيْسَ مِنَ الْإِحْسَانِ أَنْ يَبْقَى وَالِدُهُ فِي مِلْكِهِ وَتَحْتَ سُلْطَانِهِ ؛ فَإِذًا يَجِبُ عَلَيْهِ عِتْقُهُ إِمَّا لِأَجْلِ الْمِلْكِ عَمَلًا بِالْحَدِيثِ فَيَشْتَرِيَهُ فَيُعْتِقَهُ ، أَوْ لِأَجْلِ الْإِحْسَانِ عَمَلًا بِالْآيَةِ . وَمَعْنَى الْحَدِيثِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ أَنَّ الْوَلَدَ لَمَّا تَسَبَّبَ إِلَى عِتْقِ أَبِيهِ بِاشْتِرَائِهِ نَسَبَ الشَّرْعُ الْعِتْقَ إِلَيْهِ نِسْبَةَ الْإِيقَاعِ مِنْهُ . وَأَمَّا اخْتِلَافُ الْعُلَمَاءِ فِيمَنْ يُعْتَقُ بِالْمِلْكِ ، فَوَجْهُ الْقَوْلِ الْأَوَّلِ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ مَعْنَى الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ ، وَوَجْهُ الثَّانِي إِلْحَاقُ الْقَرَابَةِ الْقَرِيبَةِ الْمُحَرَّمَةِ بِالْأَبِ الْمَذْكُورِ فِي الْحَدِيثِ ، وَلَا أَقْرَبَ لِلرَّجُلِ مِنَ ابْنِهِ فَيُحْمَلُ عَلَى الْأَبِ ، وَالْأَخُ يُقَارِبُهُ فِي ذَلِكَ لِأَنَّهُ يُدْلِي بِالْأُبُوَّةِ ؛ فَإِنَّهُ يَقُولُ : أَنَا ابْنُ أَبِيهِ . وَأَمَّا الْقَوْلُ الثَّالِثُ فَمُتَعَلَّقُهُ حَدِيثُ ضَمْرَةَ وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ . الْخَامِسَةُ : قَوْلُهُ تَعَالَى : وَالْأَرْحَامُ الرَّحِمُ اسْمٌ لِكَافَّةِ الْأَقَارِبِ مِنْ غَيْرِ فَرْقٍ بَيْنَ [ ص: 9 ] الْمَحْرَمِ وَغَيْرِهِ . وَأَبُو حَنِيفَةَ يَعْتَبِرُ الرَّحِمَ الْمَحْرَمَ فِي مَنْعِ الرُّجُوعِ فِي الْهِبَةِ ، وَيَجُوزُ الرُّجُوعُ فِي حَقِّ بَنِي الْأَعْمَامِ مَعَ أَنَّ الْقَطِيعَةَ مَوْجُودَةٌ وَالْقَرَابَةَ حَاصِلَةٌ ؛ وَلِذَلِكَ تَعَلَّقَ بِهَا الْإِرْثُ وَالْوِلَايَةُ وَغَيْرُهُمَا مِنَ الْأَحْكَامِ . فَاعْتِبَارُ الْمَحْرَمِ زِيَادَةٌ عَلَى نَصِّ الْكِتَابِ مِنْ غَيْرِ مُسْتَنَدٍ . وَهُمْ يَرَوْنَ ذَلِكَ نَسْخًا ، سِيَّمَا وَفِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى التَّعْلِيلِ بِالْقَطِيعَةِ ، وَقَدْ جَوَّزُوهَا فِي حَقِّ بَنِي الْأَعْمَامِ وَبَنِي الْأَخْوَالِ وَالْخَالَاتِ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ . السَّادِسَةُ : قَوْلُهُ تَعَالَى : إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا أَيْ حَفِيظًا ؛ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَمُجَاهِدٍ . ابْنُ زَيْدٍ : عَلِيمًا . وَقِيلَ : رَقِيبًا حَافِظًا ؛ قِيلَ : بِمَعْنَى فَاعِلٍ . فَالرَّقِيبُ مِنْ صِفَاتِ اللَّهِ تَعَالَى ، وَالرَّقِيبُ : الْحَافِظُ وَالْمُنْتَظِرُ ؛ تَقُولُ رَقَبْتُ أَرْقُبُ رِقْبَةً وَرِقْبَانًا إِذَا انْتَظَرْتَ . وَالْمَرْقَبُ : الْمَكَانُ الْعَالِي الْمُشْرِفُ ، يَقِفُ عَلَيْهِ الرَّقِيبُ . وَالرَّقِيبُ : السَّهْمُ الثَّالِثُ مِنَ السَّبْعَةِ الَّتِي لَهَا أَنْصِبَاءُ . وَيُقَالُ : إِنَّ الرَّقِيبَ ضَرْبٌ مِنَ الْحَيَّاتِ ، فَهُوَ لَفْظٌ مُشْتَرَكٌ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ . قوله تعالى : وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا فيه خمس مسائل : الأولى قوله تعالى : وآتوا اليتامى أموالهم وأراد باليتامى الذين كانوا أيتاما ؛ كقوله : وألقي السحرة ساجدين ولا سحر مع السجود ، فكذلك لا يتم مع البلوغ . وكان يقال للنبي صلى الله عليه وسلم : " يتيم أبي طالب " استصحابا لما كان . وآتوا أي أعطوا . والإيتاء الإعطاء . ولفلان أتو ، أي عطاء . أبو زيد : أتوت الرجل آتوه إتاوة ، وهي الرشوة . واليتيم من لم يبلغ الحلم ، وقد تقدم في " البقرة " مستوفى . وهذه الآية خطاب للأولياء والأوصياء . نزلت - في قول مقاتل والكلبي - في رجل من غطفان كان معه مال كثير لابن أخ له يتيم ، فلما بلغ اليتيم طلب المال فمنعه عمه ؛ فنزلت ، فقال العم : نعوذ بالله من الحوب الكبير ! ورد المال . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : من يوق شح نفسه ورجع به هكذا فإنه يحل داره يعني جنته . فلما قبض الفتى المال أنفقه في سبيل الله ، فقال عليه السلام : ثبت الأجر وبقي الوزر . فقيل : كيف يا رسول الله ؟ فقال : ثبت الأجر للغلام وبقي الوزر على والده لأنه كان مشركا . [ ص: 10 ] الثانية : وإيتاء اليتامى أموالهم يكون بوجهين : أحدهما - إجراء الطعام والكسوة ما دامت الولاية ؛ إذ لا يمكن إلا ذلك لمن لا يستحق الأخذ الكلي والاستبداد كالصغير والسفيه الكبير . الثاني - الإيتاء بالتمكن وإسلام المال إليه ، وذلك عند الابتلاء والإرشاد ، وتكون تسميته مجازا ، المعنى : الذي كان يتيما ، وهو استصحاب الاسم ؛ كقوله تعالى : وألقي السحرة ساجدين أي الذين كانوا سحرة . وكان يقال للنبي صلى الله عليه وسلم : " يتيم أبي طالب " . فإذا تحقق الولي رشده حرم عليه إمساك ماله عنه وكان عاصيا . وقال أبو حنيفة : إذا بلغ خمسا وعشرين سنة أعطي ماله كله على كل حال ، لأنه يصير جدا . قلت : لما لم يذكر الله تعالى في هذه الآية إيناس الرشد وذكره في قوله تعالى : وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم . قال أبو بكر الرازي الحنفي في أحكام القرآن : لما لم يقيد الرشد في موضع وقيد في موضع وجب استعمالهما ، فأقول : إذا بلغ خمسا وعشرين سنة وهو سفيه لم يؤنس منه الرشد ، وجب دفع المال إليه ، وإن كان دون ذلك لم يجب ، عملا بالآيتين . وقال أبو حنيفة : لما بلغ أشده صار يصلح أن يكون جدا فإذا صار يصلح أن يكون جدا فكيف يصح إعطاؤه المال بعلة اليتم وباسم اليتيم ؟ ! وهل ذلك إلا في غاية البعد ؟ . قال ابن العربي : وهذا باطل لا وجه له ؛ لا سيما على أصله الذي يرى المقدرات لا تثبت قياسا وإنما تؤخذ من جهة النص ، وليس في هذه المسألة . وسيأتي ما للعلماء في الحجر إن شاء الله تعالى . 
__________________
|
|
#216
|
||||
|
||||
 تَّفْسِيرِ (الْجَامِعِ لِأَحْكَامِ الْقُرْآنِ ، وَالْمُبَيِّنِ لِمَا تَضَمَّنَهُ مِنَ السُّنَّةِ وَآيِ الْفُرْقَانِ ) الشَّيْخُ الْفَقِيهُ الْإِمَامُ الْعَالِمُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْقُرْطُبِيُّ المجلد (5) سُورَةُ النِّسَاءِ من صــ 11 الى صــ 18 الحلقة (216) الثالثة : قوله تعالى : ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب أي لا تتبدلوا الشاة السمينة من مال اليتيم بالهزيلة ، ولا الدرهم الطيب بالزيف . وكانوا في الجاهلية لعدم الدين لا يتحرجون عن أموال اليتامى ، فكانوا يأخذون الطيب والجيد من أموال اليتامى ويبدلونه بالرديء من أموالهم ؛ ويقولون : اسم باسم ورأس برأس ؛ فنهاهم الله عن ذلك . هذا قول سعيد بن المسيب والزهري والسدي والضحاك وهو ظاهر الآية . وقيل : المعنى لا تأكلوا أموال اليتامى وهي محرمة خبيثة وتدعوا الطيب وهو مالكم . وقالمجاهد وأبو صالح وباذان : لا تتعجلوا أكل الخبيث من أموالهم وتدعوا انتظار الرزق الحلال من عند الله . وقال ابن زيد : كان أهل الجاهلية لا يورثون النساء والصبيان ويأخذ الأكبر الميراث . عطاء : لا تربح على يتيمك الذي [ ص: 11 ] عندك وهو غر صغير . وهذان القولان خارجان عن ظاهر الآية ؛ فإنه يقال : تبدل الشيء بالشيء أي أخذه مكانه . ومنه البدل . الرابعة : قوله تعالى : ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم قال مجاهد : وهذه الآية ناهية عن الخلط في الإنفاق ؛ فإن العرب كانت تخلط نفقتها بنفقة أيتامها فنهوا عن ذلك ، ثم نسخ بقوله وإن تخالطوهم فإخوانكم . وقال ابن فورك ، عن الحسن : تأول الناس في هذه الآية النهي عن الخلط فاجتنبوه من قبل أنفسهم ، فخفف عنهم في آية البقرة . وقالت طائفة من المتأخرين : إن إلى بمعنى مع ، كقوله تعالى : من أنصاري إلى الله . وأنشد القتبي : يسدون أبواب القباب بضمر إلى عنن مستوثقات الأواصر وليس بجيد . وقال الحذاق : إلى على بابها وهي تتضمن الإضافة ، أي لا تضيفوا أموالهم وتضموها إلى أموالكم في الأكل . فنهوا أن يعتقدوا أموال اليتامى كأموالهم فيتسلطوا عليها بالأكل والانتفاع . الخامسة : قوله تعالى : إنه كان حوبا كبيرا " إنه " أي الأكل كان حوبا كبيرا أي إثما كبيرا ؛ عن ابن عباس والحسن وغيرهما . يقال : حاب الرجل يحوب حوبا إذا أثم . وأصله الزجر للإبل ؛ فسمي الإثم حوبا ؛ لأنه يزجر عنه وبه . ويقال في الدعاء : اللهم اغفر حوبتي ؛ أي إثمي . والحوبة أيضا الحاجة . ومنه في الدعاء : إليك أرفع حوبتي ؛ أي حاجتي . والحوب الوحشة ؛ ومنه قوله عليه السلام لأبي أيوب : إن طلاق أم أيوب لحوب . وفيه ثلاث لغات " حوبا " بضم الحاء وهي قراءة العامة ولغة أهل الحجاز . وقرأ الحسن " حوبا " بفتح الحاء . وقال الأخفش : وهي لغة تميم . مقاتل : لغة الحبش . والحوب المصدر ، وكذلك الحيابة . والحوب الاسم . وقرأ أبي بن كعب " حابا " على المصدر مثل القال . ويجوز أن يكون اسما مثل الزاد . والحوأب ( بهمزة بعد الواو ) . المكان الواسع . والحوأب ماء أيضا . ويقال : ألحق الله به الحوبة أي المسكنة والحاجة ؛ ومنه قولهم : بات بحيبة سوء . وأصل الياء الواو . وتحوب فلان أي تعبد وألقى الحوب عن نفسه . والتحوب أيضا التحزن . وهو أيضا الصياح الشديد ؛ كالزجر ، وفلان يتحوب من كذا أي يتوجع وقال طفيل : [ ص: 12 ] فذوقوا كما ذقنا غداة محجر من الغيظ في أكبادنا والتحوب فيه أربع عشرة مسألة : الأولى : قوله تعالى : وإن خفتم شرط ، وجوابه فانكحوا . أي إن خفتم ألا تعدلوا في مهورهن وفي النفقة عليهن فانكحوا ما طاب لكم أي غيرهن . وروى الأئمة واللفظ لمسلم عن عروة بن الزبير ، عن عائشة في قول الله تعالى : وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع قالت : يا ابن أختي هي اليتيمة تكون في حجر وليها تشاركه في ماله فيعجبه مالها وجمالها فيريد وليها أن يتزوجها من غير أن يقسط في صداقها فيعطيها مثل ما يعطيها غيره ، فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن ويبلغوا بهن أعلى سنتهن من الصداق وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن . وذكر الحديث . وقال ابن خويز منداد : ولهذا قلنا إنه يجوز أن يشتري الوصي من مال اليتيم لنفسه ، ويبيع من نفسه من غير محاباة . وللموكل النظر فيما اشترى وكيله لنفسه أو باع منها . وللسلطان النظر فيما يفعله الوصي من ذلك . فأما الأب فليس لأحد عليه نظر ما لم تظهر عليه المحاباة فيعترض عليه السلطان حينئذ ؛ وقد مضى في " البقرة " القول في هذا . وقال الضحاك والحسن وغيرهما : إن الآية ناسخة لما كان في الجاهلية وفي أول الإسلام ؛ من أن للرجل أن يتزوج من الحرائر ما شاء ، فقصرتهن الآية على أربع . وقال ابن عباس وابن جبير وغيرهما : المعنى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فكذلك خافوا في النساء ؛ لأنهم كانوا يتحرجون في اليتامى ولا يتحرجون في النساء و " خفتم " من الأضداد ؛ فإنه يكون المخوف منه معلوم الوقوع ، وقد يكون مظنونا ؛ فلذلك اختلف العلماء في تفسير هذا الخوف . فقال أبو عبيدة : خفتم بمعنى أيقنتم . وقال آخرون : خفتم ظننتم . قال ابن عطية : وهذا الذي اختاره الحذاق ، وأنه على بابه من الظن لا من اليقين . التقدير من غلب على ظنه التقصير في القسط لليتيمة فليعدل عنها . و " تقسطوا " معناه تعدلوا . يقال : أقسط الرجل إذا عدل . وقسط إذا جار وظلم صاحبه . قال الله تعالى : وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا يعني الجائرون . وقال عليه [ ص: 13 ] السلام : المقسطون في الدين على منابر من نور يوم القيامة يعني العادلين . وقرأ ابن وثاب والنخعي " تقسطوا " بفتح التاء من قسط على تقدير زيادة " لا " كأنه قال : وإن خفتم أن تجوروا . الثانية : قوله تعالى : فانكحوا ما طاب لكم من النساء إن قيل : كيف جاءت ما للآدميين وإنما أصلها لما لا يعقل ؛ فعنه أجوبة خمسة : الأول - أن " من " و " ما " قد يتعاقبان ؛ قال الله تعالى : والسماء وما بناها أي ومن بناها . وقال فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع . فما هاهنا لمن يعقل وهن النساء ؛ لقوله بعد ذلك من النساء مبينا لمبهم . وقرأ ابن أبي عبلة " من طاب " على ذكر من يعقل . الثاني : قال البصريون : " ما " تقع للنعوت كما تقع لما لا يعقل يقال : ما عندك ؟ فيقال : ظريف وكريم . فالمعنى فانكحوا الطيب من النساء ؛ أي الحلال ، وما حرمه الله فليس بطيب . وفي التنزيل وما رب العالمين فأجابه موسى على وفق ما سأل ؛ وسيأتي . الثالث : حكى بعض الناس أن ما في هذه الآية ظرفية ، أي ما دمتم تستحسنون النكاح قال ابن عطية : وفي هذا المنزع ضعف . جواب رابع : قال الفراء ما هاهنا مصدر . وقال النحاس : وهذا بعيد جدا ؛ لا يصح فانكحوا الطيبة . قال الجوهري : طاب الشيء يطيب طيبة وتطيابا . قال علقمة : كأن تطيابها في الأنف مشموم جواب خامس : وهو أن المراد بما هنا العقد ؛ أي فانكحوا نكاحا طيبا . وقراءة ابن أبي عبلة ترد هذه الأقوال الثلاثة . وحكى أبو عمرو بن العلاء أن أهل مكة إذا سمعوا الرعد قالوا : سبحان ما سبح له الرعد . أي سبحان من سبح له الرعد . ومثله قولهم : سبحان ما سخركن لنا . أي من سخركن . واتفق كل من يعاني العلوم على أن قوله تعالى : وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى ليس له مفهوم ؛ إذ قد أجمع المسلمون على أن من لم يخف القسط في اليتامى له أن ينكح أكثر من واحدة : اثنتين أو ثلاثا أو أربعا كمن خاف . فدل على أن الآية نزلت جوابا لمن خاف ذلك ، وأن حكمها أعم من ذلك . [ ص: 14 ] الثالثة : تعلق أبو حنيفة بهذه الآية في تجويزه نكاح اليتيمة قبل البلوغ . وقال : إنما تكون يتيمة قبل البلوغ ، وبعد البلوغ هي امرأة مطلقة لا يتيمة ؛ بدليل أنه لو أراد البالغة لما نهى عن حطها عن صداق مثلها ؛ لأنها تختار ذلك فيجوز إجماعا . وذهب مالك والشافعي والجمهور من العلماء إلى أن ذلك لا يجوز حتى تبلغ وتستأمر ؛ لقوله تعالى : ويستفتونك في النساء والنساء اسم ينطلق على الكبار كالرجال في الذكور ، واسم الرجل لا يتناول الصغير ؛ فكذلك اسم النساء ، والمرأة لا يتناول الصغيرة . وقد قال : في يتامى النساء والمراد به هناك اليتامى هنا ؛ كما قالت عائشة رضي الله عنها . فقد دخلت اليتيمة الكبيرة في الآية فلا تزوج إلا بإذنها ، ولا تنكح الصغيرة إذ لا إذن لها ، فإذا بلغت جاز نكاحها لكن لا تزوج إلا بإذنها . كما رواه الدارقطني من حديث محمد بن إسحاق ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : زوجني خالي قدامة بن مظعون بنت أخيه عثمان بن مظعون ، فدخل المغيرة بن شعبة على أمها ، فأرغبها في المال وخطبها إليها ، فرفع شأنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال قدامة : يا رسول الله ابنة أخي وأنا وصي أبيها ولم أقصر بها ، زوجتها من قد علمت فضله وقرابته . فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنها يتيمة واليتيمة أولى بأمرها فنزعت مني وزوجها المغيرة بن شعبة . قال الدارقطني : لم يسمعه محمد بن إسحاق من نافع ، وإنما سمعه من عمر بن حسين عنه . ورواه ابن أبي ذئب ، عن عمر بن حسين ، عن نافع عن عبد الله بن عمر : أنه تزوج بنت خاله عثمان بن مظعون قال : فذهبت أمها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : إن ابنتي تكره ذلك . فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يفارقها ففارقها . وقال : ولا تنكحوا اليتامى حتى تستأمروهن فإذا سكتن فهو إذنها . فتزوجها بعد عبد الله بن المغيرة بن شعبة . فهذا يرد ما يقوله أبو حنيفة من أنها إذا بلغت لم تحتج إلى ولي ، بناء على أصله في عدم اشتراط الولي في صحة النكاح . وقد مضى في " البقرة " ذكره ؛ فلا معنى لقولهم : إن هذا الحديث محمول على غير البالغة لقوله إلا بإذنها فإنه كان لا يكون لذكر اليتيم معنى والله أعلم . الرابعة : وفي تفسير عائشة للآية من الفقه ما قال به مالك صداق المثل ، والرد إليه فيما فسد من الصداق ووقع الغبن في مقداره ؛ لقولها : ( بأدنى من سنة صداقها ) . فوجب أن يكون صداق المثل معروفا لكل صنف من الناس على قدر أحوالهم . وقد قال مالك : للناس مناكح عرفت لهم وعرفوا لها . أي صدقات وأكفاء . وسئل مالك عن رجل زوج ابنته من ابن أخ له فقير فاعترضت أمها فقال : إني لأرى لها في ذلك متكلما . فسوغ لها في ذلك الكلام حتى يظهر هو [ ص: 15 ] من نظره ما يسقط اعتراض الأم عليه . وروي " لا أرى " بزيادة الألف والأول أصح . وجائز لغير اليتيمة أن تنكح بأدنى من صداق مثلها ؛ لأن الآية إنما خرجت في اليتامى . هذا مفهومها وغير اليتيمة بخلافها . الخامسة : فإذا بلغت اليتيمة وأقسط الولي في صداقها جاز له أن يتزوجها ، ويكون هو الناكح والمنكح على ما فسرته عائشة . وبه قال أبو حنيفة والأوزاعي والثوري وأبو ثور ، وقاله من التابعين الحسن وربيعة ، وهو قول الليث . وقال زفر والشافعي : لا يجوز له أن يتزوجها إلا بإذن السلطان ، أو يزوجها منه ولي لها هو أقعد بها منه ؛ أو مثله في القعدد ؛ وأما أن يتولى طرفي العقد بنفسه فيكون ناكحا منكحا فلا . واحتجوا بأن الولاية شرط من شروط العقد لقوله عليه السلام : لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل . فتعديد الناكح والمنكح والشهود واجب ؛ فإذا اتحد اثنان منهم سقط واحد من المذكورين . وفي المسألة قول ثالث ، وهو أن تجعل أمرها إلى رجل يزوجها منه . روي هذا عن المغيرة بن شعبة ، وبه قال أحمد ، ذكره ابن المنذر . السادسة : قوله تعالى : ما طاب لكم من النساء معناه ما حل لكم ؛ عن الحسن وابن جبير وغيرهما . واكتفى بذكر من يجوز نكاحه ؛ لأن المحرمات من النساء كثير . وقرأ ابن إسحاق والجحدري وحمزة " طاب " " بالإمالة " وفي مصحف أبي " طيب " بالياء ؛ فهذا دليل الإمالة . " من النساء " دليل على أنه لا يقال نساء إلا لمن بلغ الحلم . وواحد النساء نسوة ، ولا واحد لنسوة من لفظه ، ولكن يقال امرأة . السابعة : قوله تعالى : مثنى وثلاث ورباع وموضعها من الإعراب نصب على البدل من ما وهي نكرة لا تنصرف ؛ لأنها معدولة وصفة ؛ كذا قال أبو علي . وقال الطبري : هي معارف ؛ لأنها لا يدخلها الألف واللام ، وهي بمنزلة عمر في التعريف ؛ قاله الكوفي . وخطأ الزجاج هذا القول . وقيل : لم ينصرف ؛ لأنه معدول عن لفظه ومعناه ، فأحاد معدول عن واحد واحد ، ومثنى معدولة عن اثنين اثنين ، وثلاث معدولة عن ثلاثة ثلاثة ، ورباع عن أربعة أربعة . وفي كل واحد منها لغتان : فعال ومفعل ؛ يقال أحاد وموحد وثناء ومثنى وثلاث ومثلث [ ص: 16 ] ورباع ومربع ، وكذلك إلى معشر وعشار . وحكى أبو إسحاق الثعلبي لغة ثالثة : أحد وثنى وثلث وربع مثل عمر وزفر . وكذلك قرأ النخعي في هذه الآية . وحكى المهدوي ، عن النخعي وابن وثاب " ثلاث وربع " بغير ألف في ربع فهو مقصور من رباع استخفافا ؛ كما قال : أقبل سيل جاء من عند الله يحرد حرد الجنة المغله قال الثعلبي : ولا يزاد من هذا البناء على الأربع إلا بيت جاء عن الكميت : فلم يستثيروك حتى رمي ت فوق الرجال خصالا عشارا يعني طعنت عشرة . وقال ابن الدهان : وبعضهم يقف على المسموع وهو من أحاد إلى رباع ولا يعتبر بالبيت لشذوذه . وقال أبو عمرو بن الحاجب : ويقال أحاد وموحد وثناء ومثنى وثلاث ومثلث ورباع ومربع . وهل يقال فيما عداه إلى التسعة أو لا يقال ؟ فيه خلاف أصحها أنه لم يثبت . وقد نص البخاري في صحيحه على ذلك . وكونه معدولا عن معناه أنه لا يستعمل في موضع تستعمل فيه الأعداد غير المعدولة ؛ تقول : جاءني اثنان وثلاثة ، ولا يجوز مثنى وثلاث حتى يتقدم قبله جمع ، مثل جاءني القوم أحاد وثناء وثلاث ورباع من غير تكرار . وهي في موضع الحال هنا وفي الآية ، وتكون صفة ؛ ومثال كون هذه الأعداد صفة يتبين في قوله تعالى : أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع فهي صفة للأجنحة وهي نكرة . وقال ساعدة بن جؤية : ولكنما أهلي بواد أنيسه ذئاب تبغى الناس مثنى وموحد وأنشد الفراء : قتلنا به من بين مثنى وموحد بأربعة منكم وآخر خامس فوصف ذئابا وهي نكرة بمثنى وموحد ، وكذلك بيت الفراء ؛ أي قتلنا به ناسا ، فلا تنصرف إذا هذه الأسماء في معرفة ولا نكرة . وأجاز الكسائي والفراء صرفه في العدد على أنه نكرة . وزعم الأخفش أنه إن سمى به صرفه في المعرفة والنكرة ؛ لأنه قد زال عنه العدل . الثامنة : اعلم أن هذا العدد مثنى وثلاث ورباع لا يدل على إباحة تسع ، كما قاله من بعد فهمه للكتاب والسنة ، وأعرض عما كان عليه سلف هذه الأمة ، وزعم أن الواو جامعة ؛ وعضد ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم نكح تسعا ، وجمع بينهن في عصمته . والذي صار إلى هذه [ ص: 17 ] الجهالة ، وقال هذه المقالة الرافضة وبعض أهل الظاهر ؛ فجعلوا مثنى مثل اثنين ، وكذلك ثلاث ورباع . وذهب بعض أهل الظاهر أيضا إلى أقبح منها ، فقالوا بإباحة الجمع بين ثمان عشرة ؛ تمسكا منه بأن العدل في تلك الصيغ يفيد التكرار والواو للجمع ؛ فجعل مثنى بمعنى اثنين اثنين وكذلك ثلاث ورباع . وهذا كله جهل باللسان والسنة ، ومخالفة لإجماع الأمة ، إذ لم يسمع عن أحد من الصحابة ولا التابعين أنه جمع في عصمته أكثر من أربع . وأخرج مالك في موطئه ، والنسائي والدارقطني في سننهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لغيلان بن أمية الثقفي وقد أسلم وتحته عشر نسوة : اختر منهن أربعا وفارق سائرهن . في كتاب أبي داود ، عن الحارث بن قيس ، قال : أسلمت وعندي ثمان نسوة ، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : اختر منهن أربعا . وقال مقاتل : إن قيس بن الحارث كان عنده ثمان نسوة حرائر ؛ فلما نزلت هذه الآية أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطلق أربعا ويمسك أربعا . كذا قال : " قيس بن الحارث " ، والصواب أن ذلك كان حارث بن قيس الأسدي كما ذكر أبو داود . وكذا روى محمد بن الحسن في كتاب السير الكبير : أن ذلك كان حارث بن قيس ، وهو المعروف عند الفقهاء . وأما ما أبيح من ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فذلك من خصوصياته ؛ على ما يأتي بيانه في " الأحزاب " . وأما قولهم : إن الواو جامعة ؛ فقد قيل ذلك ، لكن الله تعالى خاطب العرب بأفصح اللغات . والعرب لا تدع أن تقول تسعة وتقول اثنين وثلاثة وأربعة . وكذلك تستقبح ممن يقول : أعط فلانا أربعة ستة ثمانية ، ولا يقول ثمانية عشر . وإنما الواو في هذا الموضع بدل ؛ أي انكحوا ثلاثا بدلا من مثنى ، ورباع بدلا من ثلاث ؛ ولذلك عطف بالواو ولم يعطف بأو . ولو جاء بأو لجاز ألا يكون لصاحب المثنى ثلاث ، ولا لصاحب الثلاث رباع . وأما قولهم : إن مثنى تقتضي اثنين ، وثلاث ثلاثة ، ورباع أربعة ، فتحكم بما لا يوافقهم أهل اللسان عليه ، وجهالة منهم . وكذلك جهل الآخرين ، بأن مثنى تقتضي اثنين اثنين ، وثلاث ثلاثة ثلاثة ، ورباع أربعة أربعة ، ولم يعلموا أن اثنين اثنين ، وثلاثا ثلاثا ، وأربعا أربعا ، حصر للعدد . ومثنى وثلاث ورباع بخلافها . ففي العدد المعدول عند العرب زيادة معنى ليست في الأصل ؛ وذلك أنها إذا قالت : جاءت الخيل مثنى ، إنما تعني بذلك اثنين اثنين ؛ أي جاءت مزدوجة . قال الجوهري : وكذلك معدول العدد . وقال غيره : إذا قلت جاءني قوم مثنى أو ثلاث أو أحاد أو عشار ، فإنما تريد أنهم جاءوك واحدا واحدا ، أو اثنين اثنين ، أو ثلاثة ثلاثة ، أو عشرة عشرة ، وليس هذا المعنى في الأصل ؛ لأنك إذا قلت جاءني قوم ثلاثة ثلاثة ، أو قوم عشرة عشرة ، فقد حصرت عدة القوم بقولك ثلاثة وعشرة . فإذا قلت : [ ص: 18 ] جاءوني رباع وثناء فلم تحصر عدتهم . وإنما تريد أنهم جاءوك أربعة أربعة أو اثنين اثنين . وسواء كثر عددهم أو قل في هذا الباب ، فقصرهم كل صيغة على أقل ما تقتضيه بزعمه تحكم . وأما اختلاف علماء المسلمين في الذي يتزوج خامسة وعنده أربع وهي : التاسعة : فقال مالك والشافعي : عليه الحد إن كان عالما . وبه قال أبو ثور . وقال الزهري : يرجم إذا كان عالما ، وإن كان جاهلا أدنى الحدين الذي هو الجلد ، ولها مهرها ويفرق بينهما ولا يجتمعان أبدا . وقالت طائفة : لا حد عليه في شيء من ذلك . هذا قول النعمان . وقال يعقوب ومحمد : يحد في ذات المحرم ولا يحد في غير ذلك من النكاح . وذلك مثل أن يتزوج مجوسية أو خمسة في عقدة أو تزوج متعة أو تزوج بغير شهود ، أو أمة تزوجها بغير إذن مولاها . وقال أبو ثور : إذا علم أن هذا لا يحل له يجب أن يحد فيه كله إلا التزوج بغير شهود . وفيه قول ثالث قاله النخعي في الرجل ينكح الخامسة متعمدا قبل أن تنقضي عدة الرابعة من نسائه : جلد مائة ولا ينفى . فهذه فتيا علمائنا في الخامسة على ما ذكره ابن المنذر فكيف بما فوقها . العاشرة : ذكر الزبير بن بكار حدثني إبراهيم الحزامي ، عن محمد بن معن الغفاري ، قال : أتت امرأة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه ؛ فقالت : يا أمير المؤمنين ، إن زوجي يصوم النهار ويقوم الليل وأنا أكره أن أشكوه ، وهو يعمل بطاعة الله عز وجل . فقال لها : نعم الزوج زوجك : فجعلت تكرر عليه القول وهو يكرر عليها الجواب . فقال له كعب الأسدي : يا أمير المؤمنين ، هذه المرأة تشكو زوجها في مباعدته إياها عن فراشه . فقال عمر : كما فهمت كلامها فاقض بينهما . فقال كعب : علي بزوجها ، فأتي به فقال له : إن امرأتك هذه تشكوك . قال : أفي طعام أم شراب ؟ قال لا . فقالت المرأة : يا أيها القاضي الحكيم رشده ألهى خليلي عن فراشي مسجده زهده في مضجعي تعبده فاقض القضا كعب ولا تردده نهاره وليله ما يرقده فلست في أمر النساء أحمده فقال زوجها : زهدني في فرشها وفي الحجل أني امرؤ أذهلني ما قد نزل في سورة النحل وفي السبع الطول وفي كتاب الله تخويف جلل 
__________________
|
|
#217
|
||||
|
||||
 تَّفْسِيرِ (الْجَامِعِ لِأَحْكَامِ الْقُرْآنِ ، وَالْمُبَيِّنِ لِمَا تَضَمَّنَهُ مِنَ السُّنَّةِ وَآيِ الْفُرْقَانِ ) الشَّيْخُ الْفَقِيهُ الْإِمَامُ الْعَالِمُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْقُرْطُبِيُّ المجلد (5) سُورَةُ النِّسَاءِ من صــ 19 الى صــ 26 الحلقة (217) [ ص: 19 ] فقال كعب : إن لها عليك حقا يا رجل نصيبها في أربع لمن عقل ثم قال : إن الله عز وجل قد أحل لك من النساء مثنى وثلاث ورباع ، فلك ثلاثة أيام ولياليهن تعبد فيهن ربك . فقال عمر : والله ما أدري من أي أمريك أعجب ؟ أمن فهمك أمرهما أم من حكمك بينهما ؟ اذهب فقد وليتك قضاء البصرة . وروى أبو هدبة إبراهيم بن هدبة حدثنا أنس بن مالك قال : أتت النبي صلى الله عليه وسلم امرأة تستعدي زوجها ، فقالت : ليس لي ما للنساء ؛ زوجي يصوم الدهر . قال : لك يوم وله يوم ، للعبادة يوم وللمرأة يوم . فأعطها ذاك ودع عنك العلل الحادية عشرة : قوله تعالى : فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة قال الضحاك وغيره : في الميل والمحبة والجماع والعشرة والقسم بين الزوجات الأربع والثلاث والاثنتين فواحدة فمنع من الزيادة التي تؤدي إلى ترك العدل في القسم وحسن العشرة . وذلك دليل على وجوب ذلك ، والله أعلم . وقرئت بالرفع ، أي فواحدة فيها كفاية أو كافية . وقال الكسائي : فواحدة تقنع . وقرئت بالنصب بإضمار فعل ، أي فانكحوا واحدة . الثانية عشرة : قوله تعالى : أو ما ملكت أيمانكم يريد الإماء . وهو عطف على " فواحدة " أي إن خاف ألا يعدل في واحدة فما ملكت يمينه . وفي هذا دليل على ألا حق لملك اليمين في الوطء ولا القسم ؛ لأن المعنى فإن خفتم ألا تعدلوا في القسم فواحدة أو ما ملكت أيمانكم فجعل ملك اليمين كله بمنزلة واحدة ، فانتفى بذلك أن يكون للإماء حق في الوطء أو في القسم . إلا أن ملك اليمين في العدل قائم بوجوب حسن الملكة والرفق بالرقيق . وأسند تعالى الملك إلى اليمين إذ هي صفة مدح ، واليمين مخصوصة بالمحاسن لتمكنها . ألا ترى أنها المنفقة ؟ كما قال عليه السلام : حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه وهي المعاهدة المبايعة ، وبها سميت الألية يمينا ، وهي المتلقية لرايات المجد ؛ كما قال : إذا ما راية رفعت لمجد تلقاها عرابة باليمين الثالثة عشرة : قوله تعالى : ذلك أدنى ألا تعولوا أي ذلك أقرب إلى ألا تميلوا عن الحق وتجوروا ؛ عن ابن عباس ومجاهد وغيرهما . يقال : عال الرجل يعول إذا جار ومال . ومنه قولهم : عال السهم عن الهدف مال عنه . قال ابن عمر : إنه لعائل الكيل والوزن ؛ قال الشاعر : [ ص: 20 ] قالوا اتبعنا رسول الله واطرحوا قول الرسول وعالوا في الموازين أي جاروا . وقال أبو طالب : بميزان صدق لا يغل شعيرة له شاهد من نفسه غير عائل يريد غير مائل . وقال آخر : ثلاثة أنفس وثلاث ذود لقد عال الزمان على عيالي أي جار ومال . وعال الرجل يعيل إذا افتقر فصار عالة . ومنه قوله تعالى : وإن خفتم عيلة . ومنه قول الشاعر : وما يدري الفقير متى غناه وما يدري الغني متى يعيل وهو عائل وقوم عيلة ، والعيلة والعالة الفاقة ، وعالني الشيء يعولني إذا غلبني وثقل علي ، وعال الأمر اشتد وتفاقم . وقال الشافعي : ألا تعولوا ألا تكثر عيالكم . قال الثعلبي : وما قال هذا غيره ، وإنما يقال : أعال يعيل إذا كثر عياله . وزعم ابن العربي أن عال على سبعة معان لا ثامن لها ، يقال : عال : مال ، الثاني : زاد ، الثالث : جار ، الرابع : افتقر ، الخامس : أثقل ، حكاه ابن دريد . قالت الخنساء : ويكفي العشيرة ما عالها السادس : عال قام بمئونة العيال ؛ ومنه قوله عليه السلام : وابدأ بمن تعول . السابع : عال غلب ؛ ومنه عيل صبره . أي غلب . ويقال : أعال الرجل كثر عياله . وأما عال بمعنى كثر عياله فلا يصح . قلت : أما قول الثعلبي " ما قاله غيره " فقد أسنده الدارقطني في سننه عن زيد بن أسلم ، وهو قول جابر بن زيد ؛ فهذان إمامان من علماء المسلمين وأئمتهم قد سبقا الشافعي إليه . وأما ما ذكره ابن العربي من الحصر وعدم الصحة فلا يصح . وقد ذكرنا : عال الأمر اشتد وتفاقم ، حكاه الجوهري . وقال الهروي في غريبيه : " وقال أبو بكر : يقال عال الرجل في الأرض يعيل فيها أي ضرب فيها . وقال الأحمر : يقال عالني الشيء يعيلني عيلا ومعيلا إذا أعجزك " . وأما [ ص: 21 ] عال كثر عياله فذكره الكسائي وأبو عمر الدوري وابن الأعرابي . قال الكسائي أبو الحسن علي بن حمزة : العرب تقول عال يعول وأعال يعيل أي كثر عياله . وقال أبو حاتم : كان الشافعي أعلم بلغة العرب منا ، ولعله لغة . قال الثعلبي المفسر : قال أستاذنا أبو القاسم بن حبيب : سألت أبا عمر الدوري عن هذا وكان إماما في اللغة غير مدافع فقال : هي لغة حمير ؛ وأنشد : وإن الموت يأخذ كل حي بلا شك وإن أمشى وعالا يعني وإن كثرت ماشيته وعياله . وقال أبو عمرو بن العلاء : لقد كثرت وجوه العرب حتى خشيت أن آخذ عن لاحن لحنا . وقرأ طلحة بن مصرف " ألا تعيلوا " وهي حجة الشافعي رضي الله عنه . قال ابن عطية : وقدح الزجاج وغيره في تأويل عال من العيال بأن قال : إن الله تعالى قد أباح كثرة السراري وفي ذلك تكثير العيال ، فكيف يكون أقرب إلى ألا يكثر العيال . وهذا القدح غير صحيح ؛ لأن السراري إنما هي مال يتصرف فيه بالبيع ، وإنما العيال القادح الحرائر ذوات الحقوق الواجبة . وحكى ابن الأعرابي أن العرب تقول : عال الرجل إذا كثر عياله . الرابعة عشرة : تعلق بهذه الآية من أجاز للمملوك أن يتزوج أربعا ، لأن الله تعالى قال : فانكحوا ما طاب لكم من النساء يعني ما حل مثنى وثلاث ورباع ولم يخص عبدا من حر . وهو قول داود والطبري وهو المشهور عن مالك وتحصيل مذهبه على ما في موطئه ، وكذلك روى عنه ابن القاسم وأشهب . وذكر ابن المواز أن ابن وهب روى عن مالك أن العبد لا يتزوج إلا اثنتين ؛ قال وهو قول الليث . قال أبو عمر : قال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما والثوري والليث بن سعد : لا يتزوج العبد أكثر من اثنتين ؛ وبه قال أحمد وإسحاق . وروي عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الرحمن بن عوف في العبد لا ينكح أكثر من اثنتين ؛ ولا أعلم لهم مخالفا من الصحابة . وهو قول الشعبي وعطاء وابن سيرين والحكم وإبراهيم وحماد . والحجة لهذا القول القياس الصحيح على طلاقه وحده . وكل من قال حده نصف حد الحر ، وطلاقه تطليقتان ، وإيلاؤه شهران ، ونحو ذلك من أحكامه فغير بعيد أن يقال : تناقض في قوله " ينكح أربعا " والله أعلم . [ ص: 22 ] قوله تعالى : وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا فيه عشرة مسائل : الأولى : قوله تعالى : وآتوا النساء صدقاتهن الصدقات جمع ، الواحدة صدقة . قال الأخفش : وبنو تميم يقولون صدقة والجمع صدقات ، وإن شئت فتحت وإن شئت أسكنت . قال المازني : يقال صداق المرأة بالكسر ، ولا يقال بالفتح . وحكى يعقوب وأحمد بن يحيى بالفتح ، عن النحاس . والخطاب في هذه الآية للأزواج ؛ قاله ابن عباس وقتادة وابن زيد وابن جريج . أمرهم الله تعالى بأن يتبرعوا بإعطاء المهور نحلة منهم لأزواجهم . وقيل : الخطاب للأولياء ؛ قاله أبو صالح . وكان الولي يأخذ مهر المرأة ولا يعطيها شيئا ، فنهوا عن ذلك وأمروا أن يدفعوا ذلك إليهن . قال في رواية الكلبي : أن أهل الجاهلية كان الولي إذا زوجها فإن كانت معه في العشرة لم يعطها من مهرها كثيرا ولا قليلا ، وإن كانت غريبة حملها على بعير إلى زوجها ولم يعطها شيئا غير ذلك البعير ؛ فنزل : وآتوا النساء صدقاتهن نحلة . وقال المعتمر بن سليمان ، عن أبيه : زعم حضرمي أن المراد بالآية المتشاغرون الذين كانوا يتزوجون امرأة بأخرى ، فأمروا أن يضربوا المهور . والأول أظهر ؛ فإن الضمائر واحدة وهي بجملتها للأزواج فهم المراد ؛ لأنه قال : وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى إلى قوله : وآتوا النساء صدقاتهن نحلة . وذلك يوجب تناسق الضمائر وأن يكون الأول فيها هو الآخر . الثانية : هذه الآية تدل على وجوب الصداق للمرأة ، وهو مجمع عليه ولا خلاف فيه إلا ما روي عن بعض أهل العلم من أهل العراق أن السيد إذا زوج عبده من أمته أنه لا يجب فيه صداق ؛ وليس بشيء ؛ لقوله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فعم . وقال : فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف . وأجمع العلماء أيضا أنه لا حد لكثيره ، واختلفوا في قليله على ما يأتي بيانه في قوله : وآتيتم إحداهن قنطارا . وقرأ [ ص: 23 ] الجمهور " صدقاتهن " بفتح الصاد وضم الدال . وقرأ قتادة " صدقاتهن " بضم الصاد وسكون الدال . وقرأ النخعي وابن وثاب بضمهما والتوحيد " صدقتهن " الثالثة : قوله تعالى : نحلة النحلة والنحلة ، بكسر النون وضمها لغتان . وأصلها من العطاء ؛ نحلت فلانا شيئا أعطيته . فالصداق عطية من الله تعالى للمرأة . وقيل : نحلة أي عن طيب نفس من الأزواج من غير تنازع . وقال قتادة : معنى نحلة فريضة واجبة . ابن جريج وابن زيد : فريضة مسماة . قال أبو عبيد : ولا تكون النحلة إلا مسماة معلومة . وقال الزجاج : نحلة تدينا . والنحلة الديانة والملة . يقال . هذا نحلته أي دينه . وهذا يحسن مع كون الخطاب للأولياء الذين كانوا يأخذونه في الجاهلية ، حتى قال بعض النساء في زوجها : لا يأخذ الحلوان من بناتنا تقول : لا يفعل ما يفعله غيره . فانتزعه الله منهم وأمر به للنساء . و " نحلة " منصوبة على أنها حال من الأزواج بإضمار فعل من لفظها تقديره أنحلوهن نحلة . وقيل : هي نصب وقيل على التفسير . وقيل : هي مصدر على غير الصدر في موضع الحال . الرابعة : قوله تعالى : فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا مخاطبة للأزواج ، ويدل بعمومه على أن هبة المرأة صداقها لزوجها بكرا كانت أو ثيبا جائزة ؛ وبه قال جمهور الفقهاء . ومنع مالك من هبة البكر الصداق لزوجها وجعل ذلك للولي مع أن الملك لها . وزعم الفراء أنه مخاطبة للأولياء ؛ لأنهم كانوا يأخذون الصداق ولا يعطون المرأة منه شيئا ، فلم يبح لهم منه إلا ما طابت به نفس المرأة . والقول الأول أصح ؛ لأنه لم يتقدم للأولياء ذكر ، والضمير في منه عائد على الصداق . وكذلك قال عكرمة وغيره . وسبب الآية فيما ذكر أن قوما تحرجوا أن يرجع إليهم شيء مما دفعوه إلى الزوجات فنزلت فإن طبن لكم . الخامسة : واتفق العلماء على أن المرأة المالكة لأمر نفسها إذا وهبت صداقها لزوجها نفذ ذلك عليها ، ولا رجوع لها فيه . إلا أن شريحا رأى الرجوع لها فيه ، واحتج بقوله : فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا وإذا كانت طالبة له لم تطب به نفسا . قال ابن العربي : وهذا باطل ؛ لأنها قد طابت وقد أكل فلا كلام لها ؛ إذ ليس المراد صورة الأكل ، وإنما هو كناية عن الإحلال والاستحلال ، وهذا بين . السادسة : فإن شرطت عليه عند عقد النكاح ألا يتزوج عليها ، وحطت عنه لذلك شيئا [ ص: 24 ] من صداقها ، ثم تزوج عليها فلا شيء لها عليه في رواية ابن القاسم ؛ لأنها شرطت عليه ما لا يجوز شرطه . كما اشترط أهل بريرة أن تعتقها عائشة والولاء لبائعها ، فصحح النبي صلى الله عليه وسلم العقد وأبطل الشرط . كذلك هاهنا يصح إسقاط بعض الصداق عنه وتبطل الزيجة . قال ابن عبد الحكم : إن كان بقي من صداقها مثل صداق مثلها أو أكثر لم ترجع عليه بشيء ، وإن كانت وضعت عنه شيئا من صداقها فتزوج عليها رجعت عليه بتمام صداق مثلها ؛ لأنه شرط على نفسه شرطا وأخذ عنه عوضا كان لها واجبا أخذه منه ، فوجب عليه الوفاء لقوله عليه السلام : المؤمنون عند شروطهم . وفي الآية دليل على أن العتق لا يكون صداقا ؛ لأنه ليس بمال ؛ إذ لا يمكن للمرأة هبته ولا الزوج أكله . وبه قال مالك وأبو حنيفة وزفر ومحمد والشافعي . وقال أحمد بن حنبل وإسحاق ويعقوب : يكون صداقا ولا مهر لها غير العتق ؛ على حديث صفية - رواه الأئمة - أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتقها وجعل عتقها صداقها . وروي عن أنس أنه فعله ، وهو راوي حديث صفية . وأجاب الأولون بأن قالوا : لا حجة في حديث صفية ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مخصوصا في النكاح بأن يتزوج بغير صداق ، وقد أراد زينب فحرمت على زيد فدخل عليها بغير ولي ولا صداق . فلا ينبغي الاستدلال بمثل هذا ؛ والله أعلم . الثامنة : قوله تعالى : نفسا قيل : هو منصوب على البيان . ولا يجيز سيبويه ولا الكوفيون أن يتقدم ما كان منصوبا على البيان ، وأجاز ذلك المازني وأبو العباس المبرد إذا كان العامل فعلا . وأنشد : وما كان نفسا بالفراق تطيب وفي التنزيل خشعا أبصارهم يخرجون فعلى هذا يجوز " شحما تفقأت . ووجها حسنت " . وقال أصحاب سيبويه : إن نفسا منصوبة بإضمار فعل تقديره أعني نفسا ، وليست منصوبة على التمييز ؛ وإذا كان هذا فلا حجة فيه . وقال الزجاج . الرواية : وما كان نفسي . . . واتفق الجميع على أنه لا يجوز تقديم المميز إذا كان العامل غير متصرف كعشرين درهما . التاسعة : قوله تعالى : فكلوه ليس المقصود صورة الأكل ، وإنما المراد به الاستباحة [ ص: 25 ] بأي طريق كان ، وهو المعني بقوله في الآية التي بعدها إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما . وليس المراد نفس الأكل ؛ إلا أن الأكل لما كان أوفى أنواع التمتع بالمال عبر عن التصرفات بالأكل . ونظيره قوله تعالى : إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع يعلم أن صورة البيع غير مقصودة ، وإنما المقصود ما يشغله عن ذكر الله تعالى مثل النكاح وغيره ؛ ولكن ذكر البيع لأنه أهم ما يشتغل به عن ذكر الله تعالى . العاشرة : قوله تعالى : هنيئا مريئا منصوب على الحال من الهاء في كلوه وقيل : نعت لمصدر محذوف ، أي أكلا هنيئا بطيب الأنفس . هنأه الطعام والشراب يهنؤه ، وما كان هنيئا ؛ ولقد هنؤ ، والمصدر الهنء . وكل ما لم يأت بمشقة ولا عناء فهو هنيء . وهنيء اسم فاعل من هنؤ كظريف من ظرف . وهنئ يهنأ فهو هنئ على فعل كزمن . وهنأني الطعام ومرأني على الإتباع ؛ فإذا لم يذكر " هنأني " قلت : أمرأني الطعام بالألف ، أي انهضم . قال أبو علي : وهذا كما جاء في الحديث ارجعن مأزورات غير مأجورات . فقلبوا الواو من ( موزورات ) ألفا إتباعا للفظ مأجورات . وقال أبو العباس عن ابن الأعرابي : يقال هنيء وهنأني ومرأني وأمرأني ولا يقال مرئني ؛ حكاه الهروي . وحكى القشيري أنه يقال : هنئني ومرئني بالكسر يهنأني ويمرأني ، وهو قليل . وقيل : هنيئا لا إثم فيه ، ومريئا لا داء فيه . قال كثير : هنيئا مريئا غير داء مخامر لعزة من أعراضنا ما استحلت ودخل رجل على علقمة وهو يأكل شيئا وهبته امرأته من مهرها فقال له : كل من الهنيء المريء . وقيل : الهنيء الطيب المساغ الذي لا ينغصه شيء ، والمريء المحمود العاقبة ، التام الهضم الذي لا يضر ولا يؤذي . يقول : لا تخافون في الدنيا به مطالبة ، ولا في الآخرة تبعة . يدل عليه ما روى ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن هذه الآية فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه فقال : إذا جادت لزوجها بالعطية طائعة غير مكرهة لا يقضي به عليكم سلطان ، ولا يؤاخذكم الله تعالى به في الآخرة وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : ( إذا اشتكى أحدكم شيئا فليسأل امرأته درهما من صداقها ثم ليشتر به عسلا فليشربه بماء السماء ؛ فيجمع الله عز وجل له الهنيء والمريء والماء المبارك ) . والله أعلم .[ ص: 26 ] قوله تعالى : ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا فيه عشر مسائل : الأولى : لما أمر الله تعالى بدفع أموال اليتامى إليهم في قوله : وآتوا اليتامى أموالهم وإيصال الصدقات إلى الزوجات ، بين أن السفيه وغير البالغ لا يجوز دفع ماله إليه . فدلت الآية على ثبوت الوصي والولي والكفيل للأيتام . وأجمع أهل العلم على أن الوصية إلى المسلم الحر الثقة العدل جائزة . واختلفوا في الوصية إلى المرأة الحرة ؛ فقال عوام أهل العلم : الوصية لها جائزة . واحتج أحمد بأن عمر رضي الله عنه أوصى إلى حفصة . وروي عن عطاء بن أبي رباح أنه قال في رجل أوصى إلى امرأته قال : لا تكون المرأة وصيا ؛ فإن فعل حولت إلى رجل من قومه . واختلفوا في الوصية إلى العبد ؛ فمنعه الشافعي وأبو ثور ومحمد ويعقوب . وأجازه مالك والأوزاعي وابن عبد الحكم . وهو قول النخعي إذا أوصى إلى عبده . وقد مضى القول في هذا في " البقرة " مستوفى . الثانية : قوله تعالى : السفهاء قد مضى في " البقرة " معنى السفه لغة . واختلف العلماء في هؤلاء السفهاء ، من هم ؟ فروى سالم الأفطس ، عن سعيد بن جبير قال : هم اليتامى لا تؤتوهم أموالكم . قال النحاس : وهذا من أحسن ما قيل في الآية . وروى إسماعيل بن أبي خالد ، عن أبي مالك قال : هم الأولاد الصغار ، لا تعطوهم أموالكم فيفسدوها وتبقوا بلا شيء . وروى سفيان ، عن حميد الأعرج ، عن مجاهد قال : هم النساء . قال النحاس وغيره : وهذا القول لا يصح ؛ إنما تقول العرب في النساء سفائه أو سفيهات ؛ لأنه الأكثر في جمع فعيلة . ويقال : لا تدفع مالك مضاربة ولا إلى وكيل لا يحسن التجارة . وروي عن عمر أنه قال : من لم يتفقه فلا يتجر في سوقنا ؛ فذلك قوله تعالى : ولا تؤتوا السفهاء أموالكم يعني الجهال بالأحكام . ويقال : لا تدفع إلى الكفار ؛ ولهذا كره العلماء أن يوكل المسلم ذميا بالشراء والبيع ، أو يدفع إليه مضاربة . وقال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه : ( السفهاء هنا كل من يستحق الحجر ) . وهذا جامع . وقال ابن خويز منداد : وأما الحجر على السفيه فالسفيه له أحوال : حال يحجر عليه لصغره ، وحالة لعدم عقله بجنون أو غيره ، وحالة لسوء نظره لنفسه في ماله . 
__________________
|
|
#218
|
||||
|
||||
 تَّفْسِيرِ (الْجَامِعِ لِأَحْكَامِ الْقُرْآنِ ، وَالْمُبَيِّنِ لِمَا تَضَمَّنَهُ مِنَ السُّنَّةِ وَآيِ الْفُرْقَانِ ) الشَّيْخُ الْفَقِيهُ الْإِمَامُ الْعَالِمُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْقُرْطُبِيُّ المجلد (5) سُورَةُ النِّسَاءِ من صــ 27 الى صــ 34 الحلقة (218) فأما المغمى عليه فاستحسن مالك ألا يحجر عليه لسرعة زوال ما به . والحجر يكون مرة في حق الإنسان [ ص: 27 ] ومرة في حق غيره ؛ فأما المحجور عليه في حق نفسه من ذكرنا . والمحجور عليه في حق غيره العبد والمديان والمريض في الثلثين ، والمفلس وذات الزوج لحق الزوج ، والبكر في حق نفسها . فأما الصغير والمجنون فلا خلاف في الحجر عليهما . وأما الكبير فلأنه لا يحسن النظر لنفسه في ماله ، ولا يؤمن منه إتلاف ماله في غير وجه ، فأشبه الصبي ؛ وفيه خلاف يأتي . ولا فرق بين أن يتلف ماله في المعاصي أو القرب والمباحات . واختلف أصحابنا إذا أتلف ماله في القرب ؛ فمنهم من حجر عليه ، ومنهم من لم يحجر عليه . والعبد لا خلاف فيه . والمديان ينزع ما بيده لغرمائه ؛ لإجماع الصحابة ، وفعل عمر ذلك بأسيفع جهينة ؛ ذكره مالك في الموطأ . والبكر ما دامت في الخدر محجور عليها ؛ لأنها لا تحسن النظر لنفسها . حتى إذا تزوجت ودخل إليها الناس ، وخرجت وبرز وجهها عرفت المضار من المنافع . وأما ذات الزوج فلأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا يجوز لامرأة ملك زوجها عصمتها قضاء في مالها إلا في ثلثها . قلت : وأما الجاهل بالأحكام وإن كان غير محجور عليه لتنميته لماله وعدم تدبيره ، فلا يدفع إليه المال ؛ لجهله بفاسد البياعات وصحيحها وما يحل وما يحرم منها . وكذلك الذمي مثله في الجهل بالبياعات ولما يخاف من معاملته بالربا وغيره . والله أعلم . واختلفوا في وجه إضافة المال إلى المخاطبين على هذا ، وهي للسفهاء ؛ فقيل : أضافها إليهم لأنها بأيديهم وهم الناظرون فيها فنسبت إليهم اتساعا ؛ كقوله تعالى : فسلموا على أنفسكم وقوله فاقتلوا أنفسكم . وقيل : أضافها إليهم لأنها من جنس أموالهم ؛ فإن الأموال جعلت مشتركة بين الخلق تنتقل من يد إلى يد ، ومن ملك إلى ملك ، أي هي لهم إذا احتاجوها كأموالكم التي تقي أعراضكم وتصونكم وتعظم أقداركم ، وبها قوام أمركم . وقول ثان قاله أبو موسى الأشعري وابن عباس والحسن وقتادة : ( أن المراد أموال المخاطبين حقيقة ) . قال ابن عباس : ( لا تدفع مالك الذي هو سبب معيشتك إلى امرأتك وابنك وتبقى فقيرا تنظر إليهم وإلى ما في أيديهم ؛ بل كن أنت الذي تنفق عليهم ) . فالسفهاء على هذا هم النساء والصبيان ؛ صغار ولد الرجل وامرأته . وهذا يخرج مع قول مجاهد وأبي مالك في السفهاء . [ ص: 28 ] الثالثة : ودلت الآية على جواز الحجر على السفيه ؛ لأمر الله عز وجل بذلك في قوله : ولا تؤتوا السفهاء أموالكم وقال فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا . فأثبت الولاية على السفيه كما أثبتها على الضعيف . وكان معنى الضعيف راجعا إلى الصغير ، ومعنى السفيه إلى الكبير البالغ ؛ لأن السفه اسم ذم ولا يذم الإنسان على ما لم يكتسبه ، والقلم مرفوع عن غير البالغ ، فالذم والحرج منفيان عنه ؛ قاله الخطابي . الرابعة : واختلف العلماء في أفعال السفيه قبل الحجر عليه ؛ فقال مالك وجميع أصحابه غير ابن القاسم : إن فعل السفيه وأمره كله جائز حتى يضرب الإمام على يده . وهو قول الشافعي وأبي يوسف . وقال ابن القاسم : أفعاله غير جائزة وإن لم يضرب عليه الإمام . وقال أصبغ : إن كان ظاهر السفه فأفعاله مردودة ، وإن كان غير ظاهر السفه فلا ترد أفعاله حتى يحجر عليه الإمام . واحتج سحنون لقول مالك بأن قال : لو كانت أفعال السفيه مردودة قبل الحجر ما احتاج السلطان أن يحجر على أحد . وحجة ابن القاسم ما رواه البخاري من حديث جابر أن رجلا أعتق عبدا ليس له مال غيره فرده النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن حجر عليه قبل ذلك . الخامسة : واختلفوا في الحجر على الكبير ؛ فقال مالك وجمهور الفقهاء : يحجر عليه . وقال أبو حنيفة : لا يحجر على من بلغ عاقلا إلا أن يكون مفسدا لماله ؛ فإذا كان كذلك منع من تسليم المال إليه حتى يبلغ خمسا وعشرين سنة ، فإذا بلغها سلم إليه بكل حال ، سواء كان مفسدا أو غير مفسد ؛ لأنه يحبل منه لاثنتي عشرة سنة ، ثم يولد له لستة أشهر فيصير جدا وأبا ، وأنا أستحيي أن أحجر على من يصلح أن يكون جدا . وقيل عنه : إن في مدة المنع من المال إذا بلغ مفسدا ينفذ تصرفه على الإطلاق ، وإنما يمنع من تسليم المال احتياطا . وهذا كله ضعيف في النظر والأثر . وقد روى الدارقطني : حدثنا محمد بن أحمد بن الحسن الصواف أخبرنا حامد بن شعيب أخبرنا شريح بن يونس أخبرنا يعقوب بن إبراهيم - هو أبو يوسف القاضي - أخبرنا هشام بن عروة ، عن أبيه أن عبد الله بن جعفر أتى الزبير فقال : إني اشتريت بيع كذا وكذا ، وإن عليا يريد أن يأتي أمير المؤمنين فيسأله أن يحجر علي فيه . فقال الزبير : أنا شريكك في البيع . فأتى علي عثمان فقال : إن ابن جعفر اشترى بيع كذا وكذا فاحجر عليه . فقال الزبير : فأنا شريكه في البيع . فقال عثمان : كيف أحجر على رجل في بيع شريكه فيه الزبير ؟ قال يعقوب : أنا آخذ بالحجر وأراه ، وأحجر وأبطل بيع المحجور عليه وشراءه ، وإذا اشترى أو باع قبل الحجر أجزت بيعه . قال يعقوب بن إبراهيم : وإن أبا حنيفة لا يحجر ولا [ ص: 29 ] يأخذ بالحجر . فقول عثمان : كيف أحجر على رجل ، دليل على جواز الحجر على الكبير ؛ فإن عبد الله بن جعفر ولدته أمه بأرض الحبشة ، وهو أول مولود ولد في الإسلام بها ، وقدم مع أبيه على النبي صلى الله عليه وسلم عام خيبر فسمع منه وحفظ عنه . وكانت خيبر سنة خمس من الهجرة . وهذا يرد على أبي حنيفة قوله . وستأتي حجته إن شاء الله تعالى . السادسة : قوله تعالى : التي جعل الله لكم قياما أي لمعاشكم وصلاح دينكم . وفي التي ثلاث لغات : التي واللت بكسر التاء واللت بإسكانها . وفي تثنيتها أيضا ثلاث لغات : اللتان واللتا بحذف النون واللتان بشد النون . وأما الجمع فتأتي لغاته في موضعه من هذه السورة إن شاء الله تعالى . والقيام والقوام : ما يقيمك بمعنى . يقال : فلان قيام أهله وقوام بيته ، وهو الذي يقيم شأنه ، أي يصلحه . ولما انكسرت القاف من قوام أبدلوا الواو ياء . وقراءة أهل المدينة " قيما " بغير ألف . قال الكسائي والفراء : قيما وقواما بمعنى قياما ، وانتصب عندهما على المصدر . أي ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي تصلح بها أموركم فيقوموا بها قياما . وقال الأخفش : المعنى قائمة بأموركم . يذهب إلى أنها جمع . وقال البصريون : قيما جمع قيمة ؛ كديمة وديم ، أي جعلها الله قيمة للأشياء . وخطأ أبو علي هذا القول وقال : هي مصدر كقيام وقوام وأصلها قوم ، ولكن شذت في الرد إلى الياء كما شذ قولهم : جياد في جمع جواد ونحوه . وقوما وقواما وقياما معناها ثباتا في صلاح الحال ودواما في ذلك . وقرأ الحسن والنخعي " اللاتي " جعل على جمع التي ، وقراءة العامة " التي " على لفظ الجماعة . قال الفراء : الأكثر في كلام العرب " النساء اللواتي ، والأموال التي " وكذلك غير الأموال ؛ ذكره النحاس : السابعة : قوله تعالى : وارزقوهم فيها واكسوهم قيل : معناه اجعلوا لهم فيها أو افرضوا لهم فيها . وهذا فيمن يلزم الرجل نفقته وكسوته من زوجته وبنيه الأصاغر . فكان هذا دليلا على وجوب نفقة الولد على الوالد والزوجة على زوجها . وفي البخاري ، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : أفضل الصدقة ما ترك غنى واليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول تقول المرأة : إما أن تطعمني وإما أن تطلقني ويقول العبد أطعمني واستعملني ويقول الابن أطعمني إلى من تدعني ؟ فقالوا : يا أبا هريرة ، سمعت هذا من [ ص: 30 ] رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : لا ، هذا من كيس أبي هريرة ! . قال المهلب : النفقة على الأهل والعيال واجبة بإجماع ؛ وهذا الحديث حجة في ذلك . الثامنة : قال ابن المنذر : واختلفوا في نفقة من بلغ من الأبناء ولا مال له ولا كسب ؛ فقالت طائفة : على الأب أن ينفق على ولده الذكور حتى يحتلموا ، وعلى النساء حتى يتزوجن ويدخل بهن . فإن طلقها بعد البناء أو مات عنها فلا نفقة لها على أبيها . وإن طلقها قبل البناء فهي على نفقتها . التاسعة : ولا نفقة لولد الولد على الجد ؛ هذا قول مالك . وقالت طائفة : ينفق على ولد ولده حتى يبلغوا الحلم والمحيض . ثم لا نفقة عليه إلا أن يكونوا زمنى ، وسواء في ذلك الذكور والإناث ما لم يكن لهم أموال ، وسواء في ذلك ولده أو ولد ولده وإن سفلوا ما لم يكن لهم أب دونه يقدر على النفقة عليهم ؛ هذا قول الشافعي . وأوجبت طائفة النفقة لجميع الأطفال والبالغين من الرجال والنساء إذا لم يكن لهم أموال يستغنون بها عن نفقة الوالد ؛ على ظاهر قوله عليه السلام لهند : خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف . وفي حديث أبي هريرة يقول الابن أطعمني إلى من تدعني ؟ يدل على أنه إنما يقول ذلك من لا طاقة له على الكسب والتحرف . ومن بلغ سن الحلم فلا يقول ذلك ؛ لأنه قد بلغ حد السعي على نفسه والكسب لها ، بدليل قوله تعالى : حتى إذا بلغوا النكاح الآية . فجعل بلوغ النكاح حدا في ذلك . وفي قوله : تقول المرأة إما أن تطعمني وإما أن تطلقني يرد على من قال : لا يفرق بالإعسار ويلزم المرأة الصبر ؛ وتتعلق النفقة بذمته بحكم الحاكم . هذا قول عطاء والزهري . وإليه ذهب الكوفيون متمسكين بقوله تعالى : وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة . قالوا : فوجب أن ينظر إلى أن يوسر . وقوله تعالى : وأنكحوا الأيامى منكم الآية . قالوا : فندب تعالى إلى إنكاح الفقير ؛ فلا يجوز أن يكون الفقر سببا للفرقة وهو مندوب منعه إلى النكاح . ولا حجة لهم في هذه الآية على ما يأتي بيانه في موضعها . والحديث نص في موضع الخلاف . وقيل : الخطاب لولي اليتيم لينفق عليه من ماله الذي له تحت نظره ؛ على ما تقدم من الخلاف في إضافة المال . فالوصي ينفق على اليتيم على قدر ماله وحاله ؛ فإن كان صغيرا وماله كثير اتخذ له ظئرا وحواضن ووسع عليه في النفقة . وإن كان كبيرا قدر له ناعم اللباس [ ص: 31 ] وشهي الطعام والخدم . وإن كان دون ذلك فبحسبه . وإن كان دون ذلك فخشن الطعام واللباس قدر الحاجة . فإن كان اليتيم فقيرا لا مال له وجب على الإمام القيام به من بيت المال ؛ فإن لم يفعل الإمام وجب ذلك على المسلمين الأخص به فالأخص . وأمه أخص به فيجب عليها إرضاعه والقيام به . ولا ترجع عليه ولا على أحد . وقد مضى في البقرة عند قوله : والوالدات يرضعن أولادهن . العاشرة : قوله تعالى : وقولوا لهم قولا معروفا أراد تليين الخطاب والوعد الجميل . واختلف في القول المعروف ؛ فقيل : معناه ادعوا لهم : بارك الله فيكم ، وحاطكم وصنع لكم ، وأنا ناظر لك ، وهذا الاحتياط يرجع نفعه إليك . وقيل : معناه وعدوهم وعدا حسنا ؛ أي إن رشدتم دفعنا إليكم أموالكم . ويقول الأب لابنه : مالي إليك مصيره ، وأنت إن شاء الله صاحبه إذا ملكت رشدك وعرفت تصرفك . قوله تعالى : وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا فيه سبع عشرة مسائل : الأولى : قوله تعالى : وابتلوا اليتامى الابتلاء الاختبار ؛ وقد تقدم . وهذه الآية خطاب للجميع في بيان كيفية دفع أموالهم . وقيل : إنها نزلت في ثابت بن رفاعة وفي عمه . وذلك أن رفاعة توفي وترك ابنه وهو صغير ، فأتى عم ثابت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إن ابن أخي يتيم في حجري فما يحل لي من ماله ، ومتى أدفع إليه ماله ؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية . الثانية : واختلف العلماء في معنى الاختبار ؛ فقيل : هو أن يتأمل الوصي أخلاق يتيمه ، ويستمع إلى أغراضه ، فيحصل له العلم بنجابته ، والمعرفة بالسعي في مصالحه وضبط ماله ، والإهمال لذلك . فإذا توسم الخير قال علماؤنا وغيرهم : لا بأس أن يدفع إليه شيئا من ماله يبيح له التصرف فيه ، فإن نماه وحسن النظر فيه فقد وقع الاختبار ، ووجب على الوصي تسليم جميع [ ص: 32 ] ماله إليه . وإن أساء النظر فيه وجب عليه إمساك ماله عنده . وليس في العلماء من يقول : إنه إذا اختبر الصبي فوجده رشيدا ترتفع الولاية عنه ، وأنه يجب دفع ماله إليه وإطلاق يده في التصرف ؛ لقوله تعالى : حتى إذا بلغوا النكاح . وقال جماعة من الفقهاء : الصغير لا يخلو من أحد أمرين ؛ إما أن يكون غلاما أو جارية ؛ فإن كان غلاما رد النظر إليه في نفقة الدار شهرا ، أو أعطاه شيئا نزرا يتصرف فيه ؛ ليعرف كيف تدبيره وتصرفه ، وهو مع ذلك يراعيه لئلا يتلفه ؛ فإن أتلفه فلا ضمان على الوصي . فإذا رآه متوخيا سلم إليه ماله وأشهد عليه . وإن كانت جارية رد إليها ما يرد إلى ربة البيت من تدبير بيتها والنظر فيه ، في الاستغزال والاستقصاء على الغزالات في دفع القطن وأجرته ، واستيفاء الغزل وجودته . فإن رآها رشيدة سلم أيضا إليها مالها وأشهد عليها . وإلا بقيا تحت الحجر حتى يؤنس رشدهما . وقال الحسن ومجاهد وغيرهما : اختبروهم في عقولهم وأديانهم وتنمية أموالهم . الثالثة : قوله تعالى : حتى إذا بلغوا النكاح أي الحلم ؛ لقوله تعالى : وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم أي البلوغ ، وحال النكاح . والبلوغ يكون بخمسة أشياء : ثلاثة يشترك فيها الرجال والنساء ، واثنان يختصان بالنساء وهما الحيض والحبل . فأما الحيض والحبل فلم يختلف العلماء في أنه بلوغ ، وأن الفرائض والأحكام تجب بهما . واختلفوا في الثلاث ؛ فأما الإنبات والسن فقال الأوزاعي والشافعي وابن حنبل : خمس عشرة سنة بلوغ لمن لم يحتلم . وهو قول ابن وهب وأصبغ وعبد الملك بن الماجشون وعمر بن عبد العزيز وجماعة من أهل المدينة ، واختاره ابن العربي . وتجب الحدود والفرائض عندهم على من بلغ هذا السن . قال أصبغ بن الفرج : والذي نقول به أن حد البلوغ الذي تلزم به الفرائض والحدود خمس عشرة سنة ؛ وذلك أحب ما فيه إلي وأحسنه عندي ؛ لأنه الحد الذي يسهم فيه في الجهاد ولمن حضر القتال . واحتج بحديث ابن عمر إذ عرض يوم الخندق وهو ابن خمس عشرة سنة فأجيز ، ولم يجز يوم أحد ؛ لأنه كان ابن أربع عشرة سنة . أخرجه مسلم . قال أبو عمر بن عبد البر : هذا فيمن عرف مولده ، وأما من جهل مولده وعدة سنه أو جحده فالعمل فيه بما روى نافع ، عن أسلم ، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، أنه كتب إلى أمراء الأجناد : ( ألا تضربوا الجزية إلا على من جرت عليه المواسي ) . وقال عثمان في غلام سرق : انظروا إن كان قد اخضر مئزره فاقطعوه . وقال عطية القرظي : عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم بني قريظة ؛ فكل من أنبت منهم قتله بحكم سعد بن معاذ ، ومن لم ينبت منهم استحياه ؛ فكنت فيمن لم ينبت فتركني . [ ص: 33 ] وقال مالك وأبو حنيفة وغيرهما : لا يحكم لمن لم يحتلم حتى يبلغ ما لم يبلغه أحد إلا احتلم ، وذلك سبع عشرة سنة ؛ فيكون عليه حينئذ الحد إذا أتى ما يجب عليه الحد . وقال مالك مرة : بلوغه أن يغلظ صوته وتنشق أرنبته . وعن أبي حنيفة رواية أخرى : تسع عشرة سنة ؛ وهي الأشهر . وقال في الجارية : بلوغها لسبع عشرة سنة وعليها النظر . وروى اللؤلئي عنه ثمان عشرة سنة . وقال داود : لا يبلغ بالسن ما لم يحتلم ولو بلغ أربعين سنة . فأما الإنبات فمنهم من قال : يستدل به على البلوغ ؛ روي عن ابن القاسم وسالم ، وقال مالك مرة ، والشافعي في أحد قوليه ، وبه قال أحمد وإسحاق وأبو ثور . وقيل : هو بلوغ ؛ إلا أنه يحكم به في الكفار فيقتل من أنبت ويجعل من لم ينبت في الذراري ؛ قاله الشافعي في القول الآخر ؛ لحديث عطية القرظي . ولا اعتبار بالخضرة والزغب ، وإنما يترتب الحكم على الشعر . وقال ابن القاسم : سمعت مالكا يقول : العمل عندي على حديث عمر بن الخطاب : لو جرت عليه المواسي لحددته . قال أصبغ : قال لي ابن القاسم وأحب إلي ألا يقام عليه الحد إلا باجتماع الإنبات والبلوغ . وقال أبو حنيفة : لا يثبت بالإنبات حكم ، وليس هو ببلوغ ولا دلالة على البلوغ . وقال الزهري وعطاء : لا حد على من لم يحتلم ؛ وهو قول الشافعي ، ومال إليه مالك مرة ، وقال به بعض أصحابه . وظاهره عدم اعتبار الإنبات والسن . قال ابن العربي : " إذا لم يكن حديث ابن عمر دليلا في السن فكل عدد يذكرونه من السنين فإنه دعوى ، والسن التي أجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى من سن لم يعتبرها ، ولا قام في الشرع دليل عليها ، وكذلك اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم الإنبات في بني قريظة ؛ فمن عذيري ممن ترك أمرين اعتبرهما النبي صلى الله عليه وسلم فيتأوله ويعتبر ما لم يعتبره النبي صلى الله عليه وسلم لفظا ، ولا جعل الله له في الشريعة نظرا " . قلت : هذا قوله هنا ، وقال في سورة الأنفال عكسه ؛ إذ لم يعرج على حديث ابن عمر هناك ، وتأوله كما تأول علماؤنا ، وأن موجبه الفرق بين من يطيق القتال ويسهم له وهو ابن خمس عشرة سنة ، ومن لا يطيقه فلا يسهم له فيجعل في العيال . وهو الذي فهمه عمر بن عبد العزيز من الحديث . والله أعلم . الرابعة : قوله تعالى : فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم أي أبصرتم ورأيتم ؛ ومنه قوله تعالى : آنس من جانب الطور نارا أي أبصر ورأى . قال الأزهري : تقول العرب اذهب فاستأنس هل ترى أحدا ؛ معناه تبصر . قال النابغة : كأن رحلي وقد زال النهار بنا يوم الجليل على مستأنس وحد [ ص: 34 ] أراد ثورا وحشيا يتبصر هل يرى قانصا فيحذره . وقيل : آنست وأحسست ووجدت بمعنى واحد ؛ ومنه قوله تعالى : فإن آنستم منهم رشدا أي علمتم . والأصل فيه أبصرتم . وقراءة العامة " رشدا " بضم الراء وسكون الشين . وقرأ السلمي وعيسى والثقفي وابن مسعود رضي الله عنهم " رشدا " بفتح الراء والشين ، وهما لغتان . وقيل : رشدا مصدر رشد . ورشدا مصدر رشد ، وكذلك الرشاد . والله أعلم . الخامسة : واختلف العلماء في تأويل رشدا فقال الحسن وقتادة وغيرهما : صلاحا في العقل والدين . وقال ابن عباس والسدي والثوري : ( صلاحا في العقل وحفظ المال ) . قال سعيد بن جبير والشعبي : إن الرجل ليأخذ بلحيته وما بلغ رشده ؛ فلا يدفع إلى اليتيم ماله وإن كان شيخا حتى يؤنس منه رشده . وهكذا قال الضحاك : لا يعطى اليتيم وإن بلغ مائة سنة حتى يعلم منه إصلاح ماله . وقال مجاهد : رشدا يعني في العقل خاصة . وأكثر العلماء على أن الرشد لا يكون إلا بعد البلوغ ، وعلى أنه إن لم يرشد بعد بلوغ الحلم وإن شاخ لا يزول الحجر عنه ؛ وهو مذهب مالك وغيره . وقال أبو حنيفة : لا يحجر على الحر البالغ إذا بلغ مبلغ الرجال ، ولو كان أفسق الناس وأشدهم تبذيرا إذا كان عاقلا . وبه قال زفر بن الهذيل ؛ وهو مذهب النخعي . واحتجوا في ذلك بما رواه قتادة ، عن أنس أن حبان بن منقذ كان يبتاع وفي عقدته ضعف ، فقيل : يا رسول الله احجر عليه ؛ فإنه يبتاع وفي عقدته ضعف . فاستدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال : لا تبع . فقال : لا أصبر . فقال له : فإذا بايعت فقل لا خلابة ولك الخيار ثلاثا . قالوا : فلما سأله القوم الحجر عليه لما كان في تصرفه من الغبن ولم يفعل عليه السلام ، ثبت أن الحجر لا يجوز . وهذا لا حجة لهم فيه ؛ لأنه مخصوص بذلك على ما بيناه في البقرة ، فغيره بخلافه . وقال الشافعي : إن كان مفسدا لماله ودينه ، أو كان مفسدا لماله دون دينه حجر عليه ، وإن كان مفسدا لدينه مصلحا لماله فعلى وجهين : أحدهما يحجر عليه ؛ وهو اختيار أبي العباس بن شريح . والثاني لا حجر عليه ؛ وهو اختيار إسحاق المروزي ، والأظهر من مذهب الشافعي . قال الثعلبي : وهذا الذي ذكرناه من الحجر على السفيه قول عثمان وعلي والزبير وعائشة وابن عباس وعبد الله بن جعفر رضوان الله عليهم ، ومن التابعين شريح ، وبه قال الفقهاء : مالك وأهل المدينة والأوزاعي وأهل الشام وأبو يوسف ومحمد وأحمد وإسحاق وأبو ثور . قال الثعلبي : وادعى أصحابنا الإجماع في هذه المسألة . 
__________________
|
|
#219
|
||||
|
||||
 تَّفْسِيرِ (الْجَامِعِ لِأَحْكَامِ الْقُرْآنِ ، وَالْمُبَيِّنِ لِمَا تَضَمَّنَهُ مِنَ السُّنَّةِ وَآيِ الْفُرْقَانِ ) الشَّيْخُ الْفَقِيهُ الْإِمَامُ الْعَالِمُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْقُرْطُبِيُّ المجلد (5) سُورَةُ النِّسَاءِ من صــ 35 الى صــ 42 الحلقة (219) [ ص: 35 ] السادسة : إذا ثبت هذا فاعلم أن دفع المال يكون بشرطين : إيناس الرشد والبلوغ ، فإن وجد أحدهما دون الآخر لم يجز تسليم المال ، كذلك نص الآية . وهو رواية ابن القاسم وأشهب وابن وهب عن مالك في الآية . وهو قول جماعة الفقهاء إلا أبا حنيفة وزفر والنخعي فإنهم أسقطوا إيناس الرشد ببلوغ خمس وعشرين سنة . قال أبو حنيفة : لكونه جدا وهذا يدل على ضعف قوله ، وضعف ما احتج به أبو بكر الرازي في أحكام القرآن له من استعمال الآيتين حسب ما تقدم ؛ فإن هذا من باب المطلق والمقيد ، والمطلق يرد إلى المقيد باتفاق أهل الأصول . وماذا يغني كونه جدا إذا كان غير جد ، أي بخت . إلا أن علماءنا شرطوا في الجارية دخول الزوج بها مع البلوغ ، وحينئذ يقع الابتلاء في الرشد . ولم يره أبو حنيفة والشافعي ، ورأوا الاختبار في الذكر والأنثى على ما تقدم . وفرق علماؤنا بينهما بأن قالوا : الأنثى مخالفة للغلام لكونها محجوبة لا تعاني الأمور ولا تبرز لأجل البكارة فلذلك وقف فيها على وجود النكاح ؛ فبه تفهم المقاصد كلها . والذكر بخلافها ؛ فإنه بتصرفه وملاقاته للناس من أول نشئه إلى بلوغه يحصل له الاختبار ، ويكمل عقله بالبلوغ ، فيحصل له الغرض . وما قاله الشافعي أصوب ؛ فإن نفس الوطء بإدخال الحشفة لا يزيدها في رشدها إذا كانت عارفة بجميع أمورها ومقاصدها ، غير مبذرة لمالها . ثم زاد علماؤنا فقالوا : لا بد بعد دخول زوجها من مضي مدة من الزمان تمارس فيها الأحوال . قال ابن العربي : وذكر علماؤنا في تحديدها أقوالا عديدة ؛ منها الخمسة الأعوام والستة والسبعة في ذات الأب . وجعلوا في اليتيمة التي لا أب لها ولا وصي عليها عاما واحدا بعد الدخول ، وجعلوا في المولى عليها مؤبدا حتى يثبت رشدها . وليس في هذا كله دليل ، وتحديد الأعوام في ذات الأب عسير ؛ وأعسر منه تحديد العام في اليتيمة . وأما تمادي الحجر في المولى عليها حتى يتبين رشدها فيخرجها الوصي عنه ، أو يخرجها الحكم منه فهو ظاهر القرآن . والمقصود من هذا كله داخل تحت قوله تعالى : فإن آنستم منهم رشدا فتعين اعتبار الرشد ولكن يختلف إيناسه بحسب اختلاف حال الراشد . فاعرفه وركب عليه واجتنب التحكم الذي لا دليل عليه . السابعة : واختلفوا فيما فعلته ذات الأب في تلك المدة ؛ فقيل : هو محمول على الرد لبقاء الحجر ، وما عملته بعده فهو محمول على الجواز . وقال بعضهم : ما عملته في تلك المدة محمول على الرد إلا أن يتبين فيه السداد ، وما عملته بعد ذلك محمول على الإمضاء حتى يتبين فيه السفه . [ ص: 36 ] الثامنة : واختلفوا في دفع المال إلى المحجور عليه هل يحتاج إلى السلطان أم لا ؟ فقالت فرقة : لا بد من رفعه إلى السلطان ، ويثبت عنده رشده ثم يدفع إليه ماله . وقالت فرقة : ذلك موكول إلى اجتهاد الوصي دون أن يحتاج إلى رفعه إلى السلطان . قال ابن عطية : والصواب في أوصياء زماننا ألا يستغنى عن رفعه إلى السلطان وثبوت الرشد عنده ، لما حفظ من تواطؤ الأوصياء على أن يرشد الصبي ، ويبرأ المحجور عليه لسفهه وقلة تحصيله في ذلك الوقت . التاسعة : فإذا سلم المال إليه بوجود الرشد ، ثم عاد إلى السفه بظهور تبذير وقلة تدبير عاد إليه الحجر عندنا ، وعند الشافعي في أحد قوليه . وقال أبو حنيفة : لا يعود ؛ لأنه بالغ عاقل ؛ بدليل جواز إقراره في الحدود والقصاص . ودليلنا قوله تعالى : ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وقال تعالى : فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل ولم يفرق بين أن يكون محجورا سفيها أو يطرأ ذلك عليه بعد الإطلاق . العاشرة : ويجوز للوصي أن يصنع في مال اليتيم ما كان للأب أن يصنع من تجارة وإبضاع وشراء وبيع . وعليه أن يؤدي الزكاة من سائر أمواله : عين وحرث وماشية وفطرة . ويؤدي عنه أروش الجنايات وقيم المتلفات ، ونفقة الوالدين وسائر الحقوق اللازمة . ويجوز أن يزوجه ويؤدي عنه الصداق ، ويشتري له جارية يتسررها ، ويصالح له وعليه على وجه النظر له . وإذا قضى الوصي بعض الغرماء وبقي من المال بقية تفي ما عليه من الدين كان فعل الوصي جائزا . فإن تلف باقي المال فلا شيء لباقي الغرماء على الوصي ولا على الذين اقتضوا . وإن اقتضى الغرماء جميع المال ثم أتى غرماء آخرون فإن كان عالما بالدين الباقي أو كان الميت معروفا بالدين الباقي ضمن الوصي لهؤلاء الغرماء ما كان يصيبهم في المحاصة ، ورجع على الذين اقتضوا دينهم بذلك . وإن لم يكن عالما بذلك ، ولا كان الميت معروفا بالدين فلا شيء على الوصي . وإذا دفع الوصي دين الميت بغير إشهاد ضمن . وأما إن أشهد وطال الزمان حتى مات الشهود فلا شيء عليه . وقد مضى في البقرة عند قوله تعالى : وإن تخالطوهم فإخوانكم من أحكام الوصي في الإنفاق وغيره ما فيه كفاية ، والحمد لله . الحادية عشرة : قوله تعالى : ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ليس يريد أن [ ص: 37 ] أكل مالهم من غير إسراف جائز ، فيكون له دليل خطاب ، بل المراد ولا تأكلوا أموالهم فإنه إسراف . فنهى الله سبحانه وتعالى الأوصياء عن أكل أموال اليتامى بغير الواجب المباح لهم ؛ على ما يأتي بيانه . والإسراف في اللغة الإفراط ومجاوزة الحد . وقد تقدم في آل عمران والسرف الخطأ في الإنفاق . ومنه قول الشاعر : أعطوا هنيدة يحدوها ثمانية ما في عطائهم من ولا سرف أي ليس يخطئون مواضع العطاء . وقال آخر : وقال قائلهم والخيل تخبطهم أسرفتم فأجبنا أننا سرف قال النضر بن شميل : السرف التبذير ، والسرف الغفلة . وسيأتي لمعنى الإسراف زيادة بيان في " الأنعام " إن شاء الله تعالى . " وبدارا " معناه : ومبادرة كبرهم ، وهو حال البلوغ . والبدار والمبادرة كالقتال والمقاتلة . وهو معطوف على إسرافا . و أن يكبروا في موضع نصب ب بدارا ، أي لا تستغنم مال محجورك فتأكله وتقول أبادر كبره لئلا يرشد ويأخذ ماله ؛ عن ابن عباس وغيره . الثانية عشرة : قوله تعالى : ومن كان غنيا فليستعفف الآية . بين الله تعالى ما يحل لهم من أموالهم ؛ فأمر الغني بالإمساك وأباح للوصي الفقير أن يأكل من مال وليه بالمعروف . يقال : عف الرجل عن الشيء واستعف إذا أمسك . والاستعفاف عن الشيء تركه . ومنه قوله تعالى : وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا . والعفة : الامتناع عما لا يحل ولا يجب فعله . روى أبو داود من حديث حسين المعلم ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إني فقير ليس لي شيء ولي يتيم . قال : فقال : كل من مال يتيمك غير مسرف ولا مبادر ولا متأثل . الثالثة عشرة : واختلف العلماء من المخاطب والمراد بهذه الآية ؟ ففي صحيح مسلم ، عن عائشة في قوله تعالى : ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف قالت : نزلت في ولي اليتيم الذي يقوم عليه ويصلحه إذا كان محتاجا جاز أن يأكل منه . في رواية : بقدر ماله بالمعروف . [ ص: 38 ] وقال بعضهم : المراد اليتيم إن كان غنيا وسع عليه وأعف عن ماله ، وإن كان فقيرا أنفق عليه بقدره ؛ قال ربيعة ويحيى بن سعيد . والأول قول الجمهور وهو الصحيح ؛ لأن اليتيم لا يخاطب بالتصرف في ماله لصغره ولسفهه . والله أعلم . الرابعة عشرة : واختلف الجمهور في الأكل بالمعروف ما هو ؟ فقال قوم : ( هو القرض إذا احتاج ويقضي إذا أيسر ) ؛ قاله عمر بن الخطاب وابن عباس وعبيدة وابن جبير والشعبي ومجاهد وأبو العالية ، وهو قول الأوزاعي . ولا يستسلف أكثر من حاجته . قال عمر : ( ألا إني أنزلت نفسي من مال الله منزلة الولي من مال اليتيم ، إن استغنيت استعففت ، وإن افتقرت أكلت بالمعروف ؛ فإذا أيسرت قضيت ) . روى عبد الله بن المبارك ، عن عاصم ، عن أبي العالية ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف قال : قرضا - ثم تلا فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم . وقول ثان - روي عن إبراهيم وعطاء والحسن البصري والنخعي وقتادة : لا قضاء على الوصي الفقير فيما يأكل بالمعروف ؛ لأن ذلك حق النظر ، وعليه الفقهاء . قال الحسن : هو طعمة من الله له ؛ وذلك أنه يأكل ما يسد جوعته ، ويكتسي ما يستر عورته ، ولا يلبس الرفيع من الكتان ولا الحلل . والدليل على صحة هذا القول إجماع الأمة على أن الإمام الناظر للمسلمين لا يجب عليه غرم ما أكل بالمعروف ؛ لأن الله تعالى قد فرض سهمه في مال الله . فلا حجة لهم في قول عمر : ( فإذا أيسرت قضيت ) - أن لو صح . وقد روي عن ابن عباس وأبي العالية والشعبي أن ( الأكل بالمعروف هو كالانتفاع بألبان المواشي ، واستخدام العبيد ، وركوب الدواب إذا لم يضر بأصل المال ؛ كما يهنأ الجرباء ، وينشد الضالة ، ويلوط الحوض ، ويجذ التمر . فأما أعيان الأموال وأصولها فليس للوصي أخذها ) . وهذا كله يخرج مع قول الفقهاء : إنه يأخذ بقدر أجر عمله ؛ وقالت به طائفة وأن ذلك هو المعروف ، ولا قضاء عليه ، والزيادة على ذلك محرمة . وفرق الحسن بن صالح بن حي - ويقال ابن حيان - بين وصي الأب والحاكم ؛ فلوصي الأب أن يأكل بالمعروف ، وأما وصي الحاكم فلا سبيل له إلى المال بوجه ؛ وهو القول الثالث . وقول رابع روي عن مجاهد قال : ليس له أن يأخذ قرضا ولا غيره . وذهب إلى أن الآية منسوخة ، نسخها قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم وهذا ليس بتجارة . وقال زيد بن أسلم : إن الرخصة في هذه الآية منسوخة بقوله تعالى : إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما الآية . وحكى بشر بن [ ص: 39 ] الوليد ، عن ابن يوسف ، قال : لا أدري ، لعل هذه الآية منسوخة بقوله عز وجل : يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم . وقول خامس - وهو الفرق بين الحضر والسفر ؛ فيمنع إذا كان مقيما معه في المصر . فإذا احتاج أن يسافر من أجله فله أن يأخذ ما يحتاج إليه ، ولا يقتني شيئا ؛ قاله أبو حنيفة وصاحباه أبو يوسف ومحمد . وقول سادس - قال أبو قلابة : فليأكل بالمعروف مما يجني من الغلة ؛ فأما المال الناض فليس له أن يأخذ منه شيئا قرضا ولا غيره . وقول سابع - روى عكرمة ، عن ابن عباس ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف قال : ( إذا احتاج واضطر ) . وقال الشعبي : كذلك إذا كان منه بمنزلة الدم ولحم الخنزير أخذ منه ؛ فإن وجد أوفى . قال النحاس : وهذا لا معنى له لأنه إذا اضطر هذا الاضطرار كان له أخذ ما يقيمه من مال يتيمه أو غيره من قريب أو بعيد . وقال ابن عباس أيضا والنخعي : ( المراد أن يأكل الوصي بالمعروف من مال نفسه حتى لا يحتاج إلى مال اليتيم ؛ فيستعفف الغني بغناه ، والفقير يقتر على نفسه حتى لا يحتاج إلى مال يتيمه ) . قال النحاس : وهذا من أحسن ما روي في تفسير الآية ؛ لأن أموال الناس محظورة لا يطلق شيء منها إلا بحجة قاطعة . قلت : وقد اختار هذا القول الكيا الطبري في أحكام القرآن له ؛ فقال : " توهم متوهمون من السلف بحكم الآية أن للوصي أن يأكل من مال الصبي قدرا لا ينتهي إلى حد السرف ، وذلك خلاف ما أمر الله تعالى به من قوله : - لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا يتحقق ذلك في مال اليتيم . فقوله : ومن كان غنيا فليستعفف يرجع إلى أكل مال نفسه دون مال اليتيم . فمعناه ولا تأكلوا أموال اليتيم مع أموالكم ، بل اقتصروا على أكل أموالكم . وقد دل عليه قوله تعالى : ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وبان بقوله تعالى : ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف الاقتصار على البلغة ، حتى لا يحتاج إلى أكل مال اليتيم ؛ فهذا تمام معنى الآية . فقد وجدنا آيات محكمات تمنع أكل مال الغير دون رضاه ، سيما في حق اليتيم . وقد وجدنا هذه الآية محتملة للمعاني ، فحملها على موجب الآيات المحكمات متعين . فإن قال من ينصر مذهب السلف : إن القضاة يأخذون أرزاقهم لأجل عملهم للمسلمين ، فهلا كان الوصي كذلك إذا عمل لليتيم ، ولم لا يأخذ الأجرة بقدر عمله ؟ قيل له : اعلم أن أحدا من [ ص: 40 ] السلف لم يجوز للوصي أن يأخذ من مال الصبي مع غنى الوصي ، بخلاف القاضي ؛ فذلك فارق بين المسألتين . وأيضا فالذي يأخذه الفقهاء والقضاة والخلفاء القائمون بأمور الإسلام لا يتعين له مالك . وقد جعل الله ذلك المال الضائع لأصناف بأوصاف ، والقضاة من جملتهم ، والوصي إنما يأخذ بعمله مال شخص معين من غير رضاه ؛ وعمله مجهول وأجرته مجهولة وذلك بعيد عن الاستحقاق . قلت : وكان شيخنا الإمام أبو العباس يقول : إن كان مال اليتيم كثيرا يحتاج إلى كبير قيام عليه بحيث يشغل الولي عن حاجاته ومهماته فرض له فيه أجر عمله ، وإن كان تافها لا يشغله عن حاجاته فلا يأكل منه شيئا ؛ غير أنه يستحب له شرب قليل اللبن وأكل القليل من الطعام والسمن ، غير مضر به ولا مستكثر له ، بل على ما جرت العادة بالمسامحة فيه . قال شيخنا : وما ذكرته من الأجرة ، ونيل اليسير من التمر واللبن كل واحد منهما معروف ؛ فصلح حمل الآية على ذلك . والله أعلم . قلت : والاحتراز عنه أفضل ، إن شاء الله . وأما ما يأخذه قاضي القسمة ويسميه رسما ونهب أتباعه فلا أدري له وجها ولا حلا ، وهم داخلون في عموم قوله تعالى : إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا . الخامسة عشرة : قوله تعالى : فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم أمر الله تعالى بالإشهاد تنبيها على التحصين وزوالا للتهم . وهذا الإشهاد مستحب عند طائفة من العلماء ؛ فإن القول قول الوصي ؛ لأنه أمين . وقالت طائفة : هو فرض ؛ وهو ظاهر الآية ، وليس بأمين فيقبل قوله ، كالوكيل إذا زعم أنه قد رد ما دفع إليه أو المودع ، وإنما هو أمين للأب ، ومتى ائتمنه الأب لا يقبل قوله على غيره . ألا ترى أن الوكيل لو ادعى أنه قد دفع لزيد ما أمره به بعدالته لم يقبل قوله إلا ببينة ؛ فكذلك الوصي . ورأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وابن جبير أن هذا الإشهاد إنما هو على دفع الوصي في يسره ما استقرضه من مال يتيمه حالة فقره . قال عبيدة : هذه الآية دليل على وجوب القضاء على من أكل ؛ المعنى : فإذا اقترضتم أو أكلتم فأشهدوا إذا غرمتم . والصحيح أن اللفظ يعم هذا وسواه . والظاهر أن المراد إذا أنفقتم شيئا على المولى عليه فأشهدوا ، حتى ولو وقع خلاف أمكن إقامة البينة ؛ فإن كل مال قبض على وجه [ ص: 41 ] الأمانة بإشهاد لا يبرأ منه إلا بالإشهاد على دفعه ، لقوله تعالى : فأشهدوا فإذا دفع لمن دفع إليه بغير إشهاد فلا يحتاج في دفعها لإشهاد إن كان قبضها بغير إشهاد . والله أعلم . السادسة عشرة : قوله تعالى : كما على الوصي والكفيل حفظ مال يتيمه والتثمير له ، كذلك عليه حفظ الصبي في بدنه . فالمال يحفظه بضبطه ، والبدن يحفظه بأدبه . وقد مضى هذا المعنى في " البقرة " . وروي أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم : إن في حجري يتيما أآكل من ماله ؟ قال : نعم غير متأثل مالا ولا واق مالك بماله . قال : يا رسول الله ، أفأضربه ؟ قال : ما كنت ضاربا منه ولدك . قال ابن العربي : وإن لم يثبت مسندا فليس يجد أحد عنه ملتحدا . السابعة عشرة : قوله تعالى : وكفى بالله حسيبا أي كفى الله حاسبا لأعمالكم ومجازيا بها . ففي هذا وعيد لكل جاحد حق . والباء زائدة ، وهو في موضع رفع . قوله تعالى : للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا فيه خمس مسائل : الأولى : لما ذكر الله تعالى أمر اليتامى وصله بذكر المواريث . ونزلت الآية في أوس بن ثابت الأنصاري ، توفي وترك امرأة يقال لها : أم كجة وثلاث بنات له منها ؛ فقام رجلان هما ابنا عم الميت ووصياه يقال لهما : سويد وعرفجة ؛ فأخذا ماله ولم يعطيا امرأته وبناته شيئا ، وكانوا في الجاهلية لا يورثون النساء ولا الصغير وإن كان ذكرا ، ويقولون : لا يعطى إلا من قاتل على ظهور الخيل ، وطاعن بالرمح ، وضارب بالسيف ، وحاز الغنيمة . فذكرت أم كجة ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاهما ، فقالا : يا رسول الله ، ولدها لا يركب فرسا ، ولا يحمل كلا ولا ينكأ عدوا . فقال عليه السلام : انصرفا حتى أنظر ما يحدث الله لي فيهن . فأنزل الله هذه الآية ردا عليهم ، وإبطالا لقولهم وتصرفهم بجهلهم ؛ فإن الورثة الصغار كان ينبغي أن يكونوا أحق بالمال من الكبار ، لعدم تصرفهم والنظر في مصالحهم ، فعكسوا الحكم ، وأبطلوا الحكمة فضلوا بأهوائهم ، وأخطئوا في آرائهم وتصرفاتهم . 
__________________
|
|
#220
|
||||
|
||||
 تَّفْسِيرِ (الْجَامِعِ لِأَحْكَامِ الْقُرْآنِ ، وَالْمُبَيِّنِ لِمَا تَضَمَّنَهُ مِنَ السُّنَّةِ وَآيِ الْفُرْقَانِ ) الشَّيْخُ الْفَقِيهُ الْإِمَامُ الْعَالِمُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْقُرْطُبِيُّ المجلد (5) سُورَةُ النِّسَاءِ من صــ 43 الى صــ 50 الحلقة (220) [ ص: 42 ] الثانية : قال علماؤنا : في هذه الآية فوائد ثلاث : إحداها : بيان علة الميراث وهي القرابة . الثانية : عموم القرابة كيفما تصرفت من قريب أو بعيد . الثالثة : إجمال النصيب المفروض . وذلك مبين في آية المواريث ؛ فكان في هذه الآية توطئة للحكم ، وإبطال لذلك الرأي الفاسد حتى وقع البيان الشافي . الثالثة : ثبت أن أبا طلحة لما تصدق بماله - بئر حاء - وذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال له : اجعلها في فقراء أقاربك فجعلها لحسان وأبي . قال أنس : ( وكانا أقرب إليه مني ) . قال أبو داود : بلغني عن محمد بن عبد الله الأنصاري أنه قال : أبو طلحة الأنصاري زيد بن سهل بن الأسود بن حرام بن عمرو بن زيد مناة بن عدي بن عمرو بن مالك بن النجار . وحسان بن ثابت بن المنذر بن حرام يجتمعان في الأب الثالث وهو حرام . وأبي بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار . قال الأنصاري : بين أبي طلحة وأبي ستة آباء . قال : وعمرو بن مالك يجمع حسان وأبي بن كعب وأبا طلحة . قال أبو عمر : في هذا ما يقضي على القرابة أنها ما كانت في هذا القعدد ونحوه ، وما كان دونه فهو أحرى أن يلحقه اسم القرابة . الرابعة : قوله تعالى : مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا أثبت الله تعالى للبنات نصيبا في الميراث ولم يبين كم هو ؛ فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى سويد وعرفجة ألا يفرقا من مال أوس شيئا ؛ فإن الله جعل لبناته نصيبا ولم يبين كم هو حتى أنظر ما ينزل ربنا . فنزلت يوصيكم الله في أولادكم إلى قوله تعالى : الفوز العظيم فأرسل إليهما أن أعطيا أم كجة الثمن مما ترك أوس ، ولبناته الثلثين ، ولكما بقية المال . الخامسة : استدل علماؤنا بهذه الآية في قسمة المتروك على الفرائض إذا كان فيه تغيير عن حاله ، كالحمام والبيت وبيدر الزيتون والدار التي تبطل منافعها بإقرار أهل السهام فيها . فقال مالك : يقسم ذلك وإن لم يكن في نصيب أحدهم ما ينتفع به ؛ لقوله تعالى : مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا . وهو قول ابن كنانة ، وبه قال الشافعي ، ونحوه قول أبي حنيفة . قال [ ص: 43 ] أبو حنيفة : في الدار الصغيرة بين اثنين فطلب أحدهما القسمة وأبى صاحبه قسمت له . وقال ابن أبي ليلى : إن كان فيهم من لا ينتفع بما يقسم له فلا يقسم . وكل قسم يدخل فيه الضرر على أحدهما دون الآخر فإنه لا يقسم ؛ وهو قول أبي ثور . قال ابن المنذر : وهو أصح القولين . ورواه ابن القاسم ، عن مالك فيما ذكر ابن العربي . قال ابن القاسم : وأنا أرى أن كل ما لا ينقسم من الدور والمنازل والحمامات ، وفي قسمته الضرر ولا ينتفع به إذا قسم ، أن يباع ولا شفعة فيه ؛ لقوله عليه السلام : الشفعة في كل ما لا يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة . فجعل عليه السلام الشفعة في كل ما يتأتى فيه إيقاع الحدود ، وعلق الشفعة فيما لم يقسم مما يمكن إيقاع الحدود فيه . هذا دليل الحديث . قلت : ومن الحجة لهذا القول ما خرجه الدارقطني من حديث ابن جريج أخبرني صديق بن موسى ، عن محمد بن أبي بكر ، عن أبيه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : لا تعضية على أهل الميراث إلا ما حمل القسم . قال أبو عبيد : هو أن يموت الرجل ويدع شيئا إن قسم بين ورثته كان في ذلك ضرر على جميعهم أو على بعضهم . يقول : فلا يقسم ؛ وذلك مثل الجوهرة والحمام والطيلسان وما أشبه ذلك . والتعضية التفريق ، يقال : عضيت الشيء إذا فرقته . ومنه قوله تعالى : الذين جعلوا القرآن عضين . وقال تعالى : غير مضار فنفى المضارة . وكذلك قال عليه السلام : لا ضرر ولا ضرار . وأيضا فإن الآية ليس فيها تعرض للقسمة ، وإنما اقتضت الآية وجوب الحظ والنصيب للصغير والكبير قليلا كان أو كثيرا ، ردا على الجاهلية فقال : للرجال نصيب وللنساء نصيب وهذا ظاهر جدا . فأما إبراز ذلك النصيب فإنما يؤخذ من دليل آخر ؛ وذلك بأن يقول الوارث : قد وجب لي نصيب بقول الله عز وجل فمكنوني منه ؛ فيقول له شريكه : أما تمكينك على الاختصاص فلا يمكن ؛ لأنه يؤدي إلى ضرر بيني وبينك من إفساد المال ، وتغيير الهيئة ، وتنقيص القيمة ؛ فيقع الترجيح . والأظهر سقوط القسمة فيما يبطل المنفعة وينقص المال مع ما ذكرناه من الدليل . والله الموفق . قال الفراء : نصيبا مفروضا هو كقولك : قسما واجبا ، وحقا لازما ؛ فهو اسم في معنى [ ص: 44 ] المصدر فلهذا انتصب . الزجاج : انتصب على الحال . أي لهؤلاء أنصباء في حال الفرض . الأخفش : أي جعل الله لهم نصيبا . والمفروض : المقدر الواجب . قوله تعالى : وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا فيه أربع مسائل : الأولى : بين الله تعالى أن من لم يستحق شيئا إرثا وحضر القسمة ، وكان من الأقارب أو اليتامى والفقراء الذين لا يرثون أن يكرموا ولا يحرموا ، إن كان المال كثيرا ؛ والاعتذار إليهم إن كان عقارا أو قليلا لا يقبل الرضخ . ( وإن كان عطاء من القليل ففيه أجر عظيم ؛ درهم يسبق مائة ألف ) . فالآية على هذا القول محكمة ؛ قاله ابن عباس . وامتثل ذلك جماعة من التابعين : عروة بن الزبير وغيره ، وأمر به أبو موسى الأشعري وروي عن ابن عباس أنها منسوخة نسخها قوله تعالى : يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين وقال سعيد بن المسيب : نسخها آية الميراث والوصية . وممن قال إنها منسوخة أبو مالك وعكرمة والضحاك . والأول أصح ؛ فإنها مبينة استحقاق الورثة لنصيبهم ، واستحباب المشاركة لمن لا نصيب له ممن حضرهم . قال ابن جبير : ضيع الناس هذه الآية . قال الحسن : ولكن الناس شحوا . وفي البخاري ، عن ابن عباس في قوله تعالى : وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين قال : ( هي محكمة وليست بمنسوخة ) . وفي رواية قال : ( إن ناسا يزعمون أن هذه الآية نسخت ، لا والله ما نسخت ولكنها مما تهاون بها ؛ هما واليان : وال يرث وذلك الذي يرزق ، ووال لا يرث وذلك الذي يقول بالمعروف ، ويقول : لا أملك لك أن أعطيك ) . قال ابن عباس : ( أمر الله المؤمنين عند قسمة مواريثهم أن يصلوا أرحامهم ، ويتاماهم ومساكينهم من الوصية ، فإن لم تكن وصية وصل لهم من الميراث ) . قال النحاس : فهذا أحسن ما قيل في الآية ، أن يكون على الندب والترغيب في فعل الخير ، والشكر لله عز وجل . وقالت طائفة : هذا الرضخ واجب على جهة الفرض ، تعطي الورثة لهذه الأصناف ما طابت به نفوسهم ، كالماعون والثوب الخلق وما خف . حكى هذا القول ابن عطية والقشيري . والصحيح أن هذا على الندب ؛ لأنه لو كان فرضا لكان استحقاقا في التركة ومشاركة في الميراث ، لأحد الجهتين [ ص: 45 ] معلوم وللآخر مجهول . وذلك مناقض للحكمة ، وسبب للتنازع والتقاطع . وذهبت فرقة إلى أن المخاطب والمراد في الآية المحتضرون الذين يقسمون أموالهم بالوصية ، لا الورثة . وروي عن ابن عباس وسعيد بن المسيب وابن زيد . ( فإذا أراد المريض أن يفرق ماله بالوصايا وحضره من لا يرث ينبغي له ألا يحرمه ) . وهذا والله أعلم - يتنزل حيث كانت الوصية واجبة ، ولم تنزل آية الميراث . والصحيح الأول وعليه المعول . الثانية : فإذا كان الوارث صغيرا لا يتصرف في ماله ؛ فقالت طائفة : يعطى ولي الوارث الصغير من مال محجوره بقدر ما يرى . وقيل : لا يعطى بل يقول لمن حضر القسمة : ليس لي شيء من هذا المال إنما هو لليتيم ، فإذا بلغ عرفته حقكم . فهذا هو القول المعروف . وهذا إذا لم يوص الميت له بشيء ؛ فإن أوصى يصرف له ما أوصى . ورأى عبيدة ومحمد بن سيرين أن الرزق في هذه الآية أن يصنع لهم طعاما يأكلونه ؛ وفعلا ذلك ، ذبحا شاة من التركة ، وقال عبيدة : لولا هذه الآية لكان هذا من مالي . وروى قتادة ، عن يحيى بن يعمر قال : ثلاث محكمات تركهن الناس : هذه الآية ، وآية الاستئذان يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم ، وقوله : يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى . الثالثة : قوله تعالى " منه " الضمير عائد على معنى القسمة ؛ إذ هي بمعنى المال والميراث ؛ لقوله تعالى : ثم استخرجها من وعاء أخيه أي السقاية ؛ لأن الصواع مذكر . ومنه قوله عليه السلام : واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب فأعاد مذكرا على معنى الدعاء . وكذلك قوله لسويد بن طارق الجعفي حين سأله عن الخمر إنه ليس بدواء ولكنه داء فأعاد الضمير على معنى الشراب . ومثله كثير . يقال : قاسمه المال وتقاسماه واقتسماه ، والاسم القسمة مؤنثة ؛ والقسم مصدر قسمت الشيء فانقسم ، والموضع مقسم مثل مجلس ، وتقسمهم الدهر فتقسموا ، أي فرقهم فتفرقوا . والتقسيم التفريق . والله أعلم . الرابعة : قوله تعالى : وقولوا لهم قولا معروفا قال سعيد بن جبير : يقال لهم خذوا بورك لكم . وقيل : قولوا مع الرزق وددت أن لو كان أكثر من هذا . وقيل : لا حاجة مع الرزق إلى عذر ، نعم إن لم يصرف إليهم شيء فلا أقل من قول جميل ونوع اعتذار . [ ص: 46 ] وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا فيه مسألتان : الأولى : قوله تعالى : وليخش حذفت الألف من ليخش للجزم بالأمر ، ولا يجوز عند سيبويه إضمار لام الأمر قياسا على حروف الجر إلا في ضرورة الشعر . وأجاز الكوفيون حذف اللام مع الجزم ؛ وأنشد الجميع : محمد تفد نفسك كل نفس إذا ما خفت من شيء تبالا أراد لتفد ، ومفعول يخش محذوف لدلالة الكلام عليه . و " خافوا " جواب لو . التقدير لو تركوا لخافوا . ويجوز حذف اللام في جواب لو . وهذه الآية قد اختلف العلماء في تأويلها ؛ فقالت طائفة : ( هذا وعظ للأوصياء ، أي افعلوا باليتامى ما تحبون أن يفعل بأولادكم من بعدكم ) ؛ قاله ابن عباس . ولهذا قال الله تعالى : إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما . وقالت طائفة : المراد جميع الناس ، أمرهم باتقاء الله في الأيتام وأولاد الناس ؛ وإن لم يكونوا في حجورهم . وأن يسددوا لهم القول كما يريد كل واحد منهم أن يفعل بولده بعده . ومن هذا ما حكاه الشيباني قال : كنا على قسطنطينية في عسكر مسلمة بن عبد الملك ، فجلسنا يوما في جماعة من أهل العلم فيهم ابن الديلمي ، فتذاكروا ما يكون من أهوال آخر الزمان . فقلت له : يا أبا بشر ، ودي ألا يكون لي ولد . فقال لي : ما عليك ! ما من نسمة قضى الله بخروجها من رجل إلا خرجت ، أحب أو كره ، ولكن إذا أردت أن تأمن عليهم فاتق الله في غيرهم ؛ ثم تلا الآية . وفي رواية : ألا أدلك على أمر إن أنت أدركته نجاك الله منه ، وإن تركت ولدا من بعدك حفظهم الله فيك ؟ فقلت : بلى ! فتلا هذه الآية وليخش الذين لو تركوا إلى آخرها . قلت : ومن هذا المعنى ما روى محمد بن كعب القرظي ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من أحسن الصدقة جاز على الصراط ومن قضى حاجة أرملة أخلف الله في تركته . وقول ثالث قاله جمع من المفسرين : هذا في الرجل يحضره الموت فيقول له من بحضرته عند وصيته : إن الله سيرزق ولدك فانظر لنفسك ، وأوص بمالك في سبيل الله ، وتصدق وأعتق . حتى يأتي على عامة ماله أو يستغرقه فيضر ذلك بورثته ؛ فنهوا عن ذلك . فكأن الآية تقول لهم : ( كما تخشون على ورثتكم وذريتكم بعدكم ، فكذلك فاخشوا على ورثة غيركم ولا تحملوه على [ ص: 47 ] تبذير ماله ) ؛ قاله ابن عباس وقتادة والسدي وابن جبير والضحاك ومجاهد . روى سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال : ( إذا حضر الرجل الوصية فلا ينبغي أن يقول أوص بمالك فإن الله تعالى رازق ولدك ، ولكن يقول قدم لنفسك واترك لولدك ) ؛ فذلك قوله تعالى : فليتقوا الله . وقال مقسم وحضرمي : نزلت في عكس هذا ، وهو أن يقول للمحتضر من يحضره : أمسك على ورثتك ، وأبق لولدك فليس أحد أحق بمالك من أولادك ، وينهاه عن الوصية ، فيتضرر بذلك ذوو القربى وكل من يستحق أن يوصى له ؛ فقيل لهم : كما تخشون على ذريتكم وتسرون بأن يحسن إليهم ، فكذلك سددوا القول في جهة المساكين واليتامى ، واتقوا الله في ضررهم . وهذان القولان مبنيان على وقت وجوب الوصية قبل نزول آية المواريث ؛ روي عن سعيد بن جبير وابن المسيب . قال ابن عطية : وهذان القولان لا يطرد واحد منهما في كل الناس ، بل الناس صنفان ؛ يصلح لأحدهما القول الواحد ، ولآخر القول الثاني . وذلك أن الرجل إذا ترك ورثته مستقلين بأنفسهم أغنياء حسن أن يندب إلى الوصية ، ويحمل على أن يقدم لنفسه . وإذا ترك ورثة ضعفاء مهملين مقلين حسن أن يندب إلى الترك لهم والاحتياط ؛ فإن أجره في قصد ذلك كأجره في المساكين ، فالمراعاة إنما هو الضعف فيجب أن يمال معه . قلت : وهذا التفصيل صحيح ؛ لقوله عليه السلام لسعد : إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس . فإن لم يكن للإنسان ولد ، أو كان وهو غني مستقل بنفسه وماله عن أبيه فقد أمن عليه ؛ فالأولى بالإنسان حينئذ تقديم ماله بين يديه حتى لا ينفقه من بعده فيما لا يصلح ، فيكون وزره عليه . الثانية : قوله تعالى : وليقولوا قولا سديدا السديد : العدل والصواب من القول ؛ أي مروا المريض بأن يخرج من ماله ما عليه من الحقوق الواجبة ، ثم يوصي لقرابته بقدر ما لا يضر بورثته الصغار . وقيل : المعنى قولوا للميت قولا عدلا ، وهو أن يلقنه بلا إله إلا الله ، ولا يأمره بذلك ، ولكن يقول ذلك في نفسه حتى يسمع منه ويتلقن . هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم : لقنوا موتاكم لا إله إلا الله ولم يقل مروهم ؛ لأنه لو أمر بذلك لعله يغضب ويجحد . وقيل : المراد اليتيم ؛ أن لا ينهروه ولا يستخفوا به . [ ص: 48 ] إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا فيه ثلاث مسائل : الأولى : قوله تعالى : إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما روي أنها نزلت في رجل من غطفان يقال له : مرثد بن زيد ، ولي مال ابن أخيه وهو يتيم صغير فأكله ؛ فأنزل الله تعالى فيه هذه الآية ، قال مقاتل بن حيان ؛ ولهذا قال الجمهور : إن المراد الأوصياء الذين يأكلون ما لم يبح لهم من مال اليتيم . وقال ابن زيد : نزلت في الكفار الذين كانوا لا يورثون النساء ولا الصغار . وسمي أخذ المال على كل وجوهه أكلا ؛ لما كان المقصود هو الأكل وبه أكثر إتلاف الأشياء . وخص البطون بالذكر لتبيين نقصهم ، والتشنيع عليهم بضد مكارم الأخلاق . وسمى المأكول نارا بما يئول إليه ؛ كقوله تعالى : إني أراني أعصر خمرا أي عنبا . وقيل : نارا أي حراما ؛ لأن الحرام يوجب النار ، فسماه الله تعالى باسمه . وروى أبو سعيد الخدري قال : حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ليلة أسري به قال : رأيت قوما لهم مشافر كمشافر الإبل وقد وكل بهم من يأخذ بمشافرهم ثم يجعل في أفواههم صخرا من نار يخرج من أسافلهم فقلت يا جبريل من هؤلاء قال هم الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما . فدل الكتاب والسنة على أن أكل مال اليتيم من الكبائر . وقال صلى الله عليه وسلم : اجتنبوا السبع الموبقات وذكر فيها وأكل مال اليتيم . الثانية : قوله تعالى : وسيصلون سعيرا وقرأ ابن عامر وعاصم في رواية ابن عباس بضم الياء على اسم ما لم يسم فاعله ؛ من أصلاه الله حر النار إصلاء . قال الله تعالى : سأصليه سقر . وقرأ أبو حيوة بضم الياء وفتح الصاد وتشديد اللام من التصلية لكثرة الفعل مرة بعد أخرى . دليله قوله تعالى : ثم الجحيم صلوه . ومنه قولهم : صليته مرة بعد أخرى . وتصليت : استدفأت بالنار . قال : وقد تصليت حر حربهم كما تصلى المقرور من قرس وقرأ الباقون بفتح الياء من صلي النار يصلاها صلى وصلاء . قال الله تعالى : لا يصلاها إلا الأشقى . والصلاء هو التسخن بقرب النار أو مباشرتها ؛ ومنه قول الحارث بن [ ص: 49 ] عباد : لم أكن من جناتها علم الل ه وإني لحرها اليوم صال والسعير : الجمر المشتعل . الثالثة : وهذه آية من آيات الوعيد ، ولا حجة فيها لمن يكفر بالذنوب . والذي يعتقده أهل السنة أن ذلك نافذ على بعض العصاة فيصلى ثم يحترق ويموت ؛ بخلاف أهل النار لا يموتون ولا يحيون ، فكأن هذا جمع بين الكتاب والسنة ، لئلا يقع الخبر فيهما على خلاف مخبره ، ساقط بالمشيئة عن بعضهم ؛ لقوله تعالى : إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء . وهكذا القول في كل ما يرد عليك من هذا المعنى . روى مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم - أو قال بخطاياهم - فأماتهم الله إماتة حتى إذا كانوا فحما أذن بالشفاعة فجيء بهم ضبائر ضبائر فبثوا على أنهار الجنة ثم قيل يا أهل الجنة أفيضوا عليهم فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل . فقال رجل من القوم كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان يرعى بالبادية . قوله تعالى : يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما فيه خمس وعشرون مسألة : الأولى : قوله تعالى : يوصيكم الله في أولادكم بين تعالى في هذه الآية ما أجمله في قوله : للرجال نصيب و للنساء نصيب فدل هذا على جواز تأخير البيان عن [ ص: 50 ] وقت السؤال . وهذه الآية ركن من أركان الدين ، وعمدة من عمد الأحكام ، وأم من أمهات الآيات ؛ فإن الفرائض عظيمة القدر حتى إنها ثلث العلم ، وروي نصف العلم . وهو أول علم ينزع من الناس وينسى . رواه الدارقطني ، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : تعلموا الفرائض وعلموه الناس فإنه نصف العلم وهو أول شيء ينسى وهو أول شيء ينتزع من أمتي . وروي أيضا عن عبد الله بن مسعود قال : قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : تعلموا القرآن وعلموه الناس وتعلموا الفرائض وعلموها الناس وتعلموا العلم وعلموه الناس فإني امرؤ مقبوض وإن العلم سيقبض وتظهر الفتن حتى يختلف الاثنان في الفريضة لا يجدان من يفصل بينهما . وإذا ثبت هذا فاعلم أن الفرائض كانت جل علم الصحابة ، وعظيم مناظرتهم ، ولكن الخلق ضيعوه . وقد روى مطرف ، عن مالك ، قال عبد الله بن مسعود : ( من لم يتعلم الفرائض والطلاق والحج فبم يفضل أهل البادية ؟ ) وقال ابن وهب ، عن مالك : كنت أسمع ربيعة يقول : ( من تعلم الفرائض من غير علم بها من القرآن ما أسرع ما ينساها ) . قال مالك : وصدق . الثانية : روى أبو داود والدارقطني ، عن عبد الله بن عمرو بن العاص ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : العلم ثلاثة وما سوى ذلك فهو فضل : آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة . قال الخطابي أبو سليمان : الآية المحكمة هي كتاب الله تعالى : واشترط فيها الإحكام ؛ لأن من الآي ما هو منسوخ لا يعمل به ، وإنما يعمل بناسخه . والسنة القائمة هي الثابتة مما جاء عنه صلى الله عليه وسلم من السنن الثابتة . وقوله : أو فريضة عادلة يحتمل وجهين من التأويل : أحدهما : أن يكون من العدل في القسمة ؛ فتكون معدلة على الأنصباء والسهام المذكورة في الكتاب والسنة . والوجه الآخر : أن تكون مستنبطة من الكتاب والسنة ومن معناهما ؛ فتكون هذه الفريضة تعدل ما أخذ من الكتاب والسنة إذ كانت في معنى ما أخذ عنهما نصا . 
__________________
|
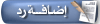 |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |