|
|||||||
| الملتقى الاسلامي العام مواضيع تهتم بالقضايا الاسلامية على مذهب اهل السنة والجماعة |
 |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
||||
|
||||
|
الكُتب المعزوَّة إلى غير مُصنّفيها (1-2) د. عادل بن صالح أحمد الغامدي 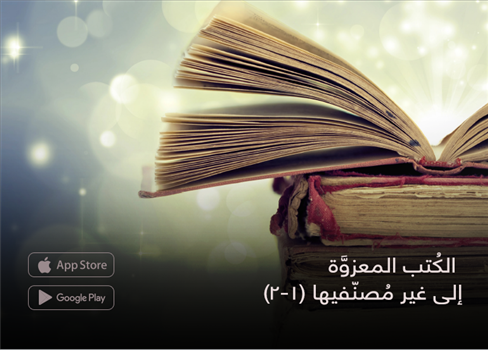 إن علم الببليوغرافيا[1] أو عِلْم قوائم الكتب، عِلْم حديث في الغرب، ولكنه علم قديم في لغة العرب، يرجع تاريخه إلى أكثر من عشرة قرون، ويكاد ينعقد إجماع الباحثين، على أن فهرست ابن النديم هو أول عمل ببليوغرافي في اللغة العربية، وقد كان ورَّاقًا في القرن الرابع الهجري، وتلا ذلك عدد من الجهود، مثل: مفتاح السعادة لأحمد مصطفى الشهير بطاشكبرى زاده، وكشف الظنون لحاجي خليفة، وإيضاح المكنون وهدية العارفين لإسماعيل البغدادي، ومعجم المطبوعات العربية والمعربة ليوسف سركيس[2]. والمطَّلع على فهارس المكتبات العامة والخاصة؛ يجد أن مُؤلّفيها كشفوا عن خطأ النسبة لبعض الكتب، إلى مؤلفين غير مُؤلفيها، أو اختلاف في نسبتها إلى أكثر من مؤلف[3]. هناك الكثير من الموسوعات والمعاجم التي عُنيت بأسماء المؤلفين ومُصنّفاتهم، مثل: سِيَر أعلام النبلاء، للذهبي، وأسماء الكتب المتمّم لكشف الظنون لعبد اللطيف زاده، والسر المصون ذيل على كشف الظنون، لجميل بيك العظم، ومعجم المؤلفين لعمر رضا كحالة، وتكملة معجم المؤلفين، لمحمد خير رمضان يوسف، وتاريخ التراث العربي لفؤاد سيزكين، والأعلام، لخير الدين الزركلي، ومداخل المؤلفين والأعلام العرب، فكري الجزار، ولو أردنا إحصاءها لطال بنا المقام. هل كان الفهرست لابن النديم أول عمل ببليوغرافي؟ يُفهَم من النص المنقول عن الدكتور عبدالستار الحلوجي حينما قال: «ويكاد ينعقد إجماع الباحثين» على أنه يُشكّك في هذه الأولية، فقد ذكَر بعد هذا النص كلامًا يُوضّح حقيقة هذا الاعتقاد، فقال: «ونظرًا لأنه لم يرد في كشف الظنون وذيله، أيّ فهرس آخر يتقدم عليه في الزمن؛ فقد اعتقد الباحثون أنه أول عمل ببليوغرافي في اللغة العربية، وذلك يدفعنا إلى محاولة الوقوف على مدى صحة هذا الاعتقاد. والذي تؤكده مصادر التراث العربي، والذي يقطع به فهرست ابن النديم نفسه، أنه سُبِقَ بمحاولات ببليوغرافية رائدة، ضاع معظمها، وبقيت شواهده تدلّ عليها»[4]. ثم ذكر الحلوجي الشواهد والأدلة على صحة كلامه، وختم ذلك بالنتيجة التي توصل إليها، فقال: «وإذن فابن النديم ليس الأب الشرعي لعلم الببليوغرافيا العربي، كما توهَّم أكثر الباحثين، فقد سبقه غيره على الطريق، وأقدم الأعمال الببليوغرافية التي ورد ذِكْرها آنفًا، هو ذلك الذي يُنْسَب إلى جابر بن حيان، وقد تُوفِّي جابر على رأس المائة الثالثة، ومعنى ذلك أن علم الببليوغرافيا عند العرب، تمتدّ جذوره إلى أواخر القرن الثاني الهجري، أي إلى ما قبل الفهرست بما يقرب من قرنين كاملين»[5]. أسباب ودوافع نسبة الكتاب إلى غير مُؤلّفه: تعدَّدت الأسباب التي أدَّت إلى وقوع الخطأ، في نسبة المُؤلَّفات لغير أصحابها؛ فقد يكون المخطوط لتلك الكتب والمؤلفات بلا عنوان، بسبب ضياع الورقة الأولى التي عليها العنوان، أو يكون هناك خرق في موضع العنوان بفعل الأرضة، أو يكون العنوان مطموسًا بسبب الرطوبة، أو بتلاعب النُّسَّاخ والتُّجَّار لحاجة في نفوسهم، وكل هذا ينتج عنه أن يأتي المخطوط وقد تَغيَّر عنوانه، إما جهلًا بعنوانه، أو تزييفًا لأهداف شخصية أو تجارية، أو بسبب اجتهاد خاطئ[6]. تحدث عن هذا أبو الأشبال، فقال: «فكثير ما طُبِعَت كُتُب ونُسِبَت إلى أكابر علماء الإسلام، وهم براء منها، إما غلطًا وإما قصدًا لتكون نافقة في البيع، أو لإدخال أشياء في دين الإسلام ليست منه، ولا يكون لقائلها من ثقة المسلمين به ما يُؤهِّله لقبول قوله عندهم، فيختبئ وراء اسم أحد الأئمة المقبولين عند المسلمين، وينحله كتابه، وذلك لما ضاق بالزنادقة الأمر، وحصرت أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في دواوين معروفة، وبُيِّن فيها الصحيح من غيره، فلم يتمكنوا من وضع الأحاديث عليه كما كانوا يفعلون في أول الإسلام قبل تدوين الحديث، ومفسدة هذه الكتب ظاهرة للعيان»[7]. وقد ذهب الأستاذ مصطفى جواد إلى أن ذلك يرجع إلى أمور أخرى، فقال: «إن فريقًا من المؤلفين على اختلاف تآليفهم، كانوا يُقصِّرون في إثبات أسمائهم في مؤلفاتهم، كأنهم كانوا يجهلون أن في التأليف حظوظًا وقسمًا كسائر شؤون الدنيا؛ فكانوا يكتفون بالاعتماد على تلامذتهم، في حفظ أسمائهم وإثباتها في تلك التآليف، أو يذكرونها في أول الكتاب أو في أثنائه، فإن ذهب أول الكتاب من كتبهم جُهِلَ اسم مؤلفه، وهذا الذهاب يكون على يد منافس لهم أو مُبغِض إياهم»[8]، ولعل هذا ما أدرَكه المؤرّخ المسعودي في القرن الرابع، حينما كرَّر اسمه في تآليفه، وأشار إليه في مواضع كثيرة[9]. الانتحال والسرقة الأدبية: ومن المصطلحات المتعلقة بنسبة المؤلفات لغير أصحابها، ما عُرِفَ قديمًا بانتحال الشِّعر ونَحْله، فيرى البعض أن النّحل: هو وضع قصيدة ما أو بيت أو أبيات وإسناد ذلك إلى غير قائله[10]، وهناك مَن يرى أن النحل مأخوذ مِن انتحله وتنحله، أي: ادّعاه لنفسه وهو لغيره[11]. وذهب أحد الباحثين إلى التفريق بين النحل والانتحال والوضع، وجعل لكل واحد منها معنًى، فقال: المراد بالوضع أن ينظم الرجل الشعر وينسبه إلى غيره لدواعٍ وأسباب، بينما الانتحال هو ادّعاء شِعْر الغير، فيما يُراد بالنحل أن ينسب الرجل شعر شاعر إلى شاعر آخر[12]. وهناك مَن جعل للانتحال معنًى واسعًا يشمل كل ما ذُكِرَ، فقال: «ويمكننا إيجاز مفهوم الانتحال بأنه نسبة الشعر لغير قائله، سواء أكان ذلك بنسبة شعر رجل إلى آخر، أم أنه يدّعي الرجل شعر غيره لنفسه، أم أن ينظم شعرًا وينسبه لشخص شاعر أو غير شاعر، سواء أكان ذلك له وجود تاريخي أم ليس له وجود تاريخي»[13]. والشعر عند العرب هو عمود الرواية، فقد كانت له منزلة كبيرة؛ لتعلُّقه بأنسابهم وأحسابهم وتاريخهم وما يجري، والشاعر موضع الثقة ومصدر رواية العرب، فلم يكن من سبب في جاهلية العرب، يجعلهم يضعون الشعر؛ «لأن شعراءهم متوافرون، ولأنهم لا يطلبون بالشعر إلا المحامد والمعاير، وقصارى ما يكون من ذلك أن يتزيد شاعرهم في المعنى ويكذب فيه، إذا هو حاول غرضًا أو أراغ معنًى مما تلك سبيله، وعلى أن ذلك لا يكون إلا في الأخبار التي تلحق بالتاريخ»[14]. فلما جاء الإسلام وانشغل العرب عن الشعر بالجهاد والفتوحات، وأخذ منهم السيف، فلما راجعوا روايته، ذهب كثير من الشعر وتاريخ الوقائع بذهاب رواته، ولهذا صنعت القبائل الأشعار، ونسبتها إلى غير أهلها تتكاثر بها وتعتاض، وكان هناك قوم آخرون، قلَّت وقائعهم وأشعارهم، وكانت العزة آنذاك للمكثرين، فسعوا في إلحاق الأذى بهؤلاء؛ فقالوا على ألسنتهم ما لم يقولوا، وأخذ عنهم الرواة[15]. وهناك مصطلح آخر متعلّق بالموضوع، وهو مصطلح السرقة العلمية، ويُرَاد به: «استخدام جزء/أجزاء من عمل شخص آخر، سواء أكان حرفيًّا، أو بإعادة صياغة الجزء/ الأجزاء المستخدَمة، من دون عزوها بطريقة علمية سليمة ومكتملة»[16]. أنواع نسبة الكتب إلى غير مُؤلّفيها: يمكن تصنيف هذه الدوافع إلى عدة أنواع، كالتالي: الأول: الوهم والخطأ: وهو ما يكون نتيجة للخطأ والوهم غير المقصود في نسبة المؤلفات، فيرى ابن النديم أن كتاب البستان منسوب إلى الفتح بن خاقان، وليس من مؤلفاته، بل هو من تأليف رجل يُعرَف بمحمد بن عبد ربه، ويُلقَّب برأس البغل[17]، وكذلك فإن كتاب إعراب القرآن المنسوب للزجاج، غلب على ظن محقّقه -وهو إبراهيم الإبياري-، أن الكتاب من تأليف مكي بن أبي طالب القيرواني[18]. كما أن كتاب الروضة الندية في شواهد علوم العربية منسوب لابن هشام الأنصاري، والحقيقة: أن الكتاب هو بعينه كتاب الاقتراح في أصول النحو للسيوطي[19]، وكذلك شرح ديوان المتنبي نُسِبَ إلى البقاء العكبري، وذهب الأستاذ مصطفى جواد إلى أنه من تأليف عفيف الدين علي بن عدلان الموصلي[20]. وهناك مَن نسب كتاب (تبيين معادن المعاني لمن إلى تبيينها دعاني إلى عبدالكريم بن محمد السمعاني المروزي، ولكن الصحيح أنه لمحمد بن أحمد الشافعي المشهور بولي الدين المولوي، ويقال له ابن المنفلوطي[21]. ومن الأخطاء والوهم في نسبة المؤلفات: أن يتعدد الاسم ولكنه في حقيقة الأمر لمُؤلّف واحد، فهناك شرح الأبيات المشكلة الإعراب من الشعر لأبي علي الفارسي النحوي، ذُكِرَ بأسماء وعناوين أخرى، مثل: أبيات الإعراب، كتاب الشعر، الشعر العضدي، ولكنها كلها ترجع إلى هذا الاسم الكامل (شرح الأبيات المشكلة الإعراب من الشعر[22]. الثاني: التباس الاسم وتشابهه: وهو على قسمين: ١ - ما كان من غير قصد. من الأمثلة على هذا النوع: الكتابان اللذان نُسِبَا إلى عبدالرحمن بن محمد ولي الدين المالكي الشهير بـ«ابن خلدون»، وهما: (تذكير الهوان بأسباب الكرامة والهوان)، و(مزيل الملام عن حكام الأنام)، وهما في الحقيقة لمحمد بن أحمد الشافعي المشهور بولي الدين المولوي، وربما أدَّى التشابه باللقب (ولي الدين) إلى هذا الوهم[23]. ٢ - ما كان بقصد وعمد. وهو ما يكون صادرًا مِن قِبَل الفِرَق المخالفة لأهل السنة والجماعة؛ حيث وقع هذا الالتباس لدى الشيعة الإمامية، وكانوا يَعدّون ذلك من جنس الخطأ البشري والوهم، وهو فِعْل غير مقصود من المؤلف، وربما كان بسبب خطأ النساخ، بينما يراه آخرون من العمد والقصد بغية تحقيق بعض المآرب. يُعدّ تفسير مجمع البيان لأبي علي الفضل الطبرسي، من أبرز المصادر التفسيرية الشيعية، وقد اقتبس كثيرًا من تفسير البيان للطوسي، وكانت له أهمية ومرجعية أكبر من كتاب الطوسي، ولكن مع هذه الأهمية[24] «اعتقد صالحي نجف آبادي أن الطبرسي قد وقع في التباس حقيقي في هذا الكتاب؛ أدَّى به إلى نسبته عددًا كبيرًا من النصوص للإمام محمد الباقر -عليه السلام-، والحال أنها لا ترجع إليه أصلًا. وتقوم نظرية نجف آبادي على أن الشيخ الطوسي في كتاب التبيان، نقل في مواضع كثيرة عن الطبري (310هـ) صاحب التفسير والتاريخ، وحيث كانت كُنْيَة محمد بن جرير الطبري أبا جعفر، فقد كان يُعبّر عنه بأبي جعفر، ولما جاء الطبرسي -معتمدًا على تفسير البيان- ليُؤلِّف كتابه مجمع البيان، حَسِب أن أبا جعفر فيه؛ هو الإمام أبو جعفر محمد بن علي الباقر -عليه السلام-، ربما أن النُّسَّاخ أضافوا كلمة -عليه السلام- بعد أبي جعفر؛ ظنًّا منهم أن الطوسي يريد به الباقر -عليه السلام-. وقد امتد هذا الوضع إلى ما بعد الطبرسي؛ حيث صارت تُنسَب الكثير من آراء الطبري المفسر إلى الإمام الباقر -عليه السلام-. وتقوم فكرة نجف آبادي على إجراء مقارنات بين كتب: التبيان، مجمع البيان، وتفسير الطبري، للتأكُّد من صحة ما يقوله هو، وقد قام فِعْلًا بذكر عشرين مثالًا؛ ليرصدها على مستوى هذه التفاسير، لكنَّه يؤكد بأننا لا نعرف كم مرة حصل مثل هذا الاشتباه من الطبرسي، من هنا ينصح نجف آبادي مُراجِعي تفسير مجمع البيان، عندما يواجهون نقلًا عن الباقر -عليه السلام- فيه، بمراجعة تفسير البيان، ثم التأكد -على تقدير وجود النقل عينه- من تفسير الطبري»[25]. أشار الدكتور ناصر القفاري إلى صنيع بعض الإمامية، حينما استغلوا التشابه في أسماء بعض أعلامهم مع بعض أعلام أهل السُّنة، وبيَّن مرادهم ومقصودهم من هذا، فقال: «إن الروافض استغلوا التشابه في أسماء بعض أعلامهم، مع بعض أعلام أهل السُّنة، وقاموا بدسّ فكري رخيص يُضلِّل الباحثين عن الحق... حيث ينظرون في أسماء المعتبرين عند أهل السُّنة، فمن وجدوه مُوافقًا لأحد منهم في الاسم واللقب، أسندوا حديث رواية ذلك الشيعي أو قوله إليه، ومن ذلك محمد بن جرير الطبري الإمام السني المشهور صاحب التفسير والتاريخ، فإنه يُوافقه في هذا الاسم محمد بن جرير بن رستم الطبري من شيوخهم، وكلاهما عاش في بغداد، وفي عصر واحد، بل كانت وفاتهما في سنة واحدة، وهي سنة 310هـ. وقد استغل الروافض هذا التشابه فنسبوا للإمام ابن جرير بعض ما يُؤيِّد مذهبهم، مثل: كتاب المسترشد في الإمامة، مع أنه لهذا الرافضي، وهم إلى اليوم يسندون بعض الأخبار التي تؤيد مذهبهم إلى ابن جرير الطبري الإمام، ولقد ألحق صنيع الروافض هذا -أيضًا- الأذى بالإمام الطبري في حياته، وقد أشار ابن كثير إلى أن بعض العوام اتهمه بالرفض، ومِن الجهلة مَن رماه بالإلحاد»[26]. قارن ابن حجر بين الطبريين؛ فقال: إن الإمام ابن جرير الطبري ضرّه الاشتراك مع الطبري الشيعي، في اسمه واسم أبيه ونسبته وكنيته ومعاصرته وكثرة تصانيفه، ولكنهما افترقا في اسم الجد؛ فإمامنا جده يزيد، والطبري الشيعي جده رستم[27]. كما كان هناك اسم آخر من الشيعة الإمامية قريب من اسم الإمام الطبري، وهو من رجال القرن السادس، يُسمَّى عماد الدين أبو جعفر محمد بن علي بن مسلم الطبري الآملي، ألَّف كتابًا بعنوان (بشارة المصطفى)، ولهذا التشابه في الاسم حصل الوهم، مما أدى إلى نسبة الكتاب للإمام ابن جرير الطبري[28]. وأشار أحمد أمين إلى أن الشيعة الإمامية استغلوا علم الحديث، وعمدوا إلى الأسانيد الصحيحة فوضعوا لها أحاديث وأخبارًا تُؤيِّد مذهبهم، واستغلوا التشابه في أسماء أعلامهم مع أعلام أهل السنة، بل تمادوا ووضعوا كُتبًا، ثم نسبوها لأئمة أهل السنة، فقال: «فاشتغل بعض علمائهم بعلم الحديث، وسمعوا الثقات، وحفظوا الأسانيد الصحيحة، ثم وضعوا بهذه الأسانيد أحاديث تتفق ومذهبهم، وأضلوا بهذه الأحاديث كثيرًا من القراء؛ لانخداعهم بالإسناد. بل كان منهم مَن سُمِّي بالسُّدي، ومنهم مَن سُمِّي بابن قتيبة، فكانوا يروون عن السُّدي وابن قتيبة، فيظن أهل السنة أنهما المُحدِّثان الشهيران، مع أنّ السُّدي وابن قتيبة اللَّذَيْن ينقل عنهما الشيعة هما رافضيان غاليان، وقد ميَّزوا بينهما بالسُّدي الكبير والسُّدي الصغير، والأول ثقة والثاني شيعي وضَّاع، وكذلك ابن قتيبة الشيعي، غير عبد الله بن مسلم بن قتيبة. بل وضعوا الكتب وحشوها بتعاليمهم ونسبوها لأئمة أهل السنة، ككتاب: سِرّ العارفين، الذي نسبوه للغزالي، ومن هذا القبيل ما نراه مبثوثًا في الكتب، من إسناد كلّ فَضْل وكل عِلْم إلى عليّ بن أبي طالب، إما مباشرةً وإما بواسطة ذُرّيته»[29]. وهناك قصة قد تكون ضمن هذا السياق، وهي متعلقة بصاحب كتابَي الإبانة الصغرى والكبرى، وهو ابن بطة العكبري، يقول محسن الأمين: «قال ابن أبي طي في تاريخه: ما زال الناس بحلب، لا يعرفون الفرق بين ابن بَطة الحنبلي، وابن بُطة الشيعي، حتى قدم الرشيد (يعني ابن شهر آشوب)، فقال: ابن بَطة الحنبلي بالفتح، والشيعي بالضم»[30]. الثالث: نسبة المُؤلف إلى اسم آخر أو اسم له غير مشتهر أو إخفاء اسمه. وحتى يمكن فهم هذا النوع لا بد من التمهيد بذِكْر حادثة وقعت في السيرة النبوية؛ إذ كانت قريش تُحذِّر من الاستماع للنبي صلى الله عليه وسلم ، فلما قدم الطفيل بن عمرو الدوسي مكة مشى إليه رجال من قريش، «وكان الطفيل رجلًا شريفًا شاعرًا لبيبًا، فقالوا له: يا طفيل، إنك قدمت بلادنا، وهذا الرجل الذي بين أظهرنا قد أعضل بنا، وقد فرَّق جماعتنا، وشتَّت أمرنا، وإنما قوله كالسحر يُفرِّق بين الرجل وبين أبيه، وبين الرجل وبين أخيه، وبين الرجل وبين زوجته، وإنا نخشى عليك وعلى قومك ما قد دخل علينا، فلا تُكلّمنه ولا تسمعن منه شيئًا. قال: فوالله ما زالوا بي حتى أجمعتُ ألَّا أسمع منه شيئًا ولا أُكلّمه، حتى حشوتُ في أذني حين غدوتُ إلى المسجد كرسفًا؛ خوفًا من أن يبلغني شيء من قوله، وأنا لا أريد أن أسمعه، قال: فغدوت إلى المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي عند الكعبة، قال: فقمتُ منه قريبًا، فأبَى الله إلا أن يُسمعني بعض قوله، قال: فسمعت كلامًا حسنًا. فقلت في نفسي: واثكل أمي! والله إني لَرجل لبيب شاعر ما يَخفى عليَّ الحَسَن من القبيح، فما يمنعني أن أسمع من هذا الرجل ما يقول؟ فإن كان الذي يأتي به حسنًا قَبِلته، وإن كان قبيحًا تركته. فمكثت حتى انصرف رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى بيته فاتبعته، حتى إذا دخل بيته دخلت عليه، فقلت: يا محمد، إن قومك قد قالوا لي كذا وكذا، للذي قالوا؛ فوالله ما برحوا يُخوّفونني أمرك حتى سددت أذني بكرسف؛ لئلا أسمع قولك، ثم أبى الله إلا أن يُسمعني قولك، فسمعته قولًا حسنًا، فاعْرِض عليَّ أمرك، قال: فعرض عليَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام، وتلا عليّ القرآن، فلا والله ما سمعت قولًا قط أحسن منه، ولا أمرًا أعدل منه؛ فأسلمت وشهدت شهادة الحق»[31]. لم يكن هذا النهج مقتصرًا على قريش وحدها، بل كانت هذه عادة كلّ مَن خالف الحق، فيعمد إلى تشويه سيرة العلماء والمصلحين، الذين يدعون الناس إلى التوحيد، ويُحذّرونهم من الخرافات والجهل والبدع، وهذه الاتهامات التي يُطلقها هؤلاء تَصُدّ الناس عنهم، فيتخذون من هؤلاء المصلحين موقفًا معاديًا، ويُحذِّرون غيرهم من الاستماع إليهم، وقراءة مُؤلّفاتهم، فيصبح في نظرهم كلّ مَن انتمى لدعوة هؤلاء المصلحين من أهل الضلال والزيغ والابتداع. لقد عمد علماء أهل السنة والجماعة إلى «الحكمة وبُعْد النظر في الدعوة، والبداءة بالمعاني والأحكام الشرعية، ونشر الهدى والحق، قبل الصراع حول الأسماء والشخصيات»[32]، وتجلَّى ذلك في بعض مواقفهم من مخالفيهم، والمناوئين للدعوات الإصلاحية، وهم يعمدون إلى إخفاء الاسم، أو عدم التصريح بالاسم المشهور للمؤلف؛ رغبةً في دعوة الناس إلى الحق، ومنع أيّ عارض قد يؤدي إلى نفورهم، فيردوا الحق بسببه. سافر الشيخ عبدالله القرعاوي إلى الهند، ودرس على بعض علمائها، فوقعت له حادثة مع «أحد شيوخه الذي كان يتلقى عليه العلم في إحدى مدارس الهند، فلا يمرُّ به ذِكْر الإمام محمد بن عبدالوهاب إلا صبَّ عليه سياط غضبه، ثم يختم ذلك بالتضرع إلى الله أن يُنقذ الإسلام والمسلمين من شرّ دعوته إلى يوم الدين... حتى يكاد يجعل من ذلك وِرْده الملزوم في أعقاب كل درس! يقول الشيخ القرعاوي: «ولم يكن معقولًا أن أواجه الرجل بأيّ اعتراض، على فكرة يمتلئ صدره وصدور سامعيه إيمانًا بها... لذلك عمدت إلى الحيلة، فأخذت كتاب التوحيد تأليف الإمام محمد بن عبدالوهاب، ونزعت عنه غلافه الذي يحمل اسمه، ثم تركته على منضدة الشيخ، دون أن يعلم مصدره... وشاء اللهُ أن يقرأ الشيخ ذلك الكتاب ويستوعبه بدقة، فراح يُبدي إعجابه ويسأل عن مؤلفه العظيم... حينئذ أعلنت له الواقع، فما كان من الرجل إلا أن قال: لقد ظلمنا هذا المصلح كثيرًا، ولا نجد كفارة لما أسلفنا، إلّا أن ندعو له بمقدار ما دعونا عليه!»[33]. كما قام الشيخ تقي الدين الهلالي بشيءٍ قريب مما فعله الشيخ القرعاوي، يقول الهلالي: «وضعت حاشية على كتاب (كشف الشبهات) لشيخ الإسلام (محمد بن عبدالوهاب) وطبعتها ونشرتها، ولكني استعملت في ذكر اسمه ما يُسمَّى في مصطلح الحديث بـ(تدليس الشيوخ)؛ وهو جائز، بل مُستحسَن إذا أُريد به الإصلاح، وذلك أن الشيخ يكون له اسمان؛ اشتهر بأحدهما، ولم يشتهر بالآخر، فيذكره الراوي عنه بالاسم الذي لم يُشتهر به؛ لمصلحة في ذلك... وقد سميت الشيخ محمد بن عبدالوهاب؛ (محمد بن سليمان الدرعي)؛ فنسبته إلى جده، ثم نسبته إلى الدرعية، وذلك حق؛ فهي بلدته ولكن لم يشتهر بذلك، وزاد الأمر غموضًا أن في (المغرب) كورة تسمى (درعة) والنسبة إليها درعي! فنجحت فيما قصدته من ترويج الكتاب، فقد طبعت (ألف نسخة) فبيعت في وقت قصير!! ولم يتفطن أحد لذلك!! حتى الشيخ أحمد بن الصديق الغماري مع سعة اطلاعه، وعلو همته في البحث، وكثرة ما في خزائنه من الكتب؛ بقي في حيرة؛ لأنه بحث في تاريخ المنسوبين إلى (درعة)، فلم يجد أحدًا منهم بذلك، ولا أثر عنه هذا الكتاب!! فبعث إليَّ يسألني عن هذا المؤلف!! من هو؟! فأخبرته بالحقيقة، ولمَّا اطلع العالم الأجلّ مفتي المملكة العربية السعودية، وشيخ شيوخها محمد بن إبراهيم آل الشيخ -رحمة الله عليه- على هذا العمل؛ استحسنه كل الاستحسان. وإنما فعلت ذلك؛ لأن المتأخرين من رجال الدولة العثمانية، حرَّضوا شرار العلماء في جميع البلاد الإسلامية، على تشويه سمعة الشيخ (محمد بن عبدالوهاب)، وكذبوا عليه، وأوهموا أتباعهم أنه جاء بدين جديد، وأنه يتنقص جانب النبي الكريم، ويُكفّر المسلمين! إلى غير ذلك من الأكاذيب. وقد تبيَّن لأكثر الناس بُطلان تلك الدعوى، وعلموا علم اليقين أن (محمد بن عبدالوهاب) من كبار المصلحين الذين فتح الله بدعوتهم عيونًا عُميًا، وآذانًا صُمًّا، وأنه أحيا العمل بكتاب الله وسنة رسوله في جزيرة العرب بعدما كاد يندثر»[34]. يواصل الهلالي الحديث عن هذا النهج الذي سلكه في دعوة الناس إلى العقيدة الصحيحة وتحذيرهم من البدع والخرافات؛ فقال: «ثم طبعتُ رسالة (زيارة القبور) مع حواشي قليلة لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية، وسميته: (أحمد بن عبد الحليم الحراني)، ولم أذكر لفظ (ابن تيمية)؛ للعلة سابقة الذِّكر؛ فراج الكتاب، وانتشر، ونفع الله به المسلمين. ولما بعثت مِن كلّ مِن الكتابين نسخة إلى الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ -رحمة الله عليه-؛ فرح بنشرهما، واستحسن الطريقة التي سلكتها؛ لبُعْد نظره ووفور عقله وحكمته»[35]. وفي هذا السياق يمكن الاستشهاد بما فعله الشيخ محمود الألوسي، في كتابه الشهير «غاية الأماني في الرد على النبهاني»، وهو كتاب جليل القدر في الرد على القبوريين، أكثَر فيه المؤلف من النقل عن علماء المسلمين مثل ابن تيمية وابن القيم وابن عبد الهادي ومحمد بن عبد الوهاب، حيث أدرج كتابه كشف الشبهات بكامله عدا شيء يسير، دون أن يُصرّح باسمه[36]، وذلك حين الرد على شُبَه أخرى للمُجوِّزين للاستغاثة وإبطالها؛ قال الألوسي: «وقد رأيت رسالة مختصرة صنَّفها العلامة أبو عبد الله الشيخ محمد -رحمه الله-، سمَّاها كشف الشبهات، أودعها نبذة من ذلك، وهي على اختصارها نافعة جدًّا لطالب الحق، فأحببتُ إيراد شيء منها؛ إتمامًا للفائدة»[37]. [1] الببليوغرافيا: مصطلح يوناني، كان معناه في أول الأمر كتابة الكتب، أي النساخة، ويقال للناسخ ببليوغرافي، ثم تطور مدلول هذه الكلمة في القرن التاسع عشر، فانتقل من كتابة الكتب إلى الكتابة عن الكتب، وهو يعني: إعداد سجل علمي يُعنَى بالإنتاج الفكري المكتوب سواء كان مخطوطًا أو مطبوعًا، وهو علم عرفه علماء المسلمين منذ القدم، وكان يُطلق على سرد تآليفهم أو تآليف غيرهم، الفهرست أو الثبت أو البرنامج. انظر: دراسات في علم المخطوطات والبحث الببليوغرافي، أحمد شوقي بنبين، (225-226)، أبجديات البحث في العلوم الشرعية، فريد الأنصاري، (ص66). [2] انظر: المخطوطات والتراث العربي، عبدالستار الحلوجي، (ص131). [3] مقدمة في أصول البحث العلمي وتحقيق التراث، رزق الطويل، (ص205). [4] المخطوطات والتراث العربي، عبدالستار الحلوجي، (134-135). [5] المخطوطات والتراث العربي، عبدالستار الحلوجي، (140-141). [6] انظر: مقدمة في أصول البحث العلمي وتحقيق التراث، رزق الطويل، (ص206). [7] الكتب المعزوة إلى غير مؤلفيها، أبو الأشبال، مجلة المنار، مجلد (19)، الجزء (1-2)، الصفحات (ص120). [8] شرح ديوان المتنبي لابن عدوان لا للعكبري، مصطفى جواد، مجلة المجتمع العلمي العربي بدمشق، العدد (22)، الجزء (1-2)، (ص40). [9] انظر: شرح ديوان المتنبي لابن عدوان لا للعكبري، مصطفى جواد، مجلة المجتمع العلمي العربي بدمشق، العدد (22)، الجزء (1-2)، الصفحات (40-41). [10] انظر: الشعر الجاهلي قضاياه وظواهره الفنية، كريم الوائلي، (ص49)، نقلًا عن في أدب ما قبل الإسلام، محمد عثمان علي، (ص75). [11] انظر: المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، جواد علي، (9/355). [12] انظر: الشعر الجاهلي قضاياه وظواهره الفنية، كريم الوائلي، (ص50)، نقلًا عن دراسات في الأدب الجاهلي، عبد العزيز نبوي، (ص89). [13] الشعر الجاهلي قضاياه وظواهره الفنية، كريم الوائلي، (ص50). [14] تاريخ آداب العرب، مصطفى صادق الرافعي، (1/277). [15] انظر: طبقات فحول الشعراء، محمد بن سلام الجمحي، (1/46)، تاريخ آداب العرب، مصطفى صادق الرافعي، (ص278). [16] وثيقة سياسات الاقتباس بجامعة الطائف، سعد المالكي وآخرون، (ص5)، انظر: البحث العلمي، عبدالعزيز الربيعة، (1/118). [17] انظر: الفهرست، ابن النديم، (169-170). [18] انظر: مقدمة في أصول البحث العلمي وتحقيق التراث، رزق الطويل، (ص204). [19] انظر: مقدمة في أصول البحث العلمي وتحقيق التراث، رزق الطويل، (ص206). [20] انظر: شرح ديوان المتنبي لابن عدوان لا للعكبري، مصطفى جواد، مجلة المجتمع العلمي العربي بدمشق، العدد (22)، الجزء (1-2)، الصفحات (43-47). [21] انظر: كتب نُسِبَت إلى غير مُؤلّفها، طه محمد فارس، (5-8، 16-20). [22] انظر: مقدمة في أصول البحث العلمي وتحقيق التراث، رزق الطويل، (ص207). [23] انظر: كتب نُسبت إلى غير مؤلفها، طه محمد فارس، (5-6، 21-31). [24] انظر: نظرية السنة في الفكر الإمامي الشيعي، حيدر حب الله، (589-590). [25] نظرية السنة في الفكر الإمامي الشيعي، حيدر حب الله، (ص590). [26] أصول مذهب الشيعة الإمامية، ناصر القفاري، (3/1443-1444)، وانظر: البداية والنهاية، ابن كثير، (12/59). [27] انظر: لسان الميزان، ابن حجر العسقلاني، (7/25-30)، الكنى والألقاب، عباس القمي، (1/241-243). [28] انظر: مقدمة تاريخ الطبري، (1/20)، الكنى والألقاب، عباس القمي، (2/443). [29] فجر الإسلام، أحمد أمين، (275-276). [30] أعيان الشيعة، محسن الأمين، (2/261)، وانظر: مقدمة كتاب معالم العلماء، محمد بن علي شهر آشوب، (ص4)، الكنى والألقاب، عباس القمي، (1/227). [31] السيرة النبوية، ابن هشام، (2/29). [32] الماجريات، إبراهيم السكران، (ص247). [33] علماء ومفكرون عرفتهم، محمد المجذوب، (1/108-109)، وانظر: مشاكل الدعوة بين الماضي والحاضر، المطبوع ضمن مجموع رسائل الجامي في العقيدة والسنة، محمد أمان الجامي، (ص237) [34] الدعوة إلى الله في أقطار مختلفة، تقي الدين الهلالي، (ص47). [35] الدعوة إلى الله في أقطار مختلفة، تقي الدين الهلالي، (ص48). [36] انظر: مقدمة كتاب صبّ العذاب على مَن سبّ الأصحاب، محمود الألوسي، (ص98). [37] غاية الأماني في الرد على النبهاني، محمود الألوسي، (1/379).
__________________
|
|
#2
|
||||
|
||||
|
الكُتب المعزوَّة إلى غير مُصنّفيها (2-2) د. عادل بن صالح أحمد الغامدي  سبق في العدد الماضي ذِكْر بعض الأسباب التي أدَّت إلى وقوع الخطأ في نسبة بعض المُؤلَّفات لغير أصحابها، ونكمل في هذا العدد، فنقول وبالله تعالى التوفيق: السبب الرابع: الخوف على النفس من الأذى بسبب انتشار مذهب بدعي أو يكون لبعض أهل البدع حظوة ومكانة لدى السلطان أو تسود طائفة حاكمة، ومن ذلك ما وقع لعبدالودود يوسف، وهو أحد علماء حمص، حينما ألَّف كتابًا مشهورًا عنوانه: (قادة الغرب يقولون: دمِّروا الإسلام أَبِيدُوا أهله)، وقد نشره باسم جلال عالم[1]. كما ألَّف الشيخ محمد المجذوب كتابًا سماه (الإسلام في مواجهة الباطنية)، ولكن طبعه باسم مستعار وهو (أبو الهيثم)، والذي دفَعه إلى ذلك أنه تحدَّث فيه عن النصيرية في سوريا، منذ وصولهم إلى الحكم في السبعينيات الميلادية، ومما يُميِّز بحثه أنه لم يعتمد على ما كتبه السابقون عن هذه الفِرْقة، بل استوفى حقيقتها من واقعها والتطورات التي طرأت عليها، وهي حصيلة جهد ربع قرن، استقى معلوماته عن النصيرية من مصادرها الحية؛ كالمخطوطات، وأفواه الشباب الذين تحرّروا من أغلال الأوهام، وآخرين يكتمون إيمانهم ويترقَّبون أجَل إعلانهم مفارقتهم لها[2]. وقد ذكَر مُحبّ الدين الخطيب أن الشيخ أمين الحلواني ألَّف كتابًا بعنوان: (السيول المغرقة على الصواعق المحرقة)، ردًّا على أحمد أسعد المدني، وهو من المنتمين إلى طريقة الشيخ أبي الهدى الصيادي[3]، ولم يُصرِّح باسمه، ولكن انتحل اسمًا مستعارًا وهو عبدالباسط المنوفي[4]. وهناك كتاب الخافي والبادي في فضائح الصيادي، كُتب باسم مستعار وهو نديم حويمل الكندي، وهو في الحقيقة لولي الدين يكن، الذي كان يُعدّ من أشد أعداء الصيادي؛ ونتيجة لهذه الرسالة نُفِيَ إلى الأناضول، وزُجَّ به في السجن من دون محاكمة، ثم نُفِيَ الى سيواس، واستمر ولي الدين يكن فيها منفيًا سبع سنوات، وظل حتى أعلن الدستور العثماني 1908م، وأفرج عن جميع السجناء والمنفيين[5]. ومن الطرائف أن الصيادي اشتهر بوضع الكتب ونسبتها لبعض المتقدمين، أو ينسبها لشخص لا حقيقة ولا وجود له؛ قال الشيخ محمد راغب الطباخ: «طبع عدة كتب ونسبها لبعض المتقدمين، ولشيخه الشيخ مهدي الرّواس الذي لا وجود له إلا في مخيلته»[6]، ومن ذلك كتاب غاية الاختصار في أخبار البيوتات العلية، الذي وضعه أبو الهدى الصيادي، ونسبه لتاج الدين بن محمد بن حمزة الحسيني نقيب حلب[7]، وأحيانًا ينتحل اسمًا ويضع له مُؤلِّفًا، قال الشيخ جمال الدين القاسمي: «والقرماني اسم بلا مسمى، انتحله الصيادي، وعزا له كتابًا كان لفَّقه على عادته، عليه ما يستحق في الافتراء والاختلاق»[8]. وتحدَّث محمود شكري الألوسي[9] في أحد كتبه، عمَّا نسبه الصيادي لأحمد الرفاعي من أنه ألَّف كتابًا بعنوان (البرهان المؤيد)، فقال: «ولكن الذي نسب هذا الكتاب إليه، دجال العصر شيخ الضلال منبع الكذب والافتراء، وكم له من مثل هذه المكايد والدسائس... وكم قد انتحل له كتابًا وافترى له دعاوى باطلة... ودجال العصر نسب إليه وإلى أصحابه كثيرًا من الكتب المشحونة بالكذب وقول الزور»[10]. كما أن كتاب (غاية الأماني في الرد على النبهاني)، هو في الحقيقة لمحمود شكري الألوسي، ولكنه طبع في سنة 1327هـ باسم غير صريح، هو أبو المعالي الحسيني السلامي الشافعي، لتجنُّب المناوئين لدعوته الإصلاحية، وتأليب دولة الخلافة العثمانية عليه، والاسم صحيح غير أنه لم يكن يشتهر به، فأبو المعالي كنيته، والسلامي نسبة إلى مدينته بغداد دار السلام. قال رشيد رضا في تقريظه لهذا الكتاب: «كتاب مُؤلّف من سفرين كبيرين، لأحد علماء العراق المكنى بأبي المعالي الحسيني السلامي الشافعي، ردّ فيهما ما جاء به النبهاني من الجهالات والنقول الكاذبة، والآراء السخيفة والدلائل المقلوبة، في جواز الاستغاثة بغير الله تعالى، وما تعدَّى به طَوْره من سبّ أئمة العلم وأنصار السُّنة، كشيخ الاسلام ابن تيمية»[11]. الخامس: الكذب والاختلاق تتعدد دوافع الكذب والاختلاق، في تأليف الكتب ونسبتها لغير مؤلفيها، فقد تكون عائدة لأهداف شخصية دنيوية صرفة، وقد يكون ذلك لتحقيق أهداف عقدية، بنشر باطل وترويجه أو تشويه بعض الدعوات الإصلاحية. ومن أشهر القدماء الذين اشتهروا بالسطو على مؤلفات الآخرين؛ متخذين ذلك مهنة لهم ومصدر كَسْب: يحيى بن أبي طي حميد الطائي أبو الفضل البخاري الحلبي[12]، قال عنه ابن حجر: «وتشاغل بالتصنيف فاتخذ رزقه منه، قال ياقوت: كان يدّعي العلم والأدب والفقه والأصول على مذهب الإمامية، وجعل التأليف حانوته، ومنه قُوته وكسبه، ولكنه كان يقطع الطريق على تصانيف الناس؛ بأخذ الكتاب الذي أتعب جامعه خاطره فيه؛ فينسخه كما هو، إلا أنه يُقدّم فيه ويُؤخِّر، ويزيد وينقص، ويكتب كتابة فائقة لمن يُشبّه عليه، ورُزِقَ من ذلك حظًّا»[13]. وهذا النوع يمكن تقسيمه إلى قسمين؛ قسم دنيوي أو أهداف شخصية، بينما الآخر هو قسم ديني متعلق ببعض الجوانب والأغراض العقدية. 1- الأهداف الشخصية: ونعني بها أن هناك كتبًا ومؤلفات نُسِبَت لغير مصنّفيها، ولا نعلم الغاية والهدف من هذا الفعل على وجه التحديد؛ إذ لم يتضح من خلال محتوى الكتاب، أن ذلك لترويج بدعة أو نشر مذهب، ولكن يظهر أن ذلك جاء ضمن الأغراض الدنيوية المتنوعة، ولهذا أطلقت عليه الأهداف الشخصية. ومن أمثلة ذلك: الكتابان المنسوبان إلى ابن سيرين وهما: تعبير الرؤيا ومنتخب الكلام في تفسير الأحلام؛ حيث يرى الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان، أنهما ليس من تأليفه على الرغم من شهرته وكثرة طبعاته. واستدل على ذلك ببعض الأمور، منها: أنه لم يذكر أحد من المؤلفين خلال القرون الثلاثة الأولى من الهجرة، أن ابن سيرين ألَّف كتابًا في أيّ عِلْم من العلوم، فضلًا عن التعبير، وكان ابن النديم صاحب الفهرست هو أول مَن نسب إليه كتاب تعبير الرؤيا، بعد أن سرد الكتب المُؤلَّفة في تعبير الرؤيا، ويُردّ على هذا أن ابن النديم كان وَرّاقًا، وهمّه سرد أسماء الكتب المؤلفين لا أن يُحقّق ويُدقّق. كما أن إلقاء نظرة عابرة على كتاب تعبير المنام، المتداول في أيدي الناس منسوبًا إلى ابن سيرين، تُوضّح أن روح التأليف وشواهد المؤلف ونسَقه وتعبيره، لا تنتمي للقرن الأول الهجري؛ أي عصر ابن سيرين[14]. وكذلك فإن بعض العلماء والمحققين والمستشرقين، كانت عباراتهم تدل على التشكيك في صحة نسبة هذه المؤلفات لابن سيرين، فنجد أن ابن خلدون يتحدث في مقدمته عن عِلْم تعبير الرؤيا، ثم يختم بقوله: «ولم يزل هذا العلم متناقلًا بين السلف، وكان محمد بن سيرين فيه من أشهر العلماء، وكُتبت عنه في ذلك قوانين، وتناقلها الناس لهذا العهد، وألَّف الكرماني فيه من بعده»[15]. وأما فؤاد سزكين فيقول: «وكان ابن سيرين حجة في تفسير الأحلام، غير أننا لا نعلم ما إذا كان قد ألَّف في تفسير الأحلام رسالة أو رسائل، أم لا»[16]. وأما المستشرق كارل بروكلمان فيذكر بعض مؤلفات الإمام ابن سيرين، ويقول: «نُسِبَ له كتاب في تعبير الأحلام، بعنوان (الجامع)، ثم يقول: ويُنْسَب له (منتخب الكلام في تفسير الأحلام)، ويذكر أن المؤلف المسمى (تعبير الرؤيا) هو اختصار له، ثم يقول أيضًا: ويُنسَب إليه كتاب (الإشارة في علم العبارة أو الإشارات في تفسير المنامات)»[17]. وهناك كتاب (تنبيه الملوك والمكايد) المنسوب إلى الجاحظ، وهذا الكتاب زَيْف لا ريب فيه؛ إذ حُشِدَت فيه أخبار تالية لعصر المؤلّف، وتجد في أبوابه باب (نكت من مكايد كافور الإخشيدي) و(مكيدة توزون بالمتقي لله)، وقد تُوفِّي الجاحظ قبلهما بعشرات السنين، وأعجب من ذلك مقدمته التي لا يصح أن تنتمي إلى قلم الجاحظ[18]. كما ذكر الشيخ أحمد شاكر أن من الكتب المنسوبة قصدًا للنفاق، كتابًا يسمى (الفوائد المشوقة إلى علوم القرآن وعلم البيان)، ونسب إلى الإمام ابن القيم، فقال عنه: «وهو كتاب لا بأس به، فيه فوائد أدبية ونكت بلاغية، فصيح العبارة، ويظهر أن مؤلّفه كان من الكتاب المنشئين لا العلماء المحققين، أمثال إمامنا ابن القيم، فإن في بعض المسائل تحقيقات واختيارات سخيفة»[19]. 2-الأهداف العقدية: ومن الكتب الدخيلة التي وُضِعَت قصدًا: كتاب سرّ العالمين؛ حيث يقول عنه أبو الأشبال: ألَّفه أحد الزنادقة من الفِرَق الباطنية، ونحَله حجة الإسلام أبا حامد الغزالي، فأدخَل فيه كثيرًا من عقائد الباطنية، التي كان الغزالي من أكثر العلماء عداءً لمعتقديها والرد عليهم، كما أدخَل فيه كثيرًا من علوم السحر، ومما استدل عليه بأن الكتاب منحول على الغزالي، تلك العبارة التي ذكرت فيه وفضحت مؤلفه، حينما قال: «أنشدني المعري لنفسه وأنا شابّ»، وهذا كذب فاضح؛ فالمعري توفي قبل أن يُولَد الغزالي بسنوات[20]. كما نُسِبَ إلى الإمام ابن قتيبة الدينوري، كتاب الإمامة والسياسة، والكتاب ليس من مؤلفاته، وقد شُحِنَ بالقدح العظيم بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يقول الدكتور علي العلياني: «وبعد قراءتي لكتاب الإمامة والسياسة قراءة فاحصة؛ ترجَّح عندي أن مُؤلّف الإمامة والسياسة رافضي خبيث، أراد إدماج هذا الكتاب في كتب ابن قتيبة؛ نظرًا لكثرتها، ونظرًا لكونه معروفًا عند الناس بانتصاره لأهل الحديث. وقد يكون من رافضة المغرب؛ فإن ابن قتيبة له سُمعة حسنة في المغرب، بل إن أهل المغرب يُغلون فيه؛ حتى إنهم قالوا: مَن ليس في بيته شيء من تصانيف ابن قتيبة فلا خير فيه. ومن يطعن في ابن قتيبة عندهم يتَّهمونه بالزندقة، فاستغل أحد الروافض اسم ابن قتيبة اللامع في تلك المنطقة، ووضع عليه تخريفاته لتَروج عند مَن لا علم له»[21]. ومن الكتب التي اشتهرت في الإساءة إلى دعوة الإمام المجدد محمد بن عبدالوهاب، كتاب بعنوان (مذكرات مستر همفر)، وهو كتاب يُنسَب لكاتب إنجليزي وصف بأنه جاسوس بريطاني، وترجمه للعربية شخص مجهول رمز له (ح.خ)، وكان محور الكتاب يدور حول أن الإمام المجدد محمد بن عبدالوهاب -رحمه الله- صنيعة الاستعمار البريطاني. ولكن الأستاذ أحمد الكاتب يرى أن هذا الكتاب ألَّفه محمد بن مهدي الشيرازي، الذي تنتسب له المدرسة الشيرازية الإمامية الإثني عشرية[22]؛ وحيث إن الكاتب كان من تلاميذ الشيرازي سابقًا، فهو يحدثنا عن مبررات هذا الرأي، ويقول: إنه بحث في بريطانيا عن هذا الكاتب المزعوم، فلم يعثر على اسم (همفر)، والموجود هو اسم (هنفر)، كما أن الكاتب غير معروف وهو مجهول العين والحال، ولا تُعرف اسم دار النشر ولا المطبعة التي طبعت الكتاب، كما أنه مطبوع في إيران، ثم إنه قرأ الكتاب في لبنان سنة 1976م؛ فوجد أن أفكار الشيرازي متمحورة في الكتاب، ثم زار الشيرازي في الكويت قبيل الثورة الإيرانية، وقال للشيرازي: مبروك الكتاب الجديد -يقصد مذكرات همفر-؛ فتبسم الشيرازي ولم يُجِب بنفي أو إثبات، ثم بعد الثورة الإيرانية انتقل أحمد الكاتب إلى إيران؛ فوجد نُسخًا كثيرة لهذا الكتاب في بيت صهر الشيرازي، وهذا كله يراه من الشواهد والقرائن التي تثبت أن هذا الكتاب من تأليف محمد الشيرازي[23]، ثم إن عادل اللباد وهو من المنتمين للتيار الشيرازي، يقول: إنهم زاروا الشيرازي فوزع عليهم مؤلفاته ومذكرات مستر همفر[24]. وحتى لو لم تصح نسبته للشيرازي، فإن الكتاب مُختلَق، والكاتب شخصية غير حقيقية ولا أثر لها، كما أن هناك مَن طعن في مضمون صحة ما في الكتاب وأثبت تناقضاته[25]. السادس: الأسماء المستعارة اشتهرت ظاهرة الأسماء المستعارة لدى الكُتّاب، وقد يتخذ أحدهم اسمًا مستعارًا فيكون كاللقب له أو مثل التوقيع، كما قد يتخذ الكاتب أكثر من اسم مستعار، فعلى سبيل المثال كان الشاعر إلياس أبو شبكة، له أكثر من خمسة أسماء مستعارة، كما كان لمنير الحسامي وهو أحد الكتاب اللبنانيين 15 اسمًا مستعارًا، ولعل أكثر الكتاب العرب استعمالًا للأسماء المستعارة، كان الأديب المشهور أنستاس ماري الكرملي، فقد أوصلها المحقق كوركيس عواد إلى 39 اسمًا مستعارًا[26]. كان المستشرق الفرنسي جان أرتوركي، من أعضاء المجمع العلمي العربي، وعُيِّن مترجمًا لبعض القنصليات في دمشق وطرابلس الغرب، ثم قنصلًا في طرابلس الغرب وإزمير وزنجبار، كما عمل في تحرير دائرة المعارف، ونشر بالعربية كتاب الأشربة لابن قتيبة، وله مقالات باللغة العربية كان يُذيلها باسم مستعار، وهو (الشيخ يحيى الدبقي)[27]. وصموئيل بن أنطونيوس بن جرجس ينّي، من أهل طرابلس الشام، وُلِدَ وتُوفِّي فيها، له كتابات في مجلات المقتطف والهلال والجامعة والمباحث، كما ترجم للعربية كتابًا عن اللغة الفرنسية بعنوان (التمدن الحديث)، وجعل له اسمًا مستعارًا (الكاتب المحجوب)[28]. كما كان هناك عدد من المستشرقين الذين تخفوا خلف ألقاب وتواقيع، ومنها: الشيخ عبدالولي وهو لقب للمستشرق الفنلندي جورج أوغست والين، والشيخ محمد الطويل وهو توقيع للمستشرق بيتر شولتز، زوج المستشرقة الألمانية زيغريد هونكه، والشيخ بركات وهو لقب للمستشرق والرحالة السويسري أوهان لودمنيغ، والشيخ بعيث الخضري، وهو اسم مستعار للأب أنستاس ماري الكرملي[29]. أسباب ودوافع الأسماء المستعارة يرى يوسف داغر أن الأسباب التي دعت الأدباء والكتاب المحدثين، إلى التستر وراء هذه الأسماء المستعارة، تختلف عن تلك التي اعتصم بها الأدباء والشعراء القدامى، فقد يكون الباعث لدى الكاتب للتستر خلف تلك الأسماء المستعارة، مصلحة مادية صِرْفة، وقد يعمد الكاتب إلى التستر باسم مستعار بسبب الحشمة والأدب، أو بدافع الظلم والحقد، أو تماشيًا مع الزّيّ أو العُرْف السائد. وقد يكون الداعي إلى ذلك طبيعة المركز الاجتماعي، والمكانة والوجاهة والمنزلة المرموقة، فيكون من الوجهاء أو رجال القضاء، أو يكون سيدًا في قومه، فيتحرّر من الاسم، حتى يكون أدعى في التعبير عما يجول في خاطره من آراء وأفكار، أو قد يأنف النزول إلى مصافّ الكَتَبة وزُمْرة الروائيين، فيتنكر باسم مستعار؛ إذ مهنة الكتابة حرفة ينظر إليها القوم بإشفاق، وأحيانًا يكتب المقال في الجريدة أو المجلة ولا يُذيَّل باسم أو توقيع، اعتمادًا على البداهة التلقائية لدى القارئ، فيعرف أن هذه المقالات تُكتَب بقلم رئيس التحرير[30]. من تاريخ الأسماء المستعارة: ذكر أحمد أمين في كتابه الشهير فيض الخاطر، لونًا طريفًا له تاريخ لطيف، وكان هذا الحدث من سنة 1857م إلى سنة 1863م، فقد كان في القاهرة شابان موسران، وهما أديبان طريفان يقرآن كثيرًا من كتب الأدب، ولهما معرفة دقيقة بالشعراء، هما إبراهيم أفندي طاهر، وعبدالحميد بك نافع، فخطر لهما أن يستعرضا الأدباء والعلماء في عصرهما، ويجعلا لكل واحد منهم لقبًا يناسبه ويوافق حاله من ألقاب الأدباء القدامى. و«كان في القاهرة علي أغا الترجمان، وكان عينًا من الأعيان، فيه جلال ووقار، بعمامة نظيفة وشيبة طريفة فسمياه القاضي الفاضل، وكان عبدالله باشا فكري، أديبًا طريفًا رقيق اللفظ عذب العبارة، سهلًا في طباعه، يرسل الحديث على سجيته، والنكتة على فطرته، فسمياه ابن سهل، وكان له صديق اسمه عبد الغني بك فكري، ضخم كبير الرأس فسمياه الأخطل. وعرض عليهما محمود صفوت الساعاتي، الشاعر المشهور، وكان نحيفًا قصيرًا كثير اللفتات، فسمياه ديك الجن... وكان الشيخ إبراهيم الدسوقي، الأديب المصحح في مطبعة بولاق، طويل القامة قوي البنية، كبير الهامة كثير الفكاهة حلو السمر... وله ضحكة عالية تُسمع من آخر الشارع، فسمياه مهيار الديلمي، والشيخ محمد قطة العدوي، أحد علماء الأزهر، وكبير مصحّحي المطبعة الأميرية، كان إذا درس تمايل يمينًا وشمالًا... فسمياه أبو شادوف. والسيد علي أبو النصر والشيخ علي الليثي، كانا نديمي الخديوي إسماعيل، وكانا معروفين بالطرف والتنادر، كان أبو النصر طويلًا جدًّا فسمياه ابن العماد، وسمّيا الشيخ علي الليثي أبا دلامة؛ إذ كان فَكِهًا مُضْحِكًا كما كان أبو دلامة للرشيد، وكان إبراهيم مرزوق أبِيّ النفس، شجاعًا جريئًا في قول الحق، حتى نُفِيَ إلى الخرطوم ومات بها، وكان شاعرًا قويًّا فسمياه أبا فراس، ومحمود سامي البارودي، كان أيام هذه التسمية جميل المنظر، لطيف القدّ، فسمياه ابن رشيق... والشيخ حسين المرصفي، كان كفيفًا نحيفًا يُتَّهم بالزندقة، فلقَّباه أبا العلاء المعري، ونسيبه الشيخ زين المرصفي، كان قليل الكلام، فسمّياه ابن السكيت... ولما فرغا من منح الألقاب، طلب كل واحد منهما من صاحبه أن يُلقِّبه، فلقب إبراهيم أفندي طاهر بالشاب الظريف، وعبدالحميد بك نافع بالصاحب ابن عباد»[31]. الخاتمة: وبعد، فهذا الموضوع من الموضوعات المشوّقة، وله جوانب متعددة، ويحتوي على فوائد وطرائف، وفي ظني أنه جدير بأن يكون عنوانًا لإحدى الرسائل العلمية في الماجستير أو الدكتوراه، أسأل الله أن يُقيِّض له مَن يكتب فيه، ويُثري الساحة الثقافية بهذا الموضوع. [1] انظر: أسماء المستعارة، عبدالحكيم أنيس، موقع الألوكة، على الرابط: https://www.alukah.net/culture/0/103554 ، نقلًا عن علماء دمشق وأعيانها في القرن الخامس عشر الهجري، نزار أباظة، (ص76). [2] انظر: الإسلام في مواجهة الباطنية، محمد المجذوب، (5-6). [3] أبو الهدى محمد بن حسن الصيادي، من كبار دعاة الطرق الصوفية وهي الطريقة الرفاعية، كان من أحظى ندماء الخليفة العثماني السلطان عبد الحميد الثاني وأخص جلسائه، وكان له من سعة النفوذ ومضاء الكلمة والجاه العريض الذي لم يحصله غيره، توفي سنة 1327ه. انظر: جناية الصيادي على التاريخ، عبد الرحمن الشايع، (6، 11). [4] انظر: مقدمة مختصر مطالع السعود بطيب أخبار الوالي داوود، عثمان بن سند الوائلي، (ص «كب»). [5] انظر: ديوان ولي الدين، (6-7)، الموسوعة العربية، على الرابط: https://arab-ency.com.sy/details/13896 [6] إعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء، محمد راغب الطباخ، (7/331). [7] معجم المطبوعات العربية والمعربة، يوسف سركيس، الاستدراك آخر المجلد الثاني، (2-3). [8] الرسائل المتبادلة بين القاسمي والألوسي، (ص102). [9] في عام 1307ه وحينما كان الشيخ في عمر الثلاثين، فاز بجائزة (أسكار الثاني)، ملك دولة السويد والنرويج، حينما أعلن عن جائزة لمن يكتب مؤلفًا عن تاريخ العرب قبل الإسلام، وكان عنوان كتابه (بلوغ الأرب في أحوال العرب). انظر: محمود شكري الألوسي وآراؤه اللغوية، محمد بهجت الأثري، (62-73). [10] غاية الأماني في الرد على النبهاني، محمود الألوسي، (2/341-342). [11] مجلة المنار، (12/785). [12] انظر: كتب حذر منها العلماء، مشهور آل سلمان، (2/375). [13] انظر: لسان الميزان، ابن حجر العسقلاني، (6/263). [14] انظر: كتب حذر منها العلماء، مشهور آل سلمان، (2/275-283). [15] مقدمة ابن خلدون، (ص441). [16] تاريخ التراث العربي، فؤاد سزكين، (4/97). [17] انظر: تاريخ الأدب العربي، كارل بروكلمان، (1/225-226). [18] انظر: تحقيق النصوص ونشرها، عبدالسلام هارون، (ص46). [19] الكتب المعزوة إلى غبر مؤلفيها، أبو الأشبال، مجلة المنار، مجلد (19)، الجزء (1-2)، الصفحات (ص121). [20] الكتب المعزوة إلى غبر مؤلفيها، أبو الأشبال، مجلة المنار، مجلد (19)، الجزء (1-2)، الصفحات (ص120). [21] عقيدة الإمام ابن قتيبة، عليّ العلياني، (ص90)، يقول العلياني: إن الأستاذ عبدالله عسيلان أثبت بطلان نسبة الكتاب لابن قتيبة من اثني عشر وجهًا، وذلك من خلال مقال كتبه في مجلة كلية اللغة العربية بالرياض، لخَّصها في كتابه، انظر المرجع السابق، (ص88)، كما جزم ببطلان هذه النسبة كثير من المؤلفين والمحققين، مثل: محب الدين الخطيب، وثروت عكاشة، وعبدالحليم عويس، وسيدة إسماعيل الكاشف، وأحمد صقر، انظر: كتب حذر منها العلماء، مشهور حسن آل سلمان، (2/298-301). [22] للاستزادة حول هذه المدرسة أو التيار الشيرازي، يُراجَع كتابي: (الشيرازية الإمامية: عرضًا ونقدًا). [23] من هو مؤلف (مذكرات مستر همفر)؟، أحمد الكاتب، على الرابط: https://www.youtube.com/watch?v=igfQxcC2vYc. [24] انظر: الانقلاب، عادل اللباد، (ص172). [25] انظر: مذكرات (همفر) في الميزان، مالك بن حسين، مجلة الراصد، على الرابط: https://www.alrased.net/main/articles.aspx?selected_article_no =5597. [26] انظر: معجم الأسماء المستعارة وأصحابها، يوسف داغر، (14-15). [27] انظر: الأعلام، الزركلي، (2/107)، معجم الأدباء، كامل الجبوري، (2/10). [28] انظر: الأعلام، الزركلي، (3/209). [29] انظر: معجم الأسماء المستعارة وأصحابها، يوسف أسعد داغر، (174-175). [30] انظر: معجم الأسماء المستعارة وأصحابها، يوسف داغر، (19-21). [31] فيض الخاطر، أحمد أمين، (6/231-233).
__________________
|
 |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
| أدوات الموضوع | |
| انواع عرض الموضوع | |
|
|
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |