
24-07-2024, 05:53 PM
|
 |
قلم ذهبي مميز
|
|
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس : 
المشاركات: 169,805
الدولة : 
|
|
 رد: تاريخ النقابات المهنية في الحضارة الإسلامية
رد: تاريخ النقابات المهنية في الحضارة الإسلامية
تاريخ النقابات المهنية في الحضارة الإسلامية
مختار خَواجَة
تميّز مؤسسي
وبدءا من أواخر القرن نفسه؛ تصادفنا الجهود التي بذلها الخليفة العباسي المعتضد بالله (ت 278هـ/891م) لتطوير التعليم الحِرَفي والمعرفي، في مشروع لم يُكتَب له الإنجاز؛ إذْ يروي قُدَامة بن جعفر (ت 337هـ/948م) -في كتابه ‘الخراج وصناعة الكتابة‘- أن المعتضد بالله أراد أن يبني “دُورا ومساكن ومقاصير يرتّب في كلّ موضع منها رؤساء كلّ صناعة ومذهب، من كلّ مذاهب العلوم النظريّة والعملية، ويجري عليه الأرزاق السنيّة، ليقصد كلّ من اختار علما أو صناعة رئيس ما يختاره فيأخذ عنه”!!
أما في منطقة الغرب الإسلامي؛ فقد عرفت الأندلس مبكرا تقاليد النقابات المهنية، فاشتهرت فيها وظيفة “عريف البنائين” التي توازي نقابة المهندسين وظلت معروفة إلى نهايات القرن السادس الهجري/الـ12م على الأقل.
ففي دولة الموحِّدين يحدثنا مؤرخها عبد الملك ابن صاحب الصلاة (ت 594هـ/1198م) -في كتابه ‘المَنُّ بالإمامة‘- عن بناء جامع إشبيلية سنة 555هـ/1160م، وأنه حضره “شيخ العرفاء أحمد بن باسة (ت بعد 555هـ/1160م) وأصحابه العرفاء البناؤون من أهل إشبيلية، ومعهم عرفاء البنائين من أهل حضرة مراكش ومدينة فاس”.
ومن تجليات عراقة العمل النقابي في تونس وتميزه مؤسسيا حتى اليوم؛ أنه كان يوجد فيها منذ القرن التاسع الهجري/الـ15م -على الأقل- منصب “أمين الأمناء” الذي يوازي اليوم وظيفة الأمين العام لأحد الاتحادات المهنية، وكانت السلطات تعترف به ممثلا لفروع نقابته أمام دوائرها الرسمية.
فقد ذكر الحافظ السخاوي -في ‘الضوء اللامع‘- أن المحدّث الفقيه محمد بن محمد ابن عزوز التونسي (ت 873هـ/1468م) تولى نقابة التجار فـ”كان أمين الأمناء بتونس، بمعنى أن التجار ونحوهم يتحاكمون إليه في العرفيات فيقضي بينهم ولو بالحبس والضرب”.
ومن العجيب أن رئاسة المهن لم تقتصر على الصنائع الفنية الدقيقة، بل تسرّب تقليدُها مبكرا إلى مختلف أنواع النقابات العمالية، بما فيها تلك التي تُسمَّى “المهن الهامشية” في المدن؛ ويبدو أن ذلك جاء لتلبية الحاجة الاجتماعية للجماعة المهمشة، بما يوفر لها مجموعة من الضمانات المختلفة، أو يُكسبها نوعا من الانتماء النفسي والتدريب العملي.
فقد كان للكنّاسين ببغداد عريف يذكره الجاحظ (ت 255هـ/869م) -في كتابه ‘الحيوان‘- حين يخبرنا بأن اسمه “نوفل عريف الكناسين، وعنده كل كنَّاس بالكرخ” غربي بغداد. كما كان لجماعات المتسوِّلين عريف؛ إذْ يروي التَّنُوخي -في ‘نشوار المحاضرة‘- أنه كان لمتسوِّلي بغداد “شيخ لهم أيسر (= تموَّل) وعظمت حالته حتى استغنى عن الشحذ (= التسول)، فكان يعلمهم ما يعملون” في “حرفتهم”.
كما عرف المغرب الأقصى نقابة العمال عبر تخصيص نقابات لعدد من تلك الفئات الحرفية “الهامشية”، منها فئة الحمّالين الذين كانت لهم أوضاع تنظيمية خاصة سنتطرق لها لاحقا. وقد بلغ عددهم مثلا في بعض مدن المغرب 300 حمّالا ما بين القرنيْن العاشر والـ14 الهجري/الـ16 والـ20م، كما سيرِد أنه كانت في مصر نقابة للحمّالين منذ العهد المملوكي على الأقل.
ولئن كان المجال لا يتسع لاستعراض المعطيات التاريخية التي يمكن للباحث الظفر بها عن النقابات المهنية في مصادرنا التراثية؛ فإنه لا يسعنا إلا أن نثبت عناوين ذات دلالة كبيرة على تجذّر وتنوع هذه الظاهرة الحضارية في تاريخنا، وكلها تتعلق بنماذج نقابية لم نتعرض لبسط القول فيه هنا.
ومن ذلك أسماء نقباء المهن التالية: “شيخ الصيارفة”، “رئيس القبّانية”، “شيخ الدباغين”، “عريف الصاغة”، “عريف الكناسين/شيخ الكناسين”، “شيخ الوقّادين”، “رئيس النخاسين”، “أمين الصيادلة” (نقيب الصيادلة)، “رئيس الأطباء بالديار المصريّة والبلاد الشاميّة”، “رئيس صناعة تربية الدجاج والأوز”، “نقابة ربابنة القرصان”، “نقابة الصابئة”.
وللطرافة أيضا؛ فإن الطفيليين أسسوا “نقابة” في القرن الثالث الهجري/التاسع الميلادي، فكان مركزها الأول في البصرة وتولاها “عريف للطفيليين [كان] يبرُّهم (= يتعهدهم) ويكسوهم، ويرشدهم إلى الأعمال ويقاسمهم” الأموال التي يجمعونها؛ طبقا للإمام الخطيب البغدادي (ت 463هـ/1071م) في كتابه ‘التطفيل وأخبار الطفيليين‘، والذي يفيدنا بأنه كان عريفهم في بغداد “بنان الطفيلي” (ت نحو 253هـ/867م).
تنظيم محكم
باستثناء نصوص متفرقة -في كتب الحِسْبة والتراجم والتاريخ- تطرقت لصلاحيات النقيب المهني وعلاقته بمنتسبي صناعته، أو تلك التي تعرضت لتاريخ جماعات الفتوّة من كتب أرَّخت لها أو مدونات رحلات احتكّ أصحابها بتلك الجماعات؛ فإننا لا نكاد نجد مؤلفات ذات بال تكشف لنا تفاصيل حياة التنظيمات الحرفية وهيكلتها الداخلية، وإضافة لذلك “ترجع أكثرُ الوثائق وكلُّ الأخبار -التي لدينا عن النظام الداخلي للأصناف (= النقابات)- إلى الفترة التي تلت العهد المغولي”؛ طبقا لبرنارد لويس في مقالاته عن النقابات الإسلامية.
وبناء على المعطيات التاريخية المتوفرة؛ يمكن القول بأن الجماعات المهنية والحِرَفية اعتمدت تراتبية تنظيمية داخلها منذ وقت قديم؛ فكان “الأستاذ” في الصنائعيين يقابل ما يُعْرف اليوم في أعرافهم بـ”المعلّم”، وكانت أجرته في الأعمال الكبيرة تختلف عن أجرة الأقل مهارة أو من يعملون تحت يده؛ وفقا لما يخبرنا به الخطيب البغدادي في حديثه عن بناء بغداد.
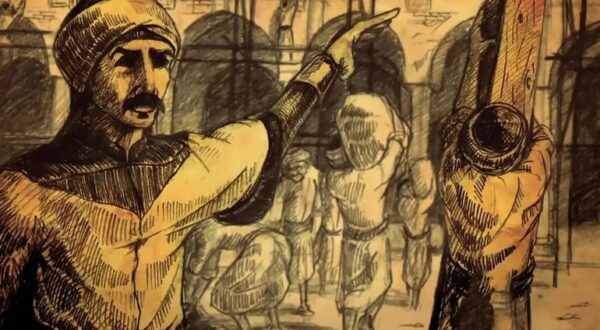 ويبدو أنه منذ القرن السادس الهجري/الـ12م استُعمل لقب “الأستاذ” للحديث عن المتميز في الحِرف اليدوية كالنجارة، حسبما يُفهم من قول الذهبي في ترجمته لمؤيد الدين محمد بن عبد الكريم الحارثي (ت 599هـ/1203م) إنه “كان ذكيا أستاذا في نجارة الدق”.
ويبدو أنه منذ القرن السادس الهجري/الـ12م استُعمل لقب “الأستاذ” للحديث عن المتميز في الحِرف اليدوية كالنجارة، حسبما يُفهم من قول الذهبي في ترجمته لمؤيد الدين محمد بن عبد الكريم الحارثي (ت 599هـ/1203م) إنه “كان ذكيا أستاذا في نجارة الدق”.
وقد بدأ الانتماء إلى “المعلم” في المهنة يأخذ طابعا هاما منذ القرن السابع الهجري/الـ13م على الأقل؛ إذ يذكره ابن المعمار البغدادي الحنبلي (ت 642هـ/1244م) -في كتابه ‘الفتوة‘- مضيفا إياه إلى لبس الخِرْقة وشدّ الفتيان، وناسبا إليه “شد الثقاف” الذي يعرّفه بأنه “انتساب في الصناعة لمن انتسب إليه” ممارسُها.
وقد ظهرت طقوس غريبة في مجال الفتوة كشرب دم الحليفين فيها، ولذا نص على تحريم تلك الممارسات ابنُ المعمار الحنبلي، وكذا شيخ الإسلام ابن تيمية (ت 728هـ/1328م) -في ‘مجموع الفتاوى‘- بقوله إن “شَدَّ الوسط لشخص معين للانتساب إليه.. من بِدَع الجاهلية”.
وفي عصر لاحق على ذلك؛ عرفت النقابات المهنية في دمشق استحداث هيئة “شيوخ المشايخ” التي هي أقرب إلى “اتحاد نقابات” مهني، وكانت تتقلُّد مهام عديدة من بينها محاكمة المخالفين للنُّظُم المهنية المعتادة. ولعل استحداثها كان أحد مظاهر تأثر تلك النقابات بالتقاليد الصوفية التي كان منها منصب “شيخ الشيوخ” الذي تنضوي تحته زعامته الدينية أغلبية الطرق الصوفية.
وذكر الرحالة ابن بطوطة (ت 779هـ/1377م) أنه في أصفهان كان مقدَّم كل صناعة يسمى “الكلو”؛ فيقول واصفا دقة تنظيمهم ومقارنا بينهم وبين نقابات “الفتيان الأخية” بالأناضول في خدماتهم الاجتماعية: “وأهل كل صناعة يقدّمون على أنفسهم كبيرا منهم يسمونه «الكلو»…، وتكون [فيهم] الجماعة من الشبّان الأعزاب (= العُزّاب)، وتتفاخر تلك الجماعات، ويُضيف (= يستضيف) بعضُهم بعضا مُظْهرين لما قدروا عليه من الإمكان (= الثراء)، محتفلين في الأطعمة وسواها الاحتفال العظيم”!!
وفي حديثه عن هيكلية الحِرَف الداخلية في العصور المتأخرة؛ أورد عبد العزيز الدوري -في مقاليْه المذكوريْن سابقا نقلا عن مصادر تركية ككتاب الفتوة أو ‘فتوّتْ نامه‘ للرحالة التركي أوليا جلبي (ت 1095هـ/1684م)- أنه في الأناضول كان “تركيب الحرفة من: ‘الشيخ‘ (النقيب) والجاويش (= العريف) والأوسطة (الأستاذ) ثم ‘الشاكرد‘ أو المبتدئ” في تعلم الصنعة. ويشير الدوري إلى أن جلبي عدّد “جميع الأصناف وحوانيتهم وشيوخهم.. وهي 1001 صنف (= حرفة)”.
مؤهلات صارمة
وطبقا للدوري أيضا؛ فإنه في بعض المدن التركية كان النقيب -الذي ربما سُمي “أخي بابا”- يتولى إدارة شؤون الحِرَفة، ويساعده مجلس تنفيذي يسمى “اللونجة” مؤلف من خمسة أساتذة منتخَبين من الحرفيين، وتحت هؤلاء مراتب متفاوتة حسب السن تبدأ من المبتدئ وحتى “الخليفة”.
وهناك مجلس أعلى لكل الحرف مكون من رؤساء كل حرفة بمثابة رابطة نقابية جامعة أو اتحاد عام للنقابات بمفهومنا اليوم، ولهم رئيس عام كان يسمى ببعض مدن الأناضول “كهيالرباش” (رئيس الرؤساء). وقد عُرف “كهيالرباش” عند الصنائعيين بدمشق بـ”شيخ المشايخ”.
أما وظيفة “شيخ الحرفة” نفسها فكان يجب على من يتولاها -ولو بالوراثة- أن يحوز موافقة أهل الحرفة، مع تحلّيه بصفات عديدة كالتميز في إتقان الحرفة، والأخلاق الطيبة. ولا يُستبدل إلا إن صدر منه ما يوجب ذلك من إخلال بأخلاقيات الصنعة أو بالسمعة، وكان تعيينه من قبل “شيخ المشايخ” يقتضي احتفالا خاصا. أما الصناع فكانت العهود تؤخذ عليهم بالمحافظة على أسرار الصنعة والالتزام الأخلاقي فيها.
ويروي أوليا جلبي -حسب الدوري- أن النقابات الحرفية كانت تنظم استعراضا سنويا ينطلق فيه “الموكب وقت الفجر ويستمر في سيره طول النهار حتى الغروب، وتمر الأصناف (= النقابات) ببيت قاضي إسطنبول -لأنه صاحب السلطة (= الوصاية على الصنائع)- لتفتيش جميع الأوزان والمقاييس والأصناف..، ثم تسير الأصناف إلى محلاتها وأسواقها، وتتوقف كل تجارة وحرفة لثلاثة أيام بمناسبة الاستعراض”.
وفي عرفٍ مؤسسيٍّ رائدٍ لنظائره في عصرنا؛ نجد أن بعض الحِرف في المغرب كانت تنتخب “أمينها” (نقيبها) في كل منطقة لمأمورية لا تتجاوز ستة أشهر، ثم ينتخب هؤلاء الأمناء الفرعيون “الأمير الأكبر الذي تعترف به الحكومة رئيسا لنقابتهم”، فيتواصل معها فيما يتعلق بعمل فروع النقابة في عموم البلاد؛ طبقا لكتاب ‘موجز دائرة المعارف الإسلامية‘ الصادرة عن مؤسسة “بريل” الهولندية.
وأما عن العلاقة بين النقابات الحرفية والطرق الصوفية وتأثيرها في تشكيل الأعراف النقابية الداخلية؛ فمن المعروف أن جماعات المتصوفة حاولت -تقريبا منذ القرن الخامس الهجري/الـ11م- شرعنة تقاليدها السلوكية الخاصة (كالوِرد والخِرْقة/المُرقَّعة) بوضع “أسانيد” تجعلها مستمَدّة بـ”الإجازة” من رجالات الرعيل الأول في الإسلام من الصحابة والتابعين، ساعية بذلك لإدماجها في حقول المعرفة الإسلامية المتلقّاة بالإسناد كعلوم القرآن والحديث ومرويات الفقه واللغة والأدب.
وقد عزز ذلك المسعى الصوفيَّ بروزُ ظاهرة “النقابية المذهبية” في وقت مبكر -كما رأينا- بين أهل المذاهب الفقهية، وما أنتجته من تناصر معنوي (في الخلاف المذهبي) ومادي (بمنافع الأوقاف المذهبية) بين أبناء المذهب الواحد، كما تفعله النقابات الحرفية والمهنية قديما وحديثا بين الاتحادات والروابط العلمية.
ولذلك فإن الصوفية مثلا “قرروا أن.. المرقَّعة (= الخِرقة) لا تُلْبَس إلا من يد شيخ (= إجازة)، وجعلوا لها إسنادا متصلا كلُّه كذبٌ ومُحالٌ”؛ طبقا للإمام المحدّث الواعظ ابن الجوزي (ت 597هـ/1201م) في كتابه ‘تلبيس إبليس‘. وهذا الإسناد له عدة طرق أغلبيتها ترقى به إلى الخليفة الراشد علي بن أبي طالب (ت 40هـ/661م) عن طريق التابعي الجليل الحسن البصري (ت 110هـ/729م)، وقد ترسخت طقوسه الاحتفالية العميقة مع نشأة تيارات الفتوة الاجتماعية منذ الخامس الهجري/الـ10م.
تقاليد رمزية
وتقليدا لجماعات المتصوفة في صنيعها ذاك، ومع ارتباط النقابات بالتصوف في عصر وبيئات ساد فيها حتى عم كل الفئات؛ سعت جماعات الحِرف والمهن -تقريبا منذ القرن السابع الهجري/الـ12م- إلى دمج صناعاتها “العملية” في الحضارة الإسلامية -التي يمكن وصفها بأنها حضارة الإسناد والإجازة- باستعارة مفهوميْ “السند” و”الإجازة” السائدين في الصناعات “العلمية”، وشجعها على ذلك اعتبار المسلمين جميعَ المعارف في حياتهم الثقافية “صناعات”، فكانوا يتحدثون عن “صنعة/صناعة الحديث” و”صنعة/صناعة الفقه” ومثل ذلك في الآداب من لغة وأدب.
واستكمالا لتقليدهم جماعاتِ الصوفية؛ فإن أصحاب الحِرف وضعوا لمختلف صنائعهم “أسانيد” تجعلها متلقّاة عن الخليفة الراشد علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- بواسطة الصحابي الجليل سلمان الفارسي (ت 33هـ/655م) رضي الله عنه، ولكنه إسناد مكذوب -كالخرقة الصوفية عند معظم علماء الحديث- ولا يعدو أن يكون صلة متخيلة ورمزية هدفها تعميق الصلة بالمشهد المعرفي العام، وغرس احترام الصناعات الحرفية في نفوس مجتمعات طالما “احتقر” كثير من نخبة أبنائها الصناعات اليدوية.
وإذا كان بعض الفقهاء ربطوا كثيرا من تلك الصناعات بأهل البدع والأهواء، فقد برّأ معظمُ الفقهاء غالبيةَ أهلها من ذلك الربط المعمَّم؛ فأشادوا بـ”أصحاب الصنائع الدنيئة -إذا حسُنت طريقتهم في الدِّين- كالكناس والدباغ والزبال… لقوله تعالى: {إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ} (الحجرات/الآية: 13)، ولأن هذه صناعات مباحة وبالناس إليها حاجة”؛ وفقا للإمام أبي إسحق الشيرازي (ت 476هـ/1083م) في كتابه ‘المهذَّب في فقه الإمام الشافعي‘.
كما رفض العلماء نزعة الاحتقار الاجتماعي لتلك الصنائع الحرفية ومنتسبيها، معتبرين أن “الرفعة في الدِّين.. لا تكون بالشرف ولا بالمال والمناصب العالية، بل للفقراء الخاملين وهم أتباع الرُّسُل، ولا يضرهم خسة صنائعهم إذا حسُنت سيرتهم في الدين”؛ طبقا للإمام علاء الدين علي بن محمد الشيحي المعروف بالخازن (ت 741هـ/1340م) في تفسيره ‘لباب التأويل‘.
بل إن كثيرا من العلماء كانوا يُعرّفون بنسبتهم إلى صنائعهم ومهنهم، وبعضهم تولى منصب النقابة المهنية لصناعته مدة طويلة، كما وقع للمحدِّث شهاب الدين أحمد بن أبي طالب الصالحي الحجّار المعروف بابن الشِّحْنة (ت 730هـ/1330م)، الذي يقول عنه الإمام ابن كثير (ت 776هـ/1374م) -في ‘البداية والنهاية‘- إنه “الشيخ الكبير المُسْنِد.. مَكَثَ مدة مُقدَّم (= نقيب) الحجّارين نحوا من خمس وعشرين سنة”!!
وفي كتاب ‘الأنساب‘ للإمام أبي سعد السَّمْعاني المروزي (ت 562هـ/1166م) ترجماتٌ لمئات العلماء المنسوبين إلى مِهَنِهم وصنائعهم، وإفادةٌ بوجود من صنّف مبكرا -خلال القرن الثالث الهجري/التاسع الميلادي- في سِيَر العلماء العاملين في هذه المهن.
فحين عرّف السمعاني بأبي عبد الله محمد بن إسحق السعدي الهَرَوي الشافعي (ت نحو 285هـ/898م)؛ قال عنه: “رأيتُ في تصنيفه كتابا حسنا ببخارَى أظنه لم يُسبَق إلى ذلك، سمّاه: ‘كتاب الصُّنّاع من الفقهاء والمحدِّثين‘”!! وذكر السمعاني أن الهَرَوي أورد في كتابه هذا من العلماء الذين تعاطَوْا تجارة العطور وحدها “جماعة كثيرة قريبا من خمسين نفْساً”.
كما أعدّ الباحث عبد الباسط بن يوسف الغريب دراسة أصدرها بعنوان: “الطُّرْفة فيمن نُسب من العلماء إلى مهنة أو حِرفة”، فأورد فيها تراجم لنحو 1500 عالم موزَّعين على زهاء 400 صنعة ومهنة كانوا يتكسبون منها.
ومن المصنفات المؤلَّفة في تراجم العلماء العاملين في الصنائع والمهن: الكتابُ المنسوب إلى المؤرخ ابن الفُوَطي الشيباني (ت 723هـ/1323م) بعنوان: “بدائع التُّحَف في ذكر مَنْ نُسِب مِن العلماء إلى الصنائع والحِرَف”. بل وألّف العالم الوزير الأندلسي أبو الحسن الخزاعي (ت 789هـ/1387م) كتابه ذا الدلالة المعبّرة في هذا السياق: “الدلالات السمعية على ما كان في عهد رسول الله من الحِرَف والصنائع والعمالات الشرعية”!!
انتماء حضاري
وعلى غرار التصوف، وربما بتأثير منه بعد أن تغلغلت نزعته بقوة في النقابات الحِرَفية؛ اندمج مفهوم “الفتوة” المعبِّر عن صفات الرجولة والشهامة -وفقا لتعريف ابن المعمار الحنبلي في كتابه ‘الفتوة‘- في هذه النقابات الحِرَفية، فظهر في الأناضول مسمَّى “الأخية الفتيان” الذين اشتُقّ اسمهم من مناداة بعضهم بعضا بلفظ “أخي/آخي”.
وقد وثّق ابن بطوطة -في رحلته- الكثير من مظاهر كرمهم وضيافتهم للناس وخاصة الغرباء، وذكر أن جماعتهم مكونة من الصناع والشباب العزاب الذين يجتمعون في زاوياهم عصر كل يوم حيث يبيتون، فإذا كان الغد “انصرفوا إلى صناعتهم بالغدوّ (= الصباح)، وأتوا بعد العصر إلى مُقدَّمهم (= نقيبهم) بما اجتمع لهم” من أموال صناعاتهم.
ويحكي ابن بطوطة أنه حين التقى قاضي المنطقة حدثه عن المكانة النقابية لأحدهم، فوصفه بأنه “أحد شيوخ الفتيان الأخية، وهو من الخرّازين وفيه كرم نفس، وأصحابه نحو مئتين من أهل الصناعات قد قدّموه على أنفسهم، وبنوا زاوية للضيافة وما يجتمع لهم بالنّهار أنفقوه بالليل”.
وهذا أول تقرير واضح حول اندماج الحرفيين والصناعيين في نظام الفتوة ذي الأصل الصوفي؛ مما يشير لدور أفكار الزهد والتصوف في امتزاج أخلاق الفتوة بعوائد الجماعات الحِرَفية.
وقد جاء عرضٌ كاملٌ لقائمة الصناعات و”أسانيدها المهنية” المتخيَّلة -والتي تتضمن أيضا ربطا واضحا بين بعض الأفكار الطرقية الصوفية والتقاليد الحِرَفية وتنتهي عادة بالصحابي سلمان الفارسي عن الخليفة علي بن أبي طالب- في كتاب “الذخائر والتُّحَف في بير (= شيخ/شيوخ) الصنائع والحِرف”، وهو لمؤلف مشرقي مجهول الاسم من رجال القرن العاشر الهجري/الـ16م.
وكما سبقت الإشارة؛ فإن تلك الأسانيد كانت نوعا من التسوية الحضارية أجراها العقل الجماعي لهؤلاء الصنائعيين لحل القضايا المتصلة بالتنوع العرقي والازدراء المجتمعي لبعض الأعراق أو الأعمال، ولربط الأصناف والحِرَف بأصول “مقدَّسة” لا تقل أهمية عن أي فرع معرفي مهم آخر، مما يمنح كل حرفة نوعا من الاحترام الذاتي لدى منتسبيها في مقابلة الاحتقار الاجتماعي الذي ربما عانوا منه في أمصار أو أعصار معينة.
والطريف أن سلاسل الإسناد الرمزية تلك تربط أصول الحِرَف بالكوفة والبصرة، وتضيف الشهادة في سبيل الله -أو القتلَ على يد الحجاج بن يوسف الثقفي (ت 95هـ/715م)- لبعض العلماء مثل كُميل بن زياد النخَعي (ت 84هـ/704م) الذي يسمونه “شيخ المصنفين”؛ مما يشير ضمنيا لمحاولة تأصيل مقاومة أصحاب الحِرَف والمهنيين للظلم والظالمين، حيث أعاد عقلهم الجمعي إنتاج قصة وتاريخ كل حرفة ودمجها في سياق الفتوة ليمنحها أصولا أخلاقية واضحة ومكينة.
كما أن هذا بدوره تحوَّل إلى رافعة اجتماعية وأخلاقية في عصور ما بعد سقوط بغداد بأيدي المغول سنة 656هـ/1258م، وخاصة في آسيا الصغرى (تركيا اليوم) التي ظلت مضطربة بين السيادة السلجوقية والهجمات المغولية والنفوذ البيزنطي؛ طبقا للدُّوري في مقاليْه المشار إليهما. وهذا الدور الأخلاقي سيستمر بداية من القرن السابع الهجري/الـ13م وحتى اندثار النقابات التقليدية في العصر الحديث إثر الهجمة الاستعمارية.
يتبع
__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟ فبكى رحمه الله ثم قال : أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.
|