
27-05-2024, 03:44 PM
|
 |
قلم ذهبي مميز
|
|
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس : 
المشاركات: 171,150
الدولة : 
|
|
 رد: فتح العليم العلام الجامع لتفسير ابن تيمية الإمام علم الأعلام وشيخ الإسلام
رد: فتح العليم العلام الجامع لتفسير ابن تيمية الإمام علم الأعلام وشيخ الإسلام

فتح العليم العلام الجامع لتفسير ابن تيمية الإمام علم الأعلام وشيخ الإسلام
المؤلف:شيخ الاسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية.
سُورَةُ المائدة
المجلد السابع
الحلقة( 278)
من صــ 371 الى صـ 385
{وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون - بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون} [البقرة: 116 - 117]. وقوله: {وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون - لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون - يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون - ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين} [الأنبياء: 26 - 29]. وقوله: {ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلا بعضهم على بعض} [المؤمنون: 91] وقوله: {لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء} [الزمر: 4]
وأهل الكتاب يذكرون أن في كتبهم تسمية عباد الله الصالحين ابنا، وتسمية الله أبا، وتسمية المصطفين أبناء، وهذا إذا كان ثابتا عن الأنبياء، فإنهم لا يعنون به إلا معنى صحيحا
واللفظ قد يكون له في لغة معنى، وله في لغة أخرى معنى غير ذلك، والمراد بهذا الولد والابن لا ينافي كونه مخلوقا مربوبا عبدا لله - عز وجل -.
وأما تسمية شيء من صفات الله ابنا أو ولدا، فهذا لا يعرف عن أحد من الأنبياء، ولا الأمم أهل اللغات سوى مبتدعة النصارى. ولم يبق للتولد إلا معنيان: أحدهما: أن ينفصل عنه جزء، والثاني: أن يحدث عنه شيء، إما باختياره، وإما بغير اختياره وقدرته، كحدوث الشعاع عن النار والشمس.
وكل من الأمرين لا يكون إلا عن أصلين، ولا بد أن يكون حادثا، لا يكون من صفاته اللازمة له، فيمتنع أن يتولد عنه شيء إن لم يكن معه أصل آخر يتولد عنهما.
والتولد عنه بغير قدرته ومشيئته، ممتنع عند أهل الملل، المسلمين واليهود والنصارى وسائر الأمم، سوى طائفة من المتفلسفة يقولون: إنه موجب بذاته مستلزما لما يصدر عنه، فهؤلاء قولهم يناسب هذا التولد.
والنصارى تكفر هؤلاء، لكن قد ضاهوهم في القول، كما قال تعالى: {وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون} [التوبة: 30].
وهذا قاله طائفة من اليهود، وهو معروف عن شخص يقال له فنحاص بن عازورا وأتباعه.
قال أبو محمد بن حزم: والصدوقية طائفة من اليهود نسبوا إلى رجل يقال له صدوق، وهم يقولون - من بين سائر اليهود -: إن العزير ابن الله، وكانوا بجهة اليمن.
ولكن المتفلسفة الذين يقولون بصدور العقول والأفلاك عنه، وإن سمي ذلك تولدا، فهم يجعلون ولده منفصلا عنه، لكن يثبتون ولدا قديما أزليا صدر عنه بغير اختياره، ويجعلون الشيء الواحد متولدا عنه.
وسائر الطوائف الذين أثبتوا لله ولدا، جعلوه حادثا منفصلا عنه.
فأما جعل صفته القائمة به ولدا له ومولودا، فهذا لا يعرف عن غير النصارى، فإذا أثبتوا له ولدا وابنا غير مخلوق، والصفة القائمة به اللازمة له، لم تتولد عنه ولا تسمى ابنا ولا ولدا عند أحد من الأنبياء وغيرهم - تعين أن يكون الولد إما جزءا منفصلا عنه، وإما معلولا له صادرا عنه بغير قدرته ومشيئته، وأي القولين قالوه فهم فيه كفار مضاهئون لقول الذين كفروا من قبل.
وبعض علمائهم، وإن أنكر ذلك، لكنهم يقولون ما يستلزم ذلك ويشبهونه بالشعاع من الشمس، ويقولون عن الروح: هو منبثق من الله خارج منه.
وهذا كله يناسب الولادة التي هي خروج شيء منه، أو حدوث شيء عنه بغير اختياره ومشيئته، ولا بد له - مع ذلك - من محل يقوم به، فإن الشعاع لا يقوم إلا بالأرض.
والأمر المنبثق الخارج من غيره، إما أن يكون جوهرا قائما بنفسه، أو صفة قائمة بغيرها.
فإن كان جوهرا، فقد انفصل من الرب جزء.
وإن كان عرضا، فلا بد له من محل، فيكون متولدا عن أصلين.
وتشبيههم بتولد الكلام عن العقل تشبيه باطل، فإن ذلك يحصل بقدرة الإنسان ومشيئته، وهو حادث بعد أن لم يكن.
هذا إذا عرف أن ما يقوم بقلب الإنسان من علم وحكمة، يقال: إنه يتولد عنه، ويقال: إنه ابنه، مع أن هذا أمر غير معروف في اللغات، ولو كان معروفا في لغة بعض الأمم، لم يجز أن يفسر به كلام الأنبياء، إن لم يكن معروفا في لغتهم.
وأما ما يدعونه، فإنهم يقولون: إن الكلمة لازمة لذات الله أزلا وأبدا، وهي مولودة منه، مع أنها غير مصنوعة، فهذا كلام متناقض باطل من وجوه.
فإن المتولد عن الشيء لا يتولد إلا عنه وعن غيره، وأما الشيء الواحد فلا يتولد عنه وحده شيء، وأيضا فإن ما تولد عن غيره لم يكن حادثا، وأما الصفة القديمة اللازمة لذات الرب فليست مولودة له، ولا متولدة عنه، بل هي قائمة به لازمة لذاته.
وأيضا، فإن المولود اسم مفعول، يقال: ولده يلده فهو مولود، وهذا لا يقال إلا في الحادث المتجدد، فإنه مفعول فعل الوالد.
والقديم الأزلي لا يكون مفعولا مولودا.
وأيضا فتسمية الصفة القديمة الأزلية مولودا وابنا، لا يوجد في كلام أحد من الأنبياء - عليهم السلام -.
فهب أن هذا مما يسوغ لنا في اللغة أن نقوله، لكن لا يجوز أن نحدث لغة غير لغة الأنبياء، ونحمل كلام الأنبياء عليها، فإن هذا كذب عليهم.
وهكذا تفعل النصارى وأمثالهم من أهل التحريف بكلام الأنبياء، يحدثون لهم لغة مخالفة للغة الأنبياء، ويحملون كلام الأنبياء عليه.
مثال ذلك أن الأنبياء أخبروا بأن الله إله واحد، وكفروا من أثبت إلهين اثنين، وأمروا بالتوحيد ودعوا إليه، وحرموا الشرك وكفروا أهله، وأخبروا أن الله واحد أحد، وكان مرادهم بذلك توحيده، وأنه لا يجوز أن يعبد إلا الله، وأنه لا يستحق العبادة إلا هو، ليس مقصودهم بذلك نفي صفاته.
فلم يقصدوا بلفظ " الأحد والواحد " أنه ليس له علم ولا قدرة ولا شيء من الصفات.
فجاء طائفة من أهل البدع، ففسروا لفظ اسم " الواحد والأحد " بما جعلوه اصطلاحا لهم، فقالوا: الواحد الذي ليس فيه تركيب ولا ينقسم، ولو كان له صفات لكان مركبا، ولو قامت به الصفات لكان جسما، والجسم مركب من الجواهر المنفردة، أو من المادة والصورة، فلا يكون أحدا ولا واحدا.
فيقال: هذا الذي قالوه، لو قدر أنه صحيح في العقل واللغة، فليس هو لغة الأنبياء التي خاطبوا بها الخلق، فكيف إذا لم يكن هذا الواحد من لغة أحد من الأمم؟
بل جميع الأمم تسمي ما قام به الصفات واحدا، بل يسمونه وحيدا، وقد يسمونه في غير الإثبات أحدا، كقوله: {وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله} [التوبة: 6] وقوله: {ذرني ومن خلقت وحيدا} [المدثر: 11] وأمثال ذلك.
وأما البحث العقلي في هذا، فقد بسطناه في غير هذا الموضع، وبينا أن ما يسميه هؤلاء المتفلسفة تركيبا، كقولهم: إن الشيء مركب من وجود وماهية، وقولهم: إن الأنواع مركبة من الأجناس والفصول، هو باطل عند جميع جمهور العقلاء.
وليس في الخارج إلا ذات متصفة بصفات، ليس في الخارج وجود القائم بنفسه، وماهية أخرى غير هذا الشيء الموجود القائم بنفسه مثلا.
ولكن قد يعنى بلفظ " ماهية " ما يتصور في الأذهان، وبالوجود ما يوجد في الأعيان، وحينئذ فهذه الماهية غير هذا الموجود، وحينئذ فيقال: هذه الماهية غير هذا الوجود.
وكذلك قولهم: إن الإنسان الموجود في الخارج مركب من الجنس والفصل، فإن الإنسان الموجود هو ذات متصفة بصفات هو وغيره من الموجودات.
ولكن يتصور في الذهن ما هو مركب من الحيوان والناطق، كما يتصور ما هو مركب من الحيوان والضاحك، وهذا تركيب ذهني لا تركيب في الخارج، وقد بسط هذا في غير هذا الموضع.
وتبين أن ما جعلوه من الصفات داخلا في الماهية، وما جعلوه خارجا عنها لازما لها، وما هو مجموع أجزاء الماهية، يرجع عند التحقيق إلى ما هو مدلول عليه بالتضمن والالتزام والمطابقة.
ومن ذلك تركيب الجسم من الجواهر المفردة، أو من المادة والصورة.
وأكثر العقلاء ينكرون تركيب الجسم من هذا وهذا، كما قد بسط في موضع آخر.
والمقصود هنا، أن كلام الأنبياء لا يجوز أن يحمل إلا على لغتهم التي من عادتهم أن يخاطبوا بها الناس، لا يجوز أن يحدث لغة غير لغتهم، ويحمل كلامهم عليها.
بل إذا كان لبعض الناس - عادة ولغة - يخاطب بها أصحابه، وقدر أن ذلك يجوز له، فليس له أن يحمل ذلك، لغة النبي، ويحمل كلام النبي على ذلك.
ومن هذا إخبار الأنبياء بأن الله يقول ويتكلم وينادي ويناجي، وأنه قال كذا وتكلم بكذا، ونادى موسى ونحو ذلك.
والمعروف في لغتهم ولغة سائر الأمم، أن المتكلم من قام به الكلام، وإن كان متكلما بقدرته ومشيئته، لا يعرف في لغتهم أن المتكلم من أحدث كلاما منفصلا عنه، ولا أن المتكلم من قام به الكلام بدون قدرته ومشيئته.
فليس لأحد - إذا جعل اسم المتكلم لمن يحدث كلاما بائنا عنه، أو من قام به بدون قدرته ومشيئته - أن يحمل كلام الأنبياء على هذا.
بل المتكلم - عند الإطلاق - من تكلم بقدرته ومشيئته، مع قيام الكلام به.
وهذا هو المعروف في لغة الأنبياء وسائر الأمم عند الإطلاق، ونظائر هذا متعددة.
فمن فسر كلام الأنبياء بغير لغتهم المعروفة، فهم ممن بدل كلامهم وحرفه، والنصارى من هؤلاء.
وكذلك اسم العادل والظالم ونحوهما، فإن المعروف من كلام الأنبياء وغيرهم أن العادل من قام به العدل وفعل العدل بمشيئته وقدرته.
والظالم من قام به الظلم، وفعله بقدرته ومشيئته، لا يسمون من لم يقم به الظلم، ولكن قام بغيره، لكون قد جعل ذلك فاعلا له، ولا يسمون من لم يفعل الظلم - ولكن فعله غيره فيه - ظالما.
فمن جعل الظالم والكافر والفاسق من لم يفعل شيئا من ذلك ولكن فعله غيره فيه، أو جعل الظالم من لم يقم به ظلم فعله، ولكن جعل غيره متصفا به ظالما - فقد خرج عن المعروف من كلام الأنبياء وغيرهم.
وأبلغ من ذلك أن المحدث والحادث في لغة جميع الأمم، لا يسمى به إلا ما كان بعد أن لم يكن، والمخلوق أبلغ من المحدث والحادث فليس لأحد - إذا أحدث اصطلاحا سمى به القديم الأزلي الذي لم يزل موجودا، ولكنه زعم أنه معلول لغيره، فسماه محدثا بهذا الاعتبار - أن يقول: أنا أحمل كلام الأنبياء الذي أخبروا به، أن السماوات والأرض
وما بينهما مخلوق أو مصنوع أو معقول أو محدث أو نحو ذلك من العبارات - على أن مرادهم بذلك أنه معلول، مع كونه قديما أزليا لم يزل.
وأما لفظ " القديم " فهو في اللغة المشهورة التي خاطبنا بها الأنبياء، يراد به ما كان متقدما على غيره تقدما زمانيا، سواء سبقه عدم أو لم يسبقه، كما قال تعالى: {حتى عاد كالعرجون القديم} [يس: 39] وقال تعالى: {تالله إنك لفي ضلالك القديم} [يوسف: 95] وقال " الخليل ": {أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين} [الشعراء: 75]
فلهذا كان القديم الأزلي الذي لم يزل موجودا، ولم يسبقه عدم - أحق باسم القديم من غيره.
وليس لأحد أن يجعل القديم والمتقدم اسما لما قارن غيره في الزمان لزعمه أنه متقدم عليه بالعلة، ويقول: إنه متقدم على غيره وسابق له بهذا الاعتبار، وإن ذلك المعلول متأخر عنه بهذا الاعتبار، ثم يحمل ما جاء من كلام الأنبياء وأتباع الأنبياء وعموم الخلق على هذا الاصطلاح لو كان حقا، فكيف إذا كان باطلا.
وما ذكره من التقدم والسبق والتأخر بغير الزمان، أمر غير موجود ولا معقول ولا يعرف في الوجود من فعل شيئا، وكان علة فاعلة له إلا وهو متقدم عليه سابق له، ليس مقارنا له في الزمان ألبتة، بل متقدم عليه تقدما زمانيا.
وكل من يعرف أنه سبب أو علة فاعلة، فإنه متقدم على مسببه ومعلوله، لكن قد يكون متصلا به ليس بينهما زمان آخر.
فيقال: ليس هذا متأخرا عن هذا ; أي هو متصل به ليس بينهما فصل.
ويقال: ليس ذلك متقدما على هذا ; أي ليس بينهما زمان، بل هو متصل به، إذ قد يراد بلفظ التقدم هذا، كقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ("الجنازة متبوعة، وليست بتابعة، ليس منها من تقدمها") ; أي من كان قد تقدمها، حتى لم يكن قريبا منها، لم يكن تابعا لها، كما جاء في الحديث الآخر: ("الراكب خلف الجنازة، والماشي أمامها ووراءها، وعن يمينها ويسارها، قريبا منها") رواه أبو داود وغيره، وهو أبين حديث
روي في هذا الباب في هذا الحكم، ومنه قوله تعالى: {ولا الليل سابق النهار} [يس: 40] أي لا يتقدم عليه، بحيث يكون بينهما انفصال، بل كل منهما متصل بالآخر.
والمقصود هنا أن معرفة اللغة التي خاطبنا بها الأنبياء وحمل كلامهم عليها - أمر واجب متعين، ومن سلك غير هذا المسلك، فقد حرف كلامهم عن مواضعه، وكذب عليهم وافترى.
ومثل هذا التحريف والتبديل قد اتفق المسلمون واليهود والنصارى على أنه وقع فيه خلق كثير من أهل الكتب الثلاثة، وأن التوراة والإنجيل حرفا بهذا الاعتبار، وكذلك القرآن حرفه أهل الإلحاد والبدع بهذا الاعتبار.
فأهل الكتاب نقلوا عن الأنبياء أنهم تكلموا بلفظ الأب والابن ومرادهم - عندهم - بالأب: الرب، وبالابن: المصطفى المختار المحبوب.
ولم ينقل أحد منهم عن الأنبياء أنهم سموا شيئا من صفات الله ابنا، ولا قالوا عن شيء من صفاته: إنه تولد عنه، ولا إنه مولود له.
فإذا وجد في كلام المسيح - عليه السلام - أنه قال: (عمدوا الناس باسم الأب والابن وروح القدس) ثم فسروا الابن بصفة الله
القديمة الأزلية، كان هذا كذبا بينا على المسيح، حيث لم يكن في لغته أن لفظ الابن يراد به صفة الله القديمة الأزلية.
وكذلك إذا لم يكن في كلام الأنبياء أن حياة الله تسمى روح القدس، وإنما يريدون بروح القدس ما ينزله الله - تبارك وتعالى - على الأنبياء والصالحين ويؤيدهم، كان تفسير قول المسيح: " روح القدس ": إنه أراد حياة الله - كذبا على المسيح.
وهذا من بعض الوجوه أفسد من قول بعض المتفلسفة: إن العقول والنفوس والأفلاك معلولة له متولدة عنه، لازمة له أزلا وأبدا، وإن كان هذا أيضا باطلا في صريح العقل، كما هو كفر بما أخبرت به الأنبياء، كما قد بسط في موضع آخر، فإنه لا يصدر شيء عن فاعل الأشياء بعد شيء لا يتصور أن يكون المفعول مقارنا للفاعل لا يتأخر عنه، ولا يكون التولد إلا عن أصلين.
والواحد من كل وجه الذي ليس له صفة ثبوتية، لا وجود له، ولو كان له وجود لم يصدر عنه وحده شيء، كما قد بسط الكلام على ذلك في مواضع أخر.
ومما يوضح ذلك، أن خواص النصارى وعلماءهم - مع تجويزهم أن يقال: إن المسيح ابن الله - يلزمهم أن تكون مريم صاحبة الله وامرأته، كما قال ذلك من يغلو منهم، ومنهم من يجعل مريم إلها مع الله، كما جعل المسيح إلها.
فإن قالوا بذلك، جعلوا لله صاحبة وولدا، وجعلوا المسيح ابن
مريم وأمه إلهين من دون الله، كما فعل ذلك من فعله منهم.
فإنهم يعبدون مريم ويدعونها بما يدعون به الله - سبحانه - والمسيح، ويجعلونها إلها كما يجعلون المسيح إلها، فيقولون: يا والدة الإله، اغفري لنا وارحمينا، ونحو ذلك، فيطلبون منها ما يطلبونه من الله - عز وجل -.
ومنهم من يقول عن مريم: إنها صاحبة الله - سبحانه وتعالى -.
وبيان لزوم ذلك أن المسيح - عندهم - إنسان تام وإله تام، ناسوت ولاهوت، فناسوته من مريم، ولاهوته الكلمة القديمة الأزلية، وهي الخالق عندهم.
فالمسيح بين أصلين، ناسوت ولاهوت، فإذا كان الأب هو الله - عندهم - والكلمة المولودة عن الأب ابن الله، فمعلوم أن اللاهوت لما التحم بالناسوت ليصير منهما المسيح ازدوج به وقارنه، وهذا معنى الزوجية.
فكما أنهم قالوا: إن الولادة عقلية لا حسية، فكذلك الازدواج والنكاح عقلي لا حسي، فإن اللاهوت - على قولهم - ازدوج بناسوت مريم ونكحها نكاحا عقليا، وخلق المسيح من هذا وهذا.
وهم يقولون في الأمانة: إن المسيح تجسد من مريم ومن روح القدس.
فإن فسروا روح القدس بجبريل - كما يقوله المسلمون - فهو
الحق، وبطل قولهم لكنهم يقولون: روح القدس هو الأقنوم الثالث، كما يقولون في الكلمة وهو اللاهوت عندهم.
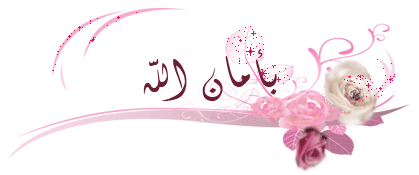
__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟ فبكى رحمه الله ثم قال : أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.
|