
10-03-2024, 10:43 PM
|
 |
قلم ذهبي مميز
|
|
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس : 
المشاركات: 172,533
الدولة : 
|
|
 رد: الأربعــون الوقفيــة
رد: الأربعــون الوقفيــة
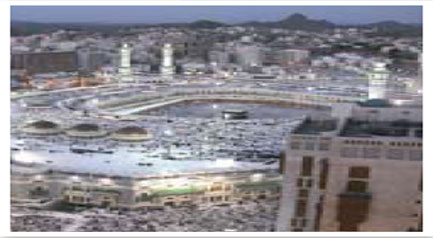
الأربعون الوقفية (35)
جرياً على نهج السلف في جمع نخبة من الأحاديث النبوية التي تخص باب علم مستقلا، وإحياء لسنة الوقف – الصدقة الجارية- فقد جمعت أربعين حديثاً نبوياً في الأعمال الوقفية، ورتبت ما جاء فيها من أحكام وفوائد من كتب السنن وشروحها، وكتب الفقه وأصوله؛ وأفردت شرحاً متوسطاً لكل حديث، حوى أحكاماً وفوائد جمة للواقفين من المتصدقين، وللقائمين على المؤسسات والمشاريع الوقفية، ونظار الوقف، والهيئات والمؤسسات المكلفة برعاية الأصول الوقفية ونمائها. أسأل الله أن يجعل هذا العمل إحياء لسنة الوقف والصدقة الجارية, وينفع به قولاً وعملا, ويكتب لنا أجر ذلك في صحائفنا.
الحديث الخامس والثلاثون:
الوقف على القرابة.. شفقة وحفظ كرامة
عن هشام بن عروة: «أن الزبير وقف على ولده وجعل للمردودة من بناته أن تسكن غير مضرة ولا مضر بها، فإن استغنت بزوج فلا حق لها فيه»(1).
من أوقاف الصحابة التي شاع خبرها، أن الزبير جعل دوره صدقة على ولده والمردودة من بناته، أي المطلقة والفاقدة التي مات زوجها، فلها أن ترد إلى البيت الذي أوقفه أبوها، وهذا من شفقة الأب على بناته؛ لتحفظ كرامتهن، ولتسد احتياجاتهن، بأن يضمن لمن تطلق أو تفقد زوجها أن تجد داراً تؤويها.
فقد أوقف الكثير من الصحابة الأوقاف، وأكد ذلك القرطبي بقوله: «إن أبا بكر وعمر وعثمان وعلياً وعائشة وفاطمة وعمرو بن العاص والزبير وجابراً كلهم وقفوا الأوقاف، وأوقافهم بمكة والمدينة معروفة مشهورة»(2).
قال محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة: «ما أعلم أحداً من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من أهل بدر من المهاجرين والأنصار، إلا وقد وقف من ماله حبساً لا يشترى ولا يورث ولا يوهب، حتى يرث الله الأرض وما عليها»(3). فقد امتثل أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وصايا النبي وطبقوها تطبيقاً عملياً، فأوقف الصحابة رضوان الله عليهم الأوقاف ابتغاء مرضاة الله تعالى، واستمر المسلمون من بعدهم في جريان أعمال الوقف وتعاهدوه جيلا بعد جيل.
وهذا ما أكده جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه بقوله: فما أعلم أحداً ذا مقدرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حبس مالاً من ماله صدقة مؤبدة لا تشترى أبداً، ولا توهب ولا تورث (4).
وكان من الصحابة ما اشترطوا في وقوفهم(5) أن يكون ريعها ومنفعتها على أولادهم وأقاربهم، كوقف عمر رضي الله عنه، ووقف ابن عمر حينما أوقف نصيبه من دار عمر رضي الله عنهما سكنى لذوي الحاجة من آل عبد الله، ووقف أنس بن مالك دارا له بالمدينة فكان إذا حج مر بالمدينة، نزل داره، وتصدق الزبير بدوره، وقال للمردودة – أي المطلقة - من بناته أن تسكن غير مضرة ولا مضر بها، فإن استغنت بزوج فليس لها حق(6).
وفي كتاب الوقف للبيهقي، قال: «تصدق الزبير ابن العوام رضي الله عنه بداره بمكة وداره بمصر، وأمواله بالمدينة»(7).
ووقف الصحابي الجليل الزبير بن العوام رضي الله عنه من هذا النوع (الوقف الذري أو الأهلي)، فقد أوقف عقاراً، وجعل منفعته لأولاده، واشترط أن تنتفع بناته منه، بشرط إن كانت غير متزوجة، فإن تزوجت فلا حق لها فيه، وإن طلقت فلها حق الانتفاع من هذا الوقف.
والوقف أنواع، إما خيري، أو أهلي - ذُرِّي- أو مشترك:
أما الوقف الخيري: فهو ما يصرف منه الريع من أول الأمر إلى جهة خيرية، كالفقراء والمساجد والمدارس والمستشفيات ونحوها.
والوقف الأهلي أو الذُرّي: ما جعلت فيه المنفعة للأفراد، إما على الواقف نفسه، أو أقاربه، أو شخص معين.
وهناك نوع ثالث سمي بالوقف المشترك: وهو ما يجمع بين الوقف الأهلي والخيري، يوقفه الواقف على جهة خيرية وعلى الأفراد، أو أن يكون لأقاربه بداية ثم لأبواب الخير من بعدهم.
ومدار الفرق بين الوقف الخيري والذري هو الجهة الموقوف عليها، فإن كانت خاصة بالواقف وقرابته كان الوقف أهليا أو ذرياً، وإن كانت عامة كان الوقف خيرياً. وكل منهما يعد قربة إلى الله وصدقة جارية لصاحبها، كما أن الوقف الذري مآله في الغالب إلى أن يكون وقفاً خيرياً.
وتقسيم الوقف وتسميته بالأهلي والخيري لم يكن موجوداً في العصور الأولى للإسلام، بل كانت الأوقاف معروفة بالصدقات؛ ولذلك كان يقال: «هذه صدقة فلان»، وكتب أوقاف الصحابة كلها عبرت عن الوقف بالتصدق: فتصدق بها عمر على كذا وكذا، وتصدق أبو بكر بداره بمكة على ولده، وكثير من هذه التعبيرات.
وبالرغم من عدم وجود تقسيم للوقف وتسميته بالأهلي أو الخيري، إلا أنه كان موجوداً بنوعيه منذ أن عرف الوقف في الإسلام، بل إن وقف عمر الذي يعد أساساً لما جاء بعده من أوقاف، كان موزعاً بين جهات البر وذوي القربى(8).
وللواقف الحق أن يشترط في وقفه، وشروط الواقف يقصد بها تلك الإرادة التي يقوم الواقف بالتعبير عنها في وثيقة وقفه، وهذه الوثيقة تسمى: كتاب الوقف، أو الإشهار بالوقف، أو حجة الوقف، فتكون المرجع في شروط الواقف، وبها تستبين النظم التي وضعها الواقف للعمل في وقفه، سواء كانت متعلقة بمصارف الوقف: وهي الجهات الموقوف عليها، أو متعلقة بكيفية توزيع ريع الوقف للموقوف عليهم، وبعضها متعلق بتحديد من يتولى الوقف، أي ناظر الوقف، وكيفية إدارة شؤونه، أو شروط أخرى أرادها الواقف.
وشرط الواقف معتبر إن لم يكن مخالفا لحكم الشرع، فلا تصح مخالفته، وهو الذي قال فيه الفقهاء: «شرط الواقف كنص الشارع»، أي في الفهم والدلالة والتزام العمل به.
ومن الأمثلة على شرط الواقف: كالذي يوقف على أولاده لصلبه ماداموا صغاراً، وشرط صرف غلة وقفه إلى أبواب الخير إذا بلغ سن التكليف أصغرهم، فيستمر الصرف حتى يبلغ أصغر أولاده الحلم.
ومن الأمثلة كذلك ما إذا وقف الواقف داره وشرط السكنى لزوجته فلانة ما دامت عزباء – أي بعد موته – فمات وانتفعت زوجته بوقفه، وإن تزوجت بعد موته فإنه ينقطع حقها من الوقف بالتزوج.
وللأثر فوائد ودلالات:
حرص الصحابة كذلك على الوقف وبذل أنفس أموالهم ليكون ذخراً لهم بعد وفاتهم؛ لتستمر معه الحسنات، وتكفر به السيئات. وحرص الصحابة على حفظ كرامة أبنائهم في حياتهم وبعد وفاتهم.
وفيه صحة وقف الشخص على أولاده، ومن بعدهم لجهة خيرية. وفيه للواقف أن يشترط في وقفه ما يريد بشرط ألا ينافي حكم الوقف، ولا يضر بالموقوف، ولا بمصلحة الموقوف عليهم، ولا يخالف شرع الله.
وفيه فضل الإحسان إلى الأقارب، والوقف لهم، والنفقة على المحتاج منهم، ففي الوقف على ذوي القربى زيادة تكافل الأسرة، وتأمين لمستقبلهم بإيجاد دخل ثابت لهم، وفيه صون البيوتات العريقة من الاندثار، وحفظ أفراد الأسرة الكريمة من الضياع والفاقة.
وفيه امتثال لجواب النبي صلى الله عليه وسلم حين سأل: «أي الصدقة أفضل؟ قال: جهد المقل، وابدأ بمن تعول» (9). والوقف سواء كان على الأهل، أو على سائر جهات البر، فيه معنى الخير، والإحسان، والصدقة.
وفيه جواز أن يجعل وقفه على من احتاج من أولاده ذكورًا وإناثًا من غير أن يضر بوقفه أحداً من الورثة، كالإضرار بوقفه البنات.
وأهل العلم على خلاف في التفضيل بين الأولاد، فقال بعضهم: لا بأس به إن كان بعضهم له عيال وبه حاجة، وأما إذا كان على سبيل الأثرة فمكروه، أي إن وقف الوالد على أحد أبنائه صحيح ما دام الابن المذكور له من الاحتياجات ما ليس لبقية إخوته. وإن المنهي عنه من هذا هو أن يخص الوالد أحد أبنائه دون مسوغ شرعي.
قال ابن قدامة في «المغني»: «المستحب أن يقسم الوقف على أولاده على حسب قسمة الله تعالى الميراث بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين... فإن خالف فسوى بين الذكر والأنثى أو فضلها عليه أو فضل بعض البنين أو بعض البنات على بعض أو خص بعضهم بالوقف دون بعض، فقال أحمد في رواية محمد بن الحكم: إن كان على طريق الأثرة فأكرهه، وإن كان على أن بعضهم له عيال وبه حاجة يعني فلا بأس به، ووجه ذلك أن الزبير خص المردودة من بناته دون المستغنية منهن بصدقته. وعلى قياس قول أحمد لو خص المشتغلين بالعلم من أولاده بوقفه تحريضا لهم على طلب العلم، أو ذا الدين دون الفساق، أو المريض أو من له فضل من أجل فضيلته فلا بأس»(10).
والشيخ ابن عثيمين – رحمه الله – قال في «الشرح الممتع»: «لا يجوز له أن يخص الوقف ببنيه؛ لأنه إذا فعل ذلك دخل في قول النبي صلّى الله عليه وسلّم: «اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم»(11)، فيكون بهذا العمل غير متقٍ لله تعالى، وسمى النبي صلّى الله عليه وسلّم تخصيص بعض الأبناء جَوْراً، فقال: «لا أشهد على جَوْر»، ولا شك أن من وقف على بنيه دون بناته أنه جَور».
والحاصل أن القول بوجوب العدل في القسمة بين الأولاد ذكورا وإناثا هو القول الحق الذي لا يجوز العدول عنه.
الهوامش:
1- أخرجه البيهقى (6/166 - 167)، وأخرجه الدارمى (2/427)، وصححه الألباني في إرواء الغليل برقم: 1595.
2- تفسير القرطبي 6/318.
3- أحكام الأوقاف للخصاف، ص:6.
4- انظر كتاب: أحكام الأوقاف للخصاف، 5 وما بعدها.
5 - الوقوف جمع وقف، والوقف يجمع على: أوقاف ووقوف.
6 - انظر: فتح الباري، كتاب الوصايا، باب إذا وقف أرضاً أو بئراً أو اشترط لنفسه مثل دلاء المسلمين (7/24).
7- انظر: السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الوقف، باب الصدقات المحرمات (6/161).
8 - أحكام وضوابط العمل الخيري، محمود صفا الصياد العكلا، رسالة ماجستير، لم تنشر، ص 157.
9- صحيح الترغيب للألباني، برقم 882.
10- انظر المغني، لابن قدامة المقدسي (8/206).
11- السلسلة الصحيحة، للألباني، برقم 3946.
اعداد: عيسى القدومي
__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟ فبكى رحمه الله ثم قال : أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.
|