
26-01-2023, 12:10 AM
|
 |
قلم ذهبي مميز
|
|
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس : 
المشاركات: 166,603
الدولة : 
|
|
 رد: فتح العليم العلام الجامع لتفسير ابن تيمية الإمام علم الأعلام وشيخ الإسلام
رد: فتح العليم العلام الجامع لتفسير ابن تيمية الإمام علم الأعلام وشيخ الإسلام

فتح العليم العلام الجامع لتفسير ابن تيمية الإمام علم الأعلام وشيخ الإسلام
المؤلف:شيخ الاسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية.
سُورَةُ المائدة
المجلد السادس
الحلقة( 252)
من صــ 476 الى صـ 490
بخلاف ما إذا قال قائل قولا نظما أو نثرا، وقال آخر مثله، فإن الناس يقولون: هذا مثل قول فلان، كما قال تعالى: {كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم} [البقرة: 118] وقال عن القرآن: {قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله} [الإسراء: 88] ولهذا لو قال قارئ: أنا آتي بقرآن مثل قرآن محمد، وتلاه نفسه وقال: هذا مثله، لأنكر الناس ذلك وضحكوا منه وقالوا: هذا القرآن الذي جاء به هو، ليس هو كلام آخر مماثل له.
فإذا كان القرآن الذي يقرؤه المسلمون هو كلام الله الذي بلغه الرسول، لم يجز أن يقال: ليس هو بكلام الله، بل هو مثل له، أو حكاية عنه، أو عبارة.
وإذا كان معلوما إنما هو كلام الله، فقد تكلم الله به - سبحانه - لم يخلقه بائنا عنه، ولم يجز أن يقال لما هو كلامه: إنه مخلوق.
فإذا قيل عما يقرؤه المسلمون: إنه مخلوق، والمخلوق بائن عن الله، ليس هو كلامه، فقد جعل مخلوقا، ليس هو بكلام الله، فصار الأئمة يقولون: هذا كلام الله وهذا غير مخلوق، لا يشيرون بذلك إلى شيء من صفات المخلوق، بل إلى كلام الله الذي تكلم به وبلغه عنه رسوله.
والمبلغ إنما بلغه بصفات نفسه، والإشارة في مثل هذا يراد بها الكلام المبلغ، لا يراد بها ما به وقع التبليغ.
وقد يراد بهذا، الثاني، مع التقييد كما في مثل الاسم إذا قيل: عبدت الله ودعوت الله، فليس المراد أن المعبود المدعو، هو الاسم الذي هو اللفظ، بل المعبود المدعو هو المسمى باللفظ، فصار بعضهم يقول: الاسم هو غير المسمى، حتى قيل لبعضهم: أقول: دعوت الله، فقال: لا تقل هكذا، ولكن قل: دعوت المسمى بالله، وظن هذا الغالط أنك إذا قلت ذلك، فالمراد دعوت هذا اللفظ، ومثل هذا يرد عليه في اللفظ الثاني.
فما من شيء عبر عنه باسم، إلا والمراد بالاسم هو المسمى، فإن الأسماء لم تذكر إلا لبيان المسميات، لا أن الاسم نفسه هو ذات المسمى.
فمن قال: إن اللفظ والمعنى القائم بالقلب هو عين المسمى، فغلطه واضح.
ومن قال: إن المراد بالاسم في مثل قولك: دعوت الله، وعبدته،هو نفس اللفظ، فغلطه واضح، ولكن اشتبه على الطائفتين ما يراد بالاسم ونفس اللفظ.
كذلك أولئك اشتبه عليهم نفس كلام المتكلم المبلغ عنه الذي هو المقصود بلفظ المبلغ وكتابته بنفس صوت المبلغ ومداده.
والفرق بين هذا وهذا واضح عند عامة العقلاء.
وإذا كتب كاتب اسم الله في ورقة، ونطق باسم الله في خطابه، وقال قائل: أنا كافر بهذا ومؤمن بهذا، كان مفهوم كلامه أنه مؤمن أو كافر بالمسمى المراد باللفظ والخط، لا أنه يؤمن ويكفر بصوت أو مداد.
فكذلك من قال لما يسمعه من القراء ولما يكتب في المصاحف: إن هذا كلام الله.
أو قال لما يسمع من جميع المبلغين لكلام غيرهم، ولما يوجد في الكتب: هذا كلام زيد، فليس مرادهم ذلك الصوت والمداد، إنما هو المعنى واللفظ الذي بلغه زيد بصوته وكتب في القرطاس بالمداد.
فإذا قيل عن ذلك: إنه مخلوق، فقد قيل: إنه ليس كلام الله، ولم يتكلم به.
ومن قصد نفس الصوت أو المداد وقال: إنه مخلوق، فقد أصاب، كما أن من قصد نفس الصوت أو الخط وقال: ليس هذا هو كلام الله، بل هو مخلوق، فقد أصاب، لكن ينبغي أن يبين مراده بلفظ لا لبس فيه.
فلهذا كان الأئمة كأحمد بن حنبل وغيره، ينكرون على من أطلق القول بأن اللفظ بالقرآن مخلوق، أو غير مخلوق ويقولون: من قال: إنه مخلوق فهو جهمي، ومن قال: إنه غير مخلوق، فهو مبتدع، ومن قال: إنه مخلوق هنا، فقد يقولون: ليس هو كلام الله، وهذا خلاف المتواتر عن الرسول، وخلاف ما يعلم بمثل ذلك بصريح المعقول.
فإن الناس يعلمون - بعقولهم - أن من بلغ كلام غيره فالكلام كلام المبلغ عنه الذي قاله مبتديا آمرا بأمره مخبرا بخبره، لا كلام من قاله مبلغا عنه مؤديا.
ولهذا «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول في المواسم: (ألا رجل يحملني إلى قومه لأبلغ كلام ربي؟ فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي)» رواه أبو داود وغيره، عن جابر.
ولما أنزل الله تعالى: {الم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون} [الروم: 1]
قال بعض الكفار لأبي بكر الصديق: هذا كلامك أم كلام صاحبك؟ قال: ليس بكلامي ولا كلام صاحبي، ولكنه كلام الله.
فلهذا اشتد به إنكار أحمد بن حنبل وغيره من أئمة الإسلام، وبالغ قوم في الإنكار عليهم وقالوا: لفظنا بالقرآن غير مخلوق، وأطلقوا عبارات تتضمن وتشعر أن يكون شيء من صفات العباد غير مخلوقة، فأنكر ذلك أحمد وغيره، كما أنكر ذلك ابن المبارك، وإسحاق بن راهويه، والبخاري، وغير هؤلاء من أئمة السنة، وبينوا أن الورق والمداد وأصوات العباد وأفعالهم مخلوقة، وأن كلام الله الذي يحفظه العباد ويقرءونه ويكتبونه غير مخلوق.
فكلام أئمة السنة والجماعة كثير في هذا الباب، متفق غير مختلف، وكله صواب.
ولكن قد يبين بعضهم في بعض الأوقات ما لا يبينه غيره لحاجته في ذلك.
فمن ابتلي بمن يقول: ليس هذا كلام الله كالإمام أحمد، كان كلامه في ذم من يقول: هذا مخلوق، أكثر من ذمه لمن يقول: لفظي مخلوق.
ومن ابتلي بمن يجعل بعض صفات العباد غير مخلوق، كالبخاري صاحب الصحيح، كان كلامه في ذم من يجعل ذلك غير مخلوق، أكثر، مع نص أحمد والبخاري وغيرهما، على خطأ الطائفتين.
(قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي ... (25)
لما كان قادرا على التصرف في أخيه؛ لطاعته له جعل ذلك ملكا له.
(قال إنما يتقبل الله من المتقين (27)
وتقول المرجئة: قوله - تعالى -: {إنما يتقبل الله من المتقين} [سورة المائدة: 27] المراد به: من اتقى الشرك.
قالوا: وأما قولكم: المتقون الذين اتقوا الشرك. فهذا خلاف القرآن ; فإن الله - تعالى - قال: {إن المتقين في ظلال وعيون - وفواكه مما يشتهون} [سورة المرسلات: 41 - 42]، {إن المتقين في جنات ونهر} [سورة القمر: 54].
وقال: {الم - ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين - الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون - والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون} [سورة البقرة: 1 - 4].
وقالت مريم: {إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا} [سورة مريم: 18]
ولم ترد به الشرك، بل أرادت التقي الذي يتقى فلا يقدم على الفجور.
وقال تعالى: {ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب} [سورة الطلاق: 1 - 2].
وقال تعالى: {إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم} [سورة الأنفال: 29].
وقال تعالى: {إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين} [سورة يوسف: 90].
وقال تعالى: {لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور} [سورة آل عمران: 186].
وقال - تعالى -: {ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون} إلى قوله: {والله ولي المتقين} [سورة الجاثية: 18 - 19].
وقال: {ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا - يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم} [سورة الأحزاب: 70 - 71] فهم قد آمنوا واتقوا الشرك فلم يكن الذي أمرهم به بعد ذلك مجرد ترك الشرك.
وقال تعالى: {ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته} [سورة آل عمران: 102].
أفيقول مسلم: إن قطاع الطريق الذين يسفكون دماء الناس ويأخذون أموالهم اتقوا الله حق تقاته لكونهم لم يشركوا، وإن أهل الفواحش وشرب الخمر وظلم الناس اتقوا الله حق تقاته؟.
وقد قال السلف: ابن مسعود وغيره: كالحسن، وعكرمة، وقتادة، ومقاتل: " حق تقاته أن يطاع فلا يعصى، وأن يشكر فلا يكفر، وأن يذكر فلا ينسى ". وبعضهم يرويه عن ابن مسعود عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. وفي تفسير الوالبي عن ابن عباس قال: هو أن يجاهد العبد في الله حق جهاده، وأن لا تأخذه في الله لومة لائم، وأن يقوموا له بالقسط ولو على أنفسهم وآبائهم وأبنائهم.
وقد قال - تعالى -: {إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون - وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون} [سورة الأعراف: 201 - 202]، فمن كان الشيطان لا يزال يمده في الغي، وهو لا يتذكر ولا يبصر، كيف يكون من المتقين؟.
وقد قال - تعالى - في آية الطلاق: {ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب} [سورة الطلاق: 2 - 3]. وفي حديث أبي ذر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: " «يا أبا ذر لو عمل الناس كلهم بهذه الآية لكفتهم» " وكان ابن عباس وغيره من الصحابة إذا تعدى الرجل حد الله في الطلاق يقولون له: لو اتقيت الله لجعل لك مخرجا وفرجا.
ومعلوم أنه ليس المراد بالتقوى هنا مجرد تقوى الشرك.
ومن أواخر ما نزل من القرآن. وقيل: إنها آخر آية نزلت قوله - تعالى -: {واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون} [سورة البقرة: 281]، فهل اتقاء ذلك هو مجرد ترك الشرك؟، وإن فعل كل ما حرم الله عليه، وترك كل ما أمر الله به؟ وقد قال طلق بن حبيب ومع هذا كان سعيد بن جبير ينسبه إلى الإرجاء قال: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو رحمة الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله.
وبالجملة فكون المتقين هم الأبرار الفاعلون للفرائض، المجتنبون للمحارم، هو من العلم العام الذي يعرفه المسلمون خلفا عن سلف، والقرآن والأحاديث تقتضي ذلك.
(إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم (33)
(فصل في سبب نزول الآية)
قال شيخ الإسلام - رحمه الله تعالى -:
قيل: سبب نزول هذه الآية العرنيون الذين ارتدوا وقتلوا وأخذوا المال.
وقيل: سببه ناس معاهدون نقضوا العهد وحاربوا. وقيل: المشركون؛ فقد قرن بالمرتدين المحاربين وناقضي العهد المحاربين وبالمشركين المحاربين.
وجمهور السلف والخلف على أنها تتناول قطاع الطريق من المسلمين والآية تتناول ذلك كله؛ ولهذا كان من تاب قبل القدرة عليه من جميع هؤلاء فإنه يسقط عنه حق الله تعالى.
(فصل في أحكام قطاع الطريق)
قال شيخ الإسلام - رحمه الله تعالى -:
وقد روى الشافعي رحمه الله في مسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما - في قطاع الطريق -: " إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا مالا نفوا من الأرض ". وهذا قول كثير من أهل العلم كالشافعي وأحمد وهو قريب من قول أبي حنيفة رحمه الله. ومنهم من قال: للإمام أن يجتهد فيهم فيقتل من رأى قتله مصلحة وإن كان لم يقتل: مثل أن يكون رئيسا مطاعا فيها ويقطع من رأى قطعه مصلحة؛ وإن كان لم يأخذ المال مثل أن يكون ذا جلد وقوة في أخذ المال. كما أن منهم من يرى أنهم إذا أخذوا المال قتلوا وقطعوا وصلبوا.
والأول قول الأكثر. فمن كان من المحاربين قد قتل فإنه يقتله الإمام حدا لا يجوز العفو عنه بحال بإجماع العلماء. ذكره ابن المنذر ولا يكون أمره إلى ورثة المقتول؛ بخلاف ما لو قتل رجل رجلا لعداوة بينهما أو خصومة أو نحو ذلك من الأسباب الخاصة؛ فإن هذا دمه لأولياء المقتول إن أحبوا قتلوا وإن أحبوا عفوا وإن أحبوا أخذوا الدية؛ لأنه قتله لغرض خاص.
وأما المحاربون فإنما يقتلون لأخذ أموال الناس فضررهم عام؛ بمنزلة السراق فإن قتلهم حدا لله. وهذا متفق عليه بين الفقهاء حتى لو كان المقتول غير مكافئ للقاتل مثل أن يكون القاتل حرا والمقتول عبدا أو القاتل مسلما والمقتول ذميا أو مستأمنا فقد اختلف الفقهاء هل يقتل في المحاربة؟ والأقوى أنه يقتل؛ لأنه قتل للفساد العام حدا كما يقطع إذا أخذ أموالهم وكما يحبس بحقوقهم.
وإذا كان المحاربون الحرامية جماعة فالواحد منهم باشر القتل بنفسه والباقون له أعوان ورده له فقد قيل: إنه يقتل المباشر فقط والجمهور على أن الجميع يقتلون ولو كانوا مائة وأن الردة والمباشر سواء وهذا هو المأثور عن الخلفاء الراشدين؛ فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قتل ربيئة المحاربين. والربيئة هو الناظر الذي يجلس على مكان عال ينظر منه لهم من يجيء. ولأن المباشر إنما تمكن من قتله بقوة الردء ومعونته. والطائفة إذا انتصر بعضها ببعض حتى صاروا ممتنعين فهم مشتركون في الثواب والعقاب كالمجاهدين.
وأما إذا أخذوا المال فقط ولم يقتلوا - كما قد يفعله الأعراب كثيرا - فإنه يقطع من كل واحد يده اليمنى ورجله اليسرى عند أكثر العلماء: كأبي حنيفة وأحمد وغيرهم. وهذا معنى قول الله تعالى: {أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف}. تقطع اليد التي يبطش بها والرجل التي يمشي عليها وتحسم يده ورجله بالزيت المغلي ونحوه؛ لينحسم الدم فلا يخرج فيفضي إلى تلفه وكذلك تحسم يد السارق بالزيت. وهذا الفعل قد يكون أزجر من القتل؛ فإن الأعراب وفسقة الجند وغيرهم إذا رأوا دائما من هو بينهم مقطوع اليد والرجل ذكروا بذلك جرمه فارتدعوا؛ بخلاف القتل فإنه قد ينسى؛ وقد يؤثر بعض النفوس الأبية قتله على قطع يده ورجله من خلاف فيكون هذا أشد تنكيلا له ولأمثاله.
وأما إذا شهروا السلاح ولم يقتلوا نفسا ولم يأخذوا مالا ثم أغمدوه أو هربوا وتركوا الحراب فإنهم ينفون. فقيل: نفيهم تشريدهم فلا يتركون يأوون في بلد. وقيل: هو حبسهم. وقيل: هو ما يراه الإمام أصلح من نفي أو حبس أو نحو ذلك. والقتل المشروع: هو ضرب الرقبة بالسيف ونحوه لأن ذلك أروح أنواع القتل وكذلك شرع الله قتل ما يباح قتله من الآدميين والبهائم إذا قدر عليه على هذا الوجه. قال النبي صلى الله عليه وسلم {إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته} رواه مسلم وقال: {إن أعف الناس قتلة أهل الإيمان}.
وأما الصلب المذكور فهو رفعهم على مكان عال ليراهم الناس ويشتهر أمرهم وهو بعد القتل عند جمهور العلماء. ومنهم من قال: يصلبون ثم يقتلون وهم مصلبون. وقد جوز بعض العلماء قتلهم بغير السيف حتى قال: يتركون على المكان العالي حتى يموتوا حتف أنوفهم بلا قتل.
فأما التمثيل في القتل فلا يجوز إلا على وجه القصاص وقد {قال عمران بن حصين رضي الله عنهما ما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة إلا أمرنا بالصدقة ونهانا عن المثلة حتى الكفار إذا قتلناهم فإنا لا نمثل بهم بعد القتل ولا نجدع آذانهم وأنوفهم ولا نبقر بطونهم إلا إن يكونوا فعلوا ذلك بنا فنفعل بهم مثل ما فعلوا}. والترك أفضل كما قال الله تعالى: {وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين} {واصبر وما صبرك إلا بالله} قيل إنها نزلت لما مثل المشركون بحمزة وغيره من شهداء أحد رضي الله عنهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم {لئن أظفرني الله بهم لأمثلن بضعفي ما مثلوا بنا} فأنزل الله هذه الآية - وإن كانت قد نزلت قبل ذلك بمكة مثل قوله: {ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي} وقوله: {وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات} وغير ذلك من الآيات التي نزلت بمكة ثم جرى بالمدينة سبب يقتضي الخطاب فأنزلت مرة ثانية - فقال النبي صلى الله عليه وسلم " بل نصبر " وفي صحيح مسلم عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه قال:
{كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعث أميرا على سرية أو جيش أو في حاجة نفسه أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله تعالى وبمن معه من المسلمين خيرا ثم يقول: اغزوا بسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا}.
ولو شهروا السلاح في البنيان - لا في الصحراء - لأخذ المال فقد قيل: إنهم ليسوا محاربين بل هم بمنزلة المختلس والمنتهب لأن المطلوب يدركه الغوث إذا استغاث بالناس. وقال أكثرهم: إن حكمهم في البنيان والصحراء واحد. وهذا قول مالك - في المشهور عنه - والشافعي وأكثر أصحاب أحمد وبعض أصحاب أبي حنيفة؛ بل هم في البنيان أحق بالعقوبة منهم في الصحراء؛ لأن البنيان محل الأمن والطمأنينة ولأنه محل تناصر الناس وتعاونهم فإقدامهم عليه يقتضي شدة المحاربة والمغالبة؛ ولأنهم يسلبون الرجل في داره جميع ماله والمسافر لا يكون معه - غالبا - إلا بعض ماله. وهذا هو الصواب؛ لا سيما هؤلاء المتحزبون الذين تسميهم العامة في الشام ومصر المنسر وكانوا يسمون ببغداد العيارين ولو حاربوا بالعصا والحجارة المقذوفة بالأيدي أو المقاليع ونحوها: فهم محاربون أيضا. وقد حكي عن بعض الفقهاء لا محاربة إلا بالمحدد. وحكى بعضهم الإجماع: على أن المحاربة تكون بالمحدد والمثقل.
وسواء كان فيه خلاف أو لم يكن. فالصواب الذي عليه جماهير المسلمين: أن من قاتل على أخذ المال بأي نوع كان من أنواع القتال فهو محارب قاطع كما أن من قاتل المسلمين من الكفار بأي نوع كان من أنواع القتال فهو حربي ومن قاتل الكفار من المسلمين بسيف أو رمح أو سهم أو حجارة أو عصا فهو مجاهد في سبيل الله.
وأما إذا كان يقتل النفوس سرا لأخذ المال؛ مثل الذي يجلس في خان يكريه لأبناء السبيل فإذا انفرد بقوم منهم قتلهم وأخذ أموالهم. أو يدعو إلى منزله من يستأجره لخياطة أو طب أو نحو ذلك فيقتله ويأخذ ماله وهذا يسمى القتل غيلة ويسميهم بعض العامة المعرجين فإذا كان لأخذ المال فهل هم كالمحاربين أو يجري عليهم حكم القود؟ فيه قولان للفقهاء.
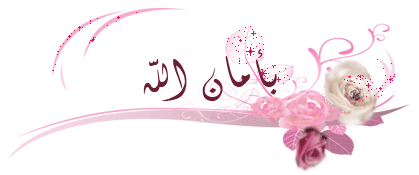
__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟ فبكى رحمه الله ثم قال : أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.
|