
26-01-2023, 12:08 AM
|
 |
قلم ذهبي مميز
|
|
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس : 
المشاركات: 166,603
الدولة : 
|
|
 رد: فتح العليم العلام الجامع لتفسير ابن تيمية الإمام علم الأعلام وشيخ الإسلام
رد: فتح العليم العلام الجامع لتفسير ابن تيمية الإمام علم الأعلام وشيخ الإسلام

فتح العليم العلام الجامع لتفسير ابن تيمية الإمام علم الأعلام وشيخ الإسلام
المؤلف:شيخ الاسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية.
سُورَةُ المائدة
المجلد السادس
الحلقة( 249)
من صــ 431 الى صـ 445
وبهذا يظهر الجواب عما يورده بعض أهل الكلام كالرازي على هذا الحديث حيث قالوا: دلائل كون الدجال ليس هو الله - ظاهرة، فكيف يحتج النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك بقوله: «إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور»؟ وهذا السؤال يدل على جهل قائله بما يقع فيه بنو آدم من الضلال، وبالأدلة البينة التي تبين فساد الأقوال الباطلة، وإلا فإذا كان بنو إسرائيل في عهد موسى ظنوا أن العجل هو إله موسى، فقالوا: هذا إلهكم وإله موسى، وظنوا أن موسى نسيه.
والنصارى مع كثرتهم يقولون: إن المسيح هو الله. وفي المنتسبين إلى القبلة خلق كثير يقولون ذلك في كثير من المشايخ وأهل البيت، حتى إن كثيرا من أكابر شيوخ المعرفة والتصوف يجعلون هذا نهاية التحقيق والتوحيد، وهو أن يكون الموحد هو الموحد، وينشدون:
ما وحد الواحد من واحد ... إذ كل من وحده جاحد
توحيد من يخبر عن نعته ... عارية أبطلها الواحد
توحيده إياه توحيده ... ونعت من ينعته لاحد
فكيف يستبعد مع إظهار الدجال هذه الخوارق العظيمة أن يعتقد فيه أنه الله، وهو يقول: أنا الله، وقد اعتقد ذلك فيمن لم يظهر فيه مثل خوارقه من الكذابين وفيمن لم يقل: أنا الله، كالمسيح، وسائر الأنبياء والصالحين.
الوجه التاسع: قولهم: فكلمة الله التي بها خلقت اللطائف تظهر في غير كثيف كلا، فيقال لهم: كلمة الله التي يدعون ظهورها في المسيح، أهي كلام الله الذي هو صفته، أو ذات الله المتكلمة أو مجموعها؟ فإن قلتم: الظاهر فيه نفس الكلام فهذا يراد به شيئان:
إن أريد به أن الله أنزل كلامه على المسيح، كما أنزله على غيره من الرسل، فهذا حق اتفق عليه أهل الإيمان، ونطق به القرآن.
وإن أريد به أن كلام الله فارق ذاته وحل في المسيح أو غيره، فهو باطل مع أن هذا لا ينفع النصارى، فإن المسيح عندهم إله خلق السماوات والأرض، وهو عندهم ابن آدم وخالق آدم، وابن مريم وخالق مريم، ابنها بناسوته وخالقها بلاهوته.
وإن أرادوا بظهور الكلمة ظهور ذات الله أو ظهور ذاته وكلامه في الكثيف الذي هو الإنسان، فهذا أيضا يراد به ظهور نوره في قلوب المؤمنين، كما قال تعالى:
{الله نور السماوات والأرض} [النور: 35] إلى قوله: {كوكب دري} [النور: 35] الآية.
وكما ظهر الله من طور سيناء وأشرق من ساعير واستعلن من جبال فاران، وكما تجلى لإبراهيم، كما ذكره في التوراة، فهذا لا يختص بالمسيح، بل هو لغيره كما هو له.
وإن أرادوا أن ذات الرب حلت في المسيح، أو في غيره فهذا محل النزاع، فأين دليلهم على إمكان ذلك ثم وقوعه؟ مع أن جماهير العقلاء من أهل الملل وغيرهم يقولون: هذا غير واقع، بل هو ممتنع.
الوجه العاشر: قولهم: فكلمة الله التي بها خلقت اللطائف تظهر في غير كثيف كلا - كلام باطل.
فإن ظهور ما يظهر من الأمور الإلهية إذا أمكن ظهوره فظهوره في اللطيف أولى من ظهوره في الكثيف، فإن الملائكة تنزل بالوحي على الأنبياء عليهم السلام، وتتلقى كلام الله من الله، وتنزل به على الأنبياء عليهم السلام، فيكون وصول كلام الله إلى ملائكة قبل وصوله إلى البشر وهم الوسائط كما قال تعالى:
{أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء} [الشورى: 51]
والله تعالى أيد رسله من البشر حتى أطاقوا التلقي عن الملائكة، وكانت الملائكة تأتيهم أحيانا في غير الصورة البشرية، وأحيانا في الصورة البشرية، فكان ظهور الأمور الإلهية باللطائف ووصولها إليهم أولى منه بالكثائف، ولو جاز أن يتحد الرب سبحانه بحي من الأحياء، ويحل فيه، لكان حلوله في ملك من الملائكة واتحاده به أولى من حلوله واتحاده بواحد من البشر.
الوجه الحادي عشر: أن الناسوت المسيحي عندهم الذي اتحد به هو البدن والروح معا، فإن المسيح كان له بدن وروح، كما لسائر البشر، واتحد به عندهم اللاهوت، فهو عندهم اسم يقع على بدن وروح آدميين وعلى اللاهوت، وحينئذ فاللاهوت على رأيهم إنما اتحد في لطيف وهو الروح، وكثيف وهو البدن، لم يظهر في كثيف فقط، ولولا اللطيف الذي كان مع الكثيف، وهو الروح - لم يكن للكثيف فضيلة ولا شرف.
الوجه الثاني عشر: أنهم يشبهون اتحاد اللاهوت بالناسوت باتحاد الروح بالبدن، كما شبهوا هنا ظهوره فيه بظهور الروح في البدن، وحينئذ فمن المعلوم أن ما يصيب البدن من الآلام تتألم به الروح، وما تتألم به الروح يتألم به البدن، فيلزمهم أن يكون الناسوت لما صلب وتألم وتوجع الوجع الشديد كان اللاهوت أيضا متألما متوجعا، وقد خاطبت بهذا بعض النصارى فقال لي: الروح بسيطة، أي لا يلحقها ألم، فقلت له: فما تقول في أرواح الكفار بعد الموت، أمنعمة أو معذبة؟ فقال: هي في العذاب، فقلت: فعلم أن الروح المفارقة تنعم وتعذب، فإذا شبهتم اللاهوت في الناسوت بالروح في البدن لزم أن تتألم إذا تألم الناسوت كما تتألم الروح إذا تألم البدن، فاعترف هو وغيره بلزوم ذلك.
الوجه الثالث عشر: أن قولهم: وإذا كانت اللطائف لا تظهر إلا في الكثائف - فكلمة الله لا تظهر إلا في كثيف كلا.
تركيب فاسد لا دلالة فيه، وإنما يدل إذا بينوا أن كل لطيف يظهر في كثيف، ولا يظهر في غيره حتى يقال: فلهذا ظهر الله في كثيف ولم يظهر في لطيف، وإلا فإذا قيل: إنه لا يحل لا في لطيف، ولا كثيف، أو قيل إنه يحل فيهما - بطل قولهم بوجوب حلوله في المسيح الكثيف دون اللطيف، وهم لم يؤلفوا الحجة تأليفا منتجا، ولا دلوا على مقدماتها بدليل، فلا أتوا بصورة الدليل، ولا مادته،، بل مغاليط لا تروج إلا على جاهل يقلدهم.
ولا يلزم من حلول الروح في البدن أن يحل كل شيء في البدن، بل هذه دعوى مجردة، فأرواح بني آدم تظهر في أبدانهم، ولا تظهر في أبدان البهائم، بل ولا في الجن، والملائكة تتصور في صورة الآدميين، وكذلك الجن، والإنسان لا يظهر في غير صورة الإنسان، فأي دليل من كلامهم على أن الرب يحل في الإنسان الكثيف، ولا يحل في اللطيف؟
والقوم شرعوا يحتجون على تجسيم كلمة الله الخالقة فقالوا: وأما تجسيم كلمة الله الخالقة بإنسان مخلوق وولادتهما معا، أي الكلمة مع الناسوت، فإن الله لم يكلم أحدا من الأنبياء إلا وحيا أو من وراء حجاب وليس فيما ذكروه قط دلالة لا قطعية ولا ظنية على تجسيم كلمة الله الخالقة وولادتها مع الناسوت.
الوجه الرابع عشر: أنهم قالوا: وأما تجسيم كلمة الله الخالقة، ثم قالوا: فكلمة الله التي بها خلقت اللطائف، فتارة يجعلونها خالقة، وتارة يجعلونها مخلوقا بها، ومعلوم أن الخالق ليس هو المخلوق به، والمخلوق به ليس هو الخالق، فإن كانت الكلمة خالقة، فهي خلقت الأشياء، ولم تخلق الأشياء بها، وإن كانت الأشياء خلقت بها، فلم تخلق الأشياء، بل خلقت الأشياء بها، ولو قالوا: إن الأشياء خلقت بها بمعنى أن الله إذا أراد أمرا فإنما يقول له: كن فيكون، لكان هذا حقا، لكنهم يجعلونها خالقة، مع قولهم بما يناقض ذلك.
الوجه الخامس عشر: أن يقال لهم: إذا كان الله لم يخاطب بشرا إلا وحيا أو من وراء حجاب، أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء - فتكليمه للبشر بالوحي ومن وراء حجاب، كما كلم موسى، وبإرسال ملك، كما أرسل الملائكة - إما أن يكون كافيا في حصول مراد الرب من الرسالة إلى عباده، أو ليس كافيا، بل لا بد من حلوله نفسه في بشر، فإن كان ذلك كافيا أمكن أن يكون المسيح مثل غيره فيوحي الله إليه أو يرسل إليه ملكا فيوحي بإذن الله ما يشاء، أو يكلمه من وراء حجاب كما كلم موسى، وحينئذ فلا حاجة به إلى اتحاده ببشر مخلوق، وإن كان التكلم ليس كافيا وجب أن يتحد بسائر الأنبياء، كما اتحد بالمسيح فيتحد بنوح وإبراهيم وموسى وداود وغيرهم، يبين هذا:
الوجه السادس عشر: وهو أنه من المعلوم أن الأنبياء الذين كانوا قبل المسيح أفضل من عوام النصارى الذين كانوا بعد المسيح، وأفضل من اليهود الذين كذبوا المسيح فإذا كان الرب قد يفضل باتحاده في المسيح حتى كلم عباده بنفسه، فيتحد بالمسيح محتجبا ببدنه الكثيف، وكلم بنفسه اليهود المكذبين للمسيح وعوام النصارى، وسائر من كلمه المسيح، فكان أن يكلم من هم أفضل من هؤلاء من الأنبياء والصالحين بنفسه أولى وأحرى، مثل أن يتحد بإبراهيم الخليل، فيكلم إسحاق ويعقوب ولوطا محتجبا ببدن الخليل، أو يتحد بيعقوب فيكلم أولاده أو غيرهم محتجبا ببدن يعقوب أو يتحد بموسى بن عمران فيكلم هارون ويوشع بن نون وغيرهما محتجبا ببدن موسى، فإذا كان هو سبحانه لم يفعل ذلك، إما لامتناع ذلك، وإما لأن عزته وحكمته أعلى من ذلك مع عدم الحاجة إلى ذلك، علم أنه لا يفعل ذلك في المسيح بطريق الأولى والأحرى.
الوجه السابع عشر: أنه إذا أمكنه أن يتحد ببشر فاتحاده بملك من الملائكة أولى وأحرى، وحينئذ فقد كان اتحاده بجبريل الذي أرسله إلى الأنبياء أولى من اتحاده ببشر يخاطب اليهود، وعوام النصارى.
[فصل: تفنيد مراد النصارى بظهور الله في عيسى]
قالوا: ولذلك ظهر في عيسى ابن مريم، إذ الإنسان أجل ما خلقه الله، ولهذا خاطب الخلق، وشاهدوا منه ما شاهدوا.
فيقال: إن ادعيتم ظهوره في عيسى كما ظهر في إبراهيم وموسى ومحمد صلوات الله عليهم وسلامه، وكما يظهر في بيوته التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، وذلك بظهور نوره ومعرفته، وذكر أسمائه وعبادته ونحو ذلك، من غير حلول ذاته في البشر ولا اتحاده به، فهذا أمر مشترك بين المسيح وغيره فلا اختصاص للمسيح بهذا، وهذا أيضا قد يسمى حلولا، وعندهم أن الله يحل في الصالحين، وهذا مذكور عندهم في بعض الكتب الإلهية، كما في كتبهم في المزمور الرابع من الزبور، يقول داود عليه السلام في مناجاته لربه:
وليفرح المتوكلون عليك إلى الأبد، ويبتهجون، وتحل فيهم ويفتخرون. فأخبر أنه يحل في الصالحين المذكورين، فعلم أن هذا لا اختصاص للمسيح به، وليس المراد بهذا - باتفاقهم واتفاق المسلمين - أن ذات الله نفسه تتحد بالبشر، ويصير اللاهوت والناسوت كالنار والحديد، والماء واللبن،ونحو ذلك مما يمثلون به الاتحاد،، بل هذا يراد به حلول الإيمان به ومعرفته، ومحبته وذكره وعبادته، ونوره وهداه.
وقد يعبر عن ذلك بحلول المثال العلمي، كما قال تعالى:
{وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله} [الزخرف: 84].
وقال تعالى:
{وهو الله في السماوات وفي الأرض} [الأنعام: 3].
{وله المثل الأعلى في السماوات والأرض} [الروم: 27].
فهو سبحانه له المثل الأعلى في قلوب أهل السماوات وأهل الأرض.
ومن هذا الباب «ما يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه قال: يقول الله: أنا مع عبدي ما ذكرني، وتحركت بي شفتاه»، فأخبر أن شفتيه تتحرك به أي باسمه، وكذلك قوله في الحديث الصحيح:
«عبدي مرضت فلم تعدني، فيقول العبد: رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟، فيقول: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلو عدته لوجدتني عنده».
فقال: لوجدتني عنده ولم يقل: لوجدتني إياه، وهو عنده أي في قلبه، والذي في قلبه المثال العلمي.
«وقال تعالى: عبدي جعت فلم تطعمني، فيقول: وكيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ فيقول: أما علمت أن عبدي فلانا جاع، فلو أطعمته لوجدت ذلك عندي»، ولم يقل لوجدتني قد أكلته.
وكذلك قوله في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: من «عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها».
وفي رواية: فبي يسمع، وبي يبصر، وبي يبطش، وبي يمشي، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته.
وهذا الحديث قد يحتج به القائلون بالحلول العام، أو الاتحاد العام أو وحدة الوجود، وقد يحتج به من يقول بالخاص من ذلك، كأشباه النصارى.
والحديث حجة على الفريقين، فإنه قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، فأثبت ثلاثة: وليا له، وعدوا يعادي وليه، وميز بين نفسه وبين وليه، وعدو وليه، فقال: «من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب»، ولكن دل ذلك على أن وليه الذي والاه فصار يحب ما يحب ويبغض ما يبغض، ويوالي من يوالي ويعادي من يعادي، فيكون الرب مؤذنا بالحرب لمن عاداه، بأنه معاد لله.
ثم قال تعالى:
«وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه»، ففرق بين العبد المتقرب، والرب المتقرب إليه، ثم قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فبين أنه يحبه بعد تقربه بالنوافل والفرائض.
ثم قال: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وعند أهل الحلول والاتحاد العام أو الوحدة: هو صدره وبطنه وظهره ورأسه وشعره، وهو كل شيء، أو في كل شيء قبل التقرب وبعده، وعند الخاص وأهل الحلول صار هو، وهو كالنار والحديد والماء واللبن، لا يختص بذلك آلة الإدراك والفعل.
ثم قال تعالى:
«فبي يسمع، وبي يبصر، وبي يبطش، وبي يمشي»، وعلى قول هؤلاء - الرب هو الذي يسمع ويبصر ويبطش ويمشي، والرسول إنما قال: فبي، ثم قال: «ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه»، فجعل العبد سائلا مستعيذا، والرب مسئولا مستعاذا به، وهذا يناقض الاتحاد، وقوله: فبي يسمع مثل قوله: ما تحركت بي شفتاه، يريد به المثال العلمي.
وقول الله: فيكون الله في قلبه أي معرفته ومحبته وهداه وموالاته، وهو المثل العلمي، فبذاك الذي في قلبه يسمع ويبصر ويبطش ويمشي.
والمخلوق إذا أحب المخلوق أو عظمه أو أطاعه يعبر عنه بمثل هذا، فيقول: أنت في قلبي وفي فؤادي، وما زلت بين عيني، ومنه قول القائل:
مثالك في عيني وذكرك في فمي ... ومثواك في قلبي فأين تغيب
وقول الآخر:
ومن عجبي أني أحن إليهم ... وأسأل عنهم من لقيت وهم معي
وتطلبهم عيني وهم في سوادها ... ويشتاقهم قلبي وهم بين أضلعي
ومثل هذا كثير مع علم العقلاء أن نفس المحبوب المعظم هو في نفسه ليست ذاته في عين محبه ولا في قلبه، ولكن قد يشتبه هذا بهذا حتى يظن الغالطون أن نفس المحبوب المعبود في ذات المحب العابد.
ولذلك غلط بعض الفلاسفة حتى ظنوا أن ذات المعلوم المعقول يتحد بالعالم العاقل، فجعلوا المعقول والعقل والعاقل شيئا واحدا، ولم يميزوا بين حلول مثال المعلوم، وبين حلول ذاته، وهذا يكون لضعف العقل وقوة سلطان المحبة والمعرفة، فيغيب الإنسان بمعبوده عن عبادته، وبمحبوبه عن محبته، وبمشهوده عن شهادته، وبمعروفه عن معرفته، فيفنى من لم يكن عن شهود العبد، لا أنه نفسه يعدم ويفنى في من لم يزل في شهوده، ومن هذا المقام إذا غلط قد يقول مثل ما يحكى عن أبي يزيد البسطامي: سبحاني، أو ما في الجبة إلا الله، وفي هذا تذكر حكاية، وهو أن شخصا كان يحب آخر فألقى المحبوب نفسه في ماء، فألقى المحب نفسه خلفه، فقال: أنا وقعت فلم وقعت أنت؟ فقال: غبت بك عني، فظننت أنك أني، فهذا العبد المحب لما استولى على قلبه سلطان المحبة صار قلبه مستغرقا في محبوبه، لا يشهد قلبه غير ما في قلبه وغاب عن شهود نفسه وأفعاله، فظن أنه هو نفس المحبوب، وهذا أهون من أن يظن أن ذات المحبوب نفسه.
فهذا الظن لاتحاد الذات أو لحلولها ظن غالط وقع فيه كثير من الناس، فالذين قالوا: إن المسيح أو غيره من البشر هو الله، أو إن الله حال فيه قد يكون غلطهم من هذا الجنس، لما سمعوا كلاما يقتضي أن الله في ذات الشخص، وجعلوا فعل هذا فعل هذا، ظنوا ذاك اتحاد الذات وحلولها.
وإنما المراد أن معرفة الله فيه، واتحاد المأمور به والمنهي عنه والموالي والمعادي، كقوله تعالى:
{إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله} [الفتح: 10].
وقوله:
{من يطع الرسول فقد أطاع الله} [النساء: 80].
وليس ذلك لأن الرسول هو الله، ولا لأن نفسه حال في الرسول،، بل لأن الرسول يأمر بما أمر الله به، وينهى عما ينهى الله عنه، ويحب ما يحبه الله، ويبغض ما يبغضه الله، ويوالي أولياء الله، ويعادي أعداء الله.
فمن بايعه على السمع والطاعة، فإنما بايع الله على السمع والطاعة، ومن أطاعه فإنما أطاع الله.
وكذلك المسيح وسائر الرسل؛ إنما يأمرون بما يأمر الله به، وينهون عما ينهى الله عنه ويوالون أولياء الله، ويعادون أعداء الله، فمن أطاعهم فقد أطاع الله، ومن صدقهم فقبل منهم ما أخبروا به، فقد قبل عن الله، ومن والاهم فقد والى الله، ومن عاداهم وحاربهم فقد عادى الله وحارب الله، ومن تصور هذه الأمور تبين له أن لفظ الحلول قد يعبر به عن معنى صحيح، وقد يعبر به عن معنى فاسد.
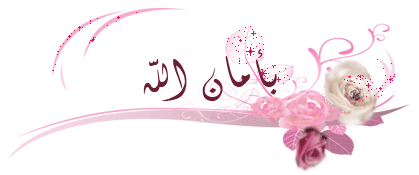
__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟ فبكى رحمه الله ثم قال : أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.
|