
03-01-2023, 01:46 PM
|
 |
قلم ذهبي مميز
|
|
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس : 
المشاركات: 171,239
الدولة : 
|
|
 رد: فتح العليم العلام الجامع لتفسير ابن تيمية الإمام علم الأعلام وشيخ الإسلام
رد: فتح العليم العلام الجامع لتفسير ابن تيمية الإمام علم الأعلام وشيخ الإسلام

فتح العليم العلام الجامع لتفسير ابن تيمية الإمام علم الأعلام وشيخ الإسلام
المؤلف:شيخ الاسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية.
سُورَةُ المائدة
المجلد السادس
الحلقة( 239)
من صــ 281 الى صـ 295
وفي قوله: {وما ذبح على النصب} [المائدة: 3] قولان:
أحدهما: أن نفس الذبح كان يكون عليها، كما ذكرناه، فيكون ذبحهم عليها تقربا إلى الأصنام، وهذا على قول من يجعلها غير الأصنام، فيكون الذبح عليها لأجل أن المذبوح عليها مذبوح للأصنام، أو مذبوح لها، وذلك يقتضي تحريم كل ما ذبح لغير الله، ولأن الذبح في البقعة لا تأثير له إلا من جهة الذبح لغير الله، كما كرهه النبي صلى الله عليه وسلم من الذبح في مواضع أصنام المشركين، وموضع أعيادهم، وإنما يكره المذبوح في البقعة المعينة؛ لكونها محل شرك، فإذا وقع الذبح حقيقة لغير الله؛ كانت حقيقة التحريم قد وجدت فيه.
والقول الثاني: أن الذبح على النصب، أي: لأجل النصب، كما قيل: أولم على زينب بخبز ولحم وأطعم فلان على ولده، وذبح فلان على ولده، ونحو ذلك، ومنه قوله تعالى: {ولتكبروا الله على ما هداكم} [البقرة: 185] وهذا ظاهر على قول من يجعل النصب نفس الأصنام، ولا منافاة بين كون الذبح لها، وبين كونها كانت تلوث بالدم، وعلى هذا القول فالدلالة ظاهرة.
واختلاف هذين القولين في قوله تعالى {على النصب} [المائدة: 3] نظير الاختلاف في قوله: {ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام} [الحج: 34] وقوله تعالى {ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام} [الحج: 28].
فإنه قد قيل: المراد بذكر اسم الله عليها، إذا كانت حاضرة.
وقيل: بل يعم ذكره لأجلها في مغيبها وشهودها، بمنزلة قوله تعالى {ولتكبروا الله على ما هداكم} [البقرة: 185].
وفي الحقيقة: مآل القولين إلى شيء واحد في قوله تعالى: {وما ذبح على النصب} [المائدة: 3] كما قد أومأنا إليه.
وفيها قول ثالث ضعيف: أن المعنى على اسم النصب. وهذا ضعيف؛ لأن هذا المعنى حاصل من قوله تعالى: {وما أهل لغير الله به} [المائدة: 3] فيكون تكريرا. لكن اللفظ يحتمله، كما روى البخاري في صحيحه عن موسى بن عقبة عن سالم «عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أنه كان يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لقي زيد بن عمرو بن نفيل بأسفل بلدح وذلك قبل أن ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي، فقدم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم سفرة في لحم.
فأبى أن يأكل منها، ثم قال زيد: إني لا آكل مما تذبحون على أنصابكم ولا آكل إلا مما ذكر اسم الله عليه». وفي رواية له: " وإن زيد بن عمرو بن نفيل كان يعيب على قريش ذبائحهم، ويقول: " الشاة خلقها الله، وأنزل لها من السماء الماء، وأنبت لها من الأرض الكلأ، ثم أنتم تذبحونها على غير اسم الله؟! إنكارا لذلك وإعظاما له.
وأيضا فإن قوله تعالى: {وما أهل لغير الله به} [المائدة: 3] ظاهره: أنه ما ذبح لغير الله، مثل أن يقال: هذا ذبيحة لكذا، وإذا كان هذا هو المقصود:
فسواء لفظ به أو لم يلفظ. وتحريم هذا أظهر من تحريم ما ذبحه للحم، وقال فيه: باسم المسيح، ونحوه، كما أن ما ذبحناه نحن متقربين به إلى الله سبحانه كان أزكى وأعظم مما ذبحناه للحم، وقلنا عليه: باسم الله، فإن عبادة الله سبحانه بالصلاة له والنسك له أعظم من الاستعانة باسمه في فواتح الأمور، فكذلك الشرك بالصلاة لغيره والنسك لغيره أعظم من الاستعانة باسمه في فواتح الأمور. فإذا حرم ما قيل فيه: باسم المسيح، أو الزهرة؛ فلأن يحرم ما قيل فيه: لأجل المسيح والزهرة أو قصد به ذلك، أولى.
وهذا يبين لك ضعف قول من حرم ما ذبح باسم غير الله، ولم يحرم ما ذبح لغير الله، كما قاله طائفة من أصحابنا وغيرهم، بل لو قيل بالعكس لكان أوجه، فإن العبادة لغير الله أعظم كفرا من الاستعانة بغير الله.
وعلى هذا: فلو ذبح لغير الله متقربا به إليه لحرم وإن قال فيه: بسم الله، كما يفعله طائفة من منافقي هذه الأمة الذين يتقربون إلى والكواكب بالذبح والبخور ونحو ذلك، وإن كان هؤلاء مرتدين لا تباح ذبيحتهم بحال، لكن يجتمع في الذبيحة مانعان.
[عودة إلى تفصيل القول فيما ذبح على النصب]
وروينا في تفسير مجاهد المشهور عنه الصحيح من رواية ابن أبي نجيح في قوله تعالى: {وما ذبح على النصب} [المائدة: 3] قال: " كانت حجارة حول الكعبة يذبح لها أهل الجاهلية، ويبدلونها إذا شاءوا بحجارة أعجب إليهم منها ".
وروى ابن أبي شيبة، حدثنا محمد بن فضيل، عن أشعث، عن الحسن، في قوله تعالى {وما ذبح على النصب} [المائدة: 3] قال: " هو بمنزلة ما ذبح لغير الله ".
وفي تفسير قتادة المشهور عنه: " وأما ما ذبح على النصب: فالنصب حجارة كان أهل الجاهلية يعبدونها ويذبحون لها، فنهى الله عن ذلك ".
وفي تفسير علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: " النصب أصنام كانوا يذبحون ويهلون عليها ".
فإن قيل: فقد نقل إسماعيل بن سعيد قال: سألت أحمد عما يقرب لآلهتهم يذبحه رجل مسلم. قال: " لا بأس به ".
قيل: إنما قال أحمد ذلك؛ لأن المسلم إذا ذبحه سمى الله عليه، ولم يقصد ذبحه لغير الله، ولا يسمي غيره، بل يقصد ضد ما قصده صاحب الشاة، فتصير نية صاحب الشاة لا أثر لها، والذابح هو المؤثر في الذبح، بدليل أن المسلم لو وكل كتابيا في ذبيحة، فسمى عليها غير الله لم تبح.
ولهذا لما كان الذبح عبادة في نفسه كره علي -رضي الله عنه- وغير واحد من أهل العلم -منهم أحمد في إحدى الروايتين عنه- أن يوكل المسلم في ذبح نسيكته كتابيا؛ لأن نفس الذبح عبادة بدنية، مثل الصلاة، ولهذا تختص بمكان وزمان ونحو ذلك، بخلاف تفرقة اللحم، فإنه عبادة مالية، ولهذا اختلف العلماء في وجوب تخصيص أهل الحرم بلحوم الهدايا المذبوحة في الحرم، وإن كان الصحيح تخصيصهم بها، وهذا بخلاف الصدقة، فإنها عبادة مالية محضة، فلهذا قد لا يؤثر فيها نية الوكيل، على أن هذه المسألة منصوصة عن أحمد محتملة.
فهذا تمام الكلام في ذبائحهم لأعيادهم.
(اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم (3)
[فصل البرهان الثالث " اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي " والجواب عليه]
فصل
قال الرافضي: " البرهان الثالث: قوله تعالى: {اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا} [سورة المائدة: 3] روى أبو نعيم بإسناده إلى أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دعا الناس إلى غدير خم، وأمر بإزالة ما تحت الشجر من الشوك، فقام فدعا
عليا، فأخذ بضبعيه فرفعهما، حتى نظر الناس إلى [بياض] إبطي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ثم لم يتفرقوا حتى نزلت هذه الآية: {اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا} [سورة المائدة: 3]. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: الله أكبر على إكمال الدين، وإتمام النعمة، ورضا الرب برسالتي، وبالولاية لعلي من بعدي. ثم قال: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله» ".
والجواب من وجوه: أحدها: أن المستدل عليه بيان صحة الحديث.
ومجرد عزوه إلى رواية أبي نعيم لا تفيد الصحة باتفاق الناس: علماء السنة والشيعة ; فإن أبا نعيم روى كثيرا من الأحاديث التي هي ضعيفة، بل موضوعة باتفاق علماء أهل الحديث: السنة والشيعة. وهو وإن كان حافظا كثير الحديث واسع الرواية، لكن روى، كما عادة المحدثين أمثاله يروون جميع ما في الباب ; لأجل المعرفة بذلك، وإن كان لا يحتج من ذلك إلا ببعضه. والناس في مصنفاتهم: منهم من لا يروي عمن يعلم أنه يكذب، مثل مالك، وشعبة، ويحيى بن سعيد، وعبد الرحمن بن مهدي، وأحمد بن حنبل ; فإن هؤلاء لا يروون عن شخص ليس بثقة عندهم،
ولا يروون حديثا يعلمون أنه عن كذاب، فلا يروون أحاديث الكذابين الذين يعرفون بتعمد الكذب، لكن قد يتفق فيما يروونه ما يكون صاحبه أخطأ فيه.
وقد يروي الإمام أحمد وإسحاق وغيرهما أحاديث تكون ضعيفة عندهم ; لاتهام رواتها بسوء الحفظ ونحو ذلك، ليعتبر بها ويستشهد بها، فإنه قد يكون لذلك الحديث ما يشهد له أنه محفوظ، وقد يكون له ما يشهد بأنه خطأ وقد يكون صاحبها كذبها في الباطن، ليس مشهورا بالكذب، بل يروي كثيرا من الصدق، فيروى حديثه.
وليس كل ما رواه الفاسق يكون كذبا، بل يجب التبين من خبره كما قال تعالى: {ياأيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا} [سورة الحجرات: 6] فيروى لتنظر سائر الشواهد: هل تدل على الصدق أو الكذب؟.
وكثير من المصنفين يعز عليه تمييز ذلك على وجهه، بل يعجز عن ذلك، فيروي ما سمعه كما سمعه، والدرك على غيره لا عليه، وأهل العلم ينظرون في ذلك وفي رجاله وإسناده.
الوجه الثاني: أن هذا الحديث من الكذب الموضوع باتفاق أهل المعرفة بالموضوعات. وهذا يعرفه أهل العلم بالحديث، والمرجع إليهم في ذلك. ولذلك لا يوجد هذا في شيء من كتب الحديث التي يرجع إليها أهل العلم بالحديث.
الوجه الثالث: أنه قد ثبت في الصحاح والمساند والتفسير أن هذه الآية نزلت على النبي - صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة، «وقال رجل من اليهود لعمر بن الخطاب: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرءونها ; لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك [اليوم] عيدا. فقال له عمر: وأي آية هي؟ قال: قوله: {اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا} [سورة المائدة: 3] فقال عمر: إني لأعلم أي يوم نزلت، وفي أي مكان نزلت. نزلت يوم عرفة بعرفة ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - واقف بعرفة». وهذا مستفيض من زيادة وجوه أخر. وهو منقول في كتب المسلمين: الصحاح والمساند والجوامع والسير والتفسير وغير ذلك.
وهذا اليوم كان قبل غدير خم بتسعة أيام، فإنه كان يوم الجمعة تاسع ذي الحجة، فكيف يقال: إنها نزلت يوم الغدير؟!.
الوجه الرابع: أن هذه الآية ليس فيها دلالة على علي ولا إمامته بوجه
من الوجوه، بل فيها إخبار الله بإكمال الدين وإتمام النعمة على المؤمنين، ورضا الإسلام دينا. فدعوى المدعي أن القرآن يدل على إمامته من هذا الوجه كذب ظاهر.
وإن قال: الحديث يدل على ذلك.
فيقال: الحديث إن كان صحيحا، فتكون الحجة من الحديث لا من الآية. وإن لم يكن صحيحا فلا حجة في هذا ولا في هذا.
فعلى التقديرين لا دلالة في الآية على ذلك. وهذا مما يبين به كذب الحديث، فإن نزول الآية لهذا السبب، وليس فيها ما يدل عليه أصلا، تناقض.
الوجه الخامس: أن هذا اللفظ، وهو قوله: " «اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله» " كذب باتفاق أهل المعرفة بالحديث.
وأما قوله: " «من كنت مولاه فعلي مولاه» " فلهم فيه قولان، وسنذكره - إن شاء الله - في موضعه.
الوجه السادس: أن دعاء النبي - صلى الله عليه وسلم - مجاب، وهذا الدعاء ليس بمجاب، فعلم أنه ليس من دعاء النبي - صلى الله عليه وسلم -، فإنه من المعلوم أنه لما تولى كان الصحابة وسائر المسلمين ثلاثة أصناف: صنف قاتلوا معه، وصنف قاتلوه، وصنف قعدوا عن هذا وهذا. وأكثر السابقين الأولين كانوا من القعود. وقد قيل: إن بعض السابقين الأولين قاتلوه. وذكر ابن حزم أن عمار بن ياسر قتله أبو الغادية، وأن أبا الغادية
هذا من السابقين، ممن بايع تحت الشجرة. وأولئك جميعهم قد ثبت في الصحيحين أنه لا يدخل النار منهم أحد.
ففي صحيح مسلم وغيره عن جابر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: " «لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة» ".
وفي الصحيح «أن غلام حاطب بن أبي بلتعة قال: يا رسول الله، ليدخلن حاطب النار. فقال: " كذبت ; إنه شهد بدرا والحديبية» ".
وحاطب هذا هو الذي كاتب المشركين بخبر النبي - صلى الله عليه وسلم -، وبسبب ذلك نزل: {ياأيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة} [سورة الممتحنة: 1] الآية، وكان مسيئا إلى مماليكه، ولهذا قال مملوكه هذا القول، وكذبه النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقال: " إنه شهد بدرا والحديبية " وفي الصحيح: " «لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة» ".
وهؤلاء فيهم ممن قاتل عليا، كطلحة والزبير، وإن كان قاتل عمار فيهم فهو أبلغ من غيره.
وكان الذين بايعوه تحت الشجرة نحو ألف وأربعمائة، وهم الذين فتح الله عليهم خيبر، كما وعدهم الله بذلك في سورة الفتح، وقسمها بينهم النبي - صلى الله عليه وسلم - على ثمانية عشر سهما ; لأنه كان فيهم مائتا فارس، فقسم للفارس ثلاثة أسهم: سهما له، وسهمين لفرسه، فصار لأهل الخيل ستمائة سهم، ولغيرهم ألف ومائتا سهم. هذا هو الذي ثبت في الأحاديث الصحيحة، وعليه أكثر أهل العلم، كمالك والشافعي وأحمد وغيرهم. وقد ذهب طائفة إلى أنه أسهم للفارس سهمين، وأن الخيل كانت ثلاثمائة، كما يقول ذلك من يقوله من أصحاب أبي حنيفة.
وأما علي فلا ريب أنه قاتل معه طائفة من السابقين الأولين، كسهل بن حنيف، وعمار بن ياسر. لكن الذين لم يقاتلوا معه كانوا أفضل، فإن سعد بن أبي وقاص لم يقاتل معه، ولم يكن قد بقي من الصحابة بعد علي أفضل منه. وكذلك محمد بن مسلمة من الأنصار، وقد جاء في الحديث: " «أن الفتنة لا تضره» " فاعتزل. وهذا مما استدل به على أن القتال كان قتال فتنة بتأويل، لم يكن من الجهاد الواجب ولا المستحب.
وعلي - ومن معه - أولى بالحق من معاوية وأصحابه، كما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: " «تمرق مارقة على خير فرقة من المسلمين، تقتلهم أولى الطائفتين بالحق» " فدل هذا الحديث على أن عليا أولى بالحق ممن قاتله ; فإنه هو الذي قتل الخوارج لما افترق المسلمون، فكان قوم معه وقوم عليه. ثم إن هؤلاء الذين قاتلوه لم يخذلوا، بل ما زالوا
منصورين يفتحون البلاد ويقتلون الكفار.
وفي الصحيح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: " «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة» " قال: " معاذ بن جبل: " وهم بالشام ".
وفي مسلم عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: " «لا يزال أهل الغرب ظاهرين حتى تقوم الساعة» ". قال أحمد بن حنبل وغيره: " أهل الغرب هم أهل الشام ".
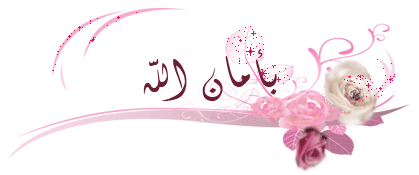
__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟ فبكى رحمه الله ثم قال : أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.
|