
03-01-2023, 01:12 PM
|
 |
قلم ذهبي مميز
|
|
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس : 
المشاركات: 166,520
الدولة : 
|
|
 رد: فتح العليم العلام الجامع لتفسير ابن تيمية الإمام علم الأعلام وشيخ الإسلام
رد: فتح العليم العلام الجامع لتفسير ابن تيمية الإمام علم الأعلام وشيخ الإسلام

فتح العليم العلام الجامع لتفسير ابن تيمية الإمام علم الأعلام وشيخ الإسلام
المؤلف:شيخ الاسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية.
سُورَةُ المائدة
المجلد السادس
الحلقة( 238)
من صــ 261 الى صـ 280
وقوله تعالى:
{وما قتلوه يقينا} [النساء: 157]
معناه: أن نفي قتله هو يقين لا ريب فيه، بخلاف الذين اختلفوا فإنهم في شك منه من قتله وغير قتله فليسوا مستيقنين أنه قتل ; إذ لا حجة معهم بذلك.
ولذلك كانت طائفة من النصارى يقولون: لم يصلب، فإن الذين صلبوا المصلوب هم اليهود، وكان قد اشتبه عليهم المسيح بغيره، كما دل عليه القرآن، وكذلك عند أهل الكتاب أنه اشتبه بغيره فلم يعرفوا من هو المسيح من أولئك حتى قال لهم بعض الناس: أنا أعرفه فعرفوه، وقول من قال: معنى الكلام ما قتلوه علما بل ظنا قول ضعيف.
الوجه الرابع: أنه قال - تعالى:
{إذ قال الله ياعيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا} [آل عمران: 55].
فلو كان المرفوع هو اللاهوت، لكان رب العالمين قال لنفسه أو لكلمته: " إني أرفعك إلي "، وكذلك قوله: بل رفعه الله إليه فالمسيح عندهم هو الله.
ومن المعلوم أنه يمتنع رفع نفسه إلى نفسه، وإذا قالوا: هو الكلمة فهم يقولون مع ذلك إنه الإله الخالق، لا يجعلونه بمنزلة التوراة والقرآن ونحوهما، مما هو من كلام الله الذي قال فيه:
{إليه يصعد الكلم الطيب} [فاطر: 10]
بل عندهم هو الله الخالق الرازق رب العالمين، ورفع رب العالمين إلى رب العالمين ممتنع.
الوجه الخامس: قوله: {وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم} [المائدة: 117] دليل على أنه بعد توفيته لم يكن الرقيب عليهم إلا الله دون المسيح، فإن قوله كنت أنت يدل على الحصر، كقوله: {إن كان هذا هو الحق} [الأنفال: 32] ونحو ذلك، فعلم أن المسيح بعد توفيته ليس رقيبا على أتباعه، بل الله هو الرقيب المطلع عليهم المحصي أعمالهم المجازي عليها، والمسيح ليس برقيب فلا يطلع على أعمالهم ولا يحصيها ولا يجازيهم بها.
سورة المائدة
وقال شيخ الإسلام - قدس الله روحه -:
فصل:
سورة المائدة أجمع سورة في القرآن لفروع الشرائع من التحليل والتحريم والأمر والنهي؛ ولهذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: {هي آخر القرآن نزولا فأحلوا حلالها وحرموا حرامها} ولهذا افتتحت بقوله: {أوفوا بالعقود} والعقود هي العهود وذكر فيها من التحليل والتحريم والإيجاب ما لم يذكر في غيرها والآيات فيها متناسبة مثل قوله: {يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين}. وقد اشتهر في التفسير أن هذه الآية نزلت بسبب الذين أرادوا التبتل من الصحابة مثل عثمان بن مظعون والذين اجتمعوا معه. وفي الصحيحين {حديث أنس في الأربعة الذين قال أحدهم: أما أنا فأصوم لا أفطر.
وقال الآخر: أما أنا فأقوم لا أنام. وقال الآخر: أما أنا فلا أتزوج النساء وقال الآخر: أما أنا فلا آكل اللحم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكني أصوم وأفطر وأتزوج النساء وآكل اللحم فمن رغب عن سنتي فليس مني} فيشبه والله أعلم أن يكون قوله: {لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم} فيمن حرم الحلال على نفسه بقول أو عزم على تركه مثل الذي قال: لا أتزوج النساء ولا آكل اللحم وهي الرهبانية المبتدعة فإن الراهب لا ينكح ولا يذبح.
وقوله: {ولا تعتدوا} فيمن قال: أقوم لا أنام وقال أصوم لا أفطر؛ لأن الاعتداء مجاوزة الحد فهذا مجاوز للحد في العبادة المشروعة كالعدوان في الدعاء في قوله: {ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين}.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم {سيكون قوم يعتدون في الدعاء والطهور} فالاعتداء في " العبادات وفي الورع " كالذين تحرجوا من أشياء ترخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم وفي " الزهد " كالذين حرموا الطيبات وهذان القسمان ترك فقوله: " {ولا تعتدوا} " إما أن يكون مختصا بجانب الأفعال العبادية وإما أن يكون العدوان يشمل العدوان في العبادة والتحريم وهذان النوعان هما اللذان ذم الله المشركين بهما في غير موضع حيث عبدوا عبادة لم يأذن الله بها وحرموا ما لم يأذن الله به فقوله: {لا تحرموا} {ولا تعتدوا} يتناول القسمين.
والعدوان هنا كالعدوان في قوله: {ولا تعاونوا على الإثم والعدوان} إما أن يكون أعم من الإثم وإما أن يكون نوعا آخر وإما أن يكون العدوان في مجاوزة حدود المأمورات واجبها ومستحبها ومجاوزة حد المباح وإما أن يكون في ذلك مجاوزة حد التحريم أيضا فإنها ثلاثة أمور: مأمور به ومنهي عنه ومباح. ثم ذكر بعد هذا قوله: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته} الآية ذكر هذا بعد النهي عن التحريم ليبين المخرج من تحريم الحلال إذا عقد عليه يمينا بالله أو يمينا أخرى وبهذا يستدل على أن تحريم الحلال يمين.
ثم ذكر بعد ذلك ما حرمه من الخمر والميسر والأنصاب والأزلام فبين به ما حرمه فإن نفي التحريم الشرعي يقع فيه طائفة من الإباحية كما يقع في تحريم الحلال طائفة من هؤلاء يكونون في حال اجتهادهم ورياضتهم تحريمية ثم إذا وصلوا بزعمهم صاروا إباحية وهاتان آفتان تقعان في المتعبدة والمتصوفة كثيرا وقرن بينهما حكم الأيمان فإن كلاهما يتعلق بالفم داخلا وخارجا كما يقرن الفقهاء بين كتاب الأيمان والأطعمة وفيه رخصة في كفارة الأيمان مطلقا خلافا لما شدد فيه طائفة من الفقهاء من جعل بعض الأيمان لا كفارة فيها فإن هذا التشديد مضاه للتحريم فيكون الرجل ممنوعا من فعل الواجب أو المباح بذلك التشديد وهذا كله رحمة من الله بنا دون غيرنا من الأمم التي حرم عليهم أشياء عقوبة لهم ولا كفارة في أيمانهم ولم يطهرهم من الرجس كما طهرنا فتدبر هذا فإنه نافع.
(ياأيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محلي الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد (1)
وقال - رحمه الله -:
في قوله تعالى {يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود} قد قيل: إنها ما أمر الله به ورسوله. فإن هذه الآية كتبها النبي صلى الله عليه وسلم في أول الكتاب الذي كتبه لعمرو بن حزم لما بعثه عاملا على نجران وكتاب عمرو فيه الفرائض والديات والسنن الواجبة بالشرع. وقوله للمؤمنين: {واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا} وقد ذكر أهل التفسير أن سبب نزولها مبايعته للأنصار ليلة العقبة فكان النبي صلى الله عليه وسلم واثقهم على ما هو واجب بأمر الله من السمع له والطاعة وذكرهم الله ذلك الميثاق ليوفوا به مع أنه لم يوجب إلا ما كان واجبا بأمر الله. وهذه الآية أمرهم فيها بذكر نعمته عليهم وذكر ميثاقه. فذكر سببي الوجوب؛ لأن الوجوب الثابت بالشرع ثابت بإيجاب الربوبية وهي إنعامه عليهم؛ ولهذا جاء في الحديث: {أحبوا الله لما يغذوكم به من نعمه}. ولهذا كان عادة المصنفين في " أصول الدين " أول ما يذكرون أول نعمة أنعمها الله على عباده وأول ما وجب على عباده ويذكرون " مسألة وجوب شكر المنعم " هل وجب مع الشرع بالعقل أم لا ولهذا كانت طريقة القرآن تذكير العباد بآلاء الله عليهم فإن ذلك يقتضي شكرهم له وهو أداء الواجبات الشرعية.
وقوله: {ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا} الآية. إلى قوله: {فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية} والميثاق على ما هو واجب عليهم من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والإيمان بالرسل وتعزيرهم. وقد أخبر أنه بنقضهم ميثاقهم لعناهم وأقسى قلوبهم؛ لا بمجرد المعصية للأمر فكان في هذا أن عقوبة هذه الواجبات الموثقة بالعهود من جهة النقض أوكد. وقوله: {ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به} والأمر فيهم كذلك. وقوله تعالى {ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين} {فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون} {فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون} فإن كونه في الصالحين واجب والصدقة المفروضة واجبة وقد روي أنها هي المنذورة. وهذا نص في أنه يجب بالنذر ما كان واجبا بالشرع فإذا تركه عوقب لإخلاف الوعد الذي هو النذر فإن النذر وعد مؤكد هكذا نقل عن العرب وهذه الآية تسمى النذر وعدا.
وقوله: {لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل} ورده إلى أبيه كان واجبا عليهم بلا موثق. ومن الحرب المباحة دفع الظالم عن النفوس والأموال والأبضاع المعصومة. وإنما جاءت الرخصة في السلم والحرب خاصة لأن هذين الموطنين مبناهما على تأليف القلوب وتنفيرها فإذا تألفت فهي المسالمة وإذا تنافرت فهي المحاربة والتأليف والتنفير يحصل بالتوهمات كما يحصل بالحقائق؛ ولهذا يؤثر قول الشعر في التأليف والتنفير بحيث يحرك النفوس شهوة ونفرة تحريكا عظيما وإن لم يكن الكلام منطبقا على الحق؛ لكن لأجل تخييل أو تمثيل. فلما كانت المسالمة والمحاربة الشرعية يقوم فيها التوهم لما لا حقيقة له مقام توهم ما له حقيقة ولم يكن في المعارض إلا الإيهام بما لا حقيقة له والناطق لم يعن إلا الحق صار ذلك حقا وصدقا عند المتكلم وموهما للمستمع توهما يؤلفه تأليفا يحبه الله ورسوله أو ينفره تنفيرا يحبه الله ورسوله بمنزلة تأليفه وتنفيره بالأشعار التي فيها تخييل وتمثيل وبمنزلة الحكايات التي فيها الأمثال المضروبة. فإن الأمثال المنظومة والمنثورة إذا كانت حقا مطابقا فهي من الشعر الذي هو حكمة وإن كان فيها تشبيهات شديدة وتخييلات عظيمة أفادت تأليفا وتنفيرا.
(وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب (2)
(فصل: هل الأفضل للسالك العزلة أو الخلطة)
قال الشيخ - رحمه الله -:
وأما قوله: هل الأفضل للسالك العزلة أو الخلطة؟ فهذه " المسألة " وإن كان الناس يتنازعون فيها؟ إما نزاعا كليا وإما حاليا. فحقيقة الأمر: أن " الخلطة " تارة تكون واجبة أو مستحبة والشخص الواحد قد يكون مأمورا بالمخالطة تارة وبالانفراد تارة. وجماع ذلك: أن " المخالطة " إن كان فيها تعاون على البر والتقوى فهي مأمور بها وإن كان فيها تعاون على الإثم والعدوان فهي منهي عنها فالاختلاط بالمسلمين في جنس العبادات: كالصلوات الخمس والجمعة والعيدين وصلاة الكسوف والاستسقاء ونحو ذلك هو مما أمر الله به ورسوله.
وكذلك الاختلاط بهم في الحج وفي غزو الكفار والخوارج المارقين وإن كان أئمة ذلك فجارا وإن كان في تلك الجماعات فجار وكذلك الاجتماع الذي يزداد العبد به إيمانا: إما لانتفاعه به وإما لنفعه له ونحو ذلك. ولا بد للعبد من أوقات ينفرد بها بنفسه في دعائه وذكره وصلاته وتفكره ومحاسبة نفسه وإصلاح قلبه وما يختص به من الأمور التي لا يشركه فيها غيره فهذه يحتاج فيها إلى انفراده بنفسه؛ إما في بيته، كما قال طاوس: نعم صومعة الرجل بيته يكف فيها بصره ولسانه، وإما في غير بيته. فاختيار المخالطة مطلقا خطأ واختيار الانفراد مطلقا خطأ.
وأما مقدار ما يحتاج إليه كل إنسان من هذا وهذا وما هو الأصلح له في كل حال فهذا يحتاج إلى نظر خاص كما تقدم.
وكذلك " السبب وترك السبب ": فمن كان قادرا على السبب ولا يشغله عما هو أنفع له في دينه فهو مأمور به مع التوكل على الله وهذا خير له من أن يأخذ من الناس ولو جاءه بغير سؤال، وسبب مثل هذا عبادة الله، وهو مأمور أن يعبد الله ويتوكل عليه فإن تسبب بغير نية صالحة أو لم يتوكل على الله فهو غير مطيع في هذا وهذا، وهذه غير طريق الأنبياء والصحابة.
وأما من كان من الفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف فهذا إما أن يكون عاجزا عن الكسب أو قادرا عليه بتفويت ما هو فيه أطوع لله من الكسب ففعل ما هو فيه أطوع هو المشروع في حقه وهذا يتنوع بتنوع أحوال الناس.
وقد تقدم أن الأفضل يتنوع " تارة " بحسب أجناس العبادات كما أن جنس الصلاة أفضل من جنس القراءة، وجنس القراءة أفضل من جنس الذكر، وجنس الذكر أفضل من جنس الدعاء. و " تارة " يختلف باختلاف الأوقات كما أن القراءة والذكر والدعاء بعد الفجر والعصر هو المشروع دون الصلاة. و " تارة " باختلاف عمل الإنسان الظاهر كما أن الذكر والدعاء في الركوع والسجود هو المشروع دون القراءة وكذلك الذكر والدعاء في الطواف مشروع بالاتفاق وأما القراءة في الطواف ففيها نزاع معروف. و " تارة " باختلاف الأمكنة: كما أن المشروع بعرفة ومزدلفة وعند الجمار وعند الصفا والمروة هو الذكر والدعاء دون الصلاة ونحوها، والطواف بالبيت للوارد أفضل من الصلاة، والصلاة للمقيمين بمكة أفضل.
و " تارة " باختلاف مرتبة جنس العبادة: فالجهاد للرجال أفضل من الحج وأما النساء فجهادهن الحج، والمرأة المتزوجة طاعتها لزوجها أفضل من طاعتها لأبويها؛ بخلاف الأيمة فإنها مأمورة بطاعة أبويها. و " تارة " يختلف باختلاف حال قدرة العبد وعجزه: فما يقدر عليه من العبادات أفضل في حقه مما يعجز عنه وإن كان جنس المعجوز عنه أفضل وهذا باب واسع يغلو فيه كثير من الناس ويتبعون أهواءهم. فإن من الناس من يرى أن العمل إذا كان أفضل في حقه لمناسبة له ولكونه أنفع لقلبه وأطوع لربه يريد أن يجعله أفضل لجميع الناس ويأمرهم بمثل ذلك. والله بعث محمدا بالكتاب والحكمة وجعله رحمة للعباد وهديا لهم يأمر كل إنسان بما هو أصلح له فعلى المسلم أن يكون ناصحا للمسلمين يقصد لكل إنسان ما هو أصلح له.
وبهذا تبين لك أن من الناس من يكون تطوعه بالعلم أفضل له ومنهم من يكون تطوعه بالجهاد أفضل ومنهم من يكون تطوعه بالعبادات البدنية - كالصلاة والصيام - أفضل له والأفضل المطلق ما كان أشبه بحال النبي صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا. فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه وتعالى أعلم.
(حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم ... (3)
وسئل - رحمه الله -:
عن " الغنم والبقر " ونحو ذلك إذا أصابه الموت وأتاه الإنسان هل يذكي شيئا منه وهو متيقن حياته حين ذبحه وأن بعض الدواب لم يتحرك منه جارحة حين ذكاته: فهل الحركة تدل على وجود الحياة وعدمها يدل على عدم الحياة أم لا؟ فإن غالب الناس يتحقق حياة الدابة عند ذبحها وإراقة دمها ولم تتحرك فيقول: إنها ميتة فيرميها؟ وهل الدم الأحمر الرقيق الجاري حين الذبح يدل على أن فيها حياة مستقرة والدم الأسود الجامد القليل دم الموت أم لا؟ وما أراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: " {ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا}؟
فأجاب:
الحمد لله رب العالمين، قال الله تعالى: {حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم}. وقوله تعالى: {إلا ما ذكيتم} عائد إلى ما تقدم: من المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وأكيلة السبع: عند عامة العلماء؛ كالشافعي وأحمد بن حنبل وأبي حنيفة وغيرهم فما أصابه قبل أن يموت أبيح. لكن تنازع العلماء فيما يذكى من ذلك. فمنهم من قال: ما تيقن موته لا يذكى كقول مالك ورواية عن أحمد. ومنهم من يقول: ما يعيش معظم اليوم ذكي. ومنهم من يقول: ما كانت فيه حياة مستقرة ذكي كما يقوله من يقوله من أصحاب الشافعي وأحمد. ثم من هؤلاء من يقول: الحياة المستقرة ما يزيد على حركة المذبوح.
ومنهم من يقول: ما يمكن أن يزيد على حياة المذبوح. والصحيح: أنه إذا كان حيا فذكي حل أكله ولا يعتبر في ذلك حركة مذبوح؛ فإن حركات المذبوح لا تنضبط؛ بل فيها ما يطول زمانه وتعظم حركته. وقد قال صلى الله عليه وسلم " {ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا} فمتى جرى الدم الذي يجري من المذبوح الذي ذبح وهو حي حل أكله. والناس يفرقون بين دم ما كان حيا ودم ما كان ميتا؛ فإن الميت يجمد دمه ويسود؛ ولهذا حرم الله الميتة؛ لاحتقان الرطوبات فيها؛ فإذا جرى منها الدم الذي يخرج من المذبوح الذي ذبح وهو حي حل أكله؛ وإن تيقن أنه يموت؛ فإن المقصود ذبح ما فيه حياة فهو حي وإن تيقن أنه يموت بعد ساعة. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه تيقن أنه يموت وكان حيا جازت وصيته وصلاته وعهوده.
وقد أفتى غير واحد من الصحابة رضي الله عنهم بأنها إذا مصعت بذنبها أو طرفت بعينها أو ركضت برجلها بعد الذبح؛ حلت؛ ولم يشرطوا أن تكون حركتها قبل ذلك أكثر من حركة المذبوح. وهذا قاله الصحابة لأن الحركة دليل على الحياة والدليل لا ينعكس فلا يلزم إذا لم يوجد هذا منها أن تكون ميتة؛ بل قد تكون حية وإن لم يوجد منها مثل ذلك. والإنسان قد يكون نائما فيذبح وهو نائم ولا يضطرب وكذلك المغمى عليه يذبح ولا يضطرب وكذلك الدابة قد تكون حية فتذبح ولا تضطرب لضعفها عن الحركة وإن كانت حية؛ ولكن خروج الدم الذي لا يخرج إلا من مذبوح وليس هو دم الميت دليل على الحياة. والله أعلم.
[فصل: ما ذبح على النصب]
وأيضا، فإنه سبحانه حرم ما ذبح على النصب، وهي كل ما ينصب ليعبد من دون الله تعالى.
وأما احتجاج أحمد على هذه المسألة بقوله تعالى {ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه} [الأنعام: 121] فحيث اشترطت التسمية في ذبيحة المسلم؛ هل تشترط في ذبيحة الكتابي؟ على روايتين: وإن كان الخلال هنا قد ذكر عدم الاشتراط، فاحتجاجه بهذه الآية يخرج على إحدى الروايتين. فلما تعارض العموم الحاظر، وهو قول الله تعالى: {وما أهل به لغير الله} [البقرة: 173] والعموم المبيح، وهو قوله:
{وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم} [المائدة: 5] اختلف العلماء في ذلك.
والأشبه بالكتاب والسنة: ما دل عليه أكثر كلام أحمد من الحظر، وإن كان من متأخري أصحابنا من لم يذكر هذه الرواية بحال؛ وذلك لأن عموم قوله تعالى: {وما أهل لغير الله به وما ذبح على النصب} [المائدة: 3] عموم محفوظ لم تخص منه صورة، بخلاف طعام الذين أوتوا الكتاب، فإنه يشترط له الذكاة المبيحة فلو ذكى الكتابي في غير المحل المشروع لم تبح ذكاته، ولأن غاية الكتابي: أن تكون ذكاته كالمسلم، والمسلم لو ذبح لغير الله، أو ذبح باسم غير الله لم يبح، وإن كان يكفر بذلك، فكذلك الذمي؛ لأن قوله تعالى: {وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم} [المائدة: 5] سواء، وهم وإن كانوا يستحلون هذا، ونحن لا نستحله فليس كل ما استحلوه حل ولأنه قد تعارض دليلان، حاظر ومبيح، فالحاظر: أولى. ولأن الذبح لغير الله، وباسم غيره، قد علمنا يقينا أنه ليس من دين الأنبياء عليهم السلام، فهو من الشرك الذي أحدثوه، فالمعنى الذي لأجله حلت ذبائحهم، منتف في هذا. والله أعلم.
فإن قيل: أما إذا سموا عليه غير الله بأن يقولوا: باسم المسيح ونحوه، فتحريمه ظاهر، أما إذا لم يسموا أحدا، ولكن قصدوا الذبح للمسيح،أو للكوكب ونحوها، فما وجه تحريمه؟
قيل: قد تقدمت الإشارة إلى ذلك. وهو أن الله سبحانه قد حرم ما ذبح على النصب، وذلك يقتضي تحريمه، وإن كان ذابحه كتابيا، لأنه لو كان التحريم لكونه وثنيا، لم يكن فرق بين ذبحه على النصب وغيرها، ولأنه لما أباح لنا طعام أهل الكتاب، دل على أن طعام المشركين حرام، فتخصيص ما ذبح على الوثن يقتضي فائدة جديدة.
وأيضا: فإنه ذكر تحريم ما ذبح على النصب، وما أهل به لغير الله؛ وقد دخل فيما أهل به لغير الله ما أهل به أهل الكتاب لغير الله فكذلك كل ما ذبح على النصب، فإذا ذبح الكتابي على ما قد نصبوه من التماثيل في الكنائس، فهو مذبوح على النصب، ومعلوم أن حكم ذلك لا يختلف بحضور الوثن وغيبته، فإنما حرم لأنه قصد بذبحه عبادة الوثن وتعظيمه، وهذه الأنصاب قد قيل: هي من الأصنام، وقيل: هي غير الأصنام.
قالوا: كان حول البيت ثلاثمائة وستون حجرا، كان أهل الجاهلية يذبحون عليها، ويشرحون اللحم عليها، وكانوا يعظمون هذه الحجارة، ويعبدونها، ويذبحون عليها، وكانوا إذا شاءوا بدلوا هذه الحجارة بحجارة هي أعجب إليهم منها.
ويدل على ذلك قول أبي ذر في حديث إسلامه: "حتى صرت كالنصب الأحمر " يريد أنه كان يصير أحمر من تلوثه بالدم.
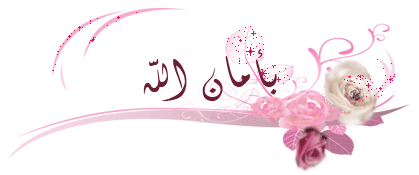
__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟ فبكى رحمه الله ثم قال : أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.
|