|
|||||||
| فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام |
 |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#21
|
||||
|
||||
|
تواليف مالكية مهمة شهاب الدين الإدريسي  تواليف مالكية مهمة 22: الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار .. لابن عبد البر الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار، وعلماء الأقطار، فيما تضمّنه الموطأ من معاني الآثار، وشرح ذلك كلّه بالإيجاز والاختصار يعدّ كتاب الاستذكار لحافظ المغرب أبي عمر يوسف بن عبد البر النمري (تـ463هـ) من أفضل شروح موطأ الإمام مالك وأكثرها بسطاً، وأجداها نفعاً، وأدقّها منهجاً، وأغزرها فائدة. ولا نكون مبالغين إن قلنا إن كتاب الاستذكار أحسن ما ألّف في فقه حديث موطأ الإمام مالك على الإطلاق، فمؤلّفه أحفظ علماء المغرب والأندلس في زمانه، وأعلمهم بالسنن والآثار، وأعرفهم باختلاف علماء الأمصار، والناس إلى اليوم يتسابقون إلى النهل من علمه، ويتنافسون في الحصول على تآليفه، فقد كان ـ رحمه الله ـ من بحور العلم؛ إماماً، ديّنا، ثقةً، متقناً، محدّثاً، فقيهاً، مفسّراً، أصولياً، أديباً، طَرَق بكتاباته ميادين مختلفة، ذاع صيته، واشتهر ذكره، وكثر طلبته، وأطبق العلماء على تزكيته والثناء عليه، فما استطاعوا أن يوفوه حقّه بما خدم به الإسلام والمسلمين؛ قال ابن سعيد الأندلسي: «إمام الأندلس في علم الشريعة ورواية الحديث، لا أستثني من أحد، وحافظها الذي جاز خصل السبق واستولى على غاية الأمد، وانظر إلى آثاره، تغنك عن أخباره، وشاهد ما أورد في تمهيده واستذكاره، وعلمه بالأنساب، يفصح عنه ما أورده في الاستيعاب، مع أنه في الأدب فارس، وكفاك على ذلك دليلا كتاب بهجة المجالس، وبالأفق الداني ظهر علمه، وعند ملوكه خفق علمه». وكتاب «الاستذكار» من جملة تآليف ابن عبد البر التي جازت حدود الشُّهرة والقَبول، ويعود سبب تأليفه إلى ما ذكر هو نفسه في مقدّمة كتابه أن جماعة من أهل العلم وطلبته سألته أن يجعل لهم كتاب التمهيد على أبواب الموطأ ونسقه، ويحذف لهم منه تكراره وشواهده وطرقه، وأن يستوعب لهم شرح جميع ما في الموطأ من مسند ومرسل وأقوال الصحابة والتابعين، وما لمالك فيه من قول. وهذا يوضّح صلة «الاستذكار» بـ«التمهيد»، فالكتابان مرتبطان ارتباطا وثيقاً؛ حيث إنّ محور ارتكازهما «الموطأ»، ويشتركان في أنّ كلاّ منهما يعرض الأحكام المستنبطة من الأحاديث وآراء الفقهاء عرضا مقارنا بين المذاهب، غير أن الاستذكار نحا فيه المؤلّف إلى الإيجاز والاختصار وطرح ما في الشواهد من التكرار، وزاد فيه شرح ما لم يشترطه في التمهيد من أقوال الصحابة والتابعين، وأئمّة السلف، وفقهاء المذهب، وتفصيل اختيارات الإمام مالك ـ رحمه الله ـ، وقد بنى كلّ ذلك على نسق الموطأ وأبوابه باباً باباً، أما في «التمهيد» فقد تعرّض لفقه الحديث واستنباطاته، وآراء الفقهاء، إلاّ أنّه أولى عناية خاصة بالمسند والمرفوع والمرسل من أحاديث الموطأ، وأحوال الرواة وأنسابهم. فنجده في «الاستذكار» يأتي إلى حديث الموطأ برواية يحيى بن يحيى، فيفصّل في الإسناد، ويحيل على التمهيد لمن أراد البسط، ويذكر اختلاف الناقلين لهذا الحديث، ويشرح ألفاظه من شواهد العربية، وما يستنبط منه من المعاني، ثم يذكر اختلاف أصحاب مالك في المسألة، ويتبعها باستعراض أقوال بقية فقهاء الأمصار، مع مناقشة أدلة كلّ فريق، وبيان الراجح من المرجوح. وقد كان معتمده ـ رحمه الله ـ في جلّ ذلك على المصادر الشفوية التي تلقاها وفق طُرق التحمّل المعروفة، مع اعتماده على مصادر المذهب المشهورة مثل «المدونة»، و«الواضحة»، وغيرها، بيد أنّه لم يكن مالكيا مقلداً؛ إذ كان في كتابه مجتهدا مطلقاً له طريقته الخاصة في الفقه والاستنباط، واعتماد كتب المذاهب كلّها، جاعلاً أساس المسائل عنده هو الدّليل. إنّ كل من تعرّض لشرح أحاديث «الموطأ» اعتمد على كتاب «الاستذكار»؛ فبدر العيني الحنفي (تـ855هـ) ينقل عنه فقرات مطولة في شرحه للبخاري المسمى «عمدة القاري»، ونقل عنه أيضا ابن التركماني صاحب «الجوهر النقي في اختصار السنن الكبرى للبيهقي»، ومن عناية العلماء به صنيع ابن زرقون (تـ 586هـ) حينما جمع بينه وبين المنتقى للباجي في تصنيفه الموسوم بـ«الأنوار في الجمع بين المنتقى والاستذكار»، وكذلك صنع محمد بن عبد الحق التلمساني (تـ625هـ) في تصنيفه «المختار الجامع بين المنتقى والاستذكار»، واعتمده كثيراً الإمام محمد بن عبد الباقي الزرقاني (تـ1122هـ) في شرحه لأحاديث الموطأ، ولعلي بن إبراهيم المعروف بابن القناص (تـ632هـ) اختصار كتاب الاستذكار. وحضي «الاستذكار» أيضا بعناية فائقة من لدُن الباحثين المعاصرين مثل كتاب سالم شيخي: «اختيارات الإمام ابن عبد البر الفقهية من خلال كتابه التمهيد والاستذكار»، وغيره. وما هذه العناية بالكتاب إلاّ لما أودعه في مصنّفه من عصارة فكره وفقهه، وبديع استنباطه وفهمه، قال ابن كثير ـ رحمه الله ـ: «وقد اعتنى الناس بكتابه ـ يقصد الإمام مالك ـ وعلّقوا عليه كتبا جمّة، ومن أجود ذلك كتابي: «التمهيد»، و«الاستذكار» للشيخ أبي عمر ابن عبد البر النمري القرطبي رحمه الله». ونشير هنا إلى أن الكتاب قد طبع بالقاهرة سنة 1971م، عن المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في جزئين بتحقيق علي النجدي ناصف، ثم صدر بعد ذلك كاملا في 30 مجلداً سنة 1993م، عن دار الوعي بحلب ودار قتيبة بدمشق، بتحقيق عبد المعطي قلعجي. ----------------------------------- جذوة المقتبس للحميدي (367)، الصلة لابن بشكوال (2/677)، بغية الملتمس للضبي (489)، وفيات الأعيان لابن خلّكان(7/71) لتحميل الكتاب لا اله الا الله
__________________
|
|
#22
|
||||
|
||||
|
تواليف مالكية مهمة شهاب الدين الإدريسي 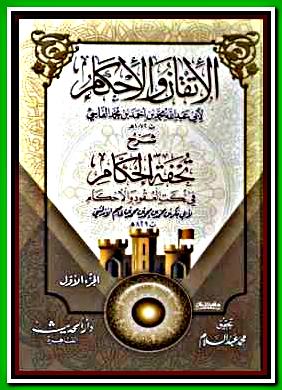 تواليف مالكية مهمة 23: الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام تعد منظومة تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام، المسماة بالعاصمية للإمام العالم المجاهد أبي بكر محمد بن محمد ابن عاصم الغرناطي (ت 829هـ)، من أجلّ وأبرز ما ألف في علم الوثائق والإبرام؛ لسلامة نظمها، ووجازة لفظها، ولكونها قد اجتمع فيها ما افترق في غيرها، ولأهميتها اشتغل عليها أهل العلم بالشرح والبيان، وإزالة اللبس والإبهام، فوضعت عليها شروح عديدة من لدن المغاربة والمشارقة. وشكل كتاب الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام للإمام محمد بن أحمد ميارة الفاسي (ت 1072هـ) أهم وأبرز وأجود الشروح التي وضعت على العاصمية، إذ أتى فيه على جميع أبيات المنظومة – التي بلغت1668 بيتا-، شرحا وتفصيلا، وبيانا وتعليلا، مستفيدا في ذلك مما سبقه من شروح، ومما حصّله من علوم وفنون؛ فهو الإمام، العلامة، الفقيه، النوازلي، المالكي، حامل لواء المذهب: أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد الفاسي، المشهور بميارة الكبير، صاحب التآليف العديدة في الفقه المالكي. وقد ألف كتابه هذا استجابة لطلب من بعض أصحابه، ممن عاين واطلع على تقييداته وحواشييه التي وضعها على ما سبقه من شروح لمتن العاصمية، فقبل الطلب، ووضع الشرح، وأبرز فيه ما جمعه من نكت وتحريرات. وافتتح الشيخ ميارة الكبير شرحه بمقدمة- ينسبها العلامة محمد الصغير الإفراني في كتابه صفوة من انتشر إلى تلميذه أبي سالم العياشي-، مهّد فيها لأهمية علم أحكام القضاء، واهتمام العلماء به، وامتدح فيها منظومة ابن عاصم الغرناطي، واعتبرها من أجل ما وضع في هذا العلم من المختصرات، وذكر ما نسج حولها من شروح بدءا بشرح أبي يحيى ابن عاصم ولد صاحب المنظومة، ومرورا بشرح أبي العباس اليرتاسني التلمساني، وانتهاءا بشرح لأحد أئمة المالكية بمصر، وكل هذه الشروح كما يقول: أغفلت عن حل مقفلات العاصمية، ولم تشف غليلاً في النقل، ولم تبرئ عليلاً من داء الجهل، فلذلك وضع شرحه اعتمادا على ما نكته وحرره حول هذه الشروح، فتناول فيه جميع أبيات العاصمية بالشرح والتعليل، وقسمه إلى سبعة عشر بابا: بدأه بباب القضاء وما يتعلق به، وختمه بباب التوارث والفرائض، وتحت كل باب جملة من الفصول. واستوفى الشيخ ميارة معاني الأبيات بالشرح والبيان، مع اقتصاد في العبارة؛ فلم يكن شرحه بالطويل الممل، ولا بالمختصر المخل، ولم يتوان في عرض الأدلة المعضدة لنظم ابن عاصم، مع طغيان الطابع النقلي على هذه الأدلة، وسعى في منهجه إلى إيراد كل ما يحتاجه الناظر من النقل، من إيراد لكلام الله عز وجل، وأقوال رسوله صلى الله عليه وسلم، إذا اقتضاهما المقام، إلى عرض لأغلب أقوال أئمة المذهب المالكي، وغيرهم، من أصولها المحررة بدءا من أقوال مالك وتلاميذه، مرورا بفطاحل المذهب أمثال: ابن رشد، واللخمي، والباجي، وابن العربي، وخليل، وابن الحاجب، وغيرهما، انتهاءا بمعاصريه وخاصة شيوخه الذين أخذ عنهم، هذا ولم يغفل الشيخ ميارة أن يعتني بالمعقول من الأدلة، وشرح المصطلحات الفقهية والأصولية، مثل القضاء، والنكاح، والوكالة، والضمان، والركن، والشرط، وغير ذلك من المصطلحات، وكذا إيراد القواعد الفقهية، والمقاصد الشرعية، ليستعين بها المناظر، اعتبارا للمقام الذي يشرحه، فالمنظومة العاصمية منظومة أحكام وقواعد. واعتمد الشارح في عرض مادته على أسلوب موحد واضح، استفاد فيه ممن سبقه من شراح العاصمية، فتجنب التكلف، وتوخى من خلاله تبيين العبارة حتى يتضح معناها للعقل، فهو يذيل شرحه لكل بيتين أو ثلاثة، غالباً بفوائد وتنبيهات وتحقيقات مفيدة، ولعل الشيخ ميارة أدرك قيمة شرحه حينما اعتبره:«شرحاً بمقصود طالبه وافياً، وبسهم صائب في مؤلفات الفقه رامياً». أما عن مصادر الشيخ في إيراد مادة كتابه، فيمكن القول أنه صال وجال في معظم المصادر الفقهية المالكية، بل وتعداها إلى المذاهب الأخرى، وخاصة الشافعية، واعتنى بإيراد أقوال الإمام مالك، وكبار أئمة مذهبه كابن القاسم، وابن حبيب، وابن عبد الحكم، واللخمي، وابن رشد، وابن أبي زمنين، وابن شاس، وخليل، وابن الحاجب، والعز ابن عبد السلام، وغيرهم، مما يفسر كثرة النقول الواردة في الكتاب. ومما يوضح أهمية هذا الكتاب احتفاء العلماء به ونهلهم منه، إذ نقف على نقول منه في مؤلفات مالكية عديدة، منها: حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني لعلي العدوي (ت 1189 هـ)، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير لمحمد الدسوقي (ت 1230 هـ)، والبهجة في شرح التحفة لأبي الحسن علي التسولي (ت 1258 هـ)، ومنح الجليل لمحمد عليش (ت 1299 هـ)، وغيرها، كما اعتنى به أهل العلم من جهة التأليف عليه، فوضعت عليه حواشي، منها حاشية قاضي فاس العلامة أبو علي الحسن بن رحال التدلاوي (ت 1140 هـ)، وحاشية الفقيه المفسر أبو عبد الله محمد بن الحسن الجنوي الحسني (ت1200هـ). طبع الكتاب عن دار الفكر في مجلدين، الطبعة الأولى، وله عدة طبعات أخرى، منها طبعة المكتبة التجارية بمصر، وطبعة دار المعرفة- بيروت، وطبعة دار الكتب العلمية- بيروت. -------------------------------------------- نشر المثاني: (2/120-121)، صفوة من انتشر: (250-251)، سلوة الأفاس: (1/165) لتحميل الكتاب مجلد 1 مجلد 2
__________________
|
|
#23
|
||||
|
||||
|
تواليف مالكية مهمة شهاب الدين الإدريسي تواليف مالكية مهمة 24: اختلاف أقوال مالك وأصحابه  اختلاف أقوال مالك وأصحابه لأبي عمر يوسف بن عبد البر النمري الأندلسي(ت463هـ) يمثل الخلاف الفقهي مرتبة عالية ضمن درجات سلم علم الفقه، فهو يحكي مختلف أقوال الفقهاء، ويذكر آراءهم في المسألة الواحدة، ويستوعب جميع المذاهب الفقهية المعتبرة، وقد يكون التأليف في الخلاف الفقهي داخل المذهب الواحد إذا تعددت الأقوال والروايات عن صاحب ذلك المذهب، كما هو الشأن بالنسبة لكتاب «اختلاف أقوال مالك وأصحابه» للإمام الحافظ أبي عمر يوسف بن عبد البر النَّمَرِي الأندلسي (ت463هـ) الذي قصد فيه مؤلفه إلى إبراز الخلاف بين الإمام مالك بن أنس وتلامذته، وتأتي أهمية هذا الكتاب كونه من أهم كتب الخلاف الفقهي في المذهب المالكي، وزاد في قيمته كونه من تأليف الحافظ ابن عبد البر النَّمَري القرطبي الإمام المحدث الكبير الذي يعتبر أحد أساطين المذهب المالكي في عصره، وكبير رجال مدرسة الحديث بالأندلس في القرن الخامس الهجري. ومن أسف أن الكتاب الذي نتحدث عنه لم يصل إلينا تاما، فهناك قطعتان منه؛ أولاهما في المكتبة الوطنية بالرباط تحمل رقم: (3369ك)، والثانية بخزانة الجامع الكبير بمكناس تحمل رقم: (387=554)، ونشرت القطعة الأولى قبل سنوات، وهي من أول الكتاب، وتشتمل على مقدمة المؤلف، وكتاب الوضوء، وجزء من كتاب الصلاة. وبالنظر في مقدمة الكتاب نجد المؤلف ينبه إلى أنه اقتصر فيه على ذكر ما حضره من أقوال مالك وأصحابه في مشكلات الفقه والأحكام، ولم يستوعب فيه كتب المالكية لأنه ترك ذلك لمؤلَّف يضم ذلك كله، وطريقته أنه يُعَنْوِن للمسألة التي يريد مناقشتها ثم يورد تحتها أقوال العلماء مجردة بحيث لم يُلزم نفسه التماس الأدلة لكل فريق، ومن غير أن يرجح بين هذا القول، أو ذاك إلا في النادر، فهو هنا مجرد ناقل للأقوال، على خلاف طريقته في «الاستذكار» و«التمهيد» حيث يطلق العنان لفكره وحفظه؛ فيسند الأحاديث والآثار، ويحكم على الرواة جرحا وتعديلا، ويشرح الغريب بينما لم يفعل ذلك في هذا الكتاب، وهذا من دقة منهجه رحمه الله في كل كتاب، وغالبا ما يُصَدِّر بالقول الموجود في المدونة، ثم يعقبه بالأقوال الأخرى، فينسب كل قول لصاحبه، أو يصرح بمصدره، وعلى الرغم من كونه سلك فيه سبيل الاختصار فإن الكتاب يعتبر مصدرا مهما، وديوانا جامعا لا يقل أهمية عن باقي الكتب في هذا الباب مثل «النوادر والزيادات» لابن أبي زيد، و«البيان والتحصيل» لابن رشد، وغيرهما من المصنفات الجامعة لأقوال فقهاء المالكية الأوائل كابن وهب(ت197هـ)، وأشهب(ت204هـ)، وابن نافع(206هـ)، وابن الماجشون(ت212هـ)، وابن عبد الحكم(ت214هـ)، ومطرف(ت220هـ)، وابن حبيب(ت238هـ)، والعُتْبي(ت255هـ) وغيرهم، ومن بعدهم كيحيى ابن إسحاق بن يحيى الأندلسي (ت303هـ)، وابن زَرْب (ت381هـ)، وأبي بكر الأبهري (ت395هـ)، وغيرهم، وقد سبَك ابن عبد البر مادةَ كتابه بأسلوب سهل يوائم مقصده من الكتاب الذي هو الاختصار. صدرت قطعة من الكتاب كما سبقت الإشارة إليه بتحقيق د.حميد محمد لحمر، ود.مِيكْلُوش مُورَاني، وصدرت طبعته الأولى عن دار الغرب الإسلامي ببيروت، سنة 2003م. ------------------------------------- جذوة المقتبس(ص586)، ترتيب المدارك (8/127)، الصلة (2/640)، بغية الملتمس (ص589) للتحميل لا اله الا الله ابن عبد البر المؤلف كتاب إختلاف أقوال مالك وأصحابه والمؤلف لـ 72 كتب أخرى. أبو عمر يوسف بن عبد الله النمري المعروف بابن عبد البر (368 هـ - 463 هـ) إمام وفقيه مالكي ومحدث ومؤرخ أندلسي، له العديد من التصانيف والكتب. سيرته ولد أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم في قرطبة، لأسرة من بني النمر بن قاسط في 25 ربيع الآخر 368 هـ. كان أبوه عبد الله فقيهًا، ومن أهل العلم في قرطبة. نشأ ابن عبد البر بقرطبة، وتعلّم الفقه والحديث واللغة والتاريخ من شيوخها، فدرس على يد أبي محمد عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أسد الجهني وأبي عمر أحمد بن محمد بن الجسور وأبي عمر أحمد بن عبد الله الباجي وأبي الوليد بن الفرضي الذي أخذ عنه الكثير من علم الحديث وقرأ عليه مسند مالك وأبي عمر الطلمنكي المقرئ. ولزم ابن عبد البر أبي عمر أحمد بن عبد الملك بن هاشم الفقيه الإشبيلي وطلب عنده الفقه، وسمع من أبي محمد عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن سنن أبي داود و«الناسخ والمنسوخ» لأبي داود ومسند أحمد، وقرأ على محمد بن عبد الملك بن ضيفون تفسير محمد بن سنجر، وقرأ على أبي القاسم عبد الوارث بن سفيان «الموطأ الصغير» لابن وهب بروايته عن قاسم بن أصبغ عن ابن وضاح عن سحنون وغيره عن ابن وهب. وسمع من سعيد بن نصر موطأ مالك و«المشكل» لابن قتيبة ومسند الحميدي. وسمع من الحافظ أبي القاسم خلف بن القاسم بن سهل تصنيف عبد الله بن عبد الحكم، وسمع من الحسين بن يعقوب البجاني. وقرأ على عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد الوهراني «موطأ ابن القاسم»، وسمع من يحيى بن عبد الرحمن بن وجه الجنة ومحمد بن رشيق المكتب وأحمد بن القاسم التاهرتي وأبي حفص عمر بن حسين بن نابل ومحمد بن خليفة الإمام وأبي زكريا الأشعري وأحمد بن فتح بن الرسّان وأبي المطرف القُنازعي والقاضي يونس بن عبد الله وأبي عمر أحمد بن عبد الملك بن المكوي وأبي عبد الله محمد بن عمروس القرطبي. برع ابن عبد البر في في علوم الحديث والرجال والقراءات والخلاف في الفقه. وكان ابن عبد البر في بدايته ظاهريًا، ثم تحول إلى المالكية مع ميل إلى فقه الشافعي في مسائل. وألف الكثير من التصانيف والكتب في مختلف العلوم ومنها «التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» الذي قال عنه ابن حزم: «وهو كتاب لا أعلم في الكلام على فقه الحديث مثله، فكيف أحسن منه؟ » و«الاستيعاب في معرفة الأصحاب» الذي قال عنه الضبي في كتابه «بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس»: «هو كتاب في أسماء المذكورين في الروايات والسير والمصنفات من الصحابة رضي الله عنهم والتعريف بهم وتلخيص أحوالهم ومنازلهم وعيون أخبارهم على حروف المعجم في أربعة أسفار، وهو كتاب حسن كثير الفائدة، رأيت أهل المشرق يستحسنونه جدًا ويُقدّمونه على ما ألف في بابه » و«جامع بيان العلم وفضله ومما ينبغي في روايته وحمله» و«الدرر في اختصار المغازي والسير» و«الشواهد في إثبات خبر الواحد» و«التقصي لما في الموطأ من حديث رسول الله » و«أخبار أئمة الأمصار» و«البيان في تلاوة القرآن» و«التجويد والمدخل إلى علم القرآن بالتجويد» و«الاكتفاء في قراءة نافع وأبي عمرو بن العلا بتوجيه ما اختلفا فيه» و«الكافي في الفقه على مذهب أهل المدينة» و«اختلاف أصحاب مالك بن أنس واختلاف رواياتهم عنه» و«العقل والعقلاء وما جاء في أوصافهم عن الحكماء والعلماء» و«بهجة المجالس وأنس المجالس بما يجري في المذكرات من غرر الأبيات ونوادر الحكايات» الذي اختصره ابن ليون التجيبي وسماه «بغية المؤانس من بهجة المجالس» و«الاستذكار لمذاهب علماء الأمصار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار» و«القصد والأمم في التعريف بأصول أنساب العرب والعجم» و«الإنباه على قبائل الرواة» و«الانتقاء لمذاهب الثلاثة العلماء مالك وأبي حنيفة والشافعي» و«الأجوبة الموعبة في الأسئلة المستغربة» و«الكنى» و«الإنصاف فيما في بسم الله من الخلاف» و«الفرائض» و«شرح زهديات أبي العتاهية» و«تجريد التمهيد في الموطأ من المعاني والأسانيد» و«الانصاف فيما بين العلماء من الاختلاف» و«نزهة المستمتعين وروضة الخائفين» و«ذكر التعريف بجماعة من الفقهاء أصحاب مالك». كاتب ابن عبد البر علماء من أهل المشرق، فأجاز له أبو القاسم السقطي المكي وعبد الغني بن سعيد الحافظ وأبو ذر الهروي وأبو محمد بن النحاس المصري وأبو الفتح بن سيبخت وأحمد بن نصر الداودي. وقد حدّث عن ابن عبد البر الكثيرون منهم أبو الحسن طاهر بن مفوز المعافري وأبو بحر سفيان بن العاصي وابن أبي تليد وأبو علي الغساني وأبو محمد عبد الرحمن بن عبد العزيز بن ثابت وأبو داود سليمان بن نجاح وأبو محمد بن حزم وأبو العباس بن دلهاث الدلائي وأبو محمد بن أبي قحافة والحافظ أبو عبد الله الحميدي، وآخر من روى عنه بالإجازة علي بن عبد الله بن موهب الجذامي. علا قدر ابن عبد البر عند علماء الحديث، فعدّه الذهبي حافظ المغرب، وقال عنه أبو علي الغساني: «لم يكن أحد ببلدنا في الحديث مثل قاسم بن محمد وأحمد بن خالد الجباب. ولم يكن ابن عبد البر بدونهما، ولا متخلفًا عنهما ». قال عنه أبو الوليد الباجي: «لم يكن بالأندلس مثل أبو عمر بن عبد البر في الحديث » وقال أيضًا: «أبو عمر أحفظ أهل المغرب ». وقال أبو عبد الله بن أبي الفتح: «كان أبو عمر أعلم من بالأندلس في السنن والآثار واختلاف علماء الأمصار »، وقال عنه الذهبي: «وكان في أصول الديانة على مذهب السلف، لم يدخل في علم الكلام، بل قفا آثار مشايخه رحمهم الله. » جال ابن عبد البر في شرق الأندلس وغربها، فزار دانية وبلنسية وشاطبة، وتولى قضاء الأشبونة وشنترين في عهد المظفر بن الأفطس صاحب بطليوس. وتوفي ابن عبد البر في آخر ربيع الآخر 463 هـ بشاطبة، وصلى عليه أبو الحسن طاهر بن مفوز المعافري. المصدر: ويكيبيديا الموسوعة الحرة برخصة المشاع الإبداعي
__________________
|
|
#24
|
||||
|
||||
|
تواليف مالكية مهمة شهاب الدين الإدريسي  تواليف مالكية مهمة 25: مذاهب الحكام في نوازل الأحكام تعددت المجالات الفقهية التي برز فيها الفقهاء المغاربة والأندلسيون، وتنوعت تصانيفهم ما بين مطولات ومختصرات وشروح، ويمثل كتاب مذاهب الحكام في نوازل الأحكام للقاضي عياض بن موسى بن عياض السبتي (ت544هـ) الذي جمعه ابنه القاضي أبو عبد الله محمد (ت575هـ) نموذجا للمؤلفات الفقهية التي تهتم بوقائع الناس الجارية ومشكلاتهم الناشئة، وأقضيتهم الطارئة، ويندرج ضمن فرع النوازل التي يطلق عليها أيضا اسم الفتاوي، أو الأحكام، أو المسائل، وأهمية الكتاب تتجلى في كونه مرجعا فقهياً يحتوي نوازل تكشف عن وقائع الحياة اليومية بالمغرب والأندلس إبَّان عهد المرابطين. ونوازل القاضي عياض التي يضمها كتاب مذاهب الحكام، هي من نتاج فترة توليه خطة القضاء، قام ولده محمد بجمعها، وترتيبها، والتذييل عليها، وكان قصده في ذلك كله: هو جمع الكتاب وإخراجه، وتسهيل الاطلاع عليه، وتقريب الإفادة منه، ويظهر من خلال تتبع أبواب الكتاب، أن القاضي عياض حينما أجاب عن القضايا والمسائل المرفوعة إليه، كان حريصاً على تبيين حكم الشرع فيها، بناء على الأدلة الشرعية المعتبرة، مهتدياً بأصول مصادر المذهب المالكي، وآراء كبار شيوخه؛ كابن رشد وابن الحاج، ثم يحكم في النازلة بما يثبت عنده، أو التعليق على المسألة بحسب وقوعها متوخيا أثناء جوابه الإيجاز والاختصار، ووضوح التعبير، وسلاسة الألفاظ. ويتلخص صنيع ولده القاضي محمد بحكم سعة اطلاعه على المسائل الفقهية، ومعرفته بمظانها، في جمعه قضايا ونوازل أبيه التي كانت متناثرة في بطائق أو جُزَازَات، ثم عنايته بوضع تذييلات عليها، يفتتحها بعبارة:«قال محمد»، بعد أن رتبها في أبواب فقهية بلغت خمسين باباً، نذكرها هنا لتقريب محتوى الكتاب وهي كما يلي: الأقضية، الشهادات، الدعاوي والأَيْمان، الحدود، الجنايات، نفي الضرر، المياه، الغائب، المريض، السفه، المديان، المفلس، السمسار، الغصب، الاستحقاق، الوصايا، الأحباس، الصدقات، الهبات، النِّحلة، المتعة، العُمرى، الإسكان، النفقة، الوديعة، الرهون، الحمالة، الوكالات، المزارعة، الشركة، القسمة، الشفعة، الصلح، الاسترعاء، الأكرية، البيوع، القيام بالعيب، الصرف، العتق، المدبر، أمهات الأولاد، النكاح، العدّة، الطلاق، الإيمان بالطلاق، الخلع، اللعان، الجنائز، الصلاة. وعلى سبيل الإجمال، يمكن القول أن هذا الكتاب يضم بين دفتيه ذخائر فكر القضاء المالكي، ويمثل بما تضمنه من أجوبة فقهية، ما استقرت عليه الفتوى في الغرب الإسلامي على عهد القاضي عياض، وهو ما جعل فقهاء النوازل الذين أتوا بعد عياض وابنه محمد، يعتمدون عليه في أحكامهم، ومن الفقهاء والنوازليين المتقدمين الذين نقلوا عنه؛ أبو القاسم البُرْزُلي (ت841هـ) في فتاويه، والـمَوَّاق (ت897هـ) في التاج والإكليل، وأبو العباس الوَنْشَرِيسي(ت914هـ) في المعيار المعرب، والحَطَّاب (ت914هـ) في مواهب الجليل، وآخرون. طبع الكتاب مرتين بتحقيق الدكتور محمد بن شريفة، عن دار الغرب الإسلامي، الطبعة الأولى كانت سنة 1990م، وصدرت الطبعة الثانية مزيدة ومنقحة سنة 1997م. لتحميل الكتاب لا اله الا الله ------------------------------------------------ الصلة لابن بشكوال (2/429-430)، بغية الملتمس (437)، الديباج المذهب (2/43-48)، الإحاطة (4/222-230)، شجرة النور الزكية (1/205) صلة الصلة لابن الزبير (3/22-23 الإحاطة (4/229-230)، الديباج المذهب (2/246)
__________________
|
 |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |