|
|||||||
| ملتقى أعلام وشخصيات ملتقى يختص بعرض السير التاريخية للشخصيات الاسلامية والعربية والعالمية من مفكرين وأدباء وسياسيين بارزين |
 |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
|
|
#1
|
||||
|
||||
|
جزاكم الله خيرا واحسن الله اليكم تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال ورفع الله قدركم فى الدنيا والاخرة اللهم آمييييييييين
__________________
|
|
#2
|
||||
|
||||
|
ابن الجزار طبيب القيروان . حسن محمد إبراهيم 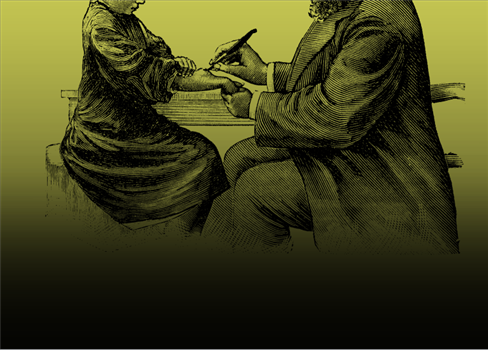 يعتبر ابن الجزار أول طبيب عربي متخصِّص في مجال طب الأطفال ابن الجزار هو أبو جعفـر أحمد بن إبراهيـم أبي خالد القيرواني التونسي الذي اشتهر باسم ابن الجزار؛ وهو طبيب مشهور ولد بمدينة القيروان وتوفي فيها في سنة 369 هـ. ويُعدُّ ابن الجزار من أشهر أطباء وفلاسفة المسلمين في القرن الرابع الهجري وكان صاحب مكانة علمية غير مسبوقة؛ خاصة في بلاد المغرب الإسلامي. أسس ابن الجزار مدرسة طبية، وتتلمذ عليه كثير من الأطباء؛ منهم الطبيب الأندلسي عمر بن حفص بن بريق الـذي عاد إلى الأندلـس حاملاً معه نسخة من كتاب ابن الجزار الشهير (زاد المسافر وقوت الحاضر)، ولقد عرف هذا الكتاب رواجاً كبيراً في أوروبا، كما تمت ترجمته إلى اللغة اللاتينية واليونانية. لقد عمل ابن الجزار على تعديل القوانين الطبية القديمة وتطويرها، كما ضبط أسماء النباتات بثلاث لغات هي الأمازيغية والعربية واليونانية، ولقد ذاع صيته وتجاوزت شهرته حدود البلاد التونسية وكان طلاب الأندلس يتوافدون إلى مدينة القيروان لتحصيل الطب منه. وكان ابن الجزار يعالج مرضاه بأقل تكلفة ممكنة كما بيَّن ذلك في مقدمة كتابه الشهير (طب الفقراء والمساكين)، ولقد كان له الفضل الكبير على المسلمين؛ إذ كان يوزع الأدوية على الفقـراء والمعـوزين دون مقابل. ألَّف ابن الجزار العديد من الكتب التي شملت علوماً مختلفة ولكنها اتجهت في المقام الأول إلى العلوم الطبية، ولعل من أشهرها كتابه (زاد المسافر) وهو يتكون من مجلدين، وقد تمت ترجمته إلى عدة لغات، وهو كتاب ذو قيمة طبية هامة؛ إذ ما تزال بعض الكليات والجامعات تستفيد منه إلى اليوم، ولقد ألَّفه ليكون ابن الجزار دليلاً طبياً للمسافر إلى البلدان البعيدة التي لا يوجد فيها طبيب. كما ألَّف كتاباً في الأدوية يُعرَف بـ (الاعتماد في الأدوية المركبة)، وكتاب (العدة لطول المدة) وهو أكبر كتاب له في الطب، وكتاب (التعريف بصحيح التاريخ) وهو تاريخ مختصر يشتمل على وفيات علماء زمانه وفي ذكر اختلاف الأوائل فيها، وكتاب في المعدة وأمراضها ومداواتها، وكتاب (طب الفقراء)، وكتاب في الفرق بين العلل التي تشتبه أسبابها وتختلف أعراضها، وكتاب (الخواص)، وكتاب (نصائح الأبرار)، وكتاب (المختبرات)، وكتاب في تحديد الأسباب المولدة للوباء. كما ألَّف في مجال التاريخ والسير كتاب (مغازي إفريقيا)، وكتاب (أخبار الدولة)، وكتاب (التعريف بصحيح التاريخ). وفي علم الجيولوجيا ألَّّف كتاب (الأحجار)، وفي الجغرافيا كتاب (عجـائب البلدان)، وفي الأدب واللغة كتاب (المكلل في الأدب) و (الفصول في سائر العلوم والبلاغات). بالإضافة إلى العديد من الرسائل؛ وخاصة منها رسالة في إبدال الأدوية، ورسـالة في التحـذير مـن إخراج الدم من غير حاجة دعت إلى إخراجه، ورسالة في الزكام وأسبابه وعلاجه، وكذلك رسالة في النوم واليقظة. ولقد خصص ابن الجزار تربية الأطفال والأمراض التي تصيبهم بمؤلَّف خاص وهو كتابه (سياسة الصبيان وتدبيرهم)، وقد شرح فيه طرق العناية بالأطفال منذ ولادتهم، وبيَّن كيفية تغذيتهم ونظافتهم وإِرضاعهم، وشرح الأمراض التي قد يتعرض لها الصبيان من الرأس حتى القدم وقدَّم سبل علاجها، ولقد ختمَ كتابَه في الحديث عن طبائع الصبيان وعاداتهم، وبفضل هذا الكتاب اعتبر ابن الجزار أول طبيب عربي متخصِّص في مجال طب الأطفال. وأكد العديد من المؤرخين أن ابن الجـزار كان أبيّاً عزيز النفس لا يتزلـف للسلاطين أو الأمراء، ولا يمتنع عن خدمة أي مريض غنياً كان أم فقيراً، وكان رحيماً بالضعفاء يبذل المال لفائدتهم، ويوزع عليهم الأدوية مجاناً، وينفق على علاج الفقراء من أموال أسرته الثرية وكذلك من أجره عند علاج الأغنياء والحكام. وكان ابن الجزار يذهب إلى مدينـة المنستير على الساحل الشمالي من البلاد التونسية ليرابط فيها مع عدد من العبَّاد والزُّهاد لعدة أيام، وفي كل صيف ينطلق مع مجاهدي البحر ليتصدى للسفن النصرانية التي كانت تهاجم مدن المسلمين الواقعة على سواحل البحر الأبيض المتوسط. عاش ابن الجزار عالماً متواضعاً لا همَّ له سوى البحث والتقصي والاشتغال بالجديد في مجال النبـاتات والعقاقير؛ حيث صنف في الأمراض واختص بعض الأعضاء بالبحث وبعض الأمراض بالتأليف. كما أنه اختص الفقراء ببعض المؤلفات وأفرد للخواص والأثرياء كتاباً وجعل قسماً من تأليفه متعلقاً بالأدوية وآخَر بالأمراض. اعتُمدَت علوم ابن الجزار في الشرق العربي وفي الأندلس، وأعجب بها كثير من ممارسي مهنة الطب. وفي القرن العاشر الميلادي وصلت إنجازاته الطبية الكبيرة إلى أوروبا وكان نابليون بونابرت يحمـل معه دائماً كتاب ابن الجزار (زاد المسافر وقوت الحاضر). إن معظم مؤلفات ابن الجزار ما زالت تحظى بالعديد من الدراسات الأكاديمية في ميدان الطب والصيدلة في كليات الغرب؛ وخصوصاً في الجامعات الفرنسية، كما بقيت كتبه تدرَّس في تونس من قِبل الأطباء قرابةَ ستة قرون بعد وفاته.
__________________
|
|
#3
|
||||
|
||||
|
الفزاري .. صاحب أول اسطرلاب في الإسلام نورالدين قلالة 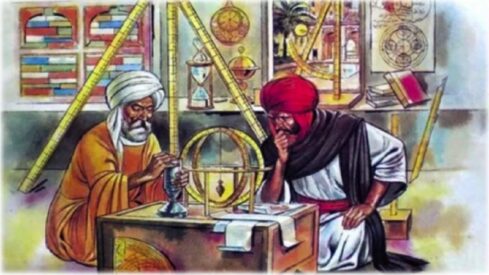 يعتبر محمد الفزاري أشهر علماء المسلمين في الفلك والرياضيات، فهو عالم فلك، ولغوي، ورياضياتي، ومترجم، وفيلسوف.. وهو أيضا الإمام الكبير الحافظ المجاهد القانت الأمَّار بالمعروف.. وقد لعب دورا محوريا في التطور الأولي للتعاليم الفلكية العربية والإسلامية من المصادر الهندية والساسانية واليونانية، لكن لا يوجد أي شيء تقريبا من أعماله حاليا، مع أن أول اسطرلاب في الإسلام من عمل هذا العالم الكبير. تاريخ المسلمين والعرب حافل بالعلماء العباقرة الأفذاذ الذين أثروا الحياة العلمية والبحثية بالمؤلفات والكتب في شتى مناحي الحياة، في الجغرافيا والتاريخ والأدب والطب والفلك والكيمياء والفيزياء والرياضيات والفقه والتفسير والتراجم، ولعل من بين هؤلاء العلماء: العالم الفذ المشهور المذكور في حكماء الإسلام محمد الفزاري، والذي يعد من أشهر علماء العرب والمسلمين في مجال الرياضيات وعلم الفلك. وقد نال مرتبة علمية وشهرة عظيمة جدا في علمي التنجيم وتقويم الشهور. وقد ذاع صيت هذا العالم بصفته أول من عمل في الإسلام اسطرلابا، وقد اشتغل في علم الفلك والتنجيم وخاصة في تأليف الكتيبات الفلكية مع جداول لحساب المواقع السماوية خلال ولاية الخليفة المنصور والخلفاء العباسيين اللاحقين. الفزاري..هوية غامضة للأسف الشديد، لا يوجد أي شيء تقريبا من أعمال هذا العالم الكبير حاليا. ليس هذا فقط، بل أن بعض الكتابات تشير إلى أن حتى هويته ليست مؤكدة تماما، يوجد بعض الغموض بين كاتبي السيرة الذاتية لمفكري العصور الوسطى حول ما إذا كان “إبراهيم بن حبيب الفزاري” و”محمد بن إبراهيم بن فزاري” ما هما إلا شخصان مختلفان -أي الأب والابن- أم أنهما نفس الشخص. لكن على أية حال، تشير أدلة مختلفة على أنهما نفس الشخص. وتعرّف العديد من المصادر محمد بن إبراهيم بن حبيب الفزاري (القرن 8 – القرن 9 م) بأنه عالم فلكي ورياضي ، ولد في الكوفة لأسرة عربية أصيلة ينحدر أصلها من بني فزارة (وبنو فزارة من ذبيان من غطفان من العرب العدنانيين) التي سكنت الكوفة. مولده ونشأته لا تذكر المصادر متى ولد محمد الفزاري، حيث تذكر وفاته فقط في بغداد سنة 180هـ تقريبا، وهو ينتمي إلى عائلة عربية اصيلة قطنت الكوفة، ويذكر المستشرق ديفيد بنقري في (موسوعة تراجم العلماء) أن أول اتصال لابي عبد الله الفزاري ببغداد سنة 144هـ وأن الخليفة العباسي أبا جعفر المنصور أحاطه بالرعاية والتقدير لعلمه الجم. وعلى العموم، يبدو أن الفزاري كان سليلا لعائلة قديمة في الكوفة (بالقرب من النجف في العراق الحديث)، كما يبدو أنه كان يعمل في علم الفلك والتنجيم – وخاصة في تأليق الكتيبات الفلكية مع جداول لحساب المواقع السماوية (زيج) – خلال ولاية الخليفة المنصور (حكم: 754-775) والخلفاء العباسيين اللاحقين. ترعرع أبو عبد الله في بيت علم، فقد تتلمذ على يدي أبيه أبي إسحاق إبراهيم بن حبيب الفزاري المتوفي سنة 160هـ، أحد كبار علماء الهيئة في عصره. وكان قد نال شهرة عظيمة جدا في علمي التنجيم وتقويم الشهور. حياته ومسيرته العلمية هاجر الفزاري إلى بغداد عام 144هـ /747 م. ليستزيد في علمه من العلماء الكبار الذين قطنوا بغداد مركز الحضارة في ذلك الوقت. ولقد أولى الفزاري دراسة اللغات الأجنبية عناية كبيرة وخاصة اللغة السنسكريتية التي بذل فيها جهدا عظيما لرغبته في معرفة ما وصل إليه علماء الهند القدماء في أرصادهم. ولقد أهلته قدراته اللغوية هذه إلى أن ينضم إلى فريق الترجمة في بيت الحكمة التي بناها أبو جعفر المنصور. وقد نال الفزاري احترام الخليفة فأحاطه بالرعاية والتقدير لعلمه الغزير. وفي بيت الحكمة عكف الفزاري على ترجمة العلوم الفلكية والرياضية من المصادر الهندية إلى اللغة العربية. ولقد كان لاطلاعه المباشر على العلوم الهندية في علم الفلك التجريبي أن جعل هذا العلم يستند على الاستقراء والملاحظة الحسية لجميع الأرصاد التي تعلل حركات الكواكب والأجرام السماوية. فاستطاع الفزاري أن يصنع أول أسطرلاب في الإسلام. وكان الفزاري من المغرمين بعلم الأرصاد لدرجة كبيرة حتى إنه نظم قصيدة في النجوم توحي بحبه الشديد لهذا الفن وصارت قصيدته يضرب بها المثل بين علماء العرب والمسلمين في مجال علم الفلك. السند هند الكبير سنة 155هـ جاءت بعثة من الهند ومعها كتاب “سدهانتا” الذي يحتوي على معلومات ثمينة عن علم الهيئة، وهو كتاب معروف عند العرب والمسلمين باسم “السند هند”. فأمر الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور، محمد بن إبراهيم الفزاري بترجمة هذا الكتاب إلى اللغة العربية، وتصنيف كتاب على غراره، سمي كتاب (السند هند الكبير) فصار هذا الكتاب من اهم المراجع الذي يعول عليها الباحث في علم الفلك الى أيام الخليفة العباسي المأمون. وأصبح هذا الكتاب المرجع الأساسي الذي استخدمه العلماء في علم الفلك إلى أيام الخليفة العباسي المأمون، حيث قام العالم العربي محمد بن موسى الخوارزمي باختصار الكتاب وأسماه “السند هند الصغير” وأضاف إليه معارف اليونان وغيرهم. ثم استخلص منه قدرا كبيرا من المعلومات، فحل كتاب الخوارزمي محل كتاب الفزاري الذي توفي حوالي 180هـ (796م). وساهانتا باللغة الهندية تعني (الدهر الداهر)..ومما لاشك فيه أن لهذا الكتاب تأثيرا عظيما في التصويرات الهندسية لحركة الكواكب، التي نتج عنها عمل الأرصاد العديدة في البلاد العربية والإسلامية. اسطرلاب الفزاري المعروف لدى المؤرخين في حقل العلوم التجريبية، أن أول اسطرلاب في الإسلام من عمل محمد بن إبراهيم الفزاري، الذي ألف مع جهاز الاسطرلاب كتابا يصف طريقة العمل به، وسماه “كتاب العمل بالإسطرلاب المسطح”. والأسطرلاب جهاز فلكيّ ذو أشكال مختلفة، استعمله المتقدّمون في تعيين ارتفاعات الأجرام السَّماويَّة ومعرفة الوقت والجهات الأصليّة. وهو عبارة عن آلة دقيقة تُصوَّر عليها حركة النجوم في السماء حول القطب السماوي، وتُستخدم لحل مشكلات فلكية عديدة، كما تم توظيفها في الملاحة وفي مجالات المساحة. وهناك من يخلط بين الابن وابيه في موضوع صنع أول اسطرلاب في الإسلام، ولكن الثابت أن المقصود الابن محمد بن إبراهيم الفزاري. وكان محمد بن إبراهيم الفزاري من المغرمين في علم الهيئة، فنظم قصيدة في النجوم، توحي بحبه الشديد لهذا الفن، صارت قصيدته يضرب بها المثل بين علماء العرب والمسلمين في مجال علم الفلك. وقيل بأن الفزاري كان أول مسلم يصنع “الاسطرلاب المستوي”. ووفقا للعديد من كاتبي السيرة الذاتية، كان الفزاري رائدا وفذًّا في العلوم الفلكية. ومعظم المعرفة الحالية حول الفزاري وصلتنا من البيروني، وهو عالم فلك عاش في القرن الحادي عشر. وكان البيروني أكثر انتقادا وتشكيكا في بعض أفكار الفزاري، إذ يعتقد البيروني باحتمال وجود أخطاء ارتكبها الفزاري وزميله يعقوب بن طارق في تفسير المصطلحات أو التقنيات الفلكية السنسكريتية في الأعمال الذي ترجموها. تحويل علم الفلك علما عربيا وإسلاميا يعتبر الفزاري هو من بدأ حركة نقل العلوم الفلكية والرياضية من المصادر المختلفة، وخاصة المصادر الهندية إلى اللغة العربية، والمعروف ان محمد الفزاري كان متمكنا من اللغات الأجنبية وخاصة اللغة السنسكريتية. وقد بذل الفزاري جهدا عظيما في حقل علم الفلك التجريبي، حيث جعل هذا العمل يستند على الاستقراء والملاحظة الحسية لجميع الأرصاد، التي تعلل حركات الكواكب والاجرام السماوية، لقد كان لتفسيراته للظواهر الفلكية اثر مرموق على مسار المنهج العربي الإسلامي في هذا المضمار. وقد شجع الخليفة العباسي المنصور(754-775) العالم محمد الفزاري ورفاقه على العطاء فترجمت الكتب التي خلفتها الأمم، ليس فقط الهندية ولكن أيضا اليونانية والفارسية، وصححت الأخطاء التي وقعوا فيها، وعملوا إضافات جوهرية في علم الفلك. وأخذ علماء العرب والمسلمين من نتاج الأمم السابقة لهم، ودرس الفزاري وزملاؤه وتفهموا جيدا أعمال الهنود واليونان والفرس في علم الفلك، فزادوا على نظرياتهم وتفننوا في حلول بعض المسائل المستعصية عليهم، وفوق هذا كله جعلوا علم الفلك علما عربيا واسلاميا. مؤلفات وترجمات ألف الفزاري العديد من الكتب في مجال الفلك والرياضيات، لكن أصول كتبه العربية ضاعت في معظمها، ولم تنجُ من التلف إلا ترجمة لاتينية لكتاب “الأسطرلابات والعمل بها”، طُبِعت في أوروبا ثلاث مرات وذلك في القرن السادس عشر وشكَّلت مصدرا علميا فريدا لكل المهتمين بهذا العلم. ومن مؤلفات أبي عبد الله الفزاري في مجال علم الفلك مايلي:
كما قام الفزاري أيضا بتأليف -على ما يبدو في تقليد أسلوب الأطروحات الفنية باللغة السنسكريتية- قصيدة طويلة عن علم الفلك أو علم التنجيم بعنوان “في علم (أو هيئة) النجوم (قصيدة عن علم أو تكوين النجوم). وقد ذُكِرَت بعض الملاحظات المتناثرة حول هذه الأعمال في أعمال مؤلفين لاحقين. وهناك أعمال أخرى منسوبة إلى الفزاري لكنها معروفة العناوين فقط مثل:
ويبدو أن المراجع المجزأة كانت كافية – إلى حد ما – لإظهار أن مساهمات الفزاري كانت تمتلك تأثير كبير على علم الفلك العربي الناشئ، على الرغم من أن عمله ككل لا يمكنه أن يجاري المقالات والأعمال اللاحقة.
__________________
|
|
#4
|
||||
|
||||
|
أثر الحضارة الإسلامية في الحضارة الأوروبية د/ جاد أحمد رمضان دور الحروب الصليبية في نقل الحضارة الإسلامية في أواخر القرن الخامس الهجري (الحادي عشر الميلادي) خرجت جموع من المسيحيين الأوروبيين مختلفي النزعات والأغراض لغزو الشرق الإسلامي. والأسباب التي دفعت هؤلاء إلى شنّ تلك الحروب التي عرفت في التاريخ باسم "الحروب الصليبية" نسبة إلى الصليب -الذي اتخذه المحاربون شعارًا لهم- أسبابٌ غير واضحة، تختلف باختلاف الطوائف التي اشتركت فيها. ويمكننا أن نعتبر رغبة القبائل القيوتونية في الهجرة، وحبهم للمخاطرة من بين تلك الأسباب، كما لا نستبعد أن يكون هدم الخليفة الفاطمي (الحاكم بأمر الله) لكنيسة القيامة في أواخر القرن الرابع الهجري من بين الأسباب البعيدة لهذه الحروب[22]. أما ادعاء الحجاج المسيحيين أنهم كانوا يلقون مصاعب في أثناء اجتيازهم أسيا الصغرى الإسلامية، وهم في طريقهم إلى بيت المقدس، أو أنهم كانوا يتعرضون لمضايقات من جانب المسلمين في أثناء حجهم، فليس له ما يبرره؛ لأن تعاليم الإسلام كفلت لأهل الأديان الأخرى الحرية التامة في مزاولة شعائر دينهم، ونهت عن التعرض لهم بسوء ماداموا مسالمين ولا نظن أن مسلمي هذا العصر كانوا يجهلون ذلك. ولئن سلمنا حدوث بعض مضايقات، فإن ذلك لا يعدو أن يكون حوادث فردية صدرت من بعض جهلة المسلمين، وحتـما على فرض صدورها، فإنها لا تقتضي هذه الضجة الكبرى التي أثارها الغرب ضد المسلمين ولا تستلزم سفك ما سفك من دماء في هذه الحروب التي استمرت نحو قرنين من الزمن. وكان الراهب بطرس الناسك الذي حج إلى بيت المقدس، وعزّ عليه أن يراه مِلكا للمسلمين، وهو المكان الذي يقدسه المسيحيون؛ كان هذا الراهب هو الذي روّج تلك الإشاعات. على أن السبب المباشر لتلك المأساة التي ذهب ضحيتها عدد من البشر هو استنجاد الإمبراطور "ألكسيوس كمنينوس" إمبراطور الدولة البيزنطية بالبابا "إربان الثاني" بطريك الكنيسة الغربية بعد هزيمة البيزنطيين أمام السلاجقة في موقعة "ملاذكر" في أواخر سنة 462 هـ [23]، وكان هذا الاستنجاد بعد الموقعة بأكثر من عشرين سنة ولكنه صادف هوى في نفس البابا الذي كان يطمع في ضم الكنيسة الشرقية إلى الكنيسة الغربية فأثار تلك الضجة العالمية التي تعتبر من أهم أحداث التاريخ العالمي. وفي العام التالي لهذا الاستنجاد ألقى البابا خطبة في مدينة "كليرمنت" في الجنوب الشرقي لفرنسا حثّ فيها المؤمنين من النصارى على أن "يسلكوا سبيلهم إلى القبر المقدس ويأخذوه عنوة من ذلك الشعب الملعون ويخضعوه لأنفسهم"[24]، ولقد أشعلت هذه الخطبة جذوة الحماس في نفوس الجماهير المسيحية شريفهم ووضيعهم على السواء، وبلغ عدد المتطوعين لهذه الحرب مائة وخمسين ألفا من النورماندبين والفرنج. ولم يكن الحماس الديني وحده هو الذي دفع هذه الجماهير إلى شنّ الغارة على الشرق بل إن كثيرا من الأمراء- ومن بينهم "بوهيمند"_ خرجوا استجابة لأطماعهم في تكوين إمارات لهم في الشرق الأوسط، كما كانت المصالح الاقتصادية هدف تجار البندقية وبيزة وجنوة. وقد نجح الصليبيون في تكوين أربع إمارات لهم في الشرق وهى إمارة الرها وإمارة أنطاكيا وإمارة طرابلس وإمارة بيت المقدس وسميت هذه الإمارات مملكة بيت المقدس حيث كان أمير بيت المقدس يتوج ملكا لهذه المملكة، وإن كان كل أمير مستقلا داخليا في إمارته. وكان الاعتداء الصليبي على الشرق سببا في ظهور قوى إسلامية فتية؛ فقد تحمس الأبطال المسلمون لاسترداد بلادهم المغتصبة، وتمكن البطل عماد الدين زنكي من استرداد إمارة الرها أول أمارة أنشأها الصليبيون في الشرق، وأهم إماراتهم وقد تم له ذلك سنة 539 هـ [25] . ثم جاء بعده ابنه السلطان نور الدين محمود (541- 569 هـ) فوحّد بلاد الشام تحت حكمه وضم إليها مصر، ولم يتمكن الصليبيون في عهده من إضافة شبر واحد إلى ممتلكاتهم في الشرق، بل انتزع السلطان من أيديهم كثيرا من البلاد التي كانوا قد احتلوها قبل أن يتنبه المسلمون لخطرهم، وحمل لواء الجهاد في عهده ومن بعده السلطان صلاح الدين الأيوبي (567- 589 هـ) فانتزع بيت المقدس من أيدي الصليبيين سنة 583 هـ [26]. ثم أخذ سلاطين الأيوبيين والمماليك من بعدهم ينتزعون المدن الإسلامية من أيدي هؤلاء المغتصبين مدينة بعد أخرى حتى انتزع السلطان المملوكي الأشراف خليل (689-693 هـ) مدينة عكا أخر معقل لهم في الشرق سنة 692 هـ [27] وبذلك قضى على مملكة الصليبيين القضاء الأخير. وكان الأثر الحضاري لهذه الحروب فنيا وصناعيا وتجاريا أكثر منه علميا أو أدبيا؛ فقد كان الأوروبيون الذين أقاموا في الشام في الإمارات التي أنشئوها يعيشون داخل حصون وسكنات عسكرية، وكان اتصالهم بالزراع الوطنيين والصناع أكثر من اتصالهم بالطبقة المثقفة. على أنهم مع ذلك استفادوا علميا، وإن كانت استفادة محدودة فقد نقل أحد علماء مدينة بيزة الكتاب الطبي المشهور "كامل الصناعة الطبية" لعلي بن العباس المعروف بالمجوسي نسبة إلى أحد أجداده الذي كان يدين بالمجوسية قبل أن يعتنق الإسلام وترجم فيليب الطرابلسي مخطوطا عربيا في الفلسفة والأخلاق يسمى "سر الأسرار" يقال إن أرسطو ألفه لتلميذه الإسكندر المقدوني. كما كان من أثر الحروب الصليبية العلمي اهتمام الأوروبيين بتعلم اللغة العربية؛ لأنهم وقد فشلوا في نشر الديانة المسيحية بحدّ السيف رأوا أن تعلم اللغة العربية يمكنهم من التخاطب مع الشرقيين ونشر المسيحية بينهم باللين والإغراء [28]. على أن إنشاء المستشفيات ومعالجة المرضى فيها لم يعرف في أوروبا قبل الحروب الصليبية؛ مما يرجح أن هذا النظام منقول عن الشرق الإسلامي، بعد أن شاهد الأوروبيون المستشفيات فيه أثناء الحروب الصليبية، كما يرجح أيضا أن نظام الحمامات العامة الذي انتقل إلى أوروبا بعد الحروب الصليبية منقول كذلك بواسطتها. وقد كان أثر الحروب الصليبية في نقل الفنون الحربية إلى أوروبا واضحا؛ فقد تعلم الصليبيون من المسلمين استخدام حمام الزاجل في نقل الأخبار الحربية [29] كما اقتبسوا منهم الاحتفال بالانتصارات بإشعال النيران، ولعبة الفروسية المعروفة باسم "الجريد"، وكذلك نقلوا عنهم اتخاذ الشعارات ونقشها على الأسلحة والخوذات، وكان اتخاذ الشعارات معروفا عند المسلمين، فقد كان صلاح الدين يلبس خوذة عليها رسم النسر، وكانت خوذة الظاهر بيبرس على شكل أسد كخوذة ابن طولون من قبل، ولم يكن ذلك معروفا في أوروبا قبل الحروب الصليبية. وفي مجال الزراعة والصناعة والتجارة نقل الصليبيون العائدون إلى أوروبا كثيرا من النباتات وأشجار الفواكه مثل السمسم والبصل والأرز والبطيخ والبرقوق والليمون، كما حملوا معهم حين عودتهم البسط والسجاجيد والمنسوجات، وبدأت تظهر في أوروبا مصانع الآنية والبسط والأقمشة تقليدا للمنتجات الشرقية، ووجدت سوق أوروبية جديدة للمنتجات الزراعية الشرقية، والسلع الصناعية مما ساعد على نشاط التجارة الدولية التي كانت قد ركدت منذ سقوط الدولة الرومانية الغربية في القرن الخامس الميلادي [30]. السفارات بين دول أوروبا والدول الإسـلامية حدثت اتصالات بين دول أوروبا والدول الإسلامية في العصور الوسطى كان لها أثر- ولو ضئيل- في نقل حضارة المسلمين إلى أوروبا. فيحدثنا التاريخ أنه عندما يئس الخليفة أبو جعفر المنصور ثاني خلفاء العباسيين من مدّ سلطانه إلى بلاد الأندلس التي أَسس فيها الأمير الأموي عبد الرحمن بن معاوية بن هشام إمارة أموية. عندما يئس أبو جعفر من التغلب على هذا الأمير بالقوة لجأ إلى سلاح سياسي يستعين به على الوصول إلى غرضه فأراد التحالف مع "ببن" ملك الفرنجة على طرد الأمويين من الأندلس. وقد مهد أبو جعفر لذلك بإرسال سفارة إلى "ببن" وجرت مفاوضات بين رسل الخليفة وبين ملك الفرنجة حول الغرض الذي جاءوا من أجله، ثم عادوا إلى بغداد يصحبهم سفراء من الفرنجة ليتفاوضوا مع أبى جعفر في التحالف مع دولة الفرنجة على سحق الدولة البيزنطية عدوتها، وعادوا إلى بلادهم يحملون الهدايا النفيسة التي أرسلها الخليفة إلى ملكهم. ولم تؤد هذه المفاوضات إلى نتيجة إيجابية لكل من الطرفين أكثر من إزعاج عبد الرحمن الداخل وتخويفه من هجوم الفرنجة على بلاده، وإزعاج البيزنطيين من هجوم العباسيين على بلادهم. ويؤخذ على حكام المسلمين الاستعانة بغير المسلمين للتغلب على إخوانهم في الدين؛ فالمسلمون إخوة ينصر بعضهم بعضا، ويقفون صفا واحدا للدفاع عن عقيدتهم وصد أي عدوان يوجه إليها {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً}. وفي عهد الخليفة هارون الرشيد تجددت العلاقة بين دولة الفرنجة والدولة العباسية؛ حيث خطب شارلمان ود الرشيدَ؛ فأرسل إليه يطلب التحالف معه ضد البيزنطيين ويرجوه أن ييسر الحج إلى بيت المقدس للفرنجة، وأن تتبادل دولة الفرنجة التجارة مع الدولة العباسية وأن يمده بالكتب العلمية، كما أرسل الرشيد بعثة إلى بلاط شارلمان بغية التحالف معه ضد الإمبراطورية البيزنطية، والأمويين بالأندلس. وقد أسفرت هذه المفاوضات عن إرسال مفاتيح كنيسة القيامة إلى شارلمان، وتبادل الهدايا بينه وبين الرشيد وكان من بين الهدايا التي أرسلها الرشيد إلى شارلمان: فيل وساعة مائية دقاقة، وأقمشة فاخرة من الموشى المنسوج بالذهب، وبسط ومواد عطرية [31]. ولم تسفر هذه المفاوضات عن عمل إيجابي من جانب شارلمان ضد الأمويين في الأندلس؛ لأنه لم يجازف بالدخول في حرب مع الأمويين لا يدرى مغبتها حيث أدرك استحالة الفضاء على الأمارة الأموية التي أصبحت ثابتة البنيان، موطدة الدعائم، واكتفى هو وأولاده من بعده بالدفاع عن أملاكهم ولم يفكروا في توجيه حملات هجومية ضد الأمويين. وكما حاول الفرنجة والعباسيون أن يتحالفوا ضد البيزنطيين والأمويين كذلك حاول الأمويون والبيزنطيون أن يتحالفوا ضد العباسيين والفرنجة. وقد بدأت هذه المحاولة في عهد الإمبراطور البيزنطي "تيوفيل" الذي اشتد العداء بينه وبين الخليفة العباسي المعتصم باللّه، فقد هاجم الإمبراطور حصن زبطرة الإسلامي وضربه فرّد عليه الخليفة بالهجوم على عمورية وتخريبها سنة 223 هـ، كما خرّب كثيرا من المدن البيزنطية [32]. بعث الإمبراطور "تيوفيل"، سفيره "كريتوس" ومعه هدايا نفيسة رسالة يطلب فيها صداقة عبد الرحمن الثاني (الأوسط) أمير الأندلس ويرجوه عقد معاهدة صداقة ويحرضه على استعادة مقر خلافة أجداده. وقد ردّ الأمير عبد الرحمن الأوسط على لا "تيوفيل" بخطاب عبّر فيه عن عداوته للعباسيين، دون أن يرتبط معه بمعاهدة حربية ضدهم وهذا تصرف نبيل من الأمير المسلم، يستحق الثناء عليه حيث لم يتفق مع المسيحيين على حرب المسلمين. ومع أن هذه المراسلات لم تؤد إلى عقد تحالف فعلي فإنها لم تخل من فائدة حيث أوجدت حالة استقرار في غرب أوروبا؛ إذ أن الأمويين والفرنجة اقتنعوا بأنه من الخير لهم أن يتفاهموا، وأن تكف كل من الدولتين عن حرب الأخرى وتنصرف كل منها إلى رعاية مصالحها وتعمل على تقدمها الحضاري. وقد نشأت بين المدن الإيطالية وبين الدولة الفاطمية بمصر والشام علاقات تأرجحت بين الودّ، والعداء فقد أرسلت مدينة بيزا سفيرا إلى بلاط الخليفة الفاطمي الظاهر (411-417 هـ) لتسوية المشكلة التي تسببت عن اعتداء بعض تجار بيزا على جماعة من التجار المصريين في البحر الأبيض، على مقربة من بيزا وسلب أموالهم، وقتل بعضهم. وقد انتقمت الحكومة الفاطمية لرعاياها وعاقبت التجار البيزيين المقيمين بمصر. ونجح سفير بيزا في تسوية الخلاف بعد أن تعهد عن حكومته بالاقتصاص من المعتدين كما تعهد بالامتناع عن إمداد أعداء المسلمين بأي مساعدة، وفي نظير ذلك تعهدت الحكومة الفاطمية بإطلاق سراح التجار البيزيين المسجونين بمصر، وحماية حجاج بيت المقدس القادمين من بيزا على سفن غير حربية. وعندما تولى الصالح طلائع بن رزيك الوزارة المصرية سنة 549 هـ بادرت حكومة بيزا بإرسال وفد لتهنئته، فرحب الوزير بهم وأكرمهم وأكد المعاهدات القديمة بينهما. وقد قامت صلات ودية بين مدينة جنوة والدولة الفاطمية وازدادت هذه الصلات في النصف الثاني من القرن الخامس الهجري فقدي بعثت جنوة سفراء معاهدة مع الحكومة الفاطمية وتمخضت المفاوضات بين الطرفين عن تعهد الحكومة الفاطمية بحماية رعايا جنوة في مصر، وكان معظمهم يقيمون في مدينة الإسكندرية. وكذلك قامت علاقات بين البندقية والدولة الفاطمية؛ حيث تعهدت البندقية في القرن الرابع الهجري بإمداد الفاطميين بما يحتاجونه من الأخشاب التي تلزم لبناء الأسطول الفاطمي المرابط في سواحل مصر، وسواحل الشام، ولكن البندقية توقفت بعد فترة عن إرسال الأخشاب- تحت تهديد حكومة بيزنطة- فتعكر صفو العلاقات بينها وبين الفاطميين، غير أن البندقية لم تلبث أن أدركت أن مصالحها التجارية تحتم عليها أن تعيد علاقاتها الطيبة بالقاهرة؛ فعادت إلى ما كانت عليه من إمدادها بالأخشاب نظير حصولها على امتيازات خاصة لسفنها التي تمر بالمياه المصرية، وتنقل حاصلات إفريقية وأسيا إلى أوروبا [33]. ومما لاشك فيه أن هذه السفارات قامت بدور في توصيل حضارة المسلمين إلى دول الغرب؛ لأن السفراء كانوا يطلعون على مظاهر الحضارة في العالم الإسلامي، وينقلون فكرة عما شاهدوه إلى بلادهم لكن عدد هؤلاء السفراء- بالطبع- كان محدودا وإقامتهم في البلاد الإسلامية لم تكن طويلة، بل كانت مدتها تتوقف على انتهاء المهمة التي أرسلوا من أجلها. ولذلك لم يكن دور هذه الاتصالات بارزا في نقل الحضارة الإسلامية، بل كان نصيبه في نقلها محدودا يقتصر أغلبه على الجانب المادي للحضارة، أما الجانب الثقافي منها فقد كان قليلا جدا، كما اقتصر نقل التجار على الجانب المادي فقط لأن همتهم كانت متجهة أولاً وبالذات إلى الحصول على المال فكانوا ينقلون التحف بقصد الكسب من ورائها فحسب ولم تكن الثقافة والفن مما يحرص التجار على تداوله. من كل ما تقدم نعلم أن ما تنعم الدول الغربية به من حضارة ليس من ابتكار عقول أهلها، ولا من صنع أيديهم إنما هو فيض الحضارة الإسلامية وصل إليهم عن تلك المصادر التي تكلمنا عنها. وقد اهتم الغربيون بالجانب المادي من الحضارة التي وصلت إليهم من الشرق وأغفلوا الجانب الروح، وهو المهم، وليتهم وجهوا الجانب المادي وجهة صالحة تعمّر ولا تخرب، وتبني ولا تهدم. بل تفننوا في نقل وسائل التخريب والتدمير، حتى أصبح العالم يعيش اليوم في جو من القلق والرعب اللذين يجب أن يخلو منها المجتمع الحضاري. ويوم يرجع المسلمون إلى التمسك بقواعد دينهم، والسير على هداها فسوف يعيدون إلى المجتمع الإنساني نعمة الأمن، ويخرجونه من جو القلق والرعب إلى جو الطمأنينة والسعادة واللّه سبحانه وتعالى يهدى إلى سواء السبيل، نسأله جلت قدرته أن يعيد للمسلمين عزهم ومجدهم إنه سميع مجيب والحمد لله رب العالمين. د/ جاد أحمد رمضان رئيس قسم التاريخ بالجامعة الاسلامية [1]لطفي عبد السميع، الإسلام في أسبانيا ص31.30. [2]المقري، نفح الطيب جـ1 ص298. [3]جوت هل، الحضارة العربية ص119. [4]ابن حوقل، المسالك والممالك ص79.78. [5]ابن خلكان، وفيات الأعيان جـ1 ص131.130. [6]ابن خلدون، كتاب العبر جـ4 ص 146. [7]المقري، نفع الطيب ج1 ص 250. [8]المدوّر. الديانات والحضارات ص 67. [9]علي الخربوطلي: العرب والحضارة ص 313. [10]المدور الديانات والحضارات ص 70. [11]سعيد عاشور. أوروبا في العصور الوسطى ص 217. [12]بالنشيا، تاريخ الفكري الأندلس ص 536. [13]هل، الحضارة العربية ص 120. [14]أماري، مكتبة صقلية العربية جـ1 ص 427،429. [15]ابن الأثير، الكامل جـ1 ص 54،53 [16]رحلة ابن جبير ص 228. [17]أماري، مكتبة صقلية العربية ص 472 [18]رحلة ابن جبير ص331. [19]المقريرزي، السلوك لمعرفة دول الملوك ج1 ص382 [20]أبو المحاسن، النجوم الزاهرة ج6 ص283 [21]المقريزي، الخطط، ج1 ص219 [22]ابن الأثير، الكامل جـ1 ص45.44. [23]ابن الأثير، الكامل جـ8 ص45.44. [24]فيليب حتى، تاريخ العرب جـ2 ص822. [25]إسحاق أرملة، الحروب الصليبية ص106 [26]ابن شداد. سيرة صلاح الدين ص 67066. [27]أبو الفداء المختصر في أخبار البشر جـ4 ص 24. [28]فليب حتى، تاريخ العرب جـ2 ص 857، 858. [29]السيوطي، حسن المحاضرة جـ3 ص 168. [30]فيليب حتى تاريخ العرب جـ3 ص 65. [31]جميل نخلة حضارة الإسلام ص 151. [32]إبراهيم العدوى، المسلمون والجرمان ص 270. [33]جمال سرور الدولة الفاطمية ص 1760175
__________________
|
|
#5
|
||||
|
||||
__________________
|
|
#6
|
||||
|
||||
|
هل اهتم المسلمون بعلم الحياة؟ نورالدين قلالة  لم يهتم المسلمون بعلوم الشريعة الإسلامية فحسب، وإنما كان لهم مساهمات عظيمة في شتى العلوم الأخرى، حيث اهتم المسلمون بعلم الحياة، وبرعوا فيه وسجلوا اكتشافات غير مسبوقة لم يصل إليها أحد. وكان لهم الفضل الأول في الكشف عن بعض الأمور التي كانت سببا في تقديم خدمات جليلة للإنسانية جمعاء. فكيف اهتم المسلمون بعلم الحياة؟ تكمن أهمية علم الأحياء في أنه ساعد في دراسة جسم الإنسان ودراسة النباتات والعمليات التي تقوم بها، حيث صنفت البيولوجيا الكائنات الحية وساعدت ذلك في دراسة وفهم خصائصها ومراحل تطورها وكيفية تطورها. وقد صب اهتمام علم الحياة في دراسة جميع الكائنات الحية الموجودة على الأرض من العصور القديمة إلى عصرنا الراهن، ويعتبر علم الأحياء فضيلة عظيمة في فهم الإنسان للبيئة المحيطة به، وأظهر له كيف ينبغي عليه المضي قدما في استخدام الموارد التي من خلالها لتحقيق المنفعة العظيمة لجميع الكائنات، مثل فك تشفير الطبيعة التي كانت لفترة طويلة غامضة وغامضة. ما هو علم الأحياء؟ يعرف علم الأحياء بانه علم طبيعي يُعنى بدراسة الحياة والكائنات الحية، بما في ذلك هياكلها ووظائفها ونموها وتطورها وتوزيعها وتصنيفها. والأحياء الحديثة هي ميدانٌ واسعٌ يتألف من العديد من الفروع والتخصصات الفرعيَّة، لكنها تتضمن بعض المفاهيم العامّة الموحدة التي تربط بين فروعها المُختلفة وتسير عليها جميع الدراسات والبحوث. يُنظر إلى الخلية في علم الأحياء عموماً باعتبارها وحدة الحياة الأساسية، والجين باعتباره وحدة التوريث الأساسية، والتطور باعتباره المُحرّك الذي يولد الأنواع الجديدة. ومن المفهوم أيضاً في علم الأحياء في الوقت الحاضر أنّ جميع الكائنات الحيّة تبقى على قيد الحياة عن طريق استهلاك وتحويل الطاقة، ومن خلال تنظيم البيئة الداخلية للحفاظ على حالةٍ مُستقرةٍ وحيويّة. ينقسم علم الأحياء إلى فروع حسب نطاق الكائنات الحيَّة التي تدرسها، وأنواع الكائنات الحيَّة المدروسة، والأساليب المُستخدمة في دراستها. فتدرس الكيمياء الحيوية العمليات الكيميائية المُتعلقة بالكائنات الحيَّة، ويدرس علم الأحياء الجزيئي التفاعلات المُعقدة التي تحصل بين الجُزيئات البيولوجية، ويُعنى علم النبات بدراسة حياة النباتات المُختلفة، ويدرس علم الأحياء الخلوي الخلية التي تُعدّ الوحدة البنائية الأساسية للحياة، ويدرس علم وظائف الأعضاء الوظائف الفيزيائية والكيميائية لأنسجة وأعضاء وأجهزة الكائن الحي، بينما يدرس علم الأحياء التطوري العمليات التي أدّت إلى تنوّع الحياة، ويُعنى علم البيئة بالبحث في كيفيّة تفاعل الكائنات الحيَّة مع بيئتها. المسلمون وعلم الأحياء أسهم العلماء المسلمون إسهامات مهمة في علم الأحياء، مثل الجاحظ، وأبو حنيفة الدينوري الذي كتب في علوم النباتات، وأبو بكر الرازي الذي كتب في علم التشريح وعلم وظائف الأعضاء. كما أولى المسلمون الطب اهتماماً خاصاً، فترجموا علوم اليونانيين وأضافوا إليها الكثير. أمّا إسهاماتهم في التاريخ الطبيعي فكانت مُعتمدةً بشكلٍ كبيرٍ على الفكر الأرسطي. وعلى الرغم من ظهور علم الأحياء بشكله الحالي حديثا نسبيا، إلا أن العلوم التي تتضمنها الأحياء أو تتعلق فيها كانت تُدرس منذ العصور القديمة. فقد كانت الفلسفة الطبيعية تُدرس في بلاد الرافدين ومصر وشبه القارة الهندية والصين. بيد أنّ أصول علوم الأحياء الحديثة ومنهجها في دراسة الطبيعة تعود إلى اليونان القديمة. فكان أبقراط بمثابة مؤسس علم الطب، بالإضافة إلى مساهمة أرسطو الكبيرة في تطوير علم الأحياء، حيث كان لكتبه التي أظهر فيها ميوله للطبيعة أهمية خاصة مثل كتاب “تاريخ الحيوانات”، تبع ذلك أعمال أكثر تجريبية ركّزت على السببية البيولوجية وتنوع الحياة. وكتب ثيوفراستوس بعد ذلك سلسلة من الكتب في علم النبات اعتُبرت الأهم من نوعها في هذا العلم في العصور القديمة حتى العصور الوسطى. أشهر علماء الحياة من العرب والمسلمين لعب العرب والمسلمون دورا كبيرا في تطوير علم الأحياء، حيث كانت مساهماتهم في علم الحياة مساهمات سجلها التاريخ لهم واستفادت منها الإنسانية حتى هذا الوقت، حيث أظهر علماء الأحياء العرب والمسلمون الكثير من الغموض الذي لم يكتشفه أحد من قبل. فهل اهتم المسلمون بعلم الحياة حقيقة؟ وكيف كان اهتمامهم؟ هناك العديد من هؤلاء العلماء الذين ساهموا في تطور وتكوين علم الأحياء ومن أشهرهم:
تميز علماء الأحياء المسلمون بالعديد من المميزات والخصائص التي تميزهم عن غيرهم من العلماء في هذا المجال:
ترك علماء الأحياء العرب والمسلمون بصمات دقيقة وواضحة في علم الأحياء، فقد كانوا مجموعة من العلماء لا يتوقف عن الحديث عنهم في عصور معينة. لكن الغريب في الأمر، لا أحد يتحدث عنهم وعن انجازاتهم واكتشافاتهم في العصر الراهن. على الرغم من أن إسهاماتهم التي قدموها أثبتت -بما لا يدع مجالا للشك- أن المسلمين قادرون على بلوغ مراحل لا يستطيع أحد أن يصل إليها. كان عالم الأحياء ابن سينا هو المكتشف الرئيسي للدودة المستديرة، قبل أن يكتشفها علماء الأحياء الغربيون، بينما كانت مساهمات ابن النفيس في العلوم الطبية غير عادية، حيث اكتشف دوران الأوعية الدقيقة، وغيرها الكثير. فيما قيل عن عالم الأحياء ابن البيطار: “إنه عالم نباتي حكيم طويل الأمد”. لكن- للأسف -كثيرا ما يحتفل التاريخ بإنجازات علماء الغرب العظيمة في شتّى العلوم والمعارف، ويتناسى العلماء العرب والمسلمون، فيذكر أرسطو و سقراط ونيوتين وماري كوري و جاليلي وأينشتاين..ولا يذكر ابن سينا وابن النفيس وابن البيطار والدميري والقزويني وابن رشد.. علماؤهم بلغ صيتهم كل الدنى والدروب، حتى أصبحوا مفخرة للشعوب بما فيهم نحن. نحن الذين رفعنا من قيمتهم ودعمناهم وأدخلناهم إلى كلياتنا وجامعاتنا ومناهجنا التعليمية. ونسينا أن تاريخنا العربي والإسلامي يزخر بأمثالهم من العلماء والمفكرين الذين قد يكونوا سبقوا هؤلاء العلماء بإنجازاتهم، وحتى أن بعض علماء الغرب قد استندوا في دراساتهم على أبحاث العلماء المسلمين.
__________________
|
|
#7
|
||||
|
||||
|
علم النبات عند العلماء العرب محمد مروان مراديشير المؤرخون المنصفون بإعجاب وتقدير إلى ريادة العلماء العرب المسلمين في ميادين العلوم المختلفة، وإلى اقتباس علماء الغرب الكثير من أفكارهم ومنجزاتهم التي تعد في الواقع أساسًا للنهضة الأوروبية الحديثة، ويعددون في هذا المجال أسبقية العشرات من علمائنا في ميادين التقنية والابتكار وفي القائمة الطويلة أسماء الخوارزمي في علم الجبر واللوغاريتمات، والبيروني في الحساب والهندسة والفلك، وابن الهيثم في العلوم الطبيعية والرياضيات والرازي في الطب، والزهراوي في الجراحة، وجابر بن حيان في الكيمياء، والكندي وابن الشاطر في الفلك وابن خلدون في علم الاجتماع، والإدريسي في الجغرافيا، وغيرهم كثيرون.. كذلك تطول القائمة حين يكون محور الدراسة أسبقية العلماء العرب في علم النبات. بدأ اهتمام العلماء بتدوين أنواع الزرع والأشجار والأثمار والأعشاب والبقول وغيرها في بغداد والبصرة والكوفة التي كانت مراكز عمل للعلماء المشتغلين في هذا المجال، باعتبارها موئلًا لفصحاء العرب يغدون إليها من البادية وهم يحملون فصيح اللغة وصحيحها، وبالعكس راح العلماء بدورهم ينزلون من الأمصار إلى البادية للتحقيق والتمحيص، ولاسيما فيما يختص بأسماء الأعشاب والنباتات. على أن اهتمام العرب الفعلي بعلم النبات، بدأ في مطلع العصر العباسي، حين ترجم العلماء مؤلفات اليونان الخاصة بعلم النبات و«الأقرابازين»، وكان مفتتح ذلك العمل نقل زمن الخليفة المتوكل. وفي عام 337هـ/948م أهدى ملك القسطنطينية إلى الخليفة الناصر بالأندلس مؤلف «ديسقوريوس» باليونانية، ولم يكن في الأندلس من يجيد هذه اللغة، فطلب الخليفة الناصر من الإمبراطور أن يرسل إليه مترجمًا ماهرًا في اللغتين اليونانية واللاتينية، فاستجاب لطلبه وأوفد الراهب «نيقولا» في أواخر القرن العاشر الميلادي، وبتعاون مع الأطباء المحليين الذين يعرفون اللاتينية والعربية، وضعت الأسماء العربية التي تركها «ابن باسيل» دون ترجمة لجهله بها، ومع مطلع القرن الحادي عشر ألف الطبيب الأندلسي «ابن جلجل» كتابًا ضمنه المعلومات التي أغفلها «ديسقوريدس» وضم هذا الكتاب إلى كتاب «ابن باسيل» المترجم عن «ديسقوريدس» فجاء الكتابان مؤلفًا كاملًا. وقد استند العرب في دراساتهم لعلم النبات على دقة الملاحظة والمعاينة واستمرار المتابعة، واعتمادًا على هذا المنهج التجريبي تمكن العلماء العرب من دراسة الكثير من النباتات الطبيعية التي لم تسبق دراستها، وأدخلوها في العقاقير الطبية واستولدوا نباتات لم تكن معروفة كالورد الأسود، وتمكنوا من أن يكسبوا بعض النباتات خصائص العقاقير في أثرها الطبي، وفي عصر المقتدر بالله نقل العرب «الأترج» المدور من الهند وزرعوه في عُمان ثم نقلوه إلى البصرة والعراق والشام. يحفل سجل الريادة في علم النبات – عملًا وتأليفًا – بعشرات أسماء العلماء العرب الذين دونوا في مؤلفاتهم النباتات والأعشاب، وبينهم أبوعبيدة البصري والأصمعي، وأبوزيد الأنصاري، وابن الأعرابي الكوفي، وابن السكيت، وتألق بشكل خاص أبوحنيفة الدينوري – ت282هـ/895م، وهو أول من ألف بالعربية في علم النبات، وأبوجعفر الغافقي الأندلسي (ت 561هـ/1165م) وأبومحمد ابن البيطار المالقي (ت 646هـ/1248م) أبرز علماء النبات العرب ومؤلف كتاب «الجامع في الأدوية المفردة» الذي يعد أفضل الكتب في فن المداواة بالأعشاب والأغذية، وأبوبكر أحمد بن وحشية أول من كتب من العرب عن الزراعة في كتابه «الفلاحة النبطية»، والطبيب الضرير داوود الأنطاكي (ت 1008هـ/1559م)، ومن المتميزين في هذا المجال أيضًا: رشيد الدين الصوري، وأبوزكريا يحيى بن العوام، وأبوالعباس بن الرومية، وسنعرض فيما يأتي صفحات من سِير الأعلام الثلاثة الذين أسهموا بشكل واضح في تقدم علوم النبات والأعشاب والأدوية. < رشيد الدين الصوري (573هـ – 1177م) ولد رشيد الدين بن أبي الفضل بن علي الصوري في مدينة صور بالشام سنة 573هـ/1177م، ونشأ فيها، وعكف في مرحلة مبكرة على دراسة علوم الأوائل دراسة متأنية، ثم تنقل بين بعض المدن العربية ودرس الطب في دمشق على مشاهير العلماء كموفق الدين عبدالعزيز، وموفق الدين عبداللطيف البغدادي والشيخ أبي العباس الجياني وغيرهم، وقد أظهر في عمله سعة اطلاع ودقة في الملاحظة، وغزارة في التجارب والبحوث، وكانت دراسات «الصوري» لأنواع النبات دراسة دقيقة اتبع فيها المنهج العلمي الحديث الذي سبق في تطبيقه علماء الغرب بسبعة قرون، وكانت بحوثه في ذلك المجال رائدة بكل معنى الكلمة، وأكد فيها إخلاصه في البحث عن الحقيقة العلمية وتكريسه الجهد والوقت لعلمه المتميز، لقد كانت من أبرز مميزات «الصوري» استناده في دراسته علم النبات على دقة الملاحظة والمعاينة ودوام المتابعة وقد تجسد ذلك في تصويره للنبات تصويرًا ملونًا في سائر مراحل عمره، منذ أن يكون بذرة وحتى مرحلة الجفاف الأخيرة، فقد اعتمد على رسام يصحبه في رحلاته الميدانية ومعه الأوراق والألوان المتنوعة فيتنقل بين مناطق النباتات – كسهول لبنان وجباله – فيشاهد أصنافها ويحقق فيها، ويريها للرسام، فيدرس شكلها ولونها وأصولها ومقدار أغصانها وورقها، فيجتهد في تصويرها ومحاكاة طبيعتها وسماتها.. ثم يقوم «الصوري» في ضم تلك الدراسة والصور إلى كتابه القيم «الأدوية المفردة» الذي اشتمل على البحث في 585 معقارًا بينها 466 عقارًا من أصل نباتي و44 عقارًا من أصل حيواني و75 عقارًا من أصل معدني، وقد أرفقت الرسوم بتعليقات وفوائد طبية كثيرة، وكشف هذا المصنف عن ثقافة «الصوري» الموسوعية في علم الأدوية المفردة وماهيتها واختلاف صفاتها وأسمائها، وتحقيق خواصها وتأثيرها. نبغ رشيد الدين الصوري إضافة لجهوده في علم النبات، في الطب أيضًا، وقد عمل طبيبًا للملك العادل أبي بكر بن أيوب عام 612هـ/1215م، واصطحبه معه إلى القدس ومصر، وبعد وفاته عمل طبيبًا لابنه الملك الناصر داود بن الملك المعظم الذي عهد له برياسة الطب، ثم عاد أخيرًا إلى دمشق وأقام فيها، حيث راح المشتغلون بالطب وصناعته يترددون إلى مجلسه ويأخذون عنه تراكيب أدوية الترياق الكبير الذي يمنع آليًا امتصاص السم، وغيرها من التراكيب المبتكرة التي لم يسبقه أحد إلى معرفتها. كذلك وفد إلى مجلسه طلاب العلم والطب في دمشق للاستفادة من خبرته وشروحه. وقد أفاض المحققون في ذكر فضل «الصوري» وبحوثه العلمية الرائدة ومن بينهم: قدري طوقان، وأحمد شوكت الشطي، وعمر رضا كحالة، وأنور الرفاعي، وخير الدين الزركلي، كما أفرد له ابن أبي أصيبعة في كتابه «عيون الأنباء في طبقات الأطباء» صفحات للحديث عن مآثره في علم النبات والصيدلة والطب.. وتحدث المؤرخون في الأدوية المفردة، وللصوري مخطوطة بعنوان «تذكرة الكحالين» المشهورة بالكافي في طب العيون، موجودة بمكتبة الأسد الوطنية بدمشق، ومخطوطة «الشامل في الأدوية المفردة» بمكتبة السلطان أحمد الثالث في إسطنبول. توفي رشيد الدين الصوري عام 639هـ/1241م بدمشق، وبقي إرثه العلمي خالدًا في مؤلفاته الباقية، وفي اقتباسات كثيرة في مؤلفات علماء الغرب. < يحيى بن زكريا بن العوام تنظم الحكومات ومؤسسات المياه خاصة، وجمعيات حماية البيئة في العالم، حملات لا تهدأ تدعو فيها إلى ترشيد استهلاك الثروة المائية، والكف عن هدر هذه النعمة الغالية، صونًا لها من النضوب، وعجزها عن توفير حاجات الناس، وترسم تلك الحملات أساليب عديدة لترشيد استهلاك الماء ومن بينها استخدام أسلوب الري بالتنقيط الذي انتشر بشكل واضح في أيامنا.. ولكن علماء المسلمين الرواد كانوا السباقين إلى هذه الدعوة، وتفصيل طريقتها بشكل علمي دقيق. يعد «يحيى بن زكريا بن العوام» أشهر علماء عصره، ويعود له الفضل في تأسيس علم الفلاحة والزراعة والبيطرة، وأول من شرح طريقة الري بالتنقيط وكذلك أول من وضع ما يُعرف اليوم بالتقويم الزراعي. < ابن العوام الأندلسي من مواليد إشبيلية في القرن السادس الهجري، ولد في أسرة غنية امتلكت ضيعة خاصة بها أطلق عليها اسم «ضيعة آل العوام» على الضفة اليمنى لنهر الوادي الكبير. انهمك ابن العوام في تأليف الكتب، لكن أكثر مصنفاته ضاعت خلال هجمات الأوروبيين على الأندلس، ولهذا لم يتبق للمكتبة العربية من مؤلفاته سوى: رسالة في تربية الكرم (العنب)، عيون الحقائق وإيضاح الطرائق، والفلاحة الأندلسية، الذي يعد أشهر مؤلفاته فهو يمثل موسوعة زراعية اجتمعت فيها خلاصة معارف الأندلس والمغرب ومصر والعراق في الزراعة والبيطرة وصار مقررًا لدراسة طلاب الزراعة في جامعاتها لعدة قرون، كما نقل منه الأوروبيون، وترجم أكثر من مرة إلى الإسبانية والفرنسية. < أبو العباس أحمد (ابن الرومية) في مدينة «إشبيلية» ظهرت عبقرية علمية أخرى، أسهمت بدورها في تقدم علم النبات والأعشاب، إضافة إلى عملها في مجالات المعرفة الأخرى كعلم الحديث ومعرفة رجاله والتأليف فيه. ولد أبوالعباس أحمد بن محمد بن مفرج سنة 561هـ-1165م بمدينة إشبيلية، وكان جده مولى لبني أمية، وواحدًا من أطباء قرطبة، مارس العشابة والعلاج بها، ثم تعلم أبوه محمد علم النبات الطبي، وتزوج من امرأة رومية من نصارى الأندلس، فأنجبت له «أحمد» ومن هنا لقب بابن الرومية. اتخذ أبوالعباس أحمد من الصيدلة حرفة له، ومارسها في دكان لبيع الأعشاب والعلاج بها، والتفت إلى دراسة علم النبات والأعشاب وقواها الطبية، وفوائدها الصيدلانية، في الوقت الذي اهتم فيه بدراسة علم الحديث وضبطه وحفظه والتأليف فيه.. وراح خلال تنقله بين مدن الأندلس وأقاليمه يلازم المحدثين ويستمع إلى الحديث منهم، ويحصل الإجازات عن الشيوخ، فتنقل بين غرناطة وقرطبة، وإلى إقليم الشرف بظاهر إشبيلة، وحبل شلبر (سيرانيفادا) قرب غرناطة ومدن جيان ورندة وجبالها وجبال غلزا شرقي الأندلس، وفيها شاهد الأعشاب وتفحصها متعرفًا إلى خصائصها وطبيعتها.. في عام 580هـ - 1184م توجه أبوالعباس ابن الرومية إلى سبتة بالمغرب للقاء الشيخ أبي محمد ابن الحجري (ت 592هـ - 1186م) ولكنه لم يحظ بالاجتماع إليه.. وإن كان قد حصل على الإجازة منه كتابة خلال رجوعه إلى الأندلس، وكانت رحلة «ابن الرومية» الثانية إلى بلاد المشرق سنة 612هـ - 1215م بهدف أداء فريضة الحج وطلب العلم، فاجتاز البحر إلى المغرب ونزل بميناء «بجاية»، وانصب اهتمامه على تحصيل علم الحديث من علمائها، ثم قام بجولات في ريف المدينة الجبلي، لجمع أنواع النبات، وتحري أصنافه فحصل معرفة واسعة عن أعشابها الطبية. انتقل «ابن الرومية» بعد ذلك إلى تونس وفيها التقى بوزير الموحدين فأخذ هذا منه كتاب «تعليم المتعلم» في أربعين مجلدًا، كان قد حمله معه عند انطلاقه من إشبيلية. وواصل رحلته إلى مصر، فمر بالقيروان والمهدية وقابس وطرابلس وبرقة، وفحص فيها أصناف النباتات والأعشاب.. ولما وصل أخيرًا إلى الإسكندرية (613هـ - 1216م) التقى فيها بكوكبة من العلماء والمحدثين، وطوف في أرجائها يعاين الأعشاب ويدرس خصائصها، وقد تناهى إلى سمع الملك العادل أبوبكر بن أيوب، سلطان الشام ومصر، وصول «ابن الرومية» وبلغه ما يمثله هذا العالم من مكانة وشهرة ذائعة، فاستدعاه إلى «القاهرة» فأقام فيها عامين، أعد خلالهما مجموعة من الأدوية النافعة.. واصل «ابن الرومية» رحلته إلى القدس، حيث توقف يدرس كعادته نباتات بيت المقدس وضواحيه وجباله، ثم توجه إلى الحجاز فتجول فيها وتعرف إلى أعشابها.. وبعد أدائه الفريضة، يمم شطر العراق، وهناك تعرف إلى رجال الحديث ببغداد، كما اتصل بالعديد من أصحاب الخبرة في نباتات وأعشاب العراق، وتابع سفره من ثم إلى الشام مرورًا بحران وحلب وكان كلما تجول يضيف إلى معارفه معلومات عن النباتات الطبية واستخداماتها، والتقى بابن القفطي (توفي 646هـ - 1248م) ودارت بينهما محاورات عن النبات والأعشاب ووصل «ابن الرومية» بعدها إلى دمشق، ثم من جديد إلى القدس فمصر لتنتهي رحلته أخيرًا بعد ثلاث سنوات من الاطلاع والبحث وجمع المعلومات عن أنواع الأعشاب والنبات. عاد «ابن الرومية» إلى «إشبيلية» وفي جعبته مخزون ثر من المعلومات حصلها من مشاهداته ومعايناته ودراسته للنباتات في بلاد المغرب والمشرق التي تنقل فيها أثناء تطوافه في الأقاليم والمدن، وقد أغنى تلك المحصلة بما استمع إليه من علماء الأعشاب والعطارين، وما جمعه من أفواه الأعراب والبربر وسكان تلك الأقاليم بما يخص أسماء تلك النباتات وخواصها الطبية واستخداماتها في علاج العديد من الأمراض، وأثبت تلك المعلومات في كتاب فريد في بابه سماه «الرحلة». استقر «ابن الرومية» في إشبيلية، وتوزع نشاطه العلمي فيها على ثلاثة محاور: 1- ممارسة حرفته كعشاب متخصص في النباتات الطبية، في دكانه بالمدينة. 2- تدريس النبات والأعشاب الطبية، حيث تقاطر إليه طلاب العلم في الشريعة والعلوم الطبيعية، وكان من بينهم العالم العربي الشهير «ابن البيطار» (ت 646هـ/1248م). 3- انصرافه إلى تأليف عدد من الكتب والرسائل تضمنت معلومات وشروح وتعليقات في أكثر من مجال علمي، وقد ضاع أكثرها وبالذات مؤلفه المهم «الرحلة النباتية» الذي حفظ ابن البيطار مقتطفات منه أوردها في كتابه «الجامع لمفردات الأدوية والأغذية» وقد بلغ عددها 85 اقتباسًا رتب ابن الرومية فيها أسماء النباتات ترتيبًا هجائيًا على حروف المعجم. وقد أشار «ابن أبي أصيبعة» في مؤلفه: «طبقات الأطباء» إلى كتاب ابن الرومية «تفسير أسماء الأدوية المفردة» من كتاب «ديسقوريدس» وإلى مقالة في تركيب الأدوية. توفي ابن الرومية بإشبيلية سنة 637هـ/1239م، وبقيت معلوماته عن النباتات ومواطنها ومعارفه عن الأدوية وقواها ومنافعها مصدرًا لمعارف علماء الغرب وبحوثهم إلى زمن طويل.
__________________
|
|
#8
|
||||
|
||||
|
تاريخ طب العيون عند العرب الاستاذ الدكتور علي عمار «إن العرب أشعلوا سراجهم من القناديل اليونانية، و بلغت حرفة الطب عندهم بداية من ق 08 إلى 11 للميلاد من المكانة و الأهمية مالا نكاد نجد له مثيلا في تاريخ الأمم». هذه هي رؤية المؤرخ الإنجليزي «السير وليام اوسلر» من خلال بحوثه في الحضارة العربية و العلوم عند العرب.. وقد تبوأ الأطباء العرب منزلة رفيعة في العلوم الطبية عامة وطب العيون خاصة، وأنجزوا فيها الدراسات القيمة التي تدلنا على مبلغ ما وصل إليه الطب العربي حتى أن العالم الألماني «هيرشيرع» يستشهد قائلا : «إن طب العيون عند العرب قد بلغ في القرنين الرابع و الخامس الهجري مرتبة سامية تدعو إلى الدهشة و الاستغراب».. و هكذا نرى كيف ساهم كثير من العلماء و الباحثين في التنقيب عن الآثار العلمية التي خلفها أجدادنا العرب.. و التي بقيت رمزا لحضارتنا المجيدة.. وفخر للأجيال المتعاقبة. و من هذا المنطلق حرص الدكتور" نشأت حمارنة " أستاذ طب العيون في جامعة دمشق أن يساهم في البحث العلمي فأصدر كتابا تحت عنوان: تاريخ طب العيون عند العرب. ولأهمية مثل هذه البحوث القيمة التي تكشف عن حقيقة تاريخية كاد الزمن أن يطمسها بغبار النسيان، رأيت أن أقدم هذا الكتاب الذي يضم بين صفحاته تاريخ الطب عند العرب من خلال الدراسات التي تخفق بين ثناياها القلوب الحية لحضارة الأمة العربية المزدهرة. ونظرا لشغف الدارسين باستطلاع التاريخ، وحب المعرفة، و الكشف عن خبايا الحقائق التاريخية.. اخترت هذا الكتاب الذي صدر حديثا.. وتوسد المكتبة العربية. لقد مهد الدكتور نشأت حمارنة كتابه بلمحة موجزة عن نشأة الطب وممارسة الإنسان قديما له، وبدء ظهور النظرية الطبية، وعرفنا بمظاهر الطب في الحضارات القديمة عبر التاريخ. فقام بتصنيف دراسته ضمن المحاور التالية: 1- أجدادنا العرب.. ونظرتهم إلى الطب. 2- إعلام أطباء العيون العرب قبل الإسلام. 3- تراجم الأطباء العرب. ويتحدث المؤلف في هذا المحور عن الهجرات الكثيفـة التي استـوطنـت جزيرة العرب، والحضارات التي اجتنبت قبائل بدوية إلى أرض ما بين النهرين، وفي بلاد الشام، حيث سيطر فيها العنصر العربي منذ أقدم العصور، و ظهرت حضارة الكنعانيين و الآراميين المتطورة و المتصلة ببلاد النهرين وبوادي النيل و ببادية العرب. (كل ذلك يشير إلى أن هؤلاء العرب (البدو الرحل)الذين يتحدث عنهم المؤرخون حينما يؤرخون للحياة العقلية و العلمية، لم يكونوا معزولين عن العالم المتحضر المحيط بهم، ولم يكونوا قليلي التطور الذهني، بل شاعت المعرفة العلمية عندهم). و الدليل على ذلك هو تطور اللغة العربية وغناها بالألفاظ المترادفة التي تشير إلى ثروة ذهنية، و إلى نشاط المعرفة العلمية مما يبرهن على أن عقل العربي في الجاهلية لم يكن عاجزا عن إدراك الفروق الدقيقة بين المعاني، لوفرة المترادفات، وغنى التعابير، ومرونة اللغة. فغنى مفردات اللغة العربية، وتطور قواعدها، هو انعكاس واضح لارتقاء المعرفة ونشاط الذهن. كـل هـذا في عـصر الجاهليـة. . ثـم جـاء الإسلام، فـوسعت هـذه اللغـة المتطورة كل المعاني التي جاء بها. وجاء عصر ترجمة العلوم من لغة الإغريق، و اللغة الآرامية إلى اللغة العربية. فوجد المترجمون في هذه اللغة قدرة عجيبة على استيعاب مفردات من أنواع العلوم المختلفة. وكان عصر الازدهار، وظهور المعاجم و القواميس التي اتسعت لشتى العلوم. لقد أراد المؤلف في عرضه أن يجسد معنى العلوم العربية و الطب العربي، فالعرب هم ورثة الحضارة و العلم، وورثة بلاد الرافدين القديمة. وعـندما استعرض المـؤلف إعلام أطبـاء العيـون العرب قبـل الإسـلام قال : إن الطبيب في المجتمع العربي ذو شخصية محترمة تتمتع بشهرة جيدة وقد وصل إلينا الكثير من المعلومات التي عرفها أطبـاء العيون العرب قديما يوم ظهرت البرديات المكتوبة في الألف الثاني قبل الميلاد، والتي كانت بدورها منقولة عن برديات أقدم بألف عام أو أكثر. فقد وصف المصريون القدماء الكثير من أمراض العيون، وعرفوا العديد من الأعشاب التي تعالج العيون، كما استعملوا أدوية من أصل معدني أو حيواني، كما عرفوا بعض الطرائق الجراحية. وقد استفاد الإغريق من الطب المصري القديم بشهادة المؤرخين القدامى. ثم ينقلنا المؤلف إلى عصر أطباء العيون في بلاد ما بين النهرين، إذ ظهرت قوانين نظمت المهن الطبية، وحددت أجور الأطباء وأتعابهم عن المداواة و العمليات الجراحية، كما سنت قوانين صارمة و قاسية و مجحفة بحق الطبيب، لكنها شكلت رادعا حقيقيا ضد الأدعياء الذين يزعمون أنهم يستطيعون ممارسة المهنة الطبية. في بلاد الرافدين جاء عهد تدريس الطب و الامتحان. .. فأصبحت الدولة مسئولة عن منح الإجازة الطبية، و السماح بممارسة المهنة. ولم يغفل التاريخ القديم عن ذكر أسماء كثير من الأطباء الذين عاشوا في صحراء الجزيرة العربية أو في باديتها أو نجودها. تـــــراجــــم أطبــــاء العـــــــــرب : لقد انهمك الأطباء الأوائل في بغداد في ترجمة مؤلفات أسلافهم إلى اللغة العربية، فصنفوا المعلومات الطبية سواء كانت من أصل يوناني أو هندي أو فارسي، وكان المصدر الرئيسي لدراسة حياة الأطباء العرب ومؤلفاتهم كتب التراجم مثل : 1- عيون الأنباء في طبقات الأطباء – لابن أبي أصيبعة. 2- تاريخ الأطباء و الحكماء –لإسحاق بن حنين. وأبرز أطباء العيون عند العرب الذين احتلوا مراكز هامة في هذا الميدان : أ- يوحنا بن مأسويه : ولد عام 160 هـ - 776 م في حنديسابور من أسرة سريانية. هاجرت أسرته إلى بغداد وهو فتي، وتلقى تربية صارمة في وسط علمي و في بيت مرموق، تعلم الطب من والديه حتى أصبح رئيس البيمارستان في بغداد ونال مركزا رفيعا في عهد هارون الرشيد، بل فقد أصبح طبيبه الخاص. وكان " يوحنا " يذهب إلى بيزنطة للحصول على كتب الطب، ويحملها معه إلى بغداد. اشتهر بغزارة إنتاجه، ووضع في طب العيون كتابين : 1- دغل العين. 2- معرفة محنة الكحالين. ويبدو أن " ابن ماسويه " لم ينل من مؤرخي الطب اهتماما كبيرا، لذلك فـإن ما روتـه عنـه المصادر يحتـاج إلى التـدقيـق، و أن انشغاله بـإدارة "البيمارستان" و التعليم و التأليف وصحبته للخلفاء، منعته من أن يعطي الوقت الكافي للممارسة الطبية. وهو أول من وصف (السبل) المرض الذي يظهر بتشكل أوعية دموية على القرنية، والذي يعود سببه إلى التراخوما. وكتاب (دغل العين) هو أقدم كتاب تعليمي في طب العيون كتب بالعربية. و يتميز أسلوب هذا الكتاب بحيوية بارزة، ويعطي أهمية كبيرة إلى عملية استجواب المريض. ويعرض " ابن ماسويه " الأعمال الجراحية عرضا موجزا، ويمكننا القول أن الكتاب مختصر يضم " 47 " فصلا. أما كتاب " معرفة محنة الكحالين " فهو أقدم كتاب عربي طبـي إختصر فيه كل علم أمراض العين في عدد محدد من الأسئلة. ب- حـنـيــــن بـن إسحــــاق: يعد الطبيب العربي "حنين بن إسحاق العبادي" من مشاهير أطباء العيون في القرن التاسع الهجري، كان ميالا إلى دراسة الطب، وهو من عداد تلاميذة الطبيب "يوحنا بن ماسويه". ويروي أن "ابن إسحاق" قد ترك مدرسة الطب في بغداد، لأنه كان يضايق أستاذه بكثرة الأسئلة، فذهب إلى " بيزنطة " وتعلم اللغة الإغريقية، وعند عودته إلى بغداد بدأ عمله كمترجم. وكان ابن إسحاق يجمع المخطوطات للنص الذي ينوي ترجمنه ويقوم بفرزها و مراجعتها و تبويبها ثم ترجمتها، وتكون الترجمة إلى اللغة السريانية ثم إلى اللغة العربية. نقل الكثير من العلوم الإغريقية و السريانية إلى اللغة العربية، حتى أصبح ترجمان الخلفاء وطبيبهم الخاص. كما تعرض إلى الدسائس والمؤامرات من خصومه وحساده. ومن أشهر مؤلفاته في الطب : 1- المقالات العشر في العين. 2- حكمة العين. 3- مسائل في العين. جـ- علي بن عيســــى الكحـال: يعد هذا الطبيب من أعظم أطباء العيون وهو صاحب كتاب " تذكرة الكحالين " انطلق فيه على منهج علمي حسب تشريح العين، بدأ بأمراض الأجفان و أمراض جهاز الدمع، ثم التهاب الملتحمة، وانتقل إلى أمراض القرنية و القزحية، حيث أوضح ماهية المرض وطبيعته، ثم يذكر أعراضه وعلاماته و أوصافه وميزاته، وأسباب هذا المرض وكيفية معالجته بأسلوب علمي واضح. وهناك عدد آخر من أطباء العيون عند العرب.. منهم : 1- أبو علي بن أعين – مؤلف كتاب أمراض العيون ومداواتها. 2- محمد بن سعيد التميمي – صاحب كتاب ماهية الرمد وأنواعه وأسبابه وعلاجه. 3- أبو علي خلف الطولوني – وكتابه – النهاية و الكفاية في تركيب العينين وخلقتهما وعلاجهما وأدويتهما. والواقع أن السمعة الوطيدة التي تمتع بها أطباء العرب في أرجاء الدنيا قاطبة، كانت تعتمد على باع طويل في العلوم و الخبرة و الامتحانات القاسية، فلم يكن بإمكان أحد أن يتعاطى مهنة الطب دون دراسة سابقة وحرصا على إبقاء العيادات الطبية وممارسة هذه المهنة بعيدة عن الاستهتار و الامتهان أو إدعاء الباطل، كان كل طبيب مضطرا إلى نيل تصريح رسمي خاص يشهد بعلمه وكفاءته، فقد كان هذا صادرا عن الخليفة. أما الكحالون /أطبـاء العيـون فيـمتحنهـم المحتسب بكتـاب حينن بـن إسحاق "العشر مقالات في العين" فمن اجتاز الفحص بتشريح العين، وعدد طبقاتها السبع وعرف رطوباتها الثلاث، ثم أدرك أمراضها الثلاثة وما يتفرع عن ذلك من الأمراض، وكان خبيرا بتركيب الكحل وأمـزجة العقاقيـر منحه المحتسب إجازة بالعمل لمداومة عيون الناس. ويضم كتاب تاريخ أطباء العيون العرب معلومات مختصرة عن نظرة العرب في العلوم الطبية. وكان باستطاعة المؤلف أن يقدم للقارئ معلومات غزيرة مما تحتويه مخطوطاتنا العربية. وقد كتب المستشرقون و المهتمون بالبحوث العربية الكثير عن فضل العرب في العلوم بأنواعها. وهم الذين استطاعوا أن يجعلوا من اسم الطب العربي الإسلامي حقيقة مشرفة بتجاربهم واختباراتهم وابتكاراتهم في مختلف العلوم و الفروع المعارفية. * لتعرف اكثر عن الموضوع تحدث مع طبيب الان . المصادر : - حنين بن إسحاق – كتاب العشر مقالات في العين – القاهرة 1928 م. - مصطفى بن الهيثم – بحوثه وكشوفه البصرية – القاهرة 1942 وما بعدها. - حنين بن إسحاق – المسائل في الطب، تحقيق و تعليق د. محمد أبو ريان وآخرون. دار الجامعات المصرية، الإسكندرية 1978 م. - شعالي أحمد محمود – معجم تعريب النباتات الموريطانية، نواقشوط 1990 م. - عودات محمد – لحام الجروح – النباتات الطبية واستعمالاتها 1987 م. - إبراهيم بن مراد : المصطلح الأعجمي في كتاب الطب و الصيدلة – دار الغرب الإسلامي – بيروت لبنان 1985 م. - أحمد بن ميلاد – تاريخ الطب العربي – تونس 1980 م. - جبارة أحمد – عجائب الطب الشعبي. دار البلاغة. حلب 1972 م.
__________________
|
|
#9
|
||||
|
||||
|
إسهامات علماء المسلمين في علم البصريات د. راغب السرجاني كغيره من العلوم التي ظهرت قبل المسلمين، كان لليونانيين وغيرهم من الشعوب القديمة اهتمام بعلم البصريات، وكان لهم فيه آثار طيبة اتَّكأ عليها علماء المسلمين عند ممارستهم لهذا العلم، فقد نقلوا عن اليونان آراءهم في انكسار الضوء, والمرايا المحرِقَة وغيرها, ولكنهم لم يقتصروا على مجرَّد النقل بل توسَّعوا وأضافوا إضافات باهرة من ابتكاراتهم، واستطاعوا أن يسطِّروا في علم البصريات تاريخًا مشرِّفًا. علم البصريات في الحضارة الإغريقية في أوَّل الأمر كانت البصريَّات الإغريقيَّة تحوي رأيين متعارضين؛ الأول: هو الإدخال، أي دخول شيء ما يمثل الجسم إلى العينيين، والثاني: الانبعاث، أي حدوث الرؤية (الإبصار) عندما تنبعث أشعة من العينين وتعترضها الأجسام المرئية. وقد ظلَّت الحضارة الإغريقيَّة تتناول البصريات بأخذٍ وردٍّ بين هذين الرأيين، وكانت مجهودات أرسطو تفتقر إلى تفصيل حتميٍّ، وكذلك إقليدس رغم مجهوداته الملموسة، إلاَّ أن نظرياته كانت مقصورة على تقديم شرح كامل للإبصار؛ لأنها أغفلت العناصر الفيزيائيَّة والفسيولوجيَّة والسيكولوجيَّة للظواهر البصريَّة، حيث ذهب إلى أن العين تُحْدِث في الجسم الشفاف المتوسِّط بينها وبين المبصَرَات شعاعًا ينبعث منها، وأن الأشياء التي يقع عليها هذا الشعاع تُبْصَر، والتي لا يقع عليها لا تُبْصَر، وأن الأشياء التي تُبْصَر من زاوية كبيرة تُرى كبيرة، والتي تبصر من زاوية صغيرة ترى صغيرة. أما بطليموس فرغم إبداعه في التوفيق بين التناول الهندسي والتناول الفيزيائي إلا أنه فشل في نهاية الأمر؛ لأن استخدامه كان مقصورًا على دعم استنتاجات سبق التوصُّل إليها فعلاً، بل إن معالجة النتائج التجريبيَّة كانت تجري أحيانًا بجواز مروره لهذه الاستنتاجات. إسهامات العلماء المسلمين : ظلَّت البحوث في علم البصريات تدور في هذا الفلك السابق دون تقدُّم أو رقيٍّ، وبقيت على ذلك حتى جاءت الحضارة الإسلاميَّة، فكان لإسهامات المسلمين في علم البصريات نسق آخر متطوِّر وفريد؛ وذلك نظرًا لنبوغهم في العديد من العلوم المرتبطة بهذا العلم مثل الفلك والهندسة الميكانيكيَّة وغيرهما، إذ إن ابتكاراتهم قد تتداخل فيها هذه العلوم. أبو يوسف الكندي جاء الفيلسوف أبو يوسف الكندي، والذي يُعَدُّ من أوائل العلماء المسلمين الذين طرقوا ميدان علم الطبيعة وعلم البصريات؛ حيث تناول الظواهر الضوئيَّة وعالجها في كتابه الشهير (علم المناظر)، وقد أخذ بنظريَّة الانبعاث الإغريقيَّة، إلا أنه أضاف كذلك وصفًا دقيقًا لمبدأ الإشعاع، وصاغ من خلال ذلك أساس نظام تصوُّريٍّ جديد يحلُّ في نهاية الأمر محلَّ نظريَّة الانبعاث، وكان لكتابه (علم المناظر) صدًى في المحافل العلميَّة العربيَّة، ثم الأوربيَّة خلال العصور الوسطى. الحسن بن الهيثم رائد علم الضوء ومن بعده جاء الحسن بن الهيثم والذي تُعَدُّ أعماله العلميَّة فتحًا جديدًا ووثبة خطيرة في عالم البصريات وفسيولوجية الإبصار، وكانت أعماله هي الأساس الذي بنى عليه علماء الغرب جميع نظرياتهم في هذا الميدان، وكان في طليعة العلماء الأجانب الذين اعتمدوا على نظرياته -بل أغاروا عليها ونسبوها لأنفسهم- روجر بيكون وفيتلو وعلماء آخرون، ولا سيما في بحوثهم الخاصَّة بالمجهر والتلسكوب والعدسة المكبِّرَة. بدأ ابن الهيثم أوَّلا بمناقشة نظريات إقليدس وبطليموس في مجال الإبصار، وأظهر فساد بعض جوانبها، ثم في أثناء ذلك قدَّم وصفًا دقيقًا للعين وللعدسات وللإبصار بواسطة العينين، ووصف أطوار انكسار الأشعة الضوئيَّة عند نفوذها في الهواء المحيط بالكرة الأرضية بعامَّة، وخاصَّة إذا نفذ من جسم شفّاف كالهواء والماء والذرَّات العالقة بالجوِّ، فإنه ينعطف -أي ينكسر- عن استقامته، وبَحَثَ في (الانعكاس) وتبيان الزوايا المترتِّبة على ذلك، كما تطرَّق إلى شرح أن الأجرام السماويَّة تظهر في الأفق عند الشروق قبل أن تصل إليه فعلاً، والعكس صحيح عند غروبها، فإنها تبقى ظاهرة في المجال الأفقي بعد أن تكون قد احتجبت تحته، وهو أول من نوَّه باستخدام الحجرة السوداء التي تُعتبر أساس التصوير الفوتوغرافي. والكتاب الذي خلَّد اسم ابن الهيثم عبر القرون هو (كتاب المناظر)، ويوضِّح هذا الكتاب تصوُّر البصريات كنظريَّة أوليَّة في الإبصار، مختلفة جذريًّا عن فرض الشعاع المرئي الذي حافظ عليه التقليد الرياضي منذ إقليدس وحتى الكندي، ولقد أدخل ابن الهيثم أيضًا منهجيَّة جديدة على هذا التفسير لعمليَّة الإبصار، وبهذا تمكَّن من صياغة مسائل كانت إمَّا غير مفهومة طبقًا لنظرية الشعاع البصري، أو مهملة من جانب فلاسفة يهدفون أساسًا إلى تفسير ماهيَّة الرؤية أكثر من اهتمامهم بشرح كيفيَّة حدوث الإبصار. وقد ألَّفَ ابن الهيثم في البصريات وحدها ما يقرب من أربعة وعشرين موضوعًا، ما بين كتاب ورسالة ومقالة، غير أن أكثر هذه الكتب قد فُقد فيما فُقِدَ من تراثنا العلمي، وما بقي منها فقد ضمَّته مكتبات إستانبول ولندن وغيرهما، وقد سلم من الضياع كتابه العظيم (المناظر) الذي احتوى على نظريات مبتكرة في علم الضوء، وظلَّ المرجع الرئيسي لهذا العلم حتى القرن السابع عشر الميلادي بعد ترجمته إلى اللاتينيَّة. فكان كتاب (المناظر) ثورة في عالم البصريات، وفيه لم يتبنَّ ابن الهيثم نظريات بطليموس ليشرحها ويُجْرِي عليها بعض التعديل فحسب، بل إنه رفض عددًا من نظرياته في علم الضوء، بعدما توصَّل إلى نظريات جديدة غدتْ نواة علم البصريات الحديث. فقد كان بطليموس -كما ذكرنا- يزعم أن الرؤية تتمُّ بواسطة أشعَّة تنبعث من العين إلى الجسم المرئي، وقد تبنَّى العلماء اللاحقون هذه النظرية، ولما جاء ابن الهيثم نسف هذه النظريَّة، وبيَّن أن الرؤية تتمُّ بواسطة الأشعة التي تنبعث من الجسم المرئي باتجاه عين المبصر، وبعد سلسلة من الاختبارات أجراها ابن الهيثم بيَّن أن الشعاع الضوئي ينتشر في خطٍّ مستقيم ضمن وسط متجانس، وقد أثبت ذلك في كتاب (المناظر). كذلك برهن ابن الهيثم رياضيًّا وهندسيًّا على كيفيَّة النظر بالعينين معًا إلى الأشياء في آنٍ واحد دون أن يحدث ازدواج في الرؤية برؤية الشيء شيئين، وعلَّل ابن الهيثم ذلك بأن صورتَي الشيء المرئي تتطابقان على شبكيَّة العينين، وقد وضع ابن الهيثم بهذه البرهنة وذلك التعليل الأساس الأول لما يُعرف الآن باسم الاستريسكوب، وكان ابن الهيثم أوَّل من درس العين دراسة علميَّة، وعرف أجزاءها وتشريحها ورسمها، وأول من أطلق على أجزاء العين أسماء أخذها الغرب بنطقها أو ترجمها إلى لغاته، ومن هذه الأسماء: القرنية (Cornea)، والشبكية (Retina)، والسائل الزجاجي(Vitrous Humour)، والسائل المائي (Aqueous Humour). ومن أهم إنجازات ابن الهيثم بصفة عامَّة في البصريات: أنه أول مَنْ أجرى تجارِب بواسطة آلة الثقب، أو البيت المظلم، أو الخزانة المظلمة، واكتشف منها أن صورة الشيء تظهر مقلوبة داخل هذه الخزانة، فمهَّد بهذا الطريق إلى ابتكار آلة التصوير، وبهذه الفكرة وتلك التجارِب سبق ابن الهيثم العالمين الإيطاليين (ليوناردو دوفنشى) و(دلا بورتا) بخمسة قرون. كما وضع ابن الهيثم -ولأول مرَّة- قوانين الانعكاس والانعطاف في علم الضوء، وعلَّل لانكسار الضوء في مساره، وهو الانكسار الذي يحدث عن طريق وسائط كالماء والزجاج والهواء، فسبق ابنُ الهيثم بما قاله العالمَ الإنجليزي نيوتن. وكان أحد أبرز إنجازات ابن الهيثم في كتابه المذكور تجربة الصندوق الأسود، وتُعتبر الخطوة الأولى في اختراع الكاميرا، وكما تقول الموسوعة العلمية: فابن الهيثم يُعتبر أولَ مخترع للكاميرات، وهي ما يُسمَّى عمليًّا: (Camera obscura). ومَنْ يطَّلع على كتاب (المناظر) والموضوعات التي تتعلَّق بالضوء وما إليه يخرج بأن ابن الهيثم قد طبع علم الضوء بطابع جديد لم يُسبق إليه، وقد ألَّف هذا الكتاب عام (411هـ/ 1021م)، وفيه استثمر عبقريته الرياضيَّة، وخبرته الطبيَّة، وتجاربه العلميَّة، فتوصَّل فيه إلى نتائج وضعته على قمَّة عالية في المجال العلمي، وصار بها أحد المؤسِّسين لعلوم غيَّرت من نظرة العلماء لأمور كثيرة في هذا المجال. وعلى الرغم من مكانة ابن الهيثم وبحوثه المبتكَرة في علم الضوء، إلاَّ أنه ظلَّ مغمورًا لا يعرفه كثير من الناس، حتى قَيَّض الله من يكشف عن جهوده وينقب عن آثاره ويجليها، وكان من هؤلاء العالم المصري مصطفى نظيف، وذلك حين كتب عنه دراسة طيبة رائدة نشرتها جامعة القاهرة في مجلدين، وقد بذل فيها جهدًا مضنيًا في قراءة مخطوطات ابن الهيثم ومئات المراجع الأخرى، حتى خلص إلى حقيقة صادقة، وهي أنَّ ابن الهيثم خليقٌ بأن يُعدَّ بحقٍّ رائد علم الضوء في مستهلِّ القرن الحادي عشر. وليس كل ما ذكرناه إلا جزءًا بسيطًا من الإنجاز الهائل الذي قدمه المسلمون لعلم البصريات، فما أروعه من إنجاز!!
__________________
|
|
#10
|
||||
|
||||
__________________
|
 |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |