|
|||||||
| الملتقى الاسلامي العام مواضيع تهتم بالقضايا الاسلامية على مذهب اهل السنة والجماعة |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
||||
|
||||
|
إِنَ الحَمدَ لله نَحْمَدَه وُنَسْتعِينَ بهْ ونَسْتغفرَه ، ونَعوُذُ بالله مِنْ شِروُر أنْفْسِنا ومِن سَيئاتِ أعْمَالِنا ، مَنْ يُهدِه الله فلا مُضِل لَه ، ومَنْ يُضلِل فَلا هَادى له ومَنْ يُضلِل فَلا هَادى له ، وأشهَدُ أنَ لا إله إلا الله وَحْده لا شريك له ، وأشهد أن مُحَمَداً عَبدُه وَرَسُوُله .. اللهم صَلِّ وسَلِم وبَارِك عَلى عَبدِك ورَسُولك مُحَمَد وعَلى آله وصَحْبِه أجْمَعينْ ، ومَنْ تَبِعَهُمْ بإحْسَان إلى يَوُمِ الدِينْ وسَلِم تسْليمَاً كَثيراً .. أمْا بَعد ... حياكم الله جميعاً أيها الأحبة الكرام ، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعاً من الجنة 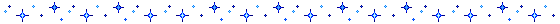  عون الرحمن في وسائل استثمار رمضان (1)  محمود العشري  1 - التمـهيد لقد أجمع العُقلاء على أن أنفسَ ما صُرِفتْ له الأوقات، هو عبادة ربِّ الأرض والسموات والسَّير في طريق الآخرة، وبذل ثَمن الجنة، والسعاية للفكاك من النار. ولما كان هذا الطريقُ - كغيره من الطُّرق والدروب - تكتَنِفُه السُّهول والوِهَاد والوِدْيان والجبال والمَفاوز ويتربَّص على جنباته قُطَّاع الطُّرق ولصوص القلوب؛ احتاج السَّائر إلى - الدليل الحاذق في معرفة الطرق والمسالك - يُبَصِّرُهُ الدروب الآمنة، والمسالك النافذة، ويُعَرِّفُهُ مكامن اللُّصوص، وأفضل الأزمنة للسَّير، وأنسب الأوقات للجدِّ في السفر، - في طريق الآخرة - هو منهج سلَفِنا الصالح في النُّسك، وطرائقهم في السير إلى الله - تعالى - وعباراتهم في الدلالة عليه، فهذه - بحقٍّ - خيرُ معوان على انتحاء جهة الأمان، وهذا النسك السَّلفي العتيق والمنهج السُّني الرشيد في التزكية، لا غِنى عنه لكلِّ طالب طريق السلامة، فلا عصمة لمنهجٍ في مُجْمله إلا المنهج السَّلفي. ولما كانت الأزمنة الفاضلة من أنسب أوقات الجدِّ والاجتهاد في الطاعة وكان شهر رمضان من مواسم الجود الإلهيِّ العميم، حيث تُعتَق الرِّقاب من النار، وتوزَّع الجوائز الربَّانية على الأصفياء والمُجتهدين؛ كان لزامًا أن تتواصى الهِممُ على تحصيل الغاية من مرضاة الربِّ في هذا الشهر، وهذا من التواصي بالحقِّ المأمور به في سورة العصر.  وإذا كان دُعاة الباطل واللَّهو والفجور تتعاظم هِممُهم في الإعداد لغواية الخَلْق في هذا الشهر بما يُذِيعونه بين النَّاس من مسلسلاتٍ ورقص، ومُجونٍ وغِناء، فأَخْلِقْ بأهل الإيمان أن يُنافسوهم في هذا الاستعداد، ولكن في البِرِّ والتَّقْوى!  ولقد صامَتْ أمَّتُنا دهورًا، غير أنَّ صومها لهذا الشهر ما كان يَزِيدُهَا إلاَّ بعدًا عن ربِّها ومليكها وحاكمِها الحقيقي، فصار رمضان موسِمًا مُفَرَّغًا من مضمونه، مُجَرَّدًا عن حقائقه، بل صار ميدانًا للعربدة، وشَغْل الأوقات بما يغضب الكريم المتعال - سبحانه وتعالى، وعزَّ وجلَّ. ولو تجهَّزَت الأمة لهذا الشهر الفضيل، وأعدَّت له عُدَّته، وشَمَّر الناس جميعًا سواعد الجِدِّ، وشَدُّوا مآزرهم في الطاعة، لرأَيْنا أمَّة جديدة تُولد ولادةً شرعيَّة، وذلك بعد استعداد جادٍّ ومَخاض، عولِجَت فيه الهمم والعزائم؛ لِتَدخل في الشهر وهي وثَّابة إلى الطاعات. وهذا التمهيد نصيحةٌ لعامَّة المسلمين، بَثَثْتُهَا غَيْرةً على حالهم مع الله - تعالى - في هذا الشهر، وجُهدُ مُقلٍّ أبذله تَأَثُّمًا، ويعلم ربِّي ما هنالك، هي منهاجٌ في كيفية الاستعداد لشهر رمضان، وبيانٌ لبعض الأعمال التي ينبغي أن يقوم بها سالك طريق الآخرة لاستثمار رمضان، إرشادات نَفِيسة من أئمَّة التربية والتزكية من السَّلف الصالح، تقود المرءَ قيادةً حثيثةً للوصول إلى درب القبول، حرَصْتُ فيها أن تكون واقعيَّة وعمَلية، وقبل ذلك: سلَفِيَّة سُنِّية، بيَّنت فيها طرق الاستعداد للشهر الكريم بعزيمة قويَّة قادرة على الاجتهاد الحقيقيِّ في الطَّاعة، بدلاً من الأمانيِّ والأحلام.  وأنا لك ناصحٌ - أخي يا بن الإسلام -:  إذا أردتَ الاستفادة من هذا السِّفْرِ فلا تَمُرَّ على ألفاظه مرَّ الكرام، بل جُلْ بخواطرك حول المعنى ومعنى المعنى فلقد استلَلْت لك النقي، وانتقيتُ لك الأطايب، فإذا استدللتُ بآيةٍ فَحُمْ حول حِماها، ثم طُفْ في أعماق مداها، وإذا ذكرتُ لك حديثًا فتمثَّل نفسك جالسًا بين يدي النبِيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - تَسْمعُه وتتدبَّر عنه، وإذا رَويتُ لك سيرة عبقريٍّ من السَّلف فهَبْ نفسك ترمقه عن كثب، كأنَّك في حضرته تشتار من رحيق كلماته، وبدون ذلك فلا تَتَعَنَّ، فإنما جمَعتُه لك ورتَّبته لتتذوَّق، لا لتقول للناس: قرأتُه! واعلم أخيرًا أنَّ ما ذكرتُه لك في هذا التمهيد ما هو إلاَّ محاولة لتكوين صورةٍ عن الشخصية الربَّانية ذات العلاقة العامرة بإله الكون، والمهيَّأة لسيادة البشريَّة، وإنقاذها من وهدتها.  القواعد الحسان في الاستعداد لرمضان  القاعدة الأولى: بعث الشوق إلى الله واستثارته: فعلى مرِّ الأيام والليالي يخْلَقُ الإيمان في القلب - يَبْلَى - وتَصْدأ أركان المحبَّة، فتحتاج إلى مَن يهَبُك سربالاً إيمانيًّا جديدًا تستقبِلُ به شهر رمضان، وأصل القدرة على فعل الشيء معونة الله، ثم مؤونة العبد، وأعني بالمَؤُونة: رغبتَه وإرادته، فعلى قدْرِ المَعُونة تأتي المَؤونة، والبداية حتمًا من العبد، ثم التَّمام من الله - تعالى - فلا بد من إثارة كوامنِ شوقك إلى الله - عزَّ وجلَّ - حتَّى تلين لك الطاعات، فتؤديها؛ ذائقًا حلاوتَها ولذَّتَها، وأية لذَّة يمكن أن تحصِّلها من قيام الليل، ومكابدة السَّهر، ومُراوحة الأقدام المتعبة، أو ظمأ الهواجر، أو ألم جوع البطون، إذا لم يكن كلُّ ذلك مبنيًّا على معنى: ﴿ وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى ﴾ [طه: 84] ومن لبَّى نداء حبيبه بدون شوقٍ يَحْدوه، فهو باردٌ سمج - قبيح - دعوى محبَّتِه لا طعم لها! لا جرم أنَّه كان من دعاء النبيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - في صلاته - كما روى النَّسائيُّ بسند صحيح -: ((وأسأَلُك الرِّضا بعد القضاء، وبَردَ العيش بعد الموت، ولذَّة النظرِ إلى وجهك، والشوقَ إلى لقائك))... وشوقك لربِّك ولإرضائه أفناه رَيْن الشُّبهات والشهوات، وأهلكته جوائِحُ المعاصي، ومرور الأزمنة دون كدحٍ إلى الله، فتحتاج يا بن الإسلام إلى بعث هذا الشَّوق من جديد لو كان ميتًا، أو استثارته إن كان موجودًا كامِنًا.  فما هي أهمُّ العوامل التي تُساعدك على هذا الأمر العظيم؟!  • مطالعة أسماء الله الحُسْنى وصفاته العُلَى وتدبُّر كلامه، وفَهْم خطابه؛ فإنَّ مِن شأن هذه المطالعة والفهم والتدبُّر فيها أن يَشْحذ من القلب همَّةً للوصول إلى تجليات هذه الأسماء والصفات والمعاني، فتتحرك كوامن المعرفة في القلب والعقل ويأتي عندئذٍ المدد، وراجِعْ لزامًا كلام ابن القيِّم في الفائدة: 36 من فوائد الذِّكر من كتابه: "الوابل الصيب"، وتأمَّل قصة أبي الدَّحْداح - رضي الله عنه - في فهمه كلام ربِّه، كيف حرَّك أريحته، وألبسه حُبَّ البَذْل؛ فعن عبدالله بن مسعودٍ قال: لمَّا نزلَت هذه الآية: ﴿ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ ﴾ [البقرة: 245] قال أبو الدَّحداح الأنصاريُّ وإن الله يريد منَّا القرض؟ قال: ((نعَم يا أبا الدحداح)) قال: أرنِي يدَك يا رسول الله قال: فناولَه رسولُ الله يده قال: فإنِّي أقرضتُ ربِّي حائطي قال: حائطه له ستّمائة نخلة وأمُّ الدحداح فيه وعيالها قال: فجاء أبو الدحداح فنادى: يا أمَّ الدحداح، قالت: لبيك، قال: اخرُجي من الحائط؛ فإنِّي أقرضتُه ربِّي - عزَّ وجلَّ. وفي روايةٍ أخرى أنَّها لما سَمِعته يقول ذلك، عمدَتْ إلى صبيانها تُخرج ما في أفواههم، وتنفض ما في أكمامهم، فقال النبِيُّ - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((كم من عِذْقٍ رَدَاح في الجنَّة لأبي الدحداح)) والعِذْق من النخل كالعنقود من العنب، "رَداح"؛ أيْ: ثقيل؛ لكثرة ما فيه من التَّمر، والقصة في "الإصابة" و"صِفَة الصفوة". وتأمَّل - رعاك الله من عَطَنِ الشُّبهات - كيف فَهِم الصحابيُّ من كلام الله - عزَّ وجلَّ - المعنى الظَّاهر بدون أن يكون في قلبه تردُّد أو تهيُّب؛ وذلك لأن شجرة إيمانه قامت على ساق التَّنْزيه، ولابن القيِّم - رحمه الله - مقالاتٌ رائقة حول كثيرٍ من الأسماء والصفات، جمعَها بعضُهم في كتابٍ مستقل، وللغزاليِّ رسالة اختصرها النبهانيُّ في "مختصر المقصد الأسني" لا تخلو من هَناتٍ تَظهر لممارِس الكتاب والسُّنة، والله المستعان.  • مطالعة مِنَن الله العظيمة وآلائه الجسيمة فالقلوب مَجْبولة على حُبِّ من أحسن إليها؛ ولذلك كَثُر في القرآن سَوْق آيات النِّعم على الخلق والفضل؛ تنبيهًا لهذا المعنى، وكلَّما ازددْتَ علمًا بنعم الله عليك ازددتَ شوقًا إلى شكره على نعمائه.  • التحسُّر على فوات الأزمِنة في غير طاعة الله بل على قضائها في عبادة الهَوى، وهذا اللَّحظ - كما يقول ابن القيِّم - يؤدِّي به إلى مُطالعة الجناية، والوقوف على الخطر فيها، والتَّشمير لتداركها والتخلُّص من رقها، وطلب النَّجاة بتمحيصها.  • تذكُّر سَبْق السابقين مع تخلُّفك مع القاعدين يورثك هذا تحرُّقًا للمسابقة والمسارعة والمنافسة وكلُّ ذلك أمر الله به: ﴿ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ ﴾ [آل عمران: 133] ﴿ سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ ﴾ [الحديد: 21] ﴿ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ ﴾ [المطففين: 26]... واعلم - أخي يا بن الإسلام - أنَّ بعث الشوق وظيفةٌ لا ينفَكُّ عنها السائرُ إلى الله، ولكن ينبغي مُضاعفة هذا الشوق قبل رمضان؛ لِتُضاعف الجهد فيه، وهذا الشوق نوعٌ من أنواع الوَقود الإيمانيِّ الذي يحفِّز على الطاعة ثم به يذوق المتعبِّدُ طعم عبادته ومناجاته. ومجالات الشوق عندك كثيرة؛ أعظمها وأخطَرُها الشوق إلى رؤية وجه الله - تعالى - ويمكنك أن تتمرَّن على قراءة هذا الحديث، مع تحديث نفسك بِمَنْزلتها عند الله، وهل ستَنال شرف رؤيته أوْ لا؟ قال - صلَّى الله عليه وسلَّم - فيما رواه مسلمٌ: ((إذا دخل أهل الجنَّةِ الجنةَ يقول الله - تعالى -: تريدون شيئًا أَزِيدكم؟ فيقولون: ألَم تبيِّضْ وجوهنا؟ ألم تُدْخِلنا الجنة، وتُنجِّنا من النَّار؟ فيكشف الحجاب، فما أُعطوا شيئًا أحبَّ إليهم من النَّظر إلى ربِّهم)).  وفي مجالات الشوق:  الشوق إلى لقاء الله وإلى جنَّتِه ورحمته، ورؤية أوليائه في الجنَّة، وخاصة الشوق إلى لقاء النبيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - في الفردوس الأعلى. واعلم أنَّ لهذا الشوق لصوصًا وقُطَّاعًا يتعرَّضون لك، فاحذر الترَفُّه - وخاصَّة في رمضان - واحذر فتنةَ الأموال والأولاد والأزواج، خَلِّفْهم وراءك ولا تلتفِت، وامضِ حيث تُؤمَر واجعل شعارك في شهر رمضان: ﴿ هُمْ أُولَاءِ عَلَى أَثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى ﴾ [طه: 84]. قال الشاعر فَحَيَّهَلاَ إِنْ كُنْتَ ذَا هِمَّةٍ فَقَدْ  حَدَا بِكَ حَادِي الشَّوْقِ فَاطْوِ الْمَرَاحِلا وَلاَ تَنْتَظِرْ بِالسَّيْرِ رُفْقَةَ قَاعِدٍ  وَدَعْهُ فَإِنَّ العَزْمَ يَكْفِيكَ حَامِلاَ   
__________________
|
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
| أدوات الموضوع | |
| انواع عرض الموضوع | |
|
|
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |