|
|||||||
| ملتقى التنمية البشرية وعلم النفس ملتقى يختص بالتنمية البشرية والمهارات العقلية وإدارة الأعمال وتطوير الذات |
 |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
||||
|
||||
 إدارة المعرفة الإسلامية.. من النظرية إلى التطبيق
يُعدّ مفهوم إدارة المعرفة (Knowledge Management) من أبرز المفاهيم التي تتصدر الفكر الإداري الحديث؛ إذ يمثل الأساس في بناء المؤسسات القادرة على التعلم والتطور واستثمار المعرفة لتحقيق التميز والاستدامة، غير إن المتأمل في التراث الإسلامي يكشف أن هذا المفهوم ليس وليد الفكر الغربي المعاصر؛ بل له جذور عميقة في الحضارة الإسلامية؛ حيث كان المسلمون الأوائل رواداً في تنظيم المعرفة، وتوثيقها، ونشرها، وتوظيفها في خدمة الإنسان والمجتمع. 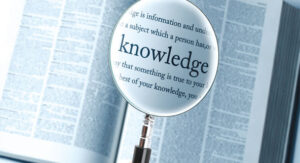 الأساس الشرعي والمعرفي: تقوم المعرفة في التصور الإسلامي على ثلاثة مسارات مترابطة: وهي معرفة الله، ومعرفة النفس، ومعرفة الكون. ومن هنا، فإن إدارة المعرفة ما هي إلا رؤية شمولية تتكامل فيها الغايات الإيمانية مع الوسائل التنظيمية. وهكذا ينطلق التصور الإسلامي لإدارة المعرفة من مبدأ الربانية والتوحيد؛ لأن الله -سبحانه وتعالى- هو مصدر المعرفة؛ فقد علّم آدم الأسماء كلها، وجعل غاية المعرفة والعلم تحقيق عبوديته وإعمار الأرض وفق منهجه، كما في قوله -سبحانه وتعالى-: {وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا}، وكما في الحديث الشريف: «من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً، سهّل الله له به طريقاً إلى الجنة»، فهذه النصوص تؤكد أن العلم في الإسلام عبادة وطريق إلى الكمال الإنساني، وأن المعرفة لا تُطلب لذاتها بل لتحقيق مقاصد الشرع في الهداية والعمران، وكما قيل: «العلم ميراث الأنبياء، والجهل سبب الفناء، ومن أحيا العلم فقد أحيا الأمة.» أهمية إدارة المعرفة: في عصر تدفق المعلومات والبيانات، تبرز (إدارة المعرفة) بوصفها إحدى أهم الحقول المعرفية الحديثة، التي تستهدف تنظيم المعلومات واستثمارها، وتحويلها إلى حكمة وسلوك ورسالة، وقد يظن كثيرون أن هذا المفهوم وليد الحضارة المعاصرة، لكن الناظر في تراثنا الإسلامي يكتشف أن أسس إدارة المعرفة كانت حاضرة بقوة في مشروعنا الحضاري الإسلامي؛ بل كانت أحد أركان نهضتنا عبر القرون. المفهوم الإسلامي للمعرفة: لقد أسس الإسلام رؤية شاملة للمعرفة، تجعل طلبها فريضة، والتعامل معها مسؤولية، كما في قوله -تعالى- في أول ما نزل من القرآن الكريم: {اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ}، وهذا التوجيه الرباني يؤسس لقاعدة تحويل المعرفة إلى عبادة يبتغى بها وجه الله؛ لأنها السبيل إلى عمارة الأرض وخدمة الخلق؛ ولذلك كان «طلب العلم فريضة على كل مسلم»؛ لأن العلم هو الذي يهدي إلى العمل الصالح، ويضبط السلوك، ويحقق الاستخلاف الرشيد في الأرض، وكذلك ما ورد في بيان فضل العلماء في قوله -تعالى-: {قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ} (الزمر:9)؛ فإن هذه الآية وغيرها تؤسس لمركزية العلم في التمييز بين الناس، ولم تكن المعرفة في الرؤية الإسلامية مجرد حشو للمعلومات؛ بل كانت عملية متكاملة تبدأ بالتعلم (الاستماع، القراءة)، ثم الفهم (التدبر، والتحليل)، ثم النقل (التعليم، والكتابة)، وانتهاء بالتطبيق (العمل، والسلوك)؛ فهي منظومة من الإدراك والوعي والسلوك والتطبيق؛ كما كان - صلى الله عليه وسلم - يحث على طلب العلم وكتابته ونشره، كما في قوله - صلى الله عليه وسلم -: «بلّغوا عني ولو آية» وهذه كلها تشكل نواة لمنظومة متكاملة لإدارة المعرفة الشخصية؛ كما جعل الإسلام المعرفة فريضة اجتماعية، لا تقتصر على دعوة الفرد إلى التعلم؛ بل أوجب على الأمة إقامة مؤسسات علمية تحفظ المعرفة وتنميها وتنقلها للأجيال، كما قال -تعالى-: {فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ}.  أسس إدارة المعرفة في الحضارة الإسلامية: لقد تميّز التراث الإسلامي بنظام معرفي منظم يمكن تسميته بـ«إدارة المعرفة الحضارية»، يقوم على مبادئ متينة، كوّنت نواة كل حركة علمية لاحقة، ويمكن تلخيص تلك الأسس فيما يلي: ١- الأمانة العلمية والإسناد: ويعدّ نظام «الإسناد» في علم الحديث من أروع ما أنتجته البشرية في مجال إدارة المعرفة وضبطها؛ فهو ليس مجرد رواية للمعلومة، بل عملية دقيقة لربط المعلومة بمصدرها عبر سلسلة من الرواة العدول، مع التشديد على الصحة والضبط، وقد تضمنت تلك الآلية عناصر التوثيق، والجودة، والحوكمة، وهي أساسيات إدارة المعرفة الحديثة. ٢- التصنيف والتبويب: حيث امتاز العلماء المسلمون ببراعتهم في تصنيف العلوم وتبويبها، ما سهل الوصول إلى المعلومة واسترجاعها؛ وهكذا ظهرت المصنفات الموسوعية، والمعاجم، والفهارس، وكتب الطبقات والتراجم، ويعدّ كتاب «الفهرست» لابن النديم مثالاً مبكراً على «قاعدة بيانات» شاملة للمعارف في عصره. ٣- النقد والتمحيص: فلم يكن التراث الإسلامي مجرد ناقل للمعرفة؛ بل كان منقحاً وناقداً؛ حيث ظهرت علوم نقد الحديث (الجرح والتعديل)، وعلم (مصطلح الحديث)، والنقد الأدبي، والمناظرات العلمية التي تخضع الأفكار للحوكمة العقلية، ويعدّ هذا التوجه النقدي روح عملية «تحديث المعرفة» وتطويرها. ٤- التكامل بين العلوم: لم تعرف الحضارة الإسلامية التجزئة الحادة بين العلوم؛ فقدكان العالم الفلكي طبيباً، والفقيه أديباً، والمهندس فيلسوفاً، وقد شجع هذا التكامل على «الابتكار المعرفي» عبر تلبية العلوم بعضها بعضاً، بما يحقق التكامل بينها. ٥- الحوار والمناظرة: حيث كانت حلقات العلم في المساجد والمجالس العلمية منابر للحوار الحرّ وتبادل الأفكار، وقد شجعت تلك الثقافة على «تشارك المعرفة» وإثرائها عبر تعدد وجهات النظر. ٦- القيم الأخلاقية للمعرفة: لم تكن المعرفة في التراث الإسلامي محايدة، بل مؤطرة بالمقاصد الشرعية والأخلاقية، وقد وضع العلماء ضوابط للعلم النافع، مؤكدين أن الغاية من العلم العمل به ونفع الناس، لا التفاخر أو التعالي. هذا التوجه القيمي هو ما يعطي لإدارة المعرفة الإسلامية بُعدها الإنساني والإصلاحي.  أركان إدارة المعرفة: يمكننا تلخيص أركان منظومة إدارة المعرفة في المنظور الإسلامي كما يلي: 1- اكتساب المعرفة: حيث اعتنى المسلمون باكتساب المعرفة من جميع المصادر المشروعة، فجمعوا بين النقل والعقل، وبين الوحي والتجربة؛ كما دعا القرآن إلى النظر والتفكر؛ فكان طلب العلم يشمل العلوم الشرعية والطبيعية والإنسانية، وقد رحل العلماء من الأندلس إلى خراسان طلباً للحديث أو الفقه أو الطب، ما يعكس ثقافة التعلم مدى الحياة، وهي من ركائز إدارة المعرفة المعاصرة.
 مناهج العلماء في إنتاج المعرفة: تميّز العلماء المسلمون بمنهج علمي في التفكير والبحث، يُعد حجر الزاوية في إدارة المعرفة الإسلامية ومن تلك المناهج ما يلي:
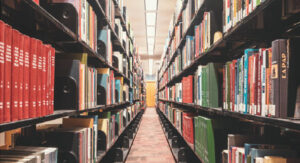 مؤسسات إدارة المعرفة في الحضارة الإسلامية: يُقدّم التاريخ الإسلامي العديد من النماذج الرائدة التي يمكن أن تُعد تطبيقات مبكرة لمفهوم إدارة المعرفة:
 القيم الحاكمة لإدارة المعرفة: تميزت إدارة المعرفة في التراث الإسلامي بارتكازها على منظومة قيمية أصيلة، من أبرزها:
 نموذج إدارة المعرفة الشخصية: كان العلماء قدوة في إدارة معارفهم الشخصية؛ حيث نقرأ عن الإمام البخاري - على سبيل المثال- كيف كان يدوّن الحديث ويحققه ويرتبه في صحيحه، في عملية استغرقت ست عشرة سنة من الجمع والفرز والتحقيق، وكان الإمام الغزالي يكتب كل ما يخطر بباله من فوائد على قصاصات صغيرة، يحملها معه أينما ذهب، وإن مثل هذه الممارسات تعكس وعياً عميقاً بأهمية توثيق المعرفة وتنظيمها. 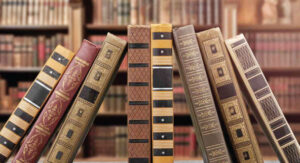 الرؤية المعاصرة لإحياء إدارة المعرفة: تحتاج الأمة - في ظل الثورة التقنية - إلى نظام معرفي معاصر، يستلهم روح التراث ويستفيد من أدوات العصر، ونعني بذلك رقمنة التراث الإسلامي وحفظه في قواعد بيانات مفتوحة تيسر الوصول إليه، مع الحرص على تطوير المناهج التعليمية لربط العلم بالقيم والمقاصد، والعمل على إحياء نظام الوقف العلمي لدعم البحث المستقل والمشاريع المعرفية، مع الحرص على تشجيع التعاون بين العلماء والخبراء والتقنيين لبناء «منصات معرفة إسلامية» موثوقة، وتضمين القيم القرآنية في إدارة المعلومات، مثل الصدق، والأمانة، والعدالة.  التوصيات: وبناء على ما سبق فإنه يمكننا استلهام هذا التراث الغني في عصرنا الحديث من خلال ما يلي:
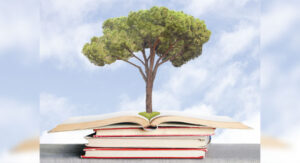 الخاتمة: يحفل تراثنا الإسلامي بمخزون استراتيجي هائل من الحكمة والخبرة، يمكنه أن يلهم حاضرنا ويصنع مستقبلنا، وإن إدارة المعرفة في تراثنا الإسلامي كانت فلسفة حياة، تجمع بين أصالة المصدر، ودقة المنهج، وأمانة النقل، وإبداع الإضافة، وغائية التطبيق، ويمكننا من خلال إحياء هذه الروح، واستلهام مثل تلك النماذج، وتطويعها بأدوات العصر، أن نعيد بناء مشروعنا الحضاري، الذي يقدم المعرفة في إطار من القيم، ويجعل من طلبها عبادة، ومن تطبيقها جهاداً، ومن غايتها رضوان الله -تعالى- وخدمة الإنسانية جمعاء. اعداد: ذياب أبو سارة
__________________
|
 |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |