قرأهما الباحث متأثرًا بالتقنية وفيضان الصورة، فقال: "إن التحوير الذي لجأ إليه الشاعر في خطابه، في أحد طرفي الحوار(الناس – عليائك) ليوحي برغبته في المراوحة في رؤيته للحدث بين السعة والضيق، فكلما ابتعدت الكاميرا جاء المشهد متعدد المناظر، وكلما اقتربت ضاقت الرؤية، وانكمشت عناصر الصورة..." (ص228)
تكررت هذه القراءة في مواضع أخرى من البحث؛ لتأكيد التجاذب بين اللغة التراثية للنص والتصور المعاصر للقارئ، نراها في قوله:"ولكن الصورة لم تقف عند اللقطة النفسية لذات الشاعر، وإنما شملت ذهنه كذلك...لتكتمل الصورة من جميع الزوايا"(ص229) ، وقوله: "وقد يمتد هذا الأسلوب لكن بطريقة اللقطة الكاريكاتورية"، (ص231) فهو يرسم صورًا تقنية يحلِّق بها بعيدًا عن بيئة الشاعر، تقنية تعتمد على الوسائط والصور البصرية التي ربما نتجت عن ثقافة الصورة الناتجة عن متابعة طويلة لشاشة الحاسب الآلي، فالمعنى هنا ليس هو المعنى الكامن في النص، بل هو المعنى الناشئ عن التفاعل بين النص وخبرات القارئ المعرفية، ذلك مما يمكن القارئ من أن يعيش النص كحدث واقع.
وثمة أمر آخر يلفت الانتباه في الشكل العام للبحث، وهو العناية الفائقة بتقسيم عناوين البحث وترقيمها مع تقسيم الأفكار إلى فقرات قصيرة منسقة[42]، ربما يدل هذا أيضًا على اهتمام الباحث بالرؤية البصرية للقارئ، وهي ثقافة تقنية حاسوبية.
(ب-3)
من مبادئ الاستخدام العشرة للشبكة: "التلاعب بالنقاط والشُّرط والشُّرط المائلة"[43]، وهي أدوات لا بد من استيعابها بصريًا، وفي قراءة الباحث نجد مجموعة متنوعة من الأسهم، جميعها تتجه إلى خارج الصفحة، وكأنها لغة إشارية تحاول تجسيد سرعة التحولات في اللحظة نفسها التي تحدث فيها، أو أنها إشارة مجسدة إلى الخبرة والتفاعل مع التقنية.
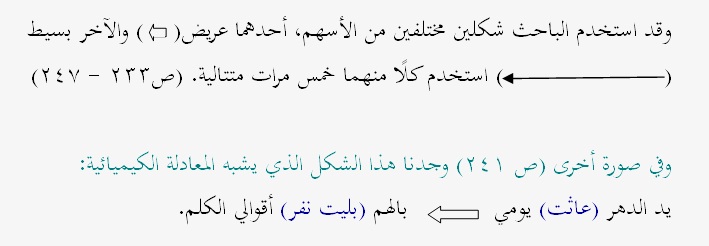
أما الشرطة المائلة (/) فقد استخدمها الباحث بكثرة، ففي تقليب سريع لصفحات البحث تمكنت عيني من عدّ ثلاث وعشرين منها، غير ما ورد في حواشي البحث، وفي المصادر والمراجع. يستخدم الباحث هذه العلامة بين كلمتين ليشير إلى تردده في اختيار إحداهما، مثل: "بؤرة التركيز/مناط الدلالة"(ص226)، أو يستخدمها للتفسير، وهذا كثير مثل: "الآخر/ الممدوح"(ص242)، فهل هناك دلالة متوارية خلف حشد العلامات المجسدة لحضور الخبرة بالشبكة في استخدام الباحث؟ أم هي تعبير عن فكرة تدور في وعي الباحث؛ فأفرزت الشكل الخاص بها؟
(ب-4)
صار الوصول إلى المعلومة من خلال الشبكة من الأمور الميسرة، فنتج عن ذلك تراكم المعلومات التعزيزية في كثير من الأبحاث التي يعتمد أصحابها على شبكة المعلومات في جمع المادة[44].
ويمكن تقسيم هذه المعلومات التعزيزية في قراءة الدكتور وئام إلى قسمين، في القسم الأول منها يستدعي القارئ معلومات بعيدة عن موضوع البحث مثل قوله: "يقول سهل التستري: الألف أول الحروف، وأعظم الحروف وهو الإشارة في الألف إلى الله الذي ألف بين الأشياء، وانفرد عن الأشياء..."(ص231)، نجد هذا النوع من المعلومات في موضعين آخرين من البحث الأول: (ص238) والثاني: (ص240)، فيها يستعرض مادة علمية ربما كان عدم إدراجها بالنص أفضل.
أما القسم الثاني ففيه نجد بعض ملامح الموسوعية في القراءة مع عدم الإشارة إلى المصدر. منها قول الباحث: "...عوامل وراثية: يرى بعض علماء النفس أن أبناء المصابين بالقلق يطورون هذا الاضطراب... عوامل بيولوجية: هناك مجموعة من الاضطرابات الهرمونية، مثل اضطراب الغدة الدرقية، والغدة الكظرية..." (ص220: 221)، وهكذا مع عدم الإشارة إلى مصدر المعلومة؛ فهو اقتطفها من صفحات عامة على الشبكة، فالثقافة المعلوماتية على حد تعبير أحد الباحثين مجرة اختيارية، وأخطبوطية بشكل ما تقوم على اقتراضات لمجالات متنوعة[45].
وبعد:
فقد توصلت الدراسة إلى النتائج الآتية:
• أصبحت تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات من أهم العناصر في تقدم البحث العلمي في العصر الحديث.
• إن تفجر المعلومات في عصرنا الحالي يحتم اللجوء إلى وسائل التقنية الحديثة في دراسة الأدب واللغة.
• إن دخول العرب على شبكة المعلومات الدولية اليوم دخول تراثي من الدرجة الأولى.
• إن القارئ لا يبدع نصه في نطاق مفاهيم اللغة والفن فقط، بل في نطاق الحيز المعرفي المتكامل للخبرة البشرية.
• تؤكد القراءة على فاعلية الذات في قراءة الموضوع، وأننا نستخلص من النص العناصر ذات الصلة بحياتنا.
• التعدد في أنماط التلقي لدى باحثي الشبكة في ما يمكن أن نطلق عليه التلقي التعددي أو المفتوح.
• تُعد القراءة الوثائقية لدى مرتادي الشبكة من الباحثين هي أكثر أنماط القراء سُلطة.
• الثقافة التشعبية التي انتقلت صورتها من الحاسوب إلى البحث الأدبي، إذ يعرض الباحث جوانب كثيرة للفكرة المحورية الواحدة.
• الحضور المكثف للوعي الجمعي لدى باحثي الشبكة.
• التفاعل الإيجابي مع التقنية أدى إلى فيضان الصور والرموز.
• تراكم المعلومات التعزيزية في كثير من الأبحاث التي يعتمد أصحابها على شبكة المعلومات الدولية في جمع المادة.
• تسهم بعض المفردات الخاصة بالشبكة في تلوين لغة القراءة بألوان جديدة تعكس درجة استجابة الباحث لمعطيات العصر.
• اهتمام باحثي الشبكة بالرؤية البصرية للقارئ، هي ثقافة تقنية حاسوبية.
مصادر البحث ومراجعه
1- أحمد الشربيني، الإنترنت شبكة شبكات المعلومات، (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، 2009م).
2- أحمد عبد المعطي حجازي، موت المؤلف موت الإنسان، (الإمارات: دبي الثقافية، العدد 69، فبراير (شباط) 2011م).
3- أيمن إبراهيم تعيلب، الشعرية القديمة والتلقي النقدي المعاصر نحو تأسيس منهجي تجريبي، (القاهرة: المجلس الأعلى للثقافة، 2009م).
4- بيل جيتس، المعلوماتية بعد الإنترنت طريق المستقبل، ترجمة، عبد السلام رضوان، (الكويت: سلسلة عالم المعرفة، يصدرها المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب العدد231، ذو القعدة 1418هـ مارس/آذار 1998م).
5- جين ب. تومبكنز، نقد استجابة القارئ من الشكلانية إلى ما بعد البنيوية، ترجمة، حسن ناظم، وعلي حاكم، (القاهرة: المجلس الأعلى للثقافة، 1999م).
6- حامد أبو أحمد، الخطاب والقارئ نظريات التلقي وتحليل الخطاب وما بعد الحداثة، (القاهرة: النسر الذهبي للطباعة، الطبعة الأولى).
7- ديفيد كريستال، اللغة وشبكة المعلومات العالمية، ترجمة، أحمد شفيق الخطيب، (القاهرة: المركز القومي للترجمة، 2010م).
8- رامان سلدن، النظرية الأدبية المعاصرة، ترجمة، جابر عصفور، (القاهرة: دار قباء، 1998م).
9- روبرت هولَب، نظرية التلقي مقدمة نقدية، ترجمة، د. عز الدين إسماعيل، (السعودية: النادي الأدبي الثقافي بجدة، 1415هـ- 1994م).
10- زاهر محمد الجوهر حنني، الأم ورحلتها في الشعر العربي من الجاهلية إلى نهاية العصر العباسي، (مجلة علوم إنسانية، مجلة إلكترونية دورية محكمة تعنى بالعلوم الإنسانية، السنة السابعة: العدد 43: خريف 2009 م الموقع على الشبكة: http://www.ulum.nl/).
11- عز الدين المناصرة، شعرية النص العنكبوتي، (مصر: مجلة فصول، العدد 79 ، سنة2011م).
12- فليب ريجو، ما بعد الافتراضي استكشاف اجتماعي للثقافة المعلوماتية، ترجمة: عزت عامر، (القاهرة: المركز القومي للترجمة، 2009م).
13- فولفغانغ إيزر. فعل القراءة نظرية جمالية التجاوب في الأدب، ترجمة، حميد لحمداني، والجلالي الكدية، (المغرب: مكتبة المناهل بفاس).
14- فيرناند هالين وآخرون، بحوث في القراءة والتلقي، ترجمة محمد خير البقاعي، (سورية: مركز الإنماء الحضاري بحلب، سنة 1998م).
15- ك.م.نيوتن، نظرية الأدب في القرن العشرين، ترجمة، د.عيسى علي العاكوب، (القاهرة: عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية، 1996م).
16- مارشال و. الكورن – مارك بريشر، الأدب والتحليل النفسي وإعادة تشكيل الذات اتجاه جديد في نظرية استجابة القارئ، ترجمة، صبار سعدوي سلطان، (السعودية: مجلة نوافذ (18) شوال 1422هـ، ديسمبر 2001م).
17- محمد بن أحمد وآخرون، استخدام اللغة العربية في المعلومات، (تونس: المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، سنة 1996م).
18- نادر كاظم، المقامات والتلقي: بحث في أنماط التلقي لمقامات الهمذاني في النقد العربي الحديث دراسة أدبية، (بيروت – لبنان: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ومملكة البحرين: وزارة الإعلام، الثقافة والتراث الوطني، 2003م).
19- نبيل علي، العقل العربي ومجتمع المعرفة مظاهر الأزمة واقتراحات بالحلول، (الكويت: سلسلة عالم المعرفة، يصدرها المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الجزء الأول، نوفمبر 2009م، والجزء الثاني، ديسمبر 2009م).
20- هانز- جيورج جادامر، تجلي الجميل ومقالات أخرى، ترجمة، سعيد توفيق، (القاهرة: المجلس الأعلى للثقافة، 1997م).
21- هانس روبيرت ياوس، جماليات التلقي من أجل تأويل جديد للنص الأدبي، ترجمة، رشيد بنحدو، (القاهرة: المجلس الأعلى للثقافة، 2004م).
22- هشام البدوي، ومحسن عبد المنعم، مقدمة شبكات الحاسبات، (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، 2008م).
23- وئام محمد سيد أحمد أنس، الشكوى في شعر ابن نُباتة، (السعودية: مجلة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابها، العدد الأول، محرم 1430هـ يناير 2009م). موقع جامعة الملك سعود:
http://faculty.ksu.edu.sa/D.weaam/default.aspx
[1] د. محمد بن أحمد وآخرون، استخدام اللغة العربية في المعلومات، (تونس: المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، سنة 1996م)، ص231 .
[2] يبدو ذلك من خلال أسماء المؤلفين أو بلد النشر.
[3] انظر: أحمد عبد المعطي حجازي، موت المؤلف..موت الإنسان، (الإمارات: دبي الثقافية، العدد 69، فبراير /شباط 2011م)، ص17
[4] المقصود بالشبكة، أو الشبكة الرقمية، أو شبكة المعلومات الدولية، أو الشبكة العنكبوتية، أو الإنترنت (Internet) ربط بين مجموعة شبكات على مستوى دول العالم ليكون لها القدرة على تبادل المعلومات بينها من خلال أجهزة كمبيوتر مركزية تسمى باسم أجهزة الخادم (Server)، التي تستطيع تخزين المعلومات الأساسية فيها والتحكم بالشبكة بصورة عامة، كانت بدايتها في مشروع وزارة الدفاع الأمريكية سنة 1960م لربط مجموعة من مراكز البحث العلمي في الجامعات مع وزارة الدفاع. انظر: د. أحمد الشربيني، الإنترنت شبكة شبكات المعلومات، (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، 2009م)، ص1، ود. هشام البدوي، ود. محسن عبد المنعم، مقدمة شبكات الحاسبات، (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، 2008م)، ص1
[5] انظر: د. نبيل علي، العقل العربي ومجتمع المعرفة مظاهر الأزمة واقتراحات بالحلول، (الكويت: سلسلة عالم المعرفة، الجزء الأول، نوفمبر 2009م، والجزء الثاني، ديسمبر 2009م)، ج2 ص61 - 198
[6] فمن يتعامل مع الكتاب الإلكتروني يدرك تمامًا أن الكلمة الإلكترونية ليس لها وجود مادي، وما يظهر على شاشة الحاسب الآلي هو التعبير الافتراضي لاستدعاء المُناظر الرقمي للحرف، أي أنه أمام حزمة رقمية تشبه الكلمات، مما يجعل الكلمة الإلكترونية تفقد عنصر الثبات واليقين. انظر: عز الدين المناصرة، شعرية النص العنكبوتي، (مصر: مجلة فصول، العدد 79 شتاء - ربيع 2011م) ص106
[7] وهذا يعني أن الاختيار في هذا البحث لم يخضع إلى القصدية أو إلى الانتقاء المبني على اطلاع مسبق على الأبحاث.
وإذا كان الاختيار قد وقع على اسمين غير معروفين من الباحثين في الأوساط النقدية العربية – بالقياس إلى أسماء أخرى أكثر شهرة – فهذا يؤكد على طبيعة المعرفة المعلوماتية للشبكة، فهي معرفة جماعية غير نخبوية تتيح فرصًا عديدة للمشاركة في إنتاج المعرفة.
[8] (مجلة علوم إنسانية، مجلة إلكترونية دورية محكمة تعنى بالعلوم الإنسانية، السنة السابعة: العدد 43: خريف 2009م الموقع على الشبكة: http://www.ulum.nl/)
[9] أستاذ مساعد، جامعة القدس المفتوحة، قلقيلة.
[10] (السعودية: مجلة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابها، العدد الأول، محرم 1430هـ يناير 2009م)، ص214: 256
[12] من خلال تتبع تواجد الباحثين على الشبكة تبين أن الدكتور زاهر يمتلك مدونة خاصة على الشبكة عنوانها: (مدونات الدكتور زاهر حنني)، العنوان على الشبكة: http://dr-zaher.maktoobblog.com/
ونشر الدكتور زاهر لبحثه على صفحات مجلة إلكترونية لا يتابعها إلا متصفح للشبكة دليل آخر على تواجده المكثف على شبكة المعلومات.
[13] وهذه طبيعة النشر الرقمي على الشبكة، من رغبة في التواصل مع المتلقي.
[14] تبدو ملامح القص واللصق في: 1- طول الاقتباسات. 2- ضبط الكلمات تماما كما وردت في الكتاب الإلكتروني. 3- لم يوثق أكثر المعاجم التي رجع إليها، كما لم يشر إليها في مصادر البحث ومراجعه؛ فهو لم يطلع على نسخة مطبوعة منها أو حتى نسخة موافقة للمطبوع في تنسيقها.
[15] من سمات البحث المنشور في دورية إلكترونية أنه يُعرض في صفحة رقمية واحدة، لهذا لا توجد أرقام لصفحات البحث.
[16] انظر: هانس روبيرت ياوس، جمالية التلقي من أجل تأويل جديد للنص الأدبي، ترجمة، رشيد بنحدو، (القاهرة: المجلس الأعلى للثقافة، 2004م)، ص23
[17] ربما اختيار الباحث للفترة التاريخية (من الجاهلية إلى نهاية العصر العباسي) له دلالته، فهي فترة تألقت فيها الحضارة العربية على أكثر الحضارات المعاصرة لها.
[18] نادر كاظم، المقامات والتلقي: بحث في أنماط التلقي لمقامات الهمذاني في النقد العربي الحديث دراسة أدبية، (بيروت – لبنان: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ومملكة البحرين: وزارة الإعلام، الثقافة والتراث الوطني، 2003م)، ص62.
[19] بمعنى أنه لو أراد الباحث الوقوف على آفاق تلك المناهج، ثم قام بالبحث على الشبكة الدولية للمعلومات، فسوف تكون النتيجة مزيدًا من التدفق المعلوماتي، يزيد هذا التدفق كلما عاود البحث في وقت آخر؛ ففي كل لحظة تضاف كميات هائلة من المعلومات إلى هذا العالم.
[20] انظر: المرجع السابق، ص63.
[21] انظر: جين ب. تومبكنز، نقد استجابة القارئ من الشكلانية إلى ما بعد البنيوية، ترجمة، حسن ناظم، وعلي حاكم، (القاهرة: المجلس الأعلى للثقافة، 1999م)، ص122 .
[22] نادر كاظم، المقامات والتلقي، ص72.
[23] جين ب. تومبكنز، نقد استجابة القارئ، ص135
[24] المرجع السابق، ص119 ،وانظر، مارشال و.الكورن – مارك بريشر، الأدب والتحليل النفسي وإعادة تشكيل الذات اتجاه جديد في نظرية استجابة القارئ، ترجمة، صبار سعدوي سلطان، (السعودية: مجلة نوافذ (18) شوال 1422هـ، ديسمبر 2001م)، ص61
[25] انظر: عز الدين المناصرة، شعرية النص العنكبوتي، ص110.
[26] أقصد بالتلقي الوثائقي قراءة النص الإبداعي بوصفه مرجعًا اجتماعيًا أو نفسيًا أو دينيًا لأفكار الكاتب وميوله، مع التركيز على صاحب النص أكثر من النص ذاته. انظر: أيمن إبراهيم تعيلب، الشعرية القديمة والتلقي النقدي المعاصر نحو تأسيس منهجي تجريبي، (القاهرة: المجلس الأعلى للثقافة، 2009م)، ص269.
[27] انظر: روبرت هولَب، نظرية التلقي مقدمة نقدية، ترجمة، د. عز الدين إسماعيل، (السعودية: النادي الأدبي الثقافي بجدة، 1415هـ- 1994م)، ص125، وانظر: هانز- جيورج جادامر، تجلي الجميل ومقالات أخرى، ترجمة، سعيد توفيق، (القاهرة: المجلس الأعلى للثقافة، 1997م)، ص33: 34، وانظر: رامان سلدن، النظرية الأدبية المعاصرة، ترجمة، جابر عصفور، (القاهرة: دار قباء، 1998م)، ص176
[28] تبدو ملامح الدفاع عن الذات في قول الباحث: "إن هذه الشكوى تُعد ضربًا من ضروب الاحتجاج على الدهر، ليست شكلًا من أشكال الدناءة أو طأطأة الرأس".(ص246)
[29] انظر: مارشال و. الكورن – مارك بريشر، الأدب والتحليل النفسي، ص61 ، وانظر: رامان سلدن، النظرية الأدبية، ص183- 184
[30] انظر: فولفغانغ إيزر. فعل القراءة نظرية جمالية التجاوب في الأدب، ترجمة، حميد لحمداني، والجلالي الكدية، (المغرب: مكتبة المناهل بفاس)، ص21 ،وانظر: ك. م. نيوتن، نظرية الأدب في القرن العشرين، ترجمة، د.عيسى علي العاكوب، (القاهرة: عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية، 1996م)، ص239: 240 ، وفيرناند هالين وآخرون، بحوث في القراءة والتلقي، ترجمة محمد خير البقاعي، (سورية: مركز الإنماء الحضاري بحلب، سنة 1998م)، ص87- 88 .
[31] "أي أن الفجوات Huecos أو الفراغات Vacios هي المناطق غير المعبَّر عنها في الخطاب، والتي تناط بالقارئ مهمة تعبئتها بما يؤدي إلى انتاج المعنى نتيجة للتفاعل القائم بين النص والقارئ". حامد أبو أحمد، الخطاب والقارئ نظريات التلقي وتحليل الخطاب وما بعد الحداثة، (القاهرة: النسر الذهبي للطباعة، الطبعة الأولى)، ص116 - 117
[32] ذخيرة النص أو رصيد النص هي المنطقة المألوفة التي يلتقي فيها النص والقارئ من أجل الشروع في التواصل. انظر: روبرت هولب، نظرية التلقي، ص208- 209
[33] المقصود بأفق توقع القارئ: أن النص الجديد يستدعي بالنسبة للقارئ مجموعة كاملة من التوقعات التي عودته عليها النصوص السابقة، وتكون طريقة استجابة العمل لتوقع جمهوره مابين: توافق أو تعديل أو تصحيح أو تغيير، ومن ثم فإن أفق التوقعات هو ذاك الذي يتكون لدى القارئ بواسطة تراث أو سلسلة من الأعمال المعروفة قبلًا، وبالحال الخاصة التي يكون عليها الذهن، وتنشأ مع بروز الأثر الجديد عن قوانين جنسه وقواعد لعبته. انظر: هانس روبيرت ياوس، جمالية التلقي، ص45- 47 ، ك.م.نيوتن، نظرية الأدب في القرن العشرين، ص234- 235، وحامد أبو أحمد، الخطاب والقارئ، ص80 .
[34] ديفيد كريستال، اللغة وشبكة المعلومات العالمية، ترجمة، أحمد شفيق الخطيب، (القاهرة: المركز القومي للترجمة، 2010م)، ص44
[35] الخط الأحمر تحت الكلمة يشير إلى أن هناك خطأ إملائيًا، أما الخط الأخضر فهو يشير إلى الحاجة إلى مراجعة العبارة.
[36] انظر: المرجع السابق، ص 264
[37] انظر: عز الدين المناصرة، شعرية النص العنكبوتي، ص 108
[38] انظر: المرجع السابق، ص87
[39] انظر: د. محمد بن أحمد وآخرون، استخدام اللغة العربية في المعلومات، ص119 ، بيل جيتس، المعلوماتية بعد الإنترنت طريق المستقبل، ترجمة، عبد السلام رضوان، (الكويت: سلسلة عالم المعرفة، يصدرها المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب العدد231، ذو القعدة 1418هـ مارس/آذار 1998م)، ص46 -56 .
[40] تتكون الشبكة العالمية/ الإنترنت من مجموعة هائلة من والوثائق المتشعبة أو النص المترابط (Hypertext)؛ فيتمكن المستخدم نتيجة للارتباط بين هذه الوثائق من الانتقال السريع من صفحة إلى أخرى أو من موقع لآخر. ويعود سبب تسميتها بالشبكة العنكبوتية إلى التداخل التام بين الوثائق التي تشكل مواقعها المنتشرة عبر العالم بطريقة تشبه تداخل خيوط شبكة العنكبوت. انظر: المرجع السابق، ص252، و د. هشام البدوي، ود. محسن عبد المنعم، مقدمة شبكات الحاسبات، ص58
[41] انظر: عز الدين المناصرة، شعرية النص العنكبوتي، ص107 - 108
[42] أجرى بعض علماء اللغة بحثًا على بعض التقارير المنشورة على الشبكة؛ فأظهرت النتائج قِصر فقرات هذه التقارير إلى أقصى حد ممكن. انظر: ديفيد كريستال، اللغة والشبكة، ص250- 251.
[43] المرجع السابق، ص99 .
[44] فبإمكان الباحث أن يجول على مكتبات رقمية وافتراضية على شبكة المعلومات، وأن يقلب صفحات كتب وبحوث ومقالات عديدة، وبإمكان الباحث الحصول على صفحات تُؤشَّر بلون متميز للكلمات التي طلبها ضمن النصوص التي وردت فيها، كما أن أكثر المصادر المطبوعة التي يرجع إليها الباحث توجد منها نسخ مصورة بصيغة (PDF)، وهي نسخة طبق الأصل من الكتاب المطبوع.
[45] فليب ريجو، ما بعد الافتراضي استكشاف اجتماعي للثقافة المعلوماتية، ترجمة: عزت عامر، (القاهرة: المركز القومي للترجمة، 2009م) ص16.